

|
|
|||||||
| قسم شخصيات و أعلام جزائرية يهتم بالشخصيات و الأعلام الجزائرية التاريخية التي تركت بصماتها على مرّ العصور |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
![]() ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
علماء وادباء و مفكرين و روائيين وفنانين و شخصيات هامة من منطقة الشاوية
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
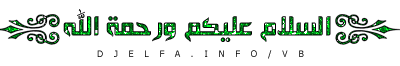 تعتبر منطقة الشاوية في شرق الجزائر من المناطق التي انجبت عبر تاريخها الطويل كمًا كبيرًا من المفكرين والادباء والعلماء ابهرو في كثير من المجالات ودالك عبر حقب تاريخية مختلفة ابتداء بالحضارة النوميدية ثم البزنطية و الاسلامية الى عصرنا الحديث لا يسعنا الوقت لدكرهم جميعًا ولعلنا اردنا دالك على سبيل التعريف والفائدة و الثقافة و الله اعلم : ماستانابال من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة ابن ما سنيسا أخو مكيبسا وغولوسا . توفي نتيجة مرض، كان شارك في الألعاب الأولمبية بتفوق في اليونان. إبنه يوغرطة من زوجة قرطاجية. ************************************************** *************************** أوغسطينوس من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة تأثيره في اللاهوت والفكرالقديس أغسطينوس  بريشة فيليب دي دي شامباني، القرن 17 أسقف تاريخ الميلاد 13 نوفمبر 354طاغست، نوميديا تاريخ الوفاة 28 أغسطس 430مقاطعة هيبو، نوميديا قديس(ة) في الكنيسة: معظم الطوائف المسيحية الرموز الأيقونية طفل؛ حمامة؛ قلم؛ صدفة: قلب مطعون شفيع(ة) إفريقيا؛ عمال المطابع؛ العيون الموجوعة؛ اللاهوتيين القديس أغسطينوس (13 نوفمبر 354 - 28 أغسطس 430) كاتب وفيلسوف من أصل نوميدي-لاتيني ولد في طاغاست (حاليا سوق أهراس، الجزائر) . يعد أحد أهم الشخصيات المؤثرة في المسيحية الغربية. تعتبره الكنيستان الكاثوليكية والأنغليكانية قديسا وأحد آباء الكنيسة البارزين وشفيع المسلك الرهباني الأوغسطيني. يعتبره العديد من البروتستانت، وخاصة الكالفنيون أحد المنابع اللاهوتية لتعاليم الإصلاح البروتستانتي حول النعمة والخلاص. وتعتبره بعض الكنائس الأورثوذكسية مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قديسا. ولد في مملكة نوميديا التي كانت مقاطعة رومانية من أمه الأمازيغية القديسة مونيكا وأبيه الوثني باتريسيوس الأفريقي-اللاتيني. تلقّى تعليمه في روما وتعمّد في ميلانو. مؤلفاته - بما فيها الاعترافات، التي تعتبر أول سيرة ذاتية في الغرب - لا تزال مقروءة في شتى أنحاء العالم. حياته القديس أوغسطين يتحدّر من أصول أمازيغية ولد في تاغست (حاليا سوق أهراس ،الجزائر) عام 354. التي كانت مدينة تقع في إحدى مقاطعات مملكة روما في شمال أفريقيا. عندما بلغ الحادية عشرة من عمره أرسلته أسرته إلى مداوروش، مدينة نوميدية تقع 30 كلم جنوبي تاغست. في عمر السابعة عشرة ذهب إلى قرطاج لإتمام دراسة علم البيان. كانت أمه مونيكا أمازيغية[1] ومسيحية مؤمنة. أما والده، فكان وثنيا رومانيا. ورغم نشأته المسيحية، فإنه ترك الكنيسة ليتبع الديانة المانوية خاذلا أمه. في شبابه عاش أوغسطين حياة استمتاعية وفي قرطاج كانت له علاقة مع امرأة ستكون خليلته لمدة 15 عاما. خلال هذه الفترة ولدت له خليلته ابنا حمل اسم أديودادتوس Adeodatus[2] كان تعليمه في موضوعي الفلسفة وعلم البيان، علم الإقناع والخطابة. بعد أن عمل في التدريس في تاغست وقرطاج انتقل عام 383 إلى روما لظنّه أنها موطن خيرة علماء البيان. إلا أنه سرعان ما خاب ظنه من مدارس روما وعندما حان الموعد لتلاميذه لكي يدفعوا ثمن أتعابه قام هؤلاء بالتهرب من ذلك. بعد أن قام أصدقاؤه المانويون بتقديمه لوالي روما، الذي كان يبحث عن أستاذ لعلم البيان في جامعة ميلانو، تم تعيينه أستاذا هناك واستلم منصبه في أواخر عام 384. في ميلانو بدأت حياة أوغسطين بالتحول. من خلال بحثه عن معنى الحياة بدأ يبتعد عن المانوية منذ أن كان في قرطاج، خاصة بعد لقاء مخيب مع أحد أقطابها. وقد استمرت هذه التوجهات في ميلانو إذ ذهبت توجهت أمه إليها لإقناعه باعتناق المسيحية كما كان للقائه بأمبروسيوس، أسقف ميلانو، أثرا كبيرا على هذا التحول. لقد أعجب أوغسطين بشخصية أمبروسيوس وبلاغته وتأثر من موعظاته فقرر ترك المانوية إلا أنه لم يعتنق المسيحية فورا بل جرّب عدة مذاهب وأصبح متحمسا للأفلاطونية المحدثة. في صيف 386، بعد قراءته سيرة القديس أنطونيوس الكبير وتأثره بها قرر اعتناق المسيحية، ترك علم البيان ومنصبه في جامعة ميلانو والدخول في سلك الكهنوت. لاحقا سيفصّل مسيرته الروحية في كتابه الاعترافات. فقام أمبروسيوس بتعميده وتعميد إبنه في عام 387 في ميلانو. عام 388 عاد إلى أفريقيا وقد توفيت أمه وإبنه في طريق العودة تاركين إياه دون عائلة. بعيد عودته إلى تاغست قام بتأسيس دير.و في عام 391 تمت تسميته كاهنا في إقليم هيبو (اليوم عنابة في الجزائر). أصبح واعظا شهيرا (وقد تم حفظ أكثر من 350 موعظة تنسب إليه يعتقد أنها أصلية) وقد عُرِفت عنه محاربته المانوية التي كان قد اعتنقها في الماضي. في عام 396 تم تعيينه أسقفا مساعدا في هيبو وبقي أسقف هيبو حتى وفاته عام 430. رغم تركه الدير إلا أنه تابع حياته الزاهدة في بيت الأسقفية. الأنظمة الرهبانية التي حددها في ديره أهلته أن يكون شفيع الكهنة. توفي أوغسطين في 18 آب 430 عن عمر يناهز 75 عاما بينما كان الفاندال يحاصرون هيبو. شجع أهل المدينة على مقاومة الفاندال وذلك لإعتناقهم الأريوسية. يُقال أيضا إنه توفي في اللحظات التي كان الوندال يقتحمون أسوار المدينة. يلقب القديس أوغسطين (بابن الدموع) نسبة إلى دموع أمه التي كانت تذرف لمدة عشرين سنة رغبه منها خلال صلاتها لرجوعه إلى ديانته الأولى وهي المسيحية. إن أوغسطين شخصية مركزية في المسيحية وتاريخ الفكر الغربي على حد السواء، يعتبره المؤرخ توماس كاهيل أول شخص من العصور الوسطى وآخر شخص من العصر الكلاسيكي. تأثر فكره اللاهوتي والفلسفي بالرواقية والأفلاطونية والأفلاطونية المحدثة وخصوصا فكر أفلوطينوس مؤلف التاسوعات. حياتهانظر أيضا ************************************************** ************************** تاكفاريناس تاكفاريناس من أهم قادة نوميديا ، الأمازيغية، نشأ في أسرة نبيلة ذات نفوذ كبير، وينتمي لقبيلة موسالامس (Musulamii)، وجنّد مساعدا في الجيش الروماني في سن السادسة عشرة برتبة مساعد، واكتسب أثناء العمل تجربة عسكرية كبيرة؛ لكنه فر من الجندية بعد أن رأى ظلم الرومان الذي كان يمارس ضد الأمازيغيين وتلمس طغيانهم واستبدادهم المطلق. فعين من قبل أتباعه ومحبيه قائدا لقبائل "المزاملة" سنة 17م، فشكل منها جيشا نظاميا من المشاةوالفرسان على الطريقة الرومانية في تنظيم الجيوش. وفقد عمه وأخاه وابنه في الحروب التي خاضها ضد الجيش الروماني في شمال أفريقيا، وقد دامت ثورته سبع سنوات ثم انهزم قتيلا في في منطقة سور الغزلان بالجزائر. وتعلم تاكفاريناس الكثير من خطط الجيش الروماني وطرائقه الاستراتيجية في توجيه الحروب والمعارك، كما اطلع على أسلحته وما يملكه من عدة مادية وبشرية، وما يتسم به هذا الجيش من نقط الضعف التي يمكن استغلالها في توجيه الضربات القاضية إليه أثناء اشتداد المواجهات والمعارك الحامية الوطيس. يعد تاكفاريناس من أهم أبطال المقاومة الأمازيغية قديما، وقد أظهر شجاعة كبيرة في مواجهة المحتل الروماني، وقد لقنه درسا لاينسى في البطولة والمقاومة الشرسة، وهو ما زال محفورا في ذاكرة تاريخ الإمبراطورية الرومانية. كما أخرت مقاومته الشعبية احتلال تامازغا من قبل المتوحش الروماني لمدة طويلة تربو على عقد من الزمن. ولم يتمكن العدو من احتلال بعض أجزاء أفريقيا الشمالية إلا بعد مقتل تاكفاريناس في ساحة الحرب. محتويات تاكفاريناس من أهم قدات نوميديا، نشأ في أسرة نبيلة ذات نفوذ كبير، وينتمي لقبيلة موسالامس، وۥجنّد مساعدا في الجيش الروماني في سن السادسة عشرة برتبة مساعد، واكتسب أثناء العمل تجربة عسكرية كبيرة؛ لكنه سيفر من الجندية بعد أن رأى ظلم الرومان الذي كان يمارس ضد الأمازيغيين وتلمس طغيانهم واستبدادهم المطلق. فعين من قبل أتباعه ومحبيه قائدا لقبائل" المزاملة" سنة 17م، فشكل منها جيشا نظاميا من المشاة والفرسان على الطريقة الرومانية في تنظيم الجيوش. وفقد عمه وأخاه وابنه في الحروب التي خاضها ضد الجيش الروماني في شمال أفريقيا، وقد دامت ثورته سبع سنوات ثم قتل في معركة في منطقة سور الغزلان بالجزائر. وتعلم تاكفاريناس الكثير من خطط الجيش الروماني وطرائقه الاستراتيجية في توجيه الحروب والمعارك، كما اطلع على أسلحته وما يملكه من عدة مادية وبشرية، وما يتسم به هذا الجيش من نقط الضعف التي يمكن استغلالها في توجيه الضربات القاضية إليه أثناء اشتداد المواجهات والمعارك الحامية الوطيس. أسباب مقاومة تاكفاريناسإذا كان موقف الأمازيغيين من الفينيقيين والقرطاجيين إيجابيا، فإن موقف الأمازيغيين من الرومان كان سلبيا إلى حد كبير؛ لأن الحكومة الرومانية كانت تسعى إلى التوسع والاستيطان واستغلال ثروات شعوب الآخرين عن طريق التهديد وإشعال الفتن والحروب كما فعلت مع الدولة القرطاجنية في تونس في إطار ما يسمى بالحروب البونيقية. تطور مقاومة تاكفاريناس ضد الاحتلال الرومانيوإذا كان القرطاجنيون قد اهتموا بالتجارة والصيد، فإن الرومان كانوا يركزون كثيرا على الفلاحة؛ مما دفعهم للبحث عن الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة. وهذا ما أدى بالحكومة الرومانية للتفكير في استعمار شمال أفريقيا قصد نهب خيراتها والاستيلاء على أراضيها التي أصبحت فيما بعد جنانا للملاكين الكبار وإقطاعات لرجال العسكر وفراديس خصبة للساهرين على الكنيسة في حين أصبح الأمازيغيون عبيدا أرقاء وخداما رعاعا وأجراء مستلبين في أراضيهم مقابل فضلات من الطعام لاتقي جوع بطونهم التي كان ينهشها الفقر والسغب. ومن ثم، « طبقت روما سياسة اقتصادية جشعة طوال احتلالها، تلخصت في جعل ولاياتها تخدم اقتصادياتها وتلبي حاجياتها من الغذاء والتسلية لفقرائها... والتجارة المربحة لتجارها والضرائب لدولتها... والإبقاء على النزر اليسير لسد متطلبات عيش الأمازيغ الخاضعين...". ويعني هذا أن سياسة الرومان في أفريقيا الشمالية كانت تعتمد على التوسع والغزو وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلها الداخلية وتصديرها إلى الخارج مع البحث عن الموارد والأسواق لتحريك دواليب اقتصادها المعطل وإيجاد مصادر التمويل والتموين لقواتها العسكرية الحاشدة عددا وعدة. ومن ثم، لم " يكتف الرومان باحتلال أجود الأراضي الفلاحية الأمازيغية فحسب، بل قام الإمبراطور الروماني أغسطس بتشجيع استيطان عدد مهم من سكان إيطاليا في شمال إفريقيا، خصوصا منهم الجنود وقادة الجيش المسرّحون أو المتقاعدون ورجال الأعمال والتجار مما كان له دوره في تغيير التوازن والتوافق السكاني، الذي كان سائدا في السابق بين ساكنة المنطقة، بل كلما تم استقدام أعداد منهم من إيطاليا، إلا ويكون على حساب الأراضي الفلاحية والرعوية للأهالي الأمازيغ. ويظهر هذا في نسبة العمران والتمدين الروماني الذي بدأ في سواحل البحر المتوسط خصوصا بعد فترة الإمبراطور أغسطس. أما المناطق الداخلية فلم تبق بمعزل عن هذه التطورات خصوصا أن الرومان كانوا يضمون الأراضي الأمازيغية باستمرار نحو الداخل، إما بهدف الحصول على أراضي جديدة للقادمين الجدد، أو الحصول على أماكن بناء الحصون والقلاع لحماية أراضي المعمرين.". ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى اندلاع ثورة تاكفاريناس الانتقام للملك الأمازيغي الأول يوغرطة الذي وحد الأمازيغيين وأعدهم لمواجهة العدو الروماني الغاشم، بيد أن الجيش الروماني نكل به تنكيلا شديدا ليكون عبرة للآخرين، وأيضا الثأر من الجيش الروماني نظرا لما قام به من اعتداء صارخ على القبائل الموسولامية التي وقفت كثيرا في وجه الغزو الروماني، ناهيك عن التفاوت الطبقي والاجتماعي في المجتمع الأمازيغي الذي خلقه الاحتلال الروماني، وتردي أحوال الفقراء والمعدمين وهذا ما سيؤدي بهم فيما بعد إلى ثورة جماعية تسمى بالدوارين؛ لأنهم كانوا يحومون ويدورون حول مستودعات الحبوب لسرقتها. ولا ننسى رجال الكنيسة الأمازيغيين الذين ساهموا في إشعال عدة فتن وثورات ضد المحتل الروماني خاصة الدوناتيين نسبة إلى رجل الدين الأمازيغي المسيحي دوناتوس الذين كانوا يطالبون إخوانهم الأمازيغيين بعدم الانتظام في الجندية الرومانية وطرد كبار الملاك من أراضيهم وأصحاب النفوذ من المسيحيين الكاثوليك من بلادهم. لم يرض تاكفاريناس بالتدخل الإيطالي ولم يقبل كذلك بالظلم الروماني وبنزعته التوسعية الجائرة التي استهدفت إخضاع الأمازيغيين وإذلالهم ونهب ثرواتهم والاستيلاء على خيراتهم وممتلكاتهم عنوة وغصبا. كما لم يرض بتلك السياسة العنصرية التي التجأ إليها الرومان لطرد الأمازيغيين خارج خط الليمس (Limes) وهو خط دفاعي يفصل الثلث الشمالي المحتل عن الجنوب الصحراوي غير النافع. وقد ۥشيّد هذا الخط الفاصل بعد القرن الثاني الميلادي بعد أن تمت للرومان السيطرة الكاملة على أراضي أفريقيا الشمالية. ويتركب خط الليمس من جدران فخمة شاهقة وخنادق وحفر وحدود محروسة وقلاع محمية من قبل الحرس العسكري، ويمكن تشبيهه بالجدار المحصن ضد الهجوم الأمازيغي المحتمل. وكان هذا الخط الفاصل يتكون من الفوساطوم الذي يتألف من أسوار تحفها خنادق من الخارج، ومن حصون للمراقبة غير بعيدة عن الفوساطوم، وطرق المواصلات الداخلية والخارجية التي تتصل بالفوساطوم قصد إمداد الحاميات بالمؤن والأسلحة. ويعني هذا أن خط الليمس كان يقوم بثلاثة أدوار أساسية: دور دفاعي يتمثل في حماية الحكومة الرومانية في إفريقيا الشمالية والحفاظ على مصالحها وكينونتها الاستعمارية من خلال التحصين بالقلاع واستعمال الأسوار العالية المتينة الشاهقة، ودور اقتصادي يكمن في إغناء التبادل التجاري مع القبائل الأمازيغية التي توجد في المنطقة الجنوبية لخط الليمس، ودور ترابي إذ كان الليمس يفصل بين منطقتين : منطقة شمالية رومانية ومنطقة جنوبية أمازيغية. ولا يعبر هذا الخط الواقي إلا عن سياسة الخوف والحذر وترقب الهجوم الأمازيغي المحتمل في كل آن ولحظة.
هذا، ولقد امتدت مقاومة تاكفاريناس شرقا وغربا لتوحيد الأمازيغيين قصد الاستعداد لمواجهة الجيش الروماني المحتل. وكانت الضربات العسكرية التي يقوم بها تاكفاريناس تتجه صوب القاعدة الرومانية الوسطى مع استخدام أسلوب المناورة والتشتت للتجمع والتمركز مرة أخرى، والتسلح بحرية الحركة و استخدام تقنية المناورة واللجوء إلى الانسحاب والمباغتة والهجوم المفاجئ وحرب العصابات المنظمة لمحاصرة الجيش الروماني وضربه في قواعده المحصنة. وهذه الطريقة في المقاومة لم يألفها الجيش الروماني الذي كان لايشارك إلا في الحروب والمعارك النظامية وينتصر فيها بكل سهولة نظرا لقوة عتاده المادي وعدته البشرية والعسكرية. ويبدأ امتداد تاكفاريناس من طرابلس الحالية غربا حتى المحيط الأطلسي شرقا والامتداد في مناطق الصحراء الكبرى جنوبا. وكل من يستقرى تاريخ مقاومة تاكفاريناس لابد أن يعتمد على كتابات المؤرخ اللاتيني تاكيتوس الذي كان قريبا من تلك الأحداث، ولكنه لم يكن موضوعيا في حولياته التاريخية وأحكامه على الأمازيغيين، وكان ينحاز إلى الإمبراطورية الرومانية وكان يعتبر تاكفاريناس ثائرا إرهابيا جشعا يريد أن يحقق أطماعه ومآربه الشخصية على حساب الآخرين وحساب أصدقائه القواد مثل: القائد الشجاع مازيبا. ويعني هذا حسب المؤرخ اللاتيني الروماني تاكيتوس أن الحكومة الرومانية لم تأت إلى أفريقيا الشمالية إلا لتزرع الخير وتنقذ الجائعين وۥتحضّر البدويين والرحل الرعاع وتزرع السلام والمحبة بين الأمازيغيين، بينما - والحق يقال- لم تقصد الجيوش الرومانية ربوع تامازغا بجيشها الجرار وأسلحتها الفتاكة سوى لاحتلالها والاستيطان بها والاستيلاء على أراضيها ونهب ثرواتها والتنكيل بأهاليها. ويقول تاكيتوس في حق تاكفاريناس:" اندلعت الحرب في إفريقية في نفس السنة (17م)، وكان على رأس الثوار قائد نوميدي يسمى تاكفاريناس، كان قد انتظم بصفة مساعد في الجيوش الرومانية ثم فر منها. وفي أول أمره جمع حوله بعض العصابات من قطاع الطريق والمشردين وقادهم إلى النهب، ثم جعل منهم مشاة ففرسانا نظاميين وسرعان ما تحول من رأس عصابة لصوص إلى قائد حربي للمزالمة، وكانوا قوما شجعانا يجوبون الفلوات المتاخمة لإفريقية. وحمل المزالمة السلاح وجروا معهم جيرانهم الموريين الذين كان يقودهم مازيبا. واقتسم القائدان الجيش، فاستبقى تاكفاريناس خيرة الجند، أي جميع من كانوا مسلحين على غرار الرومان ليدربهم على النظام ويعودهم على الامتثال، أما مازيبا فكان عليه أن يعمل السيف ويشعل النار ويذعر الذعر بواسطة العصابات". ويستعمل تاكيتوس (تاسيت Tacite) أسلوبا ذكيا في توجيه الطعنات إلى تاكفاريناس عندما اعتبره رجل عصابة يفر من الجندية ويتحول إلى قائد عسكري خائن أناني يستحوذ على خيرة الجند، بينما لا يترك لصديقه مازيبا سوى عصابة من الإرهابيين تنشر الذعر في نفوس الأبرياء من الروم!!! ونحن سنقلب القراءة لتتجه عكس مسار قراءة تاكيتوس لنثبت بأن تاكفاريناس كان رجلا شجاعا ومواطنا أمازيغيا غيورا على بلده، لم يرض بالضيم الإيطالي والذل الروماني، فوحد القبائل الأمازيغية سواء أكانت في الشرق أم في الغرب أم في الجنوب، أي إنه استعان بكل القبائل المناوئة للمحتل الروماني حتى بالقبائل الصحراوية التي كانت ترفض هذا العدو المغتصب وتناهضه. وتعتمد مقاومة تاكفاريناس على نوعين من القوات العسكرية : قوة عسكرية منظمة على الطريقة الرومانية التي تتكون من المشاة والفرسان، وقوة غير منظمة تتخذ شكل عصابات مباغتة مشروعة في أهدافها ونواياها توجه ضربات خاطفة موجعة للجيش الروماني وتزرع في صفوفه الرعب والهلع والخوف، وفي دياره الدمار والخراب وخاصة في موسم الحصاد أثناء جني المحصول، وبذلك كان يوجه الضربات السديدة إلى الاقتصاد الروماني بحرق المحصول أو السيطرة عليه أو منع الأمازيغيين من بيعه للحكومة الرومانية التي احتلت الأمازيغيين لمدة خمسة قرون. وبالتالي، فهذه" الحرب أضرت بالمصالح الاقتصادية لروما. فكانت جميع المعارك تقع في أواخر الربيع وفصل الصيف، ومن بين أسباب ذلك إغارة تاكفاريناس على المدن وقت الانتهاء من حصاد الحبوب للسيطرة على المحصول من جهة وللحيلولة دون بيع كل غلة الحبوب لروما. كما كان تاكفاريناس يشتري الحبوب من التجار الرومانيين للحيلولة دون وصولها إلى العاصمة الإمبراطورية".. وقد استمرت ثورة تاكفاريناس في مواجهة الرومان مدة سبع سنوات من 17م إلى 24م سنة مقتله في معركة الشرف ضد الجيش الروماني. ويعني هذا أن ثورة تاكفاريناس ثورة عنيفة شرسة، وتعتبر أقوى مقاومة في تاريخ الحضارة الأمازيغية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وهي لا تعبر عن صراع الحضارة والبداوة أو الصراع الطاحن بين النظام والفوضى كما يقول الكثير من المؤرخين الغربيين بما فيهم المؤرخ الروماني تاكيتوس صاحب كتاب الحوليات، بل هي تعكس صراعا جدليا بين الظلم والحق وبين الحرية والعبودية. ومن أسباب نجاح ثورة تكافاريناس أنه تبنى عدة طرائق في المواجهة العسكرية ولاسيما الجمع بين الخطة النظامية وحرب العصابات وتوحيد القبائل الأمازيغية في إطار تحالف مشترك واستغلال الظروف العصيبة التي كانت تمر بها الحكومة الرومانية لضربها ضربات موجعة. وبالتالي، لم يقتصر في تحالفه على قبائل الموسلام، بل انفتح على القبائل الصحراوية وتحالف مع الموريين، أي مع قوات موريطانيا الطنجية التي كان يقودها مازيبا. أما الحاكم يوبا الثاني ملك موريطانيا الطنجية فقد كان عميلا للرومان ومتحالفا مع الحكومة القيصرية، لذلك لم يستجب له الشعب وانساق وراء القائد مازيبا الثائر، دون أن ننسى قبائل الكينيتيين الشجعان الذين كانوا يوجدون في الجنوب الشرقي للقبائل الموسولامية وقد تحالفوا عن اختيار وطواعية مع القائد البطل تاكفاريناس. وبعد أن استجمع تاكفاريناس القبائل الثائرة عبر المناطق الجنوبية لخط الليمس من سرت حتى المحيط الأطلسي انطلق في هجماته التي كانت تخضع للمد والجزر والهجوم والانسحاب، ولكنه استطاع أن يلحق عدة هزائم بالجيش الروماني وأن يقض مضجع الحكومة المركزية في روما. وكان تاكفاريناس يعتمد على البدو الذين كانوا يعرفون مناطق الصحراء ويتحركون بسرعة على جمالهم ويباغتون الجيش الروماني في الوقت الذين يحددونه والمكان الذي يعينونه ويختارونه بدقة. لذالك، كانت الكرة في مرمى جيش تاكفاريناس يستخدمها في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. بينما ينتظر الجيش الروماني ضربات الهجوم للرد عليها. ولكن الرومان استطاعوا أن يتحالفوا مع الأمازيغيين الموالين لهم كيوبا الثاني وابنه بطليموس وأن يسخروا الجنود الأمازيغيين لضرب إخوانهم ؛ وكان المثل عند كل المحتلين لأراضي الأمازيغ من الرومان مرورا بالبيزنطيين إلى الوندال:" ينبغي أن تحارب الأمازيغيين بإخوانهم الأمازيغيين". بيد أن يوبا الثاني وابنه بطليموس لم يستطيعا أن يؤثرا على الموريين الذين مالوا إلى تاكفاريناس ومازيبا للدفاع عن أراضيهم المغتصبة من قبل الرومان وحرياتهم الطبيعية والمشروعة التي يريد الرومان انتزاعها من أصحابها ليحولونهم إلى أجراء وأرقاء مذلولين. ويقول تاكيتوس في حولياته:" تاكفاريناس لا زال ينهب في إفريقيا مساندا من طرف الموريين الذين فضلوا مساندة الثورة على الولاء للعبيد العتقاء الذين يشكلون حاشية الملك الصغير بطليموس.". وقد هاجم تاكفاريناس حصون الجيش الروماني وقلاعه وهدد مدينة" تهالة"، وطالب الرومان بأراضي خصبة لزراعتها أو للرعي فيها، لكن الرومان استمالوا بعض أتباع تاكفاريناس ووعدوهم بالعفو وبأجود الأراضي لزراعتها. وهكذا دب الشقاق في جيش تاكفاريناس وانتشرت الخيانة. وفي جهة مقابلة، سارعت الحكومة الرومانية إلى توشيح كل القادة العسكريين الذين يصدون بعنف لهجمات تاكفاريناس ووضعوا تماثيل شاهدة على إنجازاتهم. وقد قال تاكيتوس ساخرا بذلك:" يوجد في روما ثلاثة تماثيل متوجة وتاكفاريناس لا زال حرا طليقا في إفريقيا". لكن مع تعيين البروقنصل كورنيليوس دولا بيلا Coelius Dolabella، ستتغير موازين الحرب في أفريقيا الشمالية وسيحاصر هذا القائد الروماني الجديد جيوش تاكفاريناس بعد أن قضى على الكثير من أتباعه الموزولاسيين واستطاع أن يباغت جيشه في حصن أوزيا شرق نوميديا في الصباح الباكر قبل استيقاظ قوات تاكفاريناس، فاستطاع بسهولة أن يقبض على ابن الثائر أسيرا، وأن يتمكن من أخ تاكفاريناس. وبعد ذلك، دخل دولابيلا في معركة حامية الوطيس مع القائد تاكفاريناس الذي توفي في المعركة سنة 24م. وكانت هذه الهزيمة في الحقيقة نتاجا للخيانة التي دبرت في الكواليس الرومانية في تنسيق مع الأهالي الأمازيغيين، ومن هنا، طعن تاكفاريناس في الظهر كما في كل السيناريوهات الحربية والعسكرية التي حبكت من قبل الرومان للتخلص من أعدائهم الأمازيغيين... ويقول محمد بوكبوط مصورا نهاية تاكفاريناس:" شن تاكفاريناس الحرب على المدن والقرى الخاضعة للرومان، وامتدت الحركة من موريطانيا إلى خليج السرت، مما جعله يضغط بقوة ويطالب الإمبراطور بتسليمه الأراضي، مهددا بشن حرب لاهوادة فيها. غير أن الرومان استطاعوا أن يحدثوا شرخا في صفوف الثوار الأمازيغ، بقطع الوعود وتقديم تنازلات بسيطة. ورغم ثورة الموريين عقب تولي بطليموس، فإن البروقنصل دولابلا Dolabella أفلح في الظفر بتاكفاريناس الذي قتل وهو يحارب سنة 24م. لتنتهي بذلك ثورته." ************************************************** ************************************************** ****** دوناتوس دوناتوسرجل دين مسيحيأمازيغي ولد في الجزائر في منطقة الأوراس قاد ثورة ضذ الرومانوالبيزنطيين درس الدين المسيحي ثم تدرج في مناصب المسيحية قاد الحركة الدوناتية أصبح له انصار من الأمازيغ فنجحت الدوناتية بتحول المقاومة العسكرية إلى دينية (المسيحية لوطنية) نجح انصار دوناتوس في تقليص نفوذ المذهب الكاثوليكي الروماني في ذلك الوقت. ************************************************** ****************************** لوكيوس أبوليوس لوشيوس أبوليوس [1] أو لوسيوس أبوليوس [2] أو لوكيوس أبوليوس و بالأمازيغية أفولاي (125 ق.م - 180 ق.م) ترعرع في مداوروش هو كاتب لاتيني وخطيب أمازيغي نوميدي وفيلسوف وعالم طبيعي وكاتب أخلاقي وروائي ومسرحي وملحمي وشاعر غنائي. ولد في حوالي عام 125 قبل الميلاد، في مدينة مادور، والتي يطلق عليها اليوم مداوروش في ولاية سوق أهراس، الجزائر. كان يسمي نفسه في مخطوطاته أحيانا " أبوليوس المادوري الأفلاطوني " و" الفيلسوف الأفلاطوني " أحيانا أخرى.يعتبر صاحب أول رواية في التاريخ وتوفى سنة180 قبل الميلاد. كتب رواية التحوُّلات أو التغيّرات باللغة اللاتينية القديمة، وهي الرواية الوحيدة بتلك اللغة التي لها نسخة محفوظة بحالة سليمة. وُيطلق على الرواية أيضًا الحمار الذهبي. وقد كتبت في 11 جزءًا، بأسلوب طغى عليه التعقيد والمحسنات اللفظية. وتتعرّض لمغامرات شاب يُدْعَى لوسيوس، شاءت الصدف أن يُمسخ حمارًا. فصار يتنقَّل من مكان إلى مكان، وهو يُمعْن النظر في غباء البشر وقسوتهم. وأخيرًا تنجح الإلهة المصرية إيزيس في إعادته إلى هيئته البشرية. وتحتوي الرواية على العديد من الحكايات القصيرة، أشهرها قصة كِيُوبيد وبْسيشة. تتناول بعض كتاباته المحفوظة الأخرى السحر والخطابة والفلسفة، ويعد كتابه الحمار الذهبي أقدم نص روائي مكتوب في تاريخ الرواية الإنسانية. بين عامي 143 ق.م حتى 150 ق.م سافر بين مدن ساموس وهيرابولس وروما عاصمة الإمبراطورية الرومانية وزار أيضا آسيا الصغرى وبلاد المشرق والإسكندرية في مصر، ثم استقرّ في أويا (طرابلس) ممارساً للطب، "وتزوج ليبيّةً تدعى إميليا بودنتيلا، إلا أن أقرباءها اتهموه بالسحر، طمعاً في ثروة زوجته الغنية، وطالبوا بمحاكمته، وكانت عقوبة السحر في القانون الرومان هي الاعدام، فأعدّ لمحاكمته "مرافعة صبراتة" ساخراً من خصومه حيناً، مجلاً هيئة القضاء حينا آخر، أو مسترسلاً في شرح أساليب التجربة العلمية في الطب أوالفيزياء أو البصريات، محولاً الاتهام إلى عمل صادر عن جهل وانعدام معرفة، وجاعلاً مرافعته واحدة من أشهر القطع الأدبية في تاريخ إفريقيا الرومانية. ثم استقر أبوليوس في قرطاج متدرّجاً في الكهنوت، حتى سُمي كاهناً أكبر للمدينة وراعياً لمجلس الولاية، ومسؤولاً عن إقامة الشعائر والطقوس العامة. ثم انصرف إلى كهانة معبد الإله اسقليبيوس في معبد الإله الكنعاني أشمون، المقام على ربوة بِرصا... وكان أبوليوس إلى جانب لغته اللوبية ومعرفته باللغة القرطاجية يكتب أويقف خطيباً باللغتين الإغريقية واللاتينية. روي عنه أنه قال: "إني لأنهض بالأمر كله على السواء باللسان الإغريقي أو اللاتيني بنفس الإقبال والوثوق وبنفس الجد وبنفس الطراز والأسلوب". وقال: "أمبيدوقل ينظم القصائد، وأفلاطون يصنّف المحاورات، وسقراط يضع الأناشيد، وأبيكاروس يصنّف مشاهد التمثيل الإيمائي، وكسينوفون يؤلف القصص التاريخية، وغراتس يصنع الأهاجي، أما صاحبكم أبوليوس، فهو يجمع كل هذه الأصناف ويتعامل مع ربات الفنون التسع". وقد انعزل أبوليوس عن الحياة العامة منذ 164، ولا تعرف نهايته على وجه التحديد".[3] مؤلفات أبوليوس  لوكيوس أبوليوس
يوداس يوداس من أهم أبطال المقاومة الأمازيغية الذين حاربوا الاحتلال البيزنطي إلى جانب سالبوس وقرقزان وييرنا وأنطالاس … ويعتبر يوداس الأمازيغي أيضا من أهم مناضلي القبائل المورية الذين وقفوا في وجه الاحتلال البيزنطي في القرن السادس الميلادي. والمقصود بالقبائل المورية في الكتابات التاريخية القديمة: " مجموع سكان شمال أفريقيا المستقرين في المنطقة الممتدة من خليج السرت شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، باستثناء العناصر الرومانية أو المترومنة؛ وهو المعنى الذي انتهى إليه المصطلح الموري في القرنين الخامس والسادس الميلاديين.أي جميع العناصر غير المترومنة سواء انتمت أو لا إلى القبائل المستقرة داخل التراب الخاضع للسلطات السياسية الأجنبية، يقابله مصطلح الروماني الذي يشار به من خلال المصادر إلى كل عنصر أثبت انتماءه إلى الحضارة الرومانية. فالفصل بين العناصر المترومنة والموريين، قائم بالأساس على اختلاف نمط الحياة لدى كل منهما، فيكون الروماني هو ذلك الشخص المخلص للحياة الحضرية وجميع المظاهر الرومانية التي انتشرت بشمال أفريقيا، وعلى رأسها اللغة اللاتينية والدين المسيحي. أما الموري فهو من ظل مخلصا لتقاليده القبلية، ومحافظا على أعرافه المحلية." ويعني هذا، أن الموري هو الأمازيغي النقي الذي تشبث بلغته المحلية وعاداته وتقاليده الموروثة ولم يترومن كباقي الأمازيغيين المنبهرين بالحضارة اللاتينية الرومانية، وهناك من يربط الموري بالثورة والتمرد عن السلطة السياسية والمقاومة الشرسة لأي احتلال يحاول تذليل الأمازيغيين وتركيعهم كما عند المؤرخ كامبس. ومع القرن الخامس الميلادي، ستستقل مجموعة من القبائل المورية في الولايات الطرابلسية والنوميدية، الشيء الذي سيمكنها من التأثير على أحداث شمال أفريقيا وتغيير مجرى الأحداث التي رسمتها الدولة الوندالية في هذه المناطق لصالح المقاومة التي أدت إلى طرد الأعداء من تامازغا ومحاولة تحقيق الاستقلال الذاتي وتشكيل دويلات صغرى إلى أن يحل الفتح العربي الإسلامي ليدمجها في كيان قومي عربي واحد. محتويات
1-من هو يـــوداس أو إيوداس؟ أصوله : يوداس أمازيغي يعود اصله إلى منطقةغسيرة الان يعد يوداس أو إيوداس من كبار المقاومين الأمازيغيين الموريين في شمال أفريقيا في القرنين الخامس و السادس الميلاديين ، إذ كرس كل حياته في خدمة بلده ومملكته و مقاتلة الوندال والبيزنطيين الذين استهدفوا احتلال نوميديا واستغلالها والتنكيل بساكنتها . وقد ولد يوداس في جبال الأوراس بمنطقة نوميديا، وعد من كبار قواد الأوراسيين الذين خدموا القضية الأمازيغية ودافعوا عن حرية المملكة الأوراسية واستقلال الجزائر القديمة وتحريرها من قبضة الوندال أولا وبطش البيزنطيين ثانيا. وقد خاض حروبا حامية الوطيس ضد القوات الوندالية التي تغلغلت في شمال الجزائر ووسطها من أجل استعمار نوميديا والتنكيل بساكنتها المحلية قصد بسط نفوذها العسكري واستغلال ثروات المنطقة ولاسيما الفلاحية منها. هذا، و أصبح يوداس فيما بعد أميرا أو قائدا أو ملكا للقبائل الأوراسية المستقلة بعد تراجع النفوذ الروماني في بلاد تامازغا سياسيا وعسكريا واقتصاديا أمام ضربات الونداليين والبيزنطيين. والدليل على اتخاذ حكام الموريين لهذه الألقاب السامية أنه في القرن السادس الميلادي تشكلت على يد القبائل المورية" نواة مؤسسات سياسية، يرأسها قادة موريون اتخذوا في بعض الأحيان اللقب الملكي، وهذه المؤسسات ليست مؤسسات محدثة ناتجة عن اندحار المملكة الوندالية، بل تعود إلى بداية تراجع الإمبراطورية الرومانية عن أجزاء هامة من شمال أفريقيا. ومع سقوط المملكة الوندالية اتسعت حركة استقلال القبائل المورية في مناطق واسعة من ولاية نوميديا وبيزاكينا وموريطانيا القيصرية وغيرها من الولايات. ويبدو أن كوريبوس، حين أشار إلى استقلال القبائل المورية، نعت زعيم الموريين بلقب لاتيني وهو Princeps الذي يعني الأول بين أقرانه ويترجم عادة بالأمير، أما بروكوب فلقد استعمل مصطلح أرخون ، وهو مصطلح إغريقي يقصد به أحد الحكام التسعة في أثينا، ويستعمل في بعض الأحيان تفاديا لاستعمال مصطلح ملك، بمعنى أن مصطلحي برانسيپس وأرخون يستعملان في معان تندرج من القائد الأعلى للحرب إلى الملك؛ لأن القبائل المورية كانت تحتفظ باستقلالها في تسيير شؤونها الخاصة، وهي لم تكن لتلتف حول زعيم أعلى تفوق سلطته شيخ القبيلة إلا في ظروف الحرب. لذلك يظهر الملوك الموريون في النصوص التاريخية كمحاربين وقادة للجيش." وعلي أي حال، فقد خطط الأمير الأوراسي يوداس لعدة حروب ضد الوندال والبيزنطيين حقق في بعضها الانتصار و انهزم في البعض الآخر ، وبعدها استعاد يوداس القوة من جديد لشن غارات شرسة على القوات البيزنطية العدائية. 2-مراحل تطور مقاومة يوداس لقد انطلقت مقاومة يوداس من الجزائر أو ماكان يسمى بنوميديا المورية، وتتموقع مملكة يوداس أو إيوداس جغرافيا في منطقة الأوراس وخاصة في جبالها الوعرة التي من الصعب التغلغل فيها لوعورة طرقها وتشعب منافذها. لذا، وحد يوداس القبائل الأوراسية وشكل مملكة مستقلة عرفت بالقوة والشراسة كبدت القوات الوندالية خسارة مادية وبشرية فادحة ، ساعدها في ذلك موقعها الجغرافي الجبلي على غرار جبال الأطلس المغربية التي لم يستطع الرومان التوغل فيها نظرا لشساعة أرجائها وعسر اجتيازها واقتحام مراكز المقاومين العتاة. وقد قدر جيش يوداس الأمازيغي الموري بحوالي ثلاثين ألفا، وكان الأوراسيون يسيطرون على السهول الخصبة والهضاب المجاورة للجبل من الشرق والغرب، وكانوا يتوسعون في كل الاتجاهات بشكل تدريجي إلى أن وصلوا التل الشمالي. وتوجد بجوار هؤلاء الأوراسيين القبائل المورية التابعة لكوتزينا، التي كانت تستقر بدورها ببيزاكينا، وبعد هزيمتها أمام الجنرال البيزنطي سولومون، اضطرت إلى البحث عن موطن لها بالقرب من إيوداس وأتباعه على الحدود الفاصلة بين بيزاكينا ونوميديا." أي أصبحت جبال الأوراس مكانا للاحتماء والتحصين والاختباء من القوات البيزنطية العاتية. وبدأت مقاومة الملك يوداس بتنظيم حملة عسكرية قوية في العدد والعدة استهدفت تطويق الوندال ومحاصرتهم عسكريا بعد نزولهم في شمال نوميديا، وقد عملت مقاومة يوداس على تحقيق استقلال القبائل الأوراسية عن حكم الونداليين بعد وفاة ملكهم هونريك 484-477 م . كما قاد يوداس مقاومة عنيفة ضد التواجد البيزنطي في المنطقة بين سنوات 539-534م، فقام الأوراسيون بتخريب بعض المدن التي توجد في سفوح جبال الأوراس، والتي تشكل خطرا على المملكة الناشئة كمدينة تيمگاد التي كانت قريبة من الحامية العسكرية الوندالية المتمركزة في مدينة لامبيز. ولم يكن الأوراسيون" جبليين منعزلين في معاقلهم النائية، رأوا في انهيار روما وتراجع الوندال، فرصة للانقضاض على المدن الرومانية لنهبها نهبا عشوائيا، فهم بما منحتهم منطقتهم من إمكانيات اقتصادية، حققوا استقلالهم عن السلطة الوندالية وأسسوا مملكة تحت قيادة إيوداس؛ تمتعت هذه المملكة باستقلال سياسي وكانت تقوم باستقبال عدد كبير من الثائرين على السلطة البيزنطية، مثل القائد كوتزينا الذي أقام في منطقة مجاورة للأوراس بعد فراره من البيزنطيين. لكن على الرغم مما يبدو من كون المملكة الأوراسية كانت مملكة غنية اقتصاديا ومستقلة سياسيا، فإنه يصعب أن نعرف بالحجم الحقيقي للسلطة السياسية التي تمتع بها إيوداس." ومن الأسباب التي أدت إلى ظهور المقاومة الأوراسية بقيادة يوداس هو طرد المستعمر الأجنبي من تامازغا بصفة عامة ونوميديا بصفة خاصة، وحماية استقلال مملكة الأوراس و الحفاظ على نفوذها السياسي وسلطتها المحلية وسيادتها الترابية، ناهيك عن السياسة الاستبدادية التي يمارسها المحتلون في التعامل مع ساكنة نوميديا وتركيزهم على استغلال ثروات البلاد وتجويع الأمازيغيين بعد السيطرة على ثرواتهم وممتلكاتهم وأراضيهم واستغلالهم للدين المسيحي في ذلك. ومن الأسباب التي جعلت الموريين ينتصرون على البيزنطيين هو استعمالهم للتحصين وخاصة التحصين بالجمال ومعرفتهم الجيدة بالمنطقة واستخدام حرب العصابات ونهج سياسة الكر و الفر واستدراج البيزنطيين إلى المناطق الوعرة من أجل مراقبتهم وتطويقهم ومحاصرتهم عسكريا أو تسهيل عملية الفرار من وجود المحتل . ويمكن الحديث عن مرحلتين أساسيتين في مقاومة يوداس وهما: مرحلة الهزيمة مع سولومون البيزنطي ومرحلة المقاومة والانتصار. أ-مرحلة المقاومة و الهزيمة أمام قوات سولومون حاول البيزنطيون بقيادة سولومون سنة 535م استرجاع منطقة الأوراس وضمها إلى النفوذ البيزنطي، بيد أنه فشل في البداية بسبب اشتعال المقاومة الأوراسية بزعامة الأمير القائد يوداس الذي أظهر خبرة محنكة في إدارة الحروب والمعارك ضد البيزنطيين. وقد ساهمت وعورة الطرق في جبال الأوراس وقلة الماء وتمرد الجيش البيزنطي إلى اضطرار سولومون للعودة منهزما إلى مدينة قرطاجة . بيد أنه في سنة 539م، سيعد سولومون حملته العسكرية الجديدة لمواجهة قبائل الأوراس ، ولكنها انتهت بانتصار القائد يوداس الذي أحسن التحكم في منابع مياه وادي أبيگاس ، حيث أغلق جميع" مجاري النهر باستثناء المجرى المتجه نحو مدينة باگاي، أي نحو المعسكر البيزنطي الذي غمرته المياه، مما دفع بكونتاريس إلى الفرار مع أفراد الجيش متجها نحو سولوم، الذي غادر قرطاجة وعسكر عند قدم الأوراس. وتوالت المواجهات بين منتصر ومنهزم، إلا أن تمكن أحد القادة البيزنطيين ويدعى كنزو Genzo ، من تسلق جبل الأوراس والاقتراب من معسكر الأوراسيين، وقتل ثلاثة من المحاربين أتباع إيوداس،مما ساعد على اندفاع باقي أفراد الجيش البيزنطي عبر هذا الممر، فكانت وسيلة الأوراسيين الوحيدة للخلاص هي الفرار خصوصا بعد إصابة إيوداس في ذراعه، وفراره بدوره عبر الطريق المؤدية إلى موريتانيا. فتحقق بذلك لسولومون السيطرة على منطقة الأوراس ، خصوصا السفوح الشمالية لفترة زمنية محدودة". ب- مرحلة انتصار المقاومة الأوراسية على القوات البيزنطية بعد هزيمة يوداس أمام قوات سولومون البيزنطي، فر الزعيم الأوراسي الجريح إلى موريتانيا، ولم يرجع إلى مملكته في جبال الأوراس الشامخة إلا في سنة 546م بعد تدهور الوندال وضعف القوات البيزنطية في نوميديا واشتعال مقاومة حليفه أنطالاس فيما بين حدود تونس والجزائر، والذي سيتحالف عسكريا واستراتيجيا مع القائد يوداس لتطويق القوات البيزنطية ومحاصرتها من جميع الجهات قصد دحرها وإرجاعها إلى الخلف. ومن المعلوم أن القبائل الأوراسية تعد من أعتى القبائل المورية الأمازيغية شراسة ومقاومة، فقد ثار سكان الأوراس مدة سبع سنين من 477 إلى 484م،" فأوقفوا زحف الوندال وألحقوا بهم الهزائم تلو الهزائم. وهذه الوقائع هي التي قضت على سمعة الوندال وأعادت الأمل إلى نفوس أعدائهم الكاثوليكيين المضطهدين. كذلك عندما انتصر البيزنطيون سنة 533م على الوندال وظنوا أنهم قادرون على استعادة المغرب بكامله وجدوا أمامهم نفس الخصوم وواجهوا نفس المقاومة العنيدة. حاربهم يوداس أمير الأوراس أربع سنوات ثم التجأ إلى الغرب ليسترجع أنفاسه قبل أن يعيد الكرة مرة أخرى." وفي سنتي 534-539م، شن القائد يوداس حملات عسكرية عنيفة ضد المواقع البيزنطية فكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسيطر على المراكز الإستراتيجية وأحرق المدن التي توجد في الطرق القريبة من الثكنات العسكرية التي كان يتحصن فيها البيزنطيون ، ولم يتمكن الأوراسيون من زمام القوة والسيطرة إلا بعد تحالف يوداس مع القائد أنطالاس الذي أظهر بدوره شجاعة نادرة في مقاومة الوجود البيزنطي الشرس. ولم يتحطم الجيش البيزنطي بكامل عناصره في الحقيقة إلا في سنة 534م مع أربعة قادة من حكام القبائل المورية الأمازيغية وهم: كوتزيناس وإسديلاس وإييورفوتين ثم مديسنيسا. لذا، سيوجهون للبيزنطيين ضربات موجعة عبر توالي تاريخ المقاومة الأمازيغية خاصة مع أنطالاس وييرنا. وعليه، فقضاء" البيزنطيين على الوندال لم يكن يعني استرجاعهم للولاية الأفريقية، فالمرحلة التي عاشت خلالها بيزنطة صراعا عسكريا ضد الموريين، كانت أعنف وأشد من المرحلة الأولى، عبرت خلالها القبائل المورية عن مدى تشبثها بالأرض، ولعل كثرة الحصون التي أنشئت في مراكز جغرافية متعددة قد توحي باضطراب عسكري عاشته أفريقيا في القرن السادس الميلادي. فالإستراتيجية العسكرية للقرن السادس، أظهرت عدم قدرة الجيش البيزنطي على خوض معركة منظمة، ودعت إلى ضرورة تحصينه وراء سور أو حصن خلال المعارك التي خاضتها ضد الموريين. كما أن دراسة وضعية الجيش البيزنطي أظهرت مدى ضعف وتراجع أعداده، فضلا عن تكاثر ثوراته وانعدام انضباطه. فوجد البيزنطيون في هذه الحصون وسيلة عسكرية لتحقيق دفاع فعال عن الولاية الإفريقية ضد الموريين." والله اعلم
|
||||

|
|
|
رقم المشاركة : 2 | |||
|
علماء وا دباء ومفكرين وفنانين وشخصيات هامة من منطقة الشاوية : بعض علماء الأوراس و المنطقة كَكُل في العصر الوسيط *أحمد بن عيسى بن علي بن يعقوب بن شعيب الداودي الأوراسي: أصولي، منطقي، بياني، من فقهاء المالكية. من أهل أوراس. تعلم بتونس. حج سنة 849هـ ودخل القاهرة ولقي السخاوي. له "حواش" على بعض الكتب. (2) الطبني ( .. - 390هـ / .. - 1000م) *أحمد بن الحسين بن محمد الطبني، أبو عمر: محدث، من أهل طبنة، قال ابن الفرضي: "وصل الى الاندلس حدثا وسمع بقرطبة من قاسم بن أصبغ وابن أبي دليم، ورحل الى المشرق حاجا سنة 342 ه وسمع في رحلته سماعا يسيرا. وكان رجلا صالحا فاضلا، حدث، وكتبت عنه أحاديث، وتوفي بقرطبة" (1) -* أحمد التيفاشي هو أحمد بن يوسف بن أحمد ابن أبي بكر التيفاشي, نسبة إلى تيفاش جنوب سوق اهراس من القطر الجزائري. ولد بقفصة سنة 1184م, في عهد دولة الموحدين ، عالم معادن وقانون وإجتماع وفلك وشاعر . توفي با القاهره ودفن بها بمقبرة باب النصر. 580- وقد تعلم بجامع الزيتونة ثم بالأزهر ..... *يحي ابن أحمد التيفاشي.. . كان أديبا وشاعرا مقرب من الحكام والسلاطين وهو عم أحمد التيفاشي السالف الدكر.... *زيادة الله بن علي بن الحسين بن محمد بن أسد التميمي الطبني، أبو مضر: شاعر رفيع الطبقة، أديب، أحد الطبنيين الطارئين على قرطبة بالأندلس من طبنة عاصمة الزاب "وهو أول من بنى بيت شرفهم ورفع بالأندلس صوته بنباهة سلفهم، وكان نديم محمد بن أبي عامر، ظريفا ممتع الحديث، رفيع الطبقة في صنعة الشعر، حسن البديهة والروية". ذكر الحميدي له كتابا سماه "الحمام " وقال انه ألفه للمنصور محمد بن أبي عامر. توفي بقرطبة. (2) *أحمد بن العباس النقاوسي أبو العباس: نحوي، من فقهاء المالكية، حافط، أديب. له مشاركة في علوم التفسير والحديث واللغة والمنطق. أخذ عن أبي علي منصور بن أحمد بن عبد الحق المشذالي (631 - 731هـ) وابن راشد القفصي. رحل من تلمسان قبل الحصار واستقر بتونسوناقلا" سديدا، وناقدا شديدا، وعارفا مديدا، ومدرسا مفيدا، رحل من تلمسان قبل الحصار فدخل تونس وهو الآن أحد مدرسيها الإمام وأوحد من برع في علمي البيان والكلام، وأوجد الناس للدر اذا خاض بحر العلوم بسوابح الأقلام، أديب العصر ونحويه وبيانيه وحكميه ومنطقيه، قرأت عليه تأليفه المسمى "الروض الأريض في علم القريض" وتأليفه في الأدب، و"حديقة الناظر في تلخيص المثل السائر" في البيان، و"شرح المصباح" لابن مالك، و"ايضاح السبيل الى القصد الجليل في علم الخليل" شرح على عروض ابن الحاجب، وله تآليف غيرها عرف قدرها واشتهر ذكرها .. الخ ". (1) *أحمد بن عبد الرحمن أبي زيد (النقاوسي، أبو العباس):النقاوسي، أبو العباس: فقيه مالكي، من كبارهم، له مشاركة في علمي المعقول والمنقول. ذكره تلميذه الشيخ عبد الرحمن الثعالبي وقال: "هو شيخنا الإمام المحقق الجامع بين علمي المعقول والمنقول، ذو الاخلاق المرضية، والاحوال الصالحة السنية" وكان الثعالبي قد دخل بجاية سنة 802هـ ولقي بها جماعة من العلماء فأخذ عنهم ومنهم النقاوسي. له "الأنوار المنبلجة في بسط أسرار المنفرجة". قال صاحب كشف الظنون: أوله، الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والقدم، المبدىء القادر الذي برأ النسم .. الخ قدم في أوله تعريفين، الاول في ترجمة الشيخ الناظم (ابن النحوي يوسف بن محمد) والثاني في بيان بحر القصيدة" (1) النقاوسي (848 - بعد 897هـ / 1444 - بعد 1491م) *محمد بن محمد بن محمد بن يحيى بن أبي علي، ابو الطيب النقاوسي، القسنطيني: قاض، مفسر، لغوي، منطقي، أصولي، من فقهاء المالكية. ولد بنقاوس، وتعلم بقسنطينة وتونس، ثم انتقل إلى مصر فأخذ عن كبار علماء القاهرة. وفي غضون إقامته بها حج. قال السخاوي: ثم رجع الى بلاده واستقر قاضي العسكر لمولاي مسعود، ثم أعرض عنه لاختياره سكنى تونس وصار أحد عدولها ودام سنين، ثم تحول بعياله قاصدا استيطان الحجاز، فدخل الديار المصرية، فكانت اقامته نحو ثلاثة اشهر، ثم دخل مكة ولقيته هناك، فأقام بها الى ان سافر الى طيبة في أواخر سنة 897هـ، فأقرأ هناك بعض الطلبة وعزم على استيطانها. (1) *عبد الرحمن بن زيادة الله بن علي بن الحسين الطبني، أبو الحسن: متأدب، محدث. ولد بقرطبة بالاندلس، وكان أبوه قد انتقل اليها من طبنة واستوطنها. قال ابن بشكوال: كان له فضل وأدب وزهد وتنسك، وروى الحديث." (1) *محكم الأوراسي الهواري: قاض، من أكابر علماء الإباضية في وقته. ولي قضاء تيهرت في عهد الإمام أفلح بن عبد الوهاب ابن رستم (190 - 240هـ). قيل: كان إماما كبيرا مقدما على أهل عصره في الفقه وغيره، كريم الأخلاق، حسن السيرة .. " وهو والد هود التالية ترجمته. (1) الهواري ( .. - بعد 250هـ / .. - بعد 864م) *هود بن محكم الاوراسي الهواري: مفسر، فقيه أباضي، من أقدم مفسري كتاب الله العزيز في المغرب الأوسط. نشأوتعلم بتيهرت، وكان والده (السابقة ترجمته) قاضيها. من آثاره "تفسير القرآن الكريم" خاص بالاباضية، منه نسخ مخطوطة بالعطوف. (1) المصدر :معجم أعلام الجزائر الأريسي (القرن السابع الهجري / القرن الثالث الميلادي) *محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأريسي، أبو عبد الله: فقيه مالكي، عاش في بجاية في المائة السابعة، ذكره الغبريني وقال: (وكان مشاورا مفتيا معمولا على قوله، موقوفا على ما عنده، له جلال ووقار، وأخلاق مرضية، وكان في غاية الجودة في الخط المشرقي .. الخ". (2) الأريسي (القرن السابع الهجري / القرن الثالث الميلادي) *محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الأريسي المعروف بالجزائري، أبو عبد الله:شاعر، أديب، من كبار أدباء الجزائر في أواسط المائة السابعة.كان يسلك في شعره سلوك المتنبي. قال الغبريني:"وهو من أدباء الكتاب، كان حسن النظم والنثر، مليح الكتابة سهل الشعر، كثير التجنيس يأتيه عفوا من غير تكلف، وكان مليح التواشيح، إن طال في شعره أعرب، وإن اقتصر واقتصد أعجب، له شعر كثير في كل فن من فنون الشعر: وكان شيخ كتبة الديوان ببجاية" وهو حفيد الأريسي المتقدم. (1) *أحمد بن علي بن أحمد ، المعروف بأبو عباس البغائي ، فقيه مالكي ، من منطقة اسمها الباغاية و اليها ينسب ، رحل الى المشرق و اخذ كثيرا عن علماء مصر و غيرها ثم دخل الاندلس سنة 376 هـ ، و جلس الى التدريس في المسجد الجامع بقرطبة ، استأدبه المنصور محمد بن ابي عامر المعارفي لابنه عبد الرحمان كما رقاه المؤيد بالله هشام بن الحكم في دولته الثانية ( 400 / 403 هـ) الى خطة الشورة فلم يطل أمره ثم توفي بعد سنة .. قال عنه احدهم : " كان ربانيا في علوم الاسلام ، شديد الحفظ ، و كان بحرا من بحار العلم ...." الطبني محمد بن الحسين ابو عبد الله (300-394ه / 912-1114 م) . شاعر بليغ ،اديب بارع ، ينحدر من بيت أدب و فضل و حكم ،من اهل طبنة عاصمة الزاب ، و اليها ينسب ، رحل الى الاندلس سنة 323 هـ فكان من شعراء الخليفة الاموي الاندلسي الحكم بن عبد الرحمان الناصر (302-366 هـ) قال عنه احدهم :" لم يصل الى الاندلس اشعر منه ، توفي بقرطبة و شهد جنازته المظفر بن عبد الملك بن ابي عامر ".. المصدر : العلماء الجزائريون في الأندلس فيما بين القرنين 10 و14م للدكتور عمار هلال مايمكن ملاحظته هنا بسرعة ان علماءنا في هذه الفترة اشتهروا كلهم بنوعية علمية و ادبية راقية شهد عليها اكثر من عالم انذاك .. والله اعلم |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
علماء وا دباء ومفكرين وفنانين وشخصيات هامة من منطقة الشاوية : أحمد بن عبد الرزاق حمودة****بعض المجاهدين و القادة **** أحمد بن عبد الرزاق حمودة أو سي الحواس، من مواليد سنة 1923 بمشونش إحدى قرى الأوراس. من شهداء ثورة التحرير الجزائرية. نشاطه السياسي
نشاطه أثناء الثورة
************************************************** ******************************************** العربي بن مهيديمحمد العربي بن مهيدي مناضل جزائري شارك في الثورة الجزائرية من مواليد مدينة عين مليلة الواقعة في شرق الجزائر. ولد العربي بن مهيدي في عام 1923 بدوار الكواهي بناحية عين مليلة التابعة لولاية أم البواقي وهو الابن الثاني في ترتيب الاسرة التي تتكون من ثلاث بنات وولدين، دخل المدرسة الابتدائية الفرنسية بمسقط رأسه وبعد سنة دراسية واحدة انتقل إلى باتنة لمواصلة التعليم الابتدائي ولما حصل على الشهادة الابتدائية عاد لأسرته التي انتقلت هي الأخرى إلى مدينة بسكرة وفيها تابع محمد العربي دراسته وقبل في قسم الإعداد للالتحاق بمدرسة قسنطينة. في عام 1940 إنضم لصفوف الكشافة الإسلامية "فوج الرجاء" ببسكرة، وبعد بضعة أشهر أصبح قائد فريق الفتيان. جوانب عن شخصيتهكان العربي بن مهيدي ملتزما بواجباته الدينية والوطنية، إلا أن هذا لم يمنعه من حب الفن فكان يهوى أغاني المطربة فضيلة الدزيرية. وكان أيضا يحب الموسيقى خاصة الأندلسية منها، كما كان يكثر من مشاهدة الأفلام ولاسيما الأفلام الحربية والثورية كالفيلم الذي يدور محتواه حول الثائر المكسيكي زاباتا فاتخذ هذا الاسم كلقب سري له قبل أندلاع الثورة، مثلما كان يلقب أيضا بالعربي البسكري والحكيم، كان بن مهيدي يهوى المسرح والتمثيل، فقد مثل في مسرحية "في سبيل التاج" التي ترجمها إلى اللغة العربية الأديب المصري مصطفى لطفي المنفلوطي وكانت مسرحيته مقتبسة بطابع جزائري يستهدف المقتبس من خلالها نشر الفكرة الوطنية والجهاد ضد الاستعمار. كان بن مهيدي لاعبا في كرة القدم فكان أحد المدافعين الأساسيين في فريق الاتحاد الرياضي الإسلامي لبسكرة الذي أنشأته الحركة الوطنية، وقد كتب عنه أحد العارفين به في عدد 20 أغسطس 1957 من جريدة المجاهد التي كانت تتحدث باسم الثورة الجزائرية آنذاك يقول أنه "شاب مؤمن، بر وتقي، مخلص لدينه ولوطنه، بعيد كل البعد عن كل ما يشينه. كان من أقطاب الوطنية ويمتاز بصفات إنسانية قليلة الوجود في شباب العصر، فهو من المتدينين الذين لا يتأخرون عن أداء واجباتهم الدينية، لا يفكر في شيء أكثر مما يفكر في مصير بلاده الجزائر، له روح قوية في التنظيم وحسن المعاملة مع الخلق ترفعه إلى درجة الزعماء الممتازين. رجل دوخ وأرهق الاستعمار الفرنسي بنضاله وجهاده على بلاده ودينه النشاط السياسيفي عام 1942 إنضم لصفوف حزب الشعب بمكان إقامته، حيث كان كثير الاهتمام بالشؤون السياسية والوطنية، في 8 مايو 1945 وكان من بين المعتقلين ثم أفرج عنه بعد ثلاثة أسابيع قضاها في الاستنطاق والتعذيب بمركز الشرطة. عام 1947 كان من بين الشباب الأوائل الذين التحقوا بصفوف المنظمة الخاصة حيث ما لبث في عام 1949 أن أصبح مسؤول الجناح العسكري بسطيف وفي نفس الوقت نائبا لرئيس أركان التنظيم السري على مستوى الشرق الجزائري الذي كان يتولاه يومذاك محمد بوضياف، وفي عام 1950 ارتقى إلى منصب مسؤول التنظيم بعد أن تم نقل محمد بوضياف للعاصمة. بعد حادث مارس 1950 اختفى عن الأنظار وبعد حل المنظمة عيّن كمسؤول الدائرة الحزبية بوهران إلى 1953. وعند تكوين اللجنة الثورية للوحدة والعمل في مارس 1954 أصبح من بين عناصرها البارزين ثم عضوا فعالا في جماعة 22 التاريخية. نشاطه أثناء الثورةلعب بن مهيدي دورا كبيرا في التحضير للثورة المسلحة، وسعى إلى إقناع الجميع بالمشاركة فيها، وقال مقولته الشهيرة: إلقوا بالثورة إلى الشارع سيحتضنها الشعب وأيضا: أعطونا دباباتكم وطائراتكم وسنعطيكم طواعية قففنا وقنابلنا، وأصبح أول قائد للمنطقة الخامسة (وهران). استشهادهكان الشهيد من بين الذين عملوا بجد لانعقاد مؤتمر الصومام التاريخي في 20 أوت 1956، وعّين بعدها عضوا بلجنة التنسيق والتنفيذ للثورة الجزائرية (القيادة العليا للثورة)، قاد معركة الجزائر العاصمة بداية من سنة 1955. 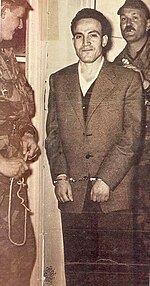 العربي بن مهيدي أثناء اعتقاله اعتقل نهاية شهر فبراير1957 واستشهد تحت التعذيب ليلة الثالث إلى الرابع من مارس1957، بعد أن أعطى درسا في البطولة والصبر لجلاديه.[1] قال فيه الجنرال الفرنسي مارسيل بيجار بعد أن يئس هو وعساكره أن يأخذوا منه اعترافا أو وشاية برفاقه بالرغم من العذاب المسلط عليه لدرجة سلخ جلد وجهه بالكامل وقبل اغتياله ابتسم العربي بن مهيدي لجلاديه ساخرا منهم، هنا رفع بيجار يده تحية للشهيد كما لو أنه قائدا له ثم قال : لو أن لي ثلة من أمثال العربي بن مهيدي لغزوت العالم. في عام 2001 اعترف الجنرال الفرنسي بول أوساريس لصحيفة لوموند أنه هو من قتل العربي بن مهيدي شنقاً بيديه.[2] ************************************************** ******************************************* حصروري العايش بن أحمد الشهيد حصروري العايش بن أحمد الاسم الثوري (سي العايش) من مواليد سنة 1925 في قرية الولجة إحدى قرى الأوراس خنشلة، عضو مجلس الولاية الأولى التاريخية (مكلف بالشؤون الاقتصادية) من شهداء ثورة التحرير الجزائرية. محتويات
نشأته ولد الشهيد رحمه الله سنة 1925 بقرية الولجة من أسرة متدينة وثورية، تعلم القرآن الكريم على يد مشاييخ القرية بزاوية سيدي عبد الله بن موسى وأخذ عليهم مبادئ والعلوم، ثم انتقل إلى المدرسة وتحصل على شهادة التعليم الأساسي عربية امتهن الفلاحة ثم التجارة . نضاله السياسي كان الشهيد مناضل في حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية مكلف بمهام قيادية من 1948 إلى 1954 م، وكان يقوم بالاجتماعات في المتجر الذي كان يملكه. وفي الثلاثي الأول من سنة 1954 انخرط في اللجنة الثورية للوحدة والعمل، حيث كان عضوا نشيطا وبارزا فيها، وكان يتصف بالحكمة في التصرف واليقظة الدائمة، مما أهله أن يكون مع الفوج الذي قام بالتحضير والإعداد للثورة في فرع الولجة، وفي ليلة الفاتح من نوفمبر 1954 قام رفقة إخوانه الثوار بإحراق مكتب القائد وقطع طرق المواصلات الرابطة بين قرية الولجة ومختلف القرى المجاورة وتوزيع المناشير ومراقبة كل تحركات العدو. سجنه تم اعتقاله لأول مرة بقرية الولجة عند اندلاع الثورة وأخذ إلى مركز التعذيب بخنقة سيدي ناجي و التحقيق معه ثم حول إلى سجن باتنة بتاريخ 13/12/1954 . حكم على الشهيد من طرف محكمة باتنة بتاريخ 20/01/1955 بعقوبة (08) ثمانية أشهر حبسا نافذا بتهمة المساس بأمن الدولة الخارجي. و بتاريخ 02/02/1955 تم تحويله إلى سجن قسنطينة إلى غاية 17/05/1955 أين تم تحويله إلى سجن سكيكدة و بتاريخ 13/07/1955 تم تحويله إلى سجن لمباز تازولت. وأفرج عن الشهيد بتاريخ 13/08/1955 بعد تنفيذ العقوبة. إلتحاقه بصفوف جيش التحرير الوطني وأهم المعارك التي خاضها التحق بصفوف جيش التحرير الوطني مباشرة بعد خروجه من السجن بتاريخ 29/08/1955 وخاض عدة معارك منها:
************************************************** ***************************** عباس لغرور محتويات المولد والنشأة ولد عباس الغرور في يوم 23 جوان 1926 بدوار إنسيغة بولاية خنشلة، ينتمي إلى أسرة فقيرة معدمة، دخل المدرسة الفرنسية واستطاع الحصول على الشهادة الابتدائية، بعدها توجه إلى الحياة العملية حيث عمل كطباخ لدى حاكم المدينة، وكان ذلك عام 1948. نشاطه قبل الثورة انضم الشهيد مبكرا إلى حزب الشعب الجزائري وكان ذلك عام 1946، وكان ينشط مع المناضل إبراهيم حشاني المسؤول الجهوي لمنطقة الأوراس، وقد شك في أمره صاحب العمل عندما شوهد مع هذا الأخير في أحد الأسواق، ولذا طرد من العمل فلجأ عباس الغرور إلى فتح دكان للخضر والفواكه في السوق العامة للمدينة، وهذا لتمويه الاستعمار عن نشاطه الحقيقي، ولقد أصبح هذا الدكان مكانا يلتقي في مناضلو الحزب لعقد اجتماعاتهم السرية ومن أمثال هؤلاء نذكر : شيهاني بشير، مسؤول حركة انتصار الحريات الديمقراطية على مستوى باتنة. ونظرا للميزات التي كان يتميز بها الشهيد فقد أوكلت له مسؤولية الإشراف على قسمة الحزب بخنشلة. وأهم ما قام به نذكر : مشاركته في مظاهارات 1 ماي و 8 ماي 1945 التي وقعت في المدينة. تنظيم مظاهرة احتجاجية عام 1951 ضمت شريحة من شبان المدينة، وكان هذا تنديدا للوضعية المأساوية التي كان يعاني منها الشعب الجزائري ومن أهم المطلب التي كان يسعى إليها المتظاهرون : القضاء على البطالة، توفير الخبز، وقد سلمت هذه المطالب للسلطات الفرنسية التي قامت على إثرها بإلقاء القبض على عباس لغرور وبعض رفقاءه، وبقي في السجن مدة 3 أيام، تعرّض خلالها إلى تعذيب وحشي مما أدى به إلى الإصابة بمرض صدري جعله ينتقل إلى باتنة للعلاج وقد تكفل حزب حركة الانتصار بجميع نفقات علاجه. وبعد أن تماثل للشفاء عاد إلى خنشلة ليواصل نشاطه السري داخل الحزب. وبرفقة الشهيد مصطفى بن بولعيد وعجول عجول وشيحاني بشير ساهم عباس لغرور بالتحضير للثورة في منطقة الأوراس. وقد أشرف على الأفواج التي أوكلت لها مهمة شن الهجومات ليلة أول نوفمبر 1954. نشاطه أثناء الثورة منذ اللحظات الأولى للثورة المسلحة برهن عباس الغرور على حنكته وشجاعته وقدرته على القيادة والمناورة وإلحاق الهزيمة بالعدو من أهم المعارك التي شارك فيها أثناء الثورة نذكر : معركة الجرف الشهيرة التي دامت 3 أيام 22/23/24 سبتمبر 1955. معركة الزاوية الشهير ة ششار. معركة تفسور ششار 1955. معركة البياضة استمرت 24 ساعة كاملة. كمين كنتيس مراح البارود أكتوبر 1956 اغتياله غادر الجزائر إلى تونس في شهر أكتوبر 1956 برفقة عدد من الإطارات منهم عدد من الطلبة اللذين غادروا مقاعد الدراسة لتحرير الوطن أمثال منتوري محمود. وكان ينوي عقد مؤتمر مصالحة بين قادة الولايةI لغرض اتخاذ موقف موحد بجانب قادة الثورة بالخارج حول قرارات مؤتمر 20 أوت 1956. إلا أن مؤامرة دبرت لإفشال المؤتمر كما اعتقل في نفس الوقت قادة الثورة بالخارج اثر تحويل طائرتهم. وقد اغتيل عباس لغرور يوم 25 جويلية 1957 في تونس مع عدد من إطارات الثورة الجزائرية من طرف رفقاء الثورة في ظروف لا تزال غامضة. ************************************************** ************************ يتبع |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 4 | |||
|
علماء وا دباء ومفكرين وفنانين وشخصيات هامة من منطقة الشاوية : ****بعض المجاهدين و القادة **** علي النمر علي النمر هو أحد الشخصيات التاريخية، ورجل حرب، وشهيد من شهداء الثورة التحريرية الجزائرية من منطقة مروانة بجبال الأوراس. محتويات نشأته ولد علي النمر في 16 مارس 1925 في مشتة أم الرخاء بدوار حيدوسة قرب مروانة التي كانت تدعى في العهد الاستعماري البائد بالبلدية المختلطة بلزمة أو كورناي، التابعة لولاية باتنة في سلسلة جبال الشلعلع، من أب يدعى مختار بن علي بن ملاح والمولود عام 1888 بحيدوسة، والذي كان عاملا في أحد المناجم قرب قريته تستغله شركة استعمارية، أما جده فكان طبيبا شعبيا يمارس مهنة التداوي بالأعشاب على الطريقة التقليدية، ومن أم تدعى (الطاوس حجام) المولودة في 1892 وأصلها من بلدية (افرحونن) ولاية تيزي وزو من جبال جرجرة الشامخة، وقد انجب أبواه عددا كبيرا من الأطفال فتوفوا جميعا ولم يعش منهم إلا طفلين وهما ذهبية وعلي. تعلمه التحق بكتاب القرية لحفظ ما تيسر من القرآن الكريم خفية عن أنظار العدو زعملائهم كغيره من الجزائريين، ثم انتقل به والده غلى مدينة باتنة وهو لم يتجاوز بعد العقد الأول من عمره. وفي مدرسة الأهالي بمدينة باتنة واصل تعلمه باللغتين العربية والفرنسية، ورغم السنوات القليلة التي قضاها في هذه المدرسة فقد استطاع أن يتقن القراءة والكتابة باللغتين معا، وهو في المستوى الذي يسمح ببلوغه لأغلب أبناء المنطقة ممن كان لهم الحظ في الدخول إلى المدرسة..إذ لا يحق لهم تجاوز المستوى الابتدائي وهو مخطط استعماري معروف، وقد انقطع عن الدراسة في نهاية الثلاثينيات بسبب خلاف بينه وبين معلمه الفرنسي الأصل، وراح يبحث عن العمل في مطلع الأربعينيات إبان الحرب العالمية الثانية لمساعدة اسرته الفقيرة. وقد مكنته السنوات القليلة التي قضاها في المدرسة من الوصول إلى مستوى ثقافي معتبر حيث يستعمل اللغتين العربية والفرنسية بطلاقة وأصبح خطيبا شديد التأثير على مستمعيه. حياته الاجتماعية الاقتصادية عاش مرحلة طفولته كغيره من الشباب الجزائريين في الحرمان وضنك العيش الذي فرضه الاستعمار الفرنسي على سكان المنطقة خاصة والجزائر عامة لا سيما بعد ثورة 1916 في كل من مروانة، باتنة، عين التوتة وما جاورها، أين شدد الاستعمار قبضته الحديدية على السكان بعد قتل ونفي المئات، وتجريد الباقين من أراضيهم وجميع ممتلكاتهم، فكان علي النمر كبقية الوطنيين يتابع عن كثب هذا الوضع غير الطبيعي الناتج عن انتقام العدو من السكان بعد كل ثورة من الظلم والاضطهاد والتعسف وثالوث الفقر والجهل والمرض المسلط على الشعب. ونظرا للوضع المادي السيء لأسرته، فقد اضطر إلى البحث عن اعمل لمساعدتها في بداية الاربعينيات، وفعلا تمكن من إيجاد منصب عمل في الشركة الصناعية للقبائل الصغرى التي كانت تقوم باستغلال الخشب في غابات هذه المناطق. وقد اشتغل في هذه الشركة مدة ست سنوات كعامل متخصص في النجارة فتمكن بذلك من تخفيف أثر الفقر والبؤس عن أسرته الصغيرة، وقد تزوج مبكرا في مطلع الأربعينيات وبالضبط عام 1943 بالسيدة (العلجة لوشن) بنت فرحات من عين التوتة وهي أخت المجاهد الشهيد (الطاهر لوشن)، الذي كان من المجاهدين الأوائل وأحد قادة الثورة. أنجب ولدا وحيدا منها، سنة 1946 المدعو عمار النمر ولا يزال على قيد الحياة، وقد كرر الزواج أثناء الثورة التحريرية بأرملة شهيد في المنطقة الثانية بآريس عندما كان على رأس المنطقة، ولم يخلف الأولاد من الزوجة الثانية. ومن حيث رعايت لعائلته يقول عنه زميل صباه ورفيقه في حزب انتصار الحريات الديمقراطية المجاهد الحاج عبد الحفيظ عبد الصمد: "كان مهملا لعائلته من أجل الثورة والإعداد لها ومنفقا أمواله لصالح الحزب والوطن" ولم تحظ عائلته بالرعاية الكافية بسبب تخصيص حياته للجزائر الشيء الذي جعله لا يخلف شيئا من الممتلكات من حطام الدنيا الزائلة حيث كان يسكن منزلا متواضعا جدا لأبيه ببوعقال-باتنة مبني بلبنات التراب ومسقف بنبات الديس فوق قطعة من الأرض مساحتها حوالي نصف هكتار، باعها أبوه ثناء الثورة التحريرية لينفق على عائلته. وقطعة أرض أخرى مساحتها حوالي 2 هكتار ببوعقال باعها أبوه أيضا بعد الاستقلال عام 1967 بثمن بخس لتغطية نفقات الأسرة وزواج حفيده عمار النمر الذي لم يترك له أبوه الشهيد شيئا. توفي أبوه سنة 1970، ثم توفيت أمه سنة 1977 بعدما عانا الكثير من الفقر لأن ولدهما البطل لم يترك لهما شيئا إذ كان ينفق دخله الشهري من عمله على المناضلين، حيث كان كريما جدا. نضاله ونشاطه السياسي قبل الثورة يؤكد زملاؤه في الحركة الوطنية أنه انضم إلى حزب الشعب الذي كان ينشط سرا أثناء الحرب العالمية الثانية وذلك في حدود سنة 1943 بباتنة وهو لم يتجاوز 18 سنة من عمره، ثم واصل نضاله وتعاظمت مسؤولياته ومهماته داخل حزب انتصار الحريات الديمقراطية ضمن خلية مدينة باتنة ثم في الخارج، إذ في أواخر سنة 1948 هاجر إلى فرنسا تحت غطاء البحث عن العمل في أوروبا بينما كان الهدف هو تجنيد المناضلين وتوعيتهم حيث استقر في منطقة (الزاس لوراين) كمسؤول حزبي يشرف على عدد من الخلايا التي كان يرأسها كل من لوشن الطاهر والعائب عمر ومحمد حرسوس المدعو بوحة وهم جميعا تحت مسؤوليته، بينما كان شيحاني بشير يتصل بالمناضلين وينسق النشاط بينهم في الجزائر وفرنسا. بعد أكثر من سنتين قضاها في فرنسا في سبيل تعبئة صفوف المناضلين عاد إلى باتنة، ليواصل نشاطه السياسي كمسؤل عن عدد من الخلايا، إلى جانب ممارسته لنفس المهنة كتجار في شركة أمريكية تستغل الثورة الغابية بالمنطقة وقام بتنظيم إضراب عمالي كبير في الشركة، كما ساهم في التحضير والدعاية لانتخابات 1948 التي ترشح فيها مصطفى بن بولعيد وعندما وقع الانشقاق في حركة انتصار الحريات الديمقراطية 1953-1954 وقع تقهقر وتشدد في أوساط المناضلين وحدثت صراعات حادة أدت إلى تقلص أفراد بعض الخلايا وانحلال بعضها. أين تمكن الشهيد علي النمر في هذه الظروف أن يساهم بفعالية في تشكيل خلايا جديدة في هذه الفترة لا سيما في عام 1954. ولم يقتصر نشاطه على مدينة باتنة وحدها بل استطاع أن يكون خلية حزبية في مدينة سريانة من مناضلين بعضهم كان يعمل تحت إشرافه في فرنسا. من أشهر زملائه في الخلية السرية التي أنشأت بعد الانشقاق في مدينة باتنة حرسوسي محمد المدعو بوحة- شهيد، ورشيد بوشمال أمين خلية – شهيد، وعبد الحفيظ عبد الصمد، والحاج لخضر أعبيدي وعمر العايب ومسعودي محمد. كانت الخلية تعقد اجتماعاتها كلما دعت الضرورة وفي سرية تامة مع تغيير مكان الاجتماع في كل مرة. وكان نشاط الشهيد على النمر محل ملاحقة واهتمام من طرف رجال الأمن الفرنسيين، إلا أن شدة كتمانه للسر وحنكته وذكائه جعلهم يعجزون عن كشف المهام التي كان يقوم بها من جهة وقوة ثقة المناضلين فيه وحبهم له من جهة أخرى. كان يتمتع بثقة كبيرة لدى مصطفى بن بولعيد، وله كفاءة سياسية وثقافية أكثر من جميع المناضلين الذي يترأسهم في الخلايا وله سمعة كبيرة في اوساط الشعب، يصفه بعض زملائه بأنه كان مؤمنا ومسلما حقا يصلي ويصوم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان ذكيا جدا وداهية يجمع بين الجد والمرح والمزاح، وكثير السرية في الامور الخطيرة وشجاعا لا يهاب الموت والمخاطر، يعجز كل من يخالفه في الامور السياسية ويتغلب عليه بالحجة والاقناع، ويمتاز بالمهارة النادرة في تفسير الرؤيا وقوي البصيرة يعتمد على الإسلام والآيات القرآنية في التوعية وتوحيد المناضلين والجماهير الشعبية. نشاطه في الميدان الرياضي إن الشهيد علي النمر لم يقتصر نشاطه على الجانب السياسي وحده بل تعداه إلى ممارسة النشاط الرياضي ليس من جل الراضة فحسب وإنما من أجل تعبئة وتكوين الشباب وغرس الروح الثورية في نفوسهم، حيث انخرط في صفوف الفريق الرياضي الباتني لكرة القدم سنة 1944 الذي تم تأسيسه عام 1932 ومارس فيه نشاطه كلاعب ماهر ممتاز إلى غاية 1948 أين توجه إلى فرنسا للقيام بمهمة نشر الوعي السياسي في أوساط المناضلين هناك، ولعل من الأدلة التي تؤكد ثورية هذا الفريق الرياضي الباتني أن أغلب أعضائه من لاعبين ومسيرين قد التحقوا بصفوف جيش التحرير، واستشهد كثير منهم في ميدان الشرف، إذ من بين حوالي ستين لاعبا و15 مسيرا قد استشهد منهم 36 لاعبا و 6 مسيرين، نذكر من بينهم الشهداء: محمد درانة، بن الطاهر بن علي، الذي استشهد عام 1958 ومصطفى سفوحي بن بورزق في 1957 مع ابنه أيضا وهما لاعبان في الفريق، ومن بين الشهداء أيضا العمراني العيد، كوكاش مسعود، بن بوزيد حميداتو، خلافنة صالح وأخيه إسماعيل 1958، حريزي إبراهيم، قليل عبد القادر وعبد الله، مستاك محمد لحسن، حمامي علي، نزاري رشيد، جاب الله محمد، حزامشعبان، بوليلة مسعود، بوعبسة محمد العربي ويوسف، تريكي بادي، مشلق عمار، زيور محمد العربي، جباري رابح، شلغوم عبد الوهاب، بخوش صالح، فرياني محمد، صغير عمر، دباش عبد الرحمن معرف إبراهيم، كشيدة عبد الله، بوشمال أحمد رشيد، شاوي عبد اللطيف، سعدي عبد المجيد، والبطل صالح نزار الذي كان له فضل السبق في تكوين وتشكيل فيالق جيش التحرير في المنطقة الأولى بولاية الأوراس عام 1957 وغيرهم من اللاعبين والمسيرين في هذا الفريق الرياضي الباتني الذي ساهم علي النمر في تجنيد أعضائه وتكوينهم وشحن نفوسهم بالروح الوطنية والثورية، وقد حل الفريق ونقطع عن نشاطه في مطلع جانفي 1955 حيث التحق جل أعضائه بصفوف جيش التحرير الوطني. أعماله ودوره أثناء الثورة التحريرية تفجير الثورة إن أمر تفجير الثورة ليلة أول نوفمبر 1954 كان محاطا بسرية متناهية جدا لا يعلم لحظتها إلا مصطفى بن بولعيد ومناضلين قلائل. قسم ابن بولعيد مهام مناضليه إلى مهام عسكرية وأخرى سياسية قبيل لحظة اشتعال فتيل الثورة المباركة. عبي النمر من المناضلين الذين أسندت لهم المهمة السياسية في أواسط الجماهير الشعبية لدعم الجانب العسكري للثورة ماديا ومعنويا وغرس مبادئها في صفوف الشعب وتعبئتهم وتجنيدهم حولها. ويرجع ذلك إلى أن علي النمر كان من المناضلين الذين تكشفهم فرنسا، ولم تتمكن من معرفة نشاطه ودوره الحقيقي في الإعداد للثورة. لذا لم يبرز علي النمر كجندي في هجمات ليلة أول نوفمبر، ولم يكن تخلفه عنها تقاعسا منه كما يدعي عليه البعض ممن كانوا يكرهونه ويحقدون عليه قبيل الثورة وأثنائها، بل بأمر من قادة الثورة الذين كلفوه بدعمها ماديا وسياسيا وهي مهمة صعبة جدا. في الأيام الأولى من تفجير الثورة ألقي القبض على بعض المناضلين من الأحزاب الأخرى حيث حملوا علي النمر بالتحضير للثورة مما أدى إلى ملاحقته من طرف بوليس العدو واعتقاله في 1954/11/11 وسجنه في باتنة حوالي ثلاثة أشهر وتعذيبه ومحاكمته وكان المحامي المدافع عنه اليهودي (قج) المعروف ولم تتمكن فرنسا من معرفة الدور الذي كان يقوم به فاضطرت إلى إخلاء سبيله في شهر فيفري 1955. وبعد أيام عالج فيها آثار التعذيب التي تعرض لها في السجن، وبعد أن تأكد أن قواة الاستعمار الفرنسي لم تعد تمهله وظلت تلاحق تحركاته التحق بالعمل العسكري في صفوف جيش التحرير، إلى جانب إخوانه المجاهدين في أوائل شهر مارس 1955. مساهمته في نشر وتوسيع رقعة الثورة منذ التحاقه بصفوف جيش التحرير الوطني عمل الشهيد علي النمر على نشر وتوسيع رقعة الثورة بتوعية وتعبئة الجماهير الشعبية وتجنيد الشباب في صفوف جيش التحرير الوطني وتعيين مسؤولين لاسيما في الجهة الغربية من ولاية الاوراس حتى القبائل الكبرى في الولاية الثالثة. توجه إلى الولاية الثالثة مع القائد الشهيد محمد لعموري ثلاث مرات أولاهما في بداية 1955 لتبليغ البريد إلى مسؤولي القبائل الكبرى بهدف التعاون والتنسيق والتشاور لنشر الثورة ودعمها وعلى مواجهة حركة المصاليين والقضاء عليها. ************************************************** ************************************************** ******* محمود خذري محمود خذري:وزير العلاقات مع البرلمان الجزائري في حكومة عبد العزيز بلخادم من مواليد 20 فبراير 1948 بغسيرة باتنة. التكويين والشهادات
الخبرة المهنية
المهام السياسية، البرلمانية والوزارية
************************************************** *************************************** مسعود بن زلماط هو مسعود بن زلماط بطل شعبي عاش في منطقة الأوراس كان راعي ماعز ثار ضد المستعمر الفرنسي و سجل إسمه بين الثورات المتتالية ضد فرنسا دامت ثورته من 1917 و انتهت 1921 تاريخ مقتله و إعتبرته السلطات الإستعمارية في ذلك الوقت كلص على عكس أهالي المنطقة الذين لازالوا إلى اليوم يتغنون ببطولاته [1][2] ميلاده ولد مسعود بن زلماط في بلدية إينوغيسن بنواحي آريس بولاية باتنة في الجزائر في 1894 من أحمد بن زلماط و عيشة بنت زروال [3] أبواه كان لهم ولدان أكبرهم كان إسمه علي و أصغرهم إسمه مْـحمد حياته كان مسعود و إخوته أُميون حيث لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة لفقرهم المدقع، فكانوا في صغرهم يزاولون رعي الغنم و الماعز كطفولة غالبية أبناء القرويين و المناطق النائية في الجزائر أثناء هذه الفترة قبض على أخيه و حكم عليه بعام سجن من طرف المحكمة الإستعمارية لمدينة باتنة بدون أدلة، لكنه هرب من السجن و التحق بالجبل في الأوراس مع شلة من الخارجين عن القانون الإستعماري الذي يطالب بهم لشتى العقوبات، ففي أثناء 1916 أطلق الجيش الفرنسي عملية عسكرية للملاحقة الثوار و القبض عليهم تكللت العملية بالقبض على جزء كبير من الهاربين من بينهم أخوه، لكن علي أخ مسعود بن زلماط يموت في ظروف غامضة ما دفع بمسعود للإلتحاق بالجبل و تولى قيادة الثوار للإنتقام من الفرنسيين و الإتيان بثأر أخيه، كانت هذه بداية اسطورة مسعود بن زلماط. في الجبل في البداية كانت رغبة في الإنتقام لتتحول فيما بعد إلى ثورة ضد الإدارة الإستعمارية إعتبره السكان المحليون في مناطق الشرق الجزائري و الأوراس بالخصوص ظالما مستبدا مغتصبا لحقوقهم، بطلاقه حينية قرر كل الفارين من الصبايحية التابعين للجيش الفرنسي الإلتحاق بحركته الثورية و تلقي أوامره. الكثير منهم تركوا حامياتهم العسكرية بكل أسلحتهم و ذخيرتهم و اموالهم. في 14 و 15 أكتوبر 1917 ، تعرضت فم الطوب قرية معمرين فرنسيين لهجوم مسلح من طرف جماعته كل البيوت أفرغت من أموالها و اشيائها الثمينة احتل بن زلماط القرية كل اليوم و غادرها في الصباح تاركا وراءه المعمرين مربوطين خائفين في العراء. انتشر الخبر بسرعة البرق بين الشاوية في بلاد الأوراس حتى آخر قرية منها ،كان كل الناس يتبادلون أخباره و يبحثون عن جديده و يفتخرون ببطولاته،[4] حكم عليه القاضي المستعمر و إعتبره خارجا عن القانون في 1917 و قررت السلطات مطاردته في كل مكان يتواجد فيه و بدأت حكايته منذ ذلك الوقت [5] فارون آخرون سيلتحقون بثورته في قرية لسكار و سريانة و يلتحقون بغابات بلازمة، و حسب تصريحات عساكر الدرك الفرنسي في باتنة فإنهم قاموا ب 1423 مداهمة و تفتيش و 972 عملية تمشيط تكللت بإلقاء القبض على 632 من الثوار منهم 179 فار من الجيش الفرنسي، 433 فار من الخدمة و 20 محكوم عليه كل هذه العمليات لم تأت بإلقاء القبض على مسعود بن زلماط إغتياله في 7 مارس 1921 أغتيل مسعود بن زلماط من طرف قوات الإحتلال الفرنسي دامت مقاومته حوالي 5 سنوات غيرت من خلالها نظرة المستعمر لسكان المنطقة و للجزائريين عموما[6] بن زلماط في التراث الثقافي يعتبر مسعود بن زلماط أو أوزلماط كما يفضل سكان المنطقة في جبال الأوراس تسميته اسطورة شعبية أمثال: “أرزقي أولبشير” في منطقة القبائل، وبوزيان القلعي في معسكر ضواحي المحمدية، ومسعود بن زلماط في الأوراس، والإخوة بوتويزرات في عين تموشنت مع فارق أن انتفاضة هؤلاء كانت دون وعي، وإنما عن رفضهم للقوانين الفرنسية وهم يشتركون في تعرضهم لظلم الكولون والإدارة الاستعمارية التي سلبتهم الأرض والأهل والشرف والوطن. [7] دخل بن زلماط في التراث الشعبي للمنطقة حيث سجلت عنه قصص بطولية كثيرة يتواترها الناس شفهيا و تغنى به المغنون من الشاوية و مازالت شخصيته تلتهم الفنانين من بينها مسرحية بعنوان المستقبل في ملتقى التاريخ [8] مراجع
يتبع |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 5 | |||
|
علماء وا دباء ومفكرين وفنانين وشخصيات هامة من منطقة الشاوية :
****بعض المجاهدين و القادة **** مصطفى بن بولعيد مصطفى بن بولعيد(1917-1956) شخصية ثورية وقائد عسكري جزائري و يعد أحد قادة الثورة الجزائرية و جبهة التحرير الوطني لقب بـأسد الأوراس و أب الثورة، كان له دور مهم كقائد عسكري في مواجهة الاستعمار الفرنسي ، كما كان قائدا سياسيا يحسن التخطيط والتنظيم والتعبئة كما امتملك رؤية واضحة لأهدافه ولأبعاد قضيته وعدالتها ، وكان يتحلى بإنسانية إلى جانب تمرسه في القيادة العسكرية والسياسية. محتويات حياته مصطفى بن بولعيد من مواليد 5 فيفري 1917 بأريس ولاية باتنة من عائلة أمازيغية ثرية . تلقى تعليمه الأولي على أيدي شيوخ منطقته فحفظ ما تيسر له من القرآن الكريم وبعد هذا التحصيل تحول إلى مدينة باتنة للالتحاق بمدرسة الأهالي لمواصلة دراسته،. الوعي المبكر  مصطفى بن بولعيد حين قبض عليه وهنا لاحظ بن بولعيد سياسة التفرقة والتمييز التي تمارسها الإدارة الاستعمارية بين الأطفال الجزائريين وأقرانهم من أبناء المعمرين. وخوفا من تأثره وذوبانه في الشخصية الاستعمارية أوقفه والده عن الدراسة، لكن طموح الفتى وإرادته في تحصيل المزيد من العلوم دفعه إلى الالتحاق بمدرسة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في أريس وكان يشرف عليها آنذاك مسعود بلعقون والشيخ عمر دردور، وفي هذه الأثناء كان يساعد والده في خدمة الأرض والتجارة غير أن وفاة الوالد في 7 مارس 1935 قلبت حياة الشهيد الذي أصبح المسؤول الأول عن عائلته وهو في الثامنة عشر من عمره. ونظرا لمشاهد البؤس اليومية التي كانت تعيشها الفئات المحرومة أسس بن بولعيد جمعية خيرية كان من أول ما قامت به هو بناء مسجد بآريس للمحافظة على الشخصية الجزائرية وليكون محورا للتعاون والتضامن بين المواطنين، خاصة التصدي لروح التفرقة والتناحر بين العروش التي كانت تغذيها الإدارة الاستعمارية وأذنابها للتحكم في العباد والأوضاع وكان نشاط بن بولعيد الاجتماعي عملا إستراتيجيا يرمي من ورائه إلى توثيق اللحمة والأواصر التي تربط بين أبناء المنطقة للتمسك بها عند الشدائد. في سنة 1937 سافر إلى فرنسا واستقر بمنطقة «ميتز» التي تكثر بها الجالية الجزائرية من العمال المحرومين من كل الحقوق وقد مكنته مواقفه في حل مشاكلهم والدفاع عنهم إلى ترأس نقابتهم. لكن غربته لم تدم أكثر من سنة حيث عاد بعدها إلى مسقط رأسه وإلى نشاطه الأول والمتعلق بالفلاحة والتجارة. ومع الوقت تحول محله التجاري إلى شبه ناد يتردد عليه شباب المنطقة من أمثال مسعود عقون،ابن حاية وغيرهم للخوض في الأوضاع التي كانت تعيشها البلاد. في بداية 1939 استدعي بن بولعيد لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية وتم تسريحه في 1942 نتيجة الجروح التي أصيب بها ثم تم تجنبده ثانية ما بين سنتي 1943 و1944 بخنشلة. بعد تسريحه نهائيا برتبة مساعد عاد إلى الحياة المدنية وتحصل على رخصة لاستغلال خط نقل بواسطة الحافلات يربط بين أريس وباتنة. وفي هذه الأثناء انخرط بن بولعيد في صفوف حزب الشعب تحت قيادة مسعود بلعقون وقد عرف بالقدرة الكبيرة على التنظيم والنشاط الفائق مما دفع بالحزب إلى ترشيحه لانتخابات المجلس الجزائري في 4-04-1948 والتي فاز بالدور الأول منها لكن الإدارة الفرنسية لجأت إلى التزوير كعادتها لتزكية أحد المواليين لسياستها. وقد تعرض بن بولعيد إلى محاولتي اغتيال من تدبير العدو وذلك في 1949 و1950. يعتبر بن بولعيد من الطلائع الأولى التي انضمت إلى المنظمة السرية بمنطقة الأوراس كما كان من الرواد الأوائل الذين أنيطت بهم مهمة تكوين نواة هذه المنظمة في الأوراس التي ضمت آنذاك خمسة خلايا نشيطة واختيار العناصر القادرة على جمع الأسلحة والتدرب عليها والقيام بدوريات استطلاعية للتعرف على تضاريس الأرض من جهة ومن جهة ثانية تدبر إمكانية إدخال الأسلحة عن طريق الصحراء دوره في التحضير لثورة نوفمبر  صورة لمجموعة الستة قبل إعلان ثورة نوفمبر 1954 من اليمين إلى اليسار رابح بيطاط ، مصطفى بن بولعيد ، ديدوش مراد ، محمد بوضياف ، الجالسين: كريم بلقاسم و العربي بن مهيدي بعد اكتشاف المنظمة السرية من قبل السلطات الاستعمارية في مارس 1950 برز دور بن بولعيد بقوة لما أخذ على عاتقه التكفل بايواء بعض المناضلين المطاردين وإخفائهم عن أعين العدو وأجهزته الأمنية، وقد أعقب اكتشاف المنظمة حملة واسعة من عمليات التمشيط والاعتقال والاستنطاق الوحشي بمنطقة الأوراس على غرار باقي مناطق الوطن. ولكن بالرغم من كل المطاردات والمضايقات وحملات التفتيش والمداهمة تمكن بن بولعيد بفضل حنكته وتجربته من الإبقاء على المنظمة الخاصة واستمرارها في النشاط على مستوى المنطقة. وبالموازاة مع هذا النشاط المكثف بذل مصطفى بن بولعيد كل ما في وسعه من أجل احتواء الأزمة بصفته عضو قيادي في اللجنة المركزية للحزب. وقد كلف بن بولعيد في أكتوبر 1953 وبتدعيم من نشطاء LصOS بالاتصال بزعيم الحزب مصالي الحاج الذي كان قد نفي في 14 ماي 1954 إلى فرنسا ووضع تحت الإقامة الجبرية، وذلك في محاولة لإيجاد حل وسطي يرضي المركزيين والمصاليين. وبعد ذلك توصل أنصار العمل الثوري المسلح وفي طليعتهم بن بولعيد إلى فكرة إنشاء «اللجنة الثورية للوحدة والعمل» والإعلان عنها في 06 مارس 1954 من أجل تضييق الهوة التي تفصل بين المصاليين والمركزيين من جهة وتوحيد العمل والالتفاف حول فكرة العمل الثوري من جهة ثانية. وبعد عدة إتصالات مع بقايا التنظيم السري OS تم عقد اللقاء التاريخي لمجموعة الـ22 بدار المناضل المرحوم الياس دريش بحي المدنية في 24 جوان 1954 الذي حسم الموقف لصالح تفجير الثورة المسلحة لاسترجاع السيادة الوطنية المغتصبة منذ أكثر من قرن مضى. ونظرا للمكانة التي يحظى بها بن بولعيد فقد أسندت إليه بالإجماع رئاسة اللقاء الذي انجر عنه تقسيم البلاد إلى مناطق خمس وعين على كل منطقة مسؤول وقد عين مصطفى بن بولعيد على رأس المنطقة الأولى: الأوراس كما كان أحد أعضاء لجنة «الستة» «بوضياف، ديدوش، بن بولعيد، بيطاط، بن مهيدي، كريم». ومن أجل توفير كل شروط النجاح والاستمرارية للثورة المزمع تفجيرها، تنقل بن بولعيد رفقة: ديدوش مراد، محمد بوضياف ومحمد العربي ين مهيدي إلى سويسرا خلال شهر جويلية 1954 بغية ربط الاتصال بأعضاء الوفد الخارجي «بن بلة، خيضر وآيت أحمد» لتبليغهم بنتائج اجتماع مجموعة الـ22 من جهة وتكليفهم بمهمة الإشراف على الدعاية لصالح الثورة. ومع اقتراب الموعد المحدد لتفجير الثورة تكثفت نشاطات بن بولعيد من أجل ضبط كل كبيرة وصغيرة لإنجاح هذا المشروع الضخم، وفي هذا الإطار تنقل بن بولعيد إلى ميلة بمعية كل من محمد بوضياف وديدوش مراد للاجتماع في ضيعة تابعة لعائلة بن طوبال وذلك في سبتمبر 1954 بغرض متابعة النتائج المتوصل إليها في التحضير الجاد لإعلان الثورة المسلحة ودراسة احتياجات كل منطقة من عتاد الحرب كأسلحة والذخيرة. وفي 10 أكتوبر 1954 التقى بن بولعيد، كريم بلقاسم ورابح بيطاط في منزل مراد بوقشورة بالرايس حميدو وأثناء هذا الاجتماع تم الاتفاق على:
وفي تلك الليلة قال بن بولعيد قولته الشهيرة: "إخواني سنجعل البارود يتكلم هذه الليلة" وتكلم البارود في الموعد المحدد وتعرضت جل الأهداف المحددة إلى نيران أسلحة جيش التحرير الوطني وسط دهشة العدو وذهوله. وفي صبيحة يوم أول نوفمبر 54 كان قائد منطقة الأوراس مصطفى بن بولعيد يراقب ردود فعل العدو من جبل الظهري المطل على أريس بمعية شيهاني بشير، مدور عزوي، عاجل عجول ومصطفى بوستة. وقد حرص بن بولعيد على عقد اجتماعات أسبوعية تضم القيادة ورؤساء الأفواج لتقييم وتقويم العمليات وتدارس ردود الفعل المتعلقة بالعدو والمواطنين. وفي بداية شهر جانفي 1955 عقد هذا الأخير اجتماعا في تاوليليت مع إطارات الثورة تناول بالأخص نقص الأسلحة والذخيرة، وقد فرضت هذه الوضعية على بن بولعيد اعلام المجتمعين بعزمه على التوجه إلى بلاد المشرق بهدف التزود بالسلاح ومن ثم تعيين شيهاني بشير قائدا للثورة خلال فترة غيابه ويساعده نائبان هما: عاجل عجول وعباس لغرور. الاعتقال والعودة لقيادة الثورة وإغتياله  تمثال مصطفى بن بولعيد بأريس ولاية باتنة وفي 24 جانفي 1955 غادر بن بولعيد الأوراس باتجاه المشرق وبعد ثلاثة أيام من السير الحثيث وسط تضاريس طبيعية صعبة وظروف أمنية خطيرة وصل إلى « القلعة « حيث عقد اجتماعا لمجاهدي الناحية لاطلاعهم على الأوضاع التي تعرفها الثورة وأرسل بعضهم موفدين من قبله إلى جهات مختلفة من الوطن. بعد ذلك واصل بن بولعيد ومرافقه عمر المستيري الطريق باتجاه الهدف المحدد. وبعد مرورهما بناحية نقرين «تبسة « التقيا في تامغرة بعمر الفرشيشي الذي ألح على مرافقتهما كمرشد. وعند الوصول إلى « أرديف « المدينة المنجمية التونسية، وبها يعمل الكثير من الجزائريين، اتصل بن بولعيد ببعض هؤلاء المنخرطين في صفوف الحركة الوطنية، وكان قد تعرف عليهم عند سفره إلى ليبيا في منتصف أوت 1954، وذلك لرسم خطة تمكن من إدخال الأسلحة، الذخيرة والأموال إلى الجزائر عبر وادي سوف. وانتقل بن بولعيد من أرديف إلى المتلوي بواسطة القطار ومن هناك استقل الحافلة إلى مدينة قفصة حيث بات ليلته فيها رفقة زميليه. وفي الغد اتجه إلى مدينة قابس حيث كان على موعد مع المجاهد حجاج بشير، لكن هذا اللقاء لم يتم بين الرجلين نظرا لاعتقال بشير حجاج من قبل السلطات الفرنسية قبل ذلك. وعند بلوغ الخبر مسامع بن بولعيد ومخافة أن يلقى نفس المصير غادر مدينة قابس على جناح السرعة على متن أول حافلة باتجاه بن قردان. وعند وصول الحافلة إلى المحطة النهائية بن قرادن طلب هؤلاء من كل الركاب التوجه إلى مركز الشرطة، وحينها أدرك بن بولعيد خطورة الموقف فطلب من مرافقه القيام بنفس الخطوات التي يقوم بها، وكان الظلام قد بدأ يخيم على المكان فأغتنما الفرصة وتسللا بعيدا عن مركز الشرطة عبر الأزقة. ولما اقترب منهما أحد أفراد الدورية أطلق عليه بن بولعيد النار من مسدسه فقتله. وواصلا هروبهما سريعا عبر الطريق الصحراوي كامل الليل وفي الصباح اختبأ، وعند حلول الظلام تابعا سيرهما معتقدين أنهما يسيران باتجاه الحدود التونسيةالليبية لأن بن بولعيد كان قد أضاع البوصلة التي تحدد الإتجاه، كما أنه فقد إحدى قطع مسدسه عند سقوطه. وما أن طلع النهار حتى كانت فرقة الخيالة تحاصر المكان وطلب منهما الخروج وعندما حاول بن بولعيد استعمال مسدسه وجده غير صالح وإثر ذلك تلقى هذا الأخير ضربة أفقدته الوعي وهكذا تم اعتقال بن بولعيد يوم 11 فيفري 1955. وفي 3 مارس 1955 قدم للمحكمة العسكرية الفرنسية بتونس التي أصدرت يوم 28 ماي 1955 حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة بعدها نقل إلى قسنطينة لتعاد محاكمته من جديد أمام المحكمة العسكرية في 21 جوان 1955 وبعد محاكمة مهزلة أصدرت الحكم عليه بالإعدام.ونقل إلى سجن الكدية الحصين.وفي السجن خاض بن بولعيد نضالا مريرا مع الإدارة لتعامل مساجين الثورة معاملة السجناء السياسيين وأسرى الحرب بما تنص عليه القوانين الدولية. ونتيجة تلك النضالات ومنها الإضراب عن الطعام مدة 14 يوما ومراسلة رئيس الجمهورية الفرنسية تم نزع القيود والسلاسل التي كانت تكبل المجاهدين داخل زنزاناتهم وتم السماح لهم بالخروج صباحا ومساء إلى فناء السجن. وفي هذه المرحلة واصل بن بولعيد مهمته النضالية بالرفع من معنويات المجاهدين ومحاربة الضعف واليأس من جهة والتفكير الجدي في الهروب من جهة ثانية. وبعد تفكير متمعن تم التوصل إلى فكرة الهروب عن طريق حفر نفق يصلها بمخزن من البناء الاصطناعي وبوسائل جد بدائية شرع الرفاق في عملية الحفر التي دامت 28 يوما كاملا. وقد عرفت عملية الحفر صعوبات عدة منها الصوت الذي يحدثه عملية الحفر في حد ذاتها ثم الأتربة والحجارة الناتجة عن الحفر. وقد تمكن من الفرار من هذا السجن الحصين والمرعب كل من مصطفى بن بولعيد، محمد العيفة، الطاهر الزبيري، لخضر مشري، علي حفطاوي، إبراهيم طايبي، رشيد أحمد بوشمال، حمادي كرومة، محمد بزيان، سليمان زايدي وحسين عريف. وبعد مسيرة شاقة على الأقدام الحافية المتورمة والبطون الجائعة والجراح الدامية النازفة وصبر على المحن والرزايا وصلوا إلى مراكز الثورة. وفي طريق العودة إلى مقر قيادته انتقل إلى كيمل حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع إطارات الثورة ومسؤوليها بالناحية، كما قام بجولة تفقدية إلى العديد من الأقسام للوقوف على الوضعية النظامية والعسكرية بالمنطقة الأولى "الأوراس". وقد تخلل هذه الجولة إشراف بن بولعيد على قيادة بعض أفواج جيش التحرير الوطني التي خاضت معارك ضارية ضد قوات العدو وأهمها: معركة إيفري البلح يوم 13-01-1956 ودامت يومين كاملين والثانية وقعت بجبل أحمر خدو يوم 18-01-1956. وقد عقد آخر اجتماع له قبل استشهاده يوم 22 مارس 1956 بالجبل الأزرق بحضور إطارات الثورة بالمنطقة الأولى وبعض مسؤولي جيش التحرير الوطني بمنطقة الصحراء. ومساء اليوم نفسه أحضر إلى مكان الاجتماع مذياع الذي كان ملغما الذس ألقته قوات الاستعمار الفرنسي وعند محاولة تشغيله انفجر مخلفا استشهاد قائد المنطقة الأولى مصطفى بن بولعيد وخمسة من رفاقه. و يشاع أيضا عن وفاته: غموض شديد يلف قضية إغتيال البطل الشهيد مصطفى بن بولعيد أحد الستة الذين فجروا ثورة التحرير، وأغرب ما في الأمر هو محاولة البعض التعتيم على هذه القضية والكثير من القضايا التاريخية المتعلقة بثورة التحرير، وحرمان الجيل الجديد من معرفة تاريخ وطنه بكل تفاصيله، رغم مرور أكثر من نصف قرن على اندلاع الثورة، ورغم أن كل ما كنا نعرفه عن قضية استشهاد بن بولعيد خلال طفولتنا المدرسية هو انفجار مذياع مفخخ في ظروف “غامضة” على مصطفى بن بولعيد، ولكن كيف؟ وأين؟ ومتى؟ ومن دبر ونفذ هذا العملية الشنيعة؟ أسئلة كثيرة يطرحها جيلنا على جيل الثورة، ويريد إجابات صريحة ودقيقة بعيدا عن أي خلفيات سياسية أو شخصية أو قبلية، وكل ما أردنا ان نفتح هذا الملف بشكل أكثر عمقا وتفصيلا، كانو ينصحوننا بعدم الخوض في هكذا مسائل، إلا اننا ارتأينا أنه لا بد من معرفة الحقيقة، وإسكات صراخ هذه الأسئلة التي لا نجد لها جوابا. وعملنا خلال هذا التحقيق على الاتصال ببعض المجاهدين والباحثين في تاريخ الثورة والاستعانة ببعض الكتب والمذكرات التاريخية التي تناولت قضية اغتيال مصطفى بن بولعيد، وكان لا بد من الرجوع قليلا إلى الوراء لمعرفة الصراع بين قادة الأوراس بعد أسر بن بولعيد قائد المنطقة التاريخية الأولى (أوراس النمامشة)، والذي أدى إلى مقتل شيحاني بشير نائب مصطفى بن بولعيد بأمر من عجول عجول الذي أصبح عمليا قائدا للأوراس، في حين تمرد عليه عمر بن بولعيد شقيق سي مصطفى وفي هذا الجو المشحون بالصراعات، تمكن مصطفى بن بولعيد من الهرب بأعجوبة من سجن الكدية بقسنطينة في 10 نوفمبر 1955 رفقة عشرة من رفاقه كان من بينهم الطاهر الزبيري، وبعودته إلى الأوراس اكتشف سي مصطفى عدة أخطاء ارتكبت في غيابه، كما أن أن عجول القائد الفعلي للأوراس فاجأه تمكن بن بولعيد من الهرب من السجن، كما أن السلطات الاستعمارية غاضها كثيرا تمكن زعيم الأوراس من الفرار من قبضتها وإعادة تنظيمه وتوحيده لصفوف المجاهدين. عجول يشكك في وطنية بن بولعيد!! حسب رواية الطاهر الزبيري آخر قادة الأوراس التاريخيين فإن عودة مصطفى بن بولعيد إلى مركز قيادة منطقة الأوراس فاجأت عجول عجول الذي آلت إليه قيادة المنطقة عمليا بعدما تمكن من التخلص من شيحاني بشير نائب بن بولعيد الذي خلفه على رأس المنطقة قبل اعتقاله على الحدود التونسية الليبية، وما زاد في تعميق الهوة بين الرجلين هو اكتشاف بن بولعيد أن عجول هو الذي أمر بقتل نائبه شيحاني بشير رفقة عدد آخر من المجاهدين بسبب أخطاء لا يرى بن بولعيد أنها تستحق عقوبة الموت فلام عجول كثيرا على هذا الأمر وقال له “تستقل الجزائر ولن نجد خمسة رجال مثله” فقد كان شيحاني رجلا مثقفا في زمن طغى فيه الجهل والأمية، ولم يستسغ عجول هذا التأنيب. ويؤكد العقيد الزبيري حسبما رواه له شخصيا المرحوم العقيد الحاج لخضر عبيد أحد قادة الأوراس الذي كان قريبا من بولعيد في تلك الفترة أن عجول لم يبد كبير ترحاب بنجاة بن بولعيد من الأسر وفراره من السجن، بل شكك في صحة هروبه فعلا من سجن الكدية الحصين عندما قال لبعض المجاهدين “سجن فرنسا ليس كرتونا ليهربوا منه بسهولة”، بل أكثر من ذلك رفض عجول إعادة الاعتبار لبن بولعيد كقائد للمنطقة الأولى رغم أنه واحد من الستة المفجرين لثورة التحرير وواجهه قائلا “النظام (الثورة) ما يديرش فيك الثقة غير بعد ست أشهر” بمعنى أن نظام الثورة لن يجدد فيك الثقة كقائد للمنطقة إلا بعد ستة أشهر من التحري والتحقق إلى غاية التأكد بأن بن بولعيد ليس مبعوثا من فرنسا لاختراق الثورة وإضعافها، وهذه الكلمات فاجأت بن بولعيد وأثارت حفيظته وأزعجته كثيرا وشكا هذا الأمر للحاج لخضر عبيد عندما قال له “أتعلم ماذا قال لي عجول؟..الثورة لن تجدد فيك الثقة إلا بعد ستة أشهر”. وأثار عجول قضية عمر بن بولعيد شقيق مصطفى بن بولعيد الذي انفرد بقيادة ناحية من نواحي المنطقة الأولى ونصب نفسه قائدا للمنطقة في غياب أخيه ولم يعترف بعجول وعباس لغرور كقائدين للأوراس، فرد عليه سي مصطفى “سأستدعي عمر وإن ثبت عليه التهم التي وجهتها إليه فأنا من سينفذ حكم الموت عليه بيدي”. ولم يكن عجول ينظر بعين الرضا إلى الوفود التي كانت تزور مصطفى بن بولعيد وتهنئه على النجاة وتعلن له الولاء والطاعة، متجاوزة عجول، ولم يكن يمر يوم على سي مصطفى إلا ويجتمع مع هؤلاء وهؤلاء لإعادة تنظيم منطقة الأوراس التي نخرتها الانقسامات بفعل الصراعات الشخصية والعروشية والفراغ الذي تركه غيابه ونائبه، وتمكن بن بولعيد في فترة قصيرة من حل العديد من الخلافات والصراعات وإعادة لحمة منطقة الأوراس، فقد كان يحظى بثقة قيادات الثورة في الداخل والخارج فضلا عن مجاهدي الأوراس الذين يدينون له بالولاء. بن بولعيد يستشهد بطريقة طالما حذر أصحابه منها!! وفي 22 مارس 1956 استشهد البطل مصطفى بن بولعيد في ظروف غامضة عند انفجار جهاز إشارة (إرسال واستقبال) مفخخ بإحدى الكأزمات ومعه سبعة من المجاهدين ولم ينجو منهم إلا اثنين أحدهم يدعى علي بن شايبة، ويستغرب الطاهر الزبيري كيف يقتل بن بولعيد بجهاز فرنسي مفخخ رغم أنه حرص في كل مرة على غرار ما أوصاهم به قبل الهروب من السجن بعدم لمس الأشياء المشبوهة حتى ولو كانت قلما، خشية أن تكون مفخخة، مما يوحي بأن هناك مؤامرة دبرت بليل ضد مصطفى بن بولعيد، ولكن يبقى التساؤل من قتل هذا البطل؟ ومن خطط لهذه المؤامرة؟ ويوضح الزبيري أن الجهاز المفخخ الذي أدى إلى استشهاد مصطفى بن بولعيد تركته فرقة للجيش الفرنسي بمكان غير بعيد عن مركز قيادة الأوراس، وعند مغادرتها للمكان عثر المجاهدون على الجهاز فحملوه إلى مصطفى بن بولعيد الذي أراد تشغيله فانفجر الجهاز مما أدى إلى استشهاد البطل بن بولعيد، ويستدل أصحاب هذه الرواية باعترافات بعض جنرالات فرنسا في مذكراتهم بأنهم هم من خطط وفخخ الجهاز الذي أدى إلى استشهاد قائد المنطقة الأولى، غير أن هذه الرواية تبدوا غريبة إذا قسنا ذلك بالحذر الذي يميز بن بولعيد في التعامل مع الأشياء التي يخلفها جيش الاحتلال، إذ كيف يقوم بن بولعيد بتشغيل جهاز دون التحقق منه إلا إذا كان واثقا من سلامته من المتفجرات بناء على تطمينات من معه؟ بوضياف: بن بولعيد قتله مجاهد ألماني خطأ ويروي العقيد الطاهر الزبيري على لسان علي بن شايبة الناجي من الانفجار الذي خلفته القنبلة المخبأة في الجهاز أن مصطفى بن بولعيد عندما عاين الجهاز لاحظ أنه لا يحتوي على بطاريات فطلب منه إحضار البطاريات ولما جاءه بما طلب تم وضعها في الجهاز وبمجرد تشغيله انفجر مخلفا ثماني قتلى وجريحين، ولكن سي الطاهر نفسه يشكك في صحة هذه الرواية، ويشير إلى أن المجاهدين تحصلوا خلال كمين نصبوه لفرقة لجيش الاحتلال على جهاز إشارة وغنموا منها بعض قطع السلاح، وعندما أحضر المجاهدون جهاز الإشارة الصغير هذا قال لهم سي مصطفى ـ حسبما رواه موسى حواسنية للطاهر الزبيري ـ “حطوه حتى انشوفولوا خبير يتأكد إذا فيه مينا” بمعنى ضعوا جهاز الإشارة هذا جانبا حتى يفحصه خبير في المتفجرات لعل فيه لغم، وجاء الخبير وفحص جهاز الإشارة هذا وتأكد من أن الجهاز غير مفخخ، وتؤكد هذه الحادثة الحرص الشديد لبن بولعيد على عدم استعمال أي جهاز يأتي من العدو حتى ولو غنموه في المعارك، لذلك يبدوا الأمر غامضا عندما ينفجر جهاز إشارة كبير يستعمل في الاتصالات الدولية في كازمة لقائد المنطقة، خلفه عساكر العدو في إحدى تنقلاتهم!! أما محمد بوضياف المنسق العام للثورة فيؤكد أن مجاهدا ألمانيا كان ضمن صفوف جيش التحرير هو الذي قتل مصطفى بن بولعيد عن طريق الخطأ، ويقول في حوار أجراه معه الصحفي والكاتب خالد بن ققة في 1991 بالمغرب “..إن ثورتنا كان فيها أناس من أمم أخرى كالألمان، حتى أن أحدهم قتل مصطفى بن بولعيد خطأ، إذ وضع قنبلة في مذياع، ووجده رجال الثورة في الطريق، فأخذوه، وعندما فتح بن بولعيد المذياع تفجرت فيه القنبلة”، إلا أن بعض المجاهدين يقللون من شهادة بوضياف الذي كان في الخارج عند اغتيال مصطفى بن بولعيد ويعتبرون أن شهادته لا يعتد بها ما دام لم يكن حاضرا عند حادثة الاغتيال، إلا أن شهادة محمد بوضياف لها أهميتها باعتباره المنسق العام للثورة وبالتالي فإن المعلومات التي يتحصل عليها هي معلومات رسمية خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصية بحجم بن بولعيد. سعيداني يتهم عجول بتدبير مؤامرة اغتيال بطل الأوراس غير أن أخطر ما قيل عن استشهاد مصطفى بن بولعيد ما كتبه الرائد الطاهر سعيداني في مذكراته حيث اتهم صراحة عجول عجول بتدبير عملية اغتيال مصطفى بن بولعيد عندما أمر علي الألماني بتفخيخ جهاز إشارة للتخلص من أحد الخونة، ثم قدم الجهاز المفخخ إلى أحد المجاهدين وطلب منه أن يقدمه لمصطفى بن بولعيد على أساس أنه عثر عليه في الخارج، وعندما أراد ذلك المجاهد تنفيذ ما أمر به، كان عجول مع بن بولعيد في إحدى الكأزمات ولما دخل عليهم خرج عجول وترك بن بولعيد مع المجاهد الذي سلمه الجهاز، وبمجرد أن شغله بن بولعيد حتى انفجر وقضى عليه. ويروي الطاهر السعيداني هذه الحادثة مع بعض التفصيل فيقول “ذات يوم فيما كان مصطفى بن بولعيد يتحدث إلى مجاهديه دخل عليهم جندي يحمل بين يديه مذياعا (لم يكن مذياعا وإنما جهاز إشارة) أعطاه لمصطفى بن بولعيد مؤكدا له أنه وجده مرميا، ولكن هذا غير صحيح، فما إن أمسكه حتى غادر عجول عجول المكان وحينما حاول بن بولعيد فتح المذياع ليستمع إلى الأخبار وإذا به ينفجر عليه ويسقط شهيدا” ويضيف سعيداني الذي كان ضابطا في القاعدة الشرقية “… في طريقنا لتهنئة الكتيبة التي كان يقودها لخضر بلحاج ـ بعد انتصارها في إحدى المعارك ـ وجدنا وسط المجاهدين جنديين من الألمان اللذين كانا مجندين في اللفيف الأجنبي الفرنسي..أحدهما يدعى علي الألماني اعتنق الإسلام في القاعدة الشرقية… وكان متخصصا في المتفجرات فطلبنا منه من باب الفضول كيف تم تلغيم المذياع الذي أعطي لبن بولعيد فأجابنا أنه لم يكن يعلم بأن المذياع الذي أتاه به عجول عجول من أجل تلغيمه كان موجها للانفجار في وجه مصطفى بن بولعيد لقتله بل ظن انه سيرسل لشخص خائن كما قال له عجول” ويختم المجاهد الطاهر سعيداني كلامه “هذا ما أجابني به علي الألماني وأشهد به أمام الشهداء والتاريخ”. وباستشهاد مصطفى بن بولعيد تعرضت منطقة الأوراس إلى هزة قوية أفقدتها توازنها ولم يتمكن عجول عجول بالرغم من صرامته من جمع كلمة المنطقة تحت سلطته فرفض عدد من قادة الأوراس الاعتراف بقيادته للمنطقة بل وحملوه مسؤولية استشهاد البطل مصطفى بن بولعيد، وحاول بعضهم اغتياله لكنه تمكن من النجاة بأعجوبة بعدما أصيب بجراح حسب بعض الشهادات وسلم نفسه إلى الجيش الفرنسي لأسباب ما زالت غامضة رغم اعتراف الكثير من المجاهدين حتى أولئك الذين اختلفوا معه بوطنيته وشجاعته وقوة شخصيته. يتبع ان شاء الله |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 6 | |||
|
علماء وا دباء ومفكرين وفنانين وشخصيات هامة من منطقة الشاوية :
****بعض المجاهدين و القادة **** اكمال مصطفى بن بولعيد المخابرات الفرنسية تفتخر بـ”نجاحها” في اغتيال بن بولعيد غير أن الكاتب والباحث محمد عباس المتخصص في قضايا الثورة الجزائرية والحركة الوطنية ينفي بشكل مطلق صحة هذه الرواية، ويشكك في مصداقية صاحبها، مؤكدا أن بعض الجهات التي كانت تنافس عجول عجول على قيادة منطقة الأوراس بعد أسر قائدها هي التي سعت لتلفيق تهمة اغتيال عجول لمصطفى بن بولعيد قصد تشويهه، مضيفا أن عمر بن بولعيد شقيق مصطفى كان يسعى لخلافة أخيه على رأس المنطقة الأولى عندما كان هذا الأخير أسيرا وبعد اغتياله، كما أن خلافاته مع عجول معروفة لذلك سعى لترويج رفقة الجماعة التي كانت ملتفة حول مصطفى بن بولعيد إشاعة أن عجول هو الذي دبر عملية اغتيال بن بولعيد، مشيرا إلى أن هذا الأخير منع شقيقه عمر بعد فراره من السجن من تولي أي مسؤولية قيادية، بالإضافة إلى أن عرش بن بولعيد نفسه لا يصدقون رواية تورط عجول في اغتيال سي مصطفى. ويجزم محمد عباس بأن المخابرات الفرنسية وعلى أعلى المستويات في باريس هي التي دبرت عملية اغتيال مصطفى بن بولعيد، باعتراف جنرالاتها الذين اعتبروا هذه العملية إنجازا كبيرا لهم يستحق الافتخار، حيث نشر أحد رجال المخابرات الفرنسية كتابا تحت اسم مستعار تحدث بالتفصيل عن هذه العملية “الناجحة” التي أدت إلى تعطيل ولاية الأوراس من 1956 إلى غاية نهاية 1959 وبداية 1960 وتحييدها عن الكفاح المسلح بعد أن كانت قلب الثورة النابض حيث اشتدت الانقسامات بين قياداتها، ولكن لحسن الحظ أن الثورة امتدت إلى بقية الولايات بشكل لا رجعة فيه. ويوضح الباحث محمد عباس الذي استقى معلوماته من بعض الشهود والشهادات أن المخابرات الفرنسية وبعد هروب مصطفى بن بولعيد من السجن خططت لزعزعة استقرار منطقة الأوراس (أصبحت ولاية بعد مؤتمر الصومام في أوت 1956) عن طريق اغتيال بن بولعيد بطريقة ماكرة، وكانت تعلم أن قيادة الأوراس بحاجة إلى جهاز إشارة للاتصال بقيادة الثورة في الخارج، فأرسلوا فصيل إشارة إلى المنطقة وتعمدوا ترك مؤن على سبيل الخطأ حتى لا يثيروا شكوك المجاهدين عندما تركوا جهاز الإشارة الذي تم تلغيمه بشكل محكم وبمستوى تكنولوجي متطور، وحمل المجاهدون الجهاز إلى مصطفى بن بولعيد وقام أحدهم باستعمال بطاريات جهاز الإشارة لإشعال جهاز إنارة فانفجر الجهاز الملغم واستشهد ثماني مجاهدين وجرح اثنان وهما علي بن شايبة (ما زال على قيد الحياة)، ومصطفى بوستة (توفي بعد الاستقلال). وعن السر وراء تعامل بن بولعيد مع جهاز تركه جيش الاحتلال بالرغم من أنه طالما حذر رجاله من التقاط الأشياء المشبوهة خشية أن تكون ملغمة، برر محمد عباس ذلك بان الأجل لا ينفع معه الحذر، وأشار إلى حاجة قيادة الأوراس لجهاز إشارة للاتصال بقيادات الثورة في الداخل والخارج، فضلا عن أن الجهاز كان ملغما بشكل محكم يصعب اكتشافه، ولكنه تحدث من جهة أخرى عن محاولة ثانية وبنفس الطريقة قامت بها المخابرات الفرنسية في 1957 لتمزيق الولاية الثالثة (القبائل) عندما انفجر جهاز مفخخ على محند أولحاج قائد الولاية ولكنه أصيب بجروح ولم يستشهد. عملاء المخابرات الفرنسية هم من قتلوا سي مصطفى من جهته يؤكد الدكتور لحسن بومالي الباحث في تاريخ الثورة الجزائرية أن المخابرات الفرنسية هي التي دبرت عملية اغتيال مصطفى بن بولعيد ونفذتها عن طريق عملائها الذين غرستهم في صفوف المجاهدين، ويضيف أن السلطات الفرنسية لم تحتمل قضية هروب مصطفى بن بولعيد من سجن الكدية بقسنطينة ببساطة رغم الحراسة المشددة التي كان خاضعا لها، فأرادت القضاء عليه بأي وسيلة، مستعينة في ذلك بعملائها المندسين بين صفوف المجاهدين لكنه لا يعطي تفاصيل أكثر عن هؤلاء العملاء الذين اغتالت المخابرات الفرنسية بأيديهم أحد الستة المفجرين لثورة التحرير وعضو مجموعة 22 التي خططت لاندلاعها. إن هذا التحقيق يطرح أمامنا ثلاث فرضيات حول اغتيال مصطفى بن بولعيد، الفرضية الأولى وهي الأقوى تدين المخابرات الفرنسية بتدبير عملية الاغتيال هذه لأنها كانت تسعى للقضاء على قائد الأوراس مهما كلفها ذلك من ثمن، وذلك منذ تمكن سي مصطفى من الفرار من سجن الكدية وما يشكله ذلك من خطورة على الوجود الاستعماري، واعتراف ضباط المخابرات الفرنسية في مذكراتهم بأنهم هم من دبروا عملية الاغتيال وهذا الاعتراف هو سيد الأدلة على أنهم هم من قتل مصطفى بن بولعيد بدليل أنهم كرروا نفس الأسلوب في الولاية الثالثة، وهذه الفرضية يميل إلى تصديقها بعض الباحثين والمؤرخين والجهات الرسمية. الفرضية الثانية وترجح وقوع خطأ أدى إلى استشهاد مصطفى بن بولعيد، فعلي الألماني طبقا لشهادتي المرحوم محمد بوضياف والرائد الطاهر سعيداني قام بتفخيخ جهاز الإشارة قصد استعماله ضد عدو، وهذا ما يبرر عدم أخذ مصطفى بن بولعيد حذره المعتاد عند استعماله لهذا الجهاز وهذه الأخطاء كثيرا ما تقع في الحروب والثورات، وليس مستبعدا أن يكون مقتل بن بولعيد جاء عن طريق الخطأ. الفرضية الثالثة وتحمل مسؤولية اغتيال بن بولعيد لعجول إذا فرضنا صدق رواية الرائد سعيداني، وانطلاقا من خلفيات الصراع بين عجول ومصطفى بن بولعيد الذي وبخه لقتله نائبه شيحاني بشير بطل معركة الجرف، بالإضافة إلى خلافات عجول مع شقيق بن بولعيد حول قيادة الأوراس، والأخطر من ذلك محاولة عجول التشكيك في حقيقة هروب بن بولعيد من السجن ورفضه تجديد الثقة به كقائد للأوراس قبل ستة أشهر طبقا لنظام الثورة الذي يعتمد على مبدأ “أدنى ثقة يعني أعلى درجة من الأمان”، كما أن بعض المجاهدين حاولوا اغتيال عجول لاتهامه بالتورط في اغتيال بن بولعيد لتزعم الأوراس، والسؤال الكبير لماذا سلم عجول نفسه إلى الجيش الفرنسي رغم ما يشهد له من الشجاعة في محاربة الاستعمار؟ ************************************************** ******** مصطفى مراردة مصطفى مراردة هو أحد قيادات الثورة الجزائرية، مجاهد ومناضل ضمن صفوف جبهة التحرير الوطني الجزائرية. نبذة عن حياته ولد المجاهد مراردة مصطفى المسمى بن النوي في 21 أوت 1928 بأولاد شليح ولاية باتنة ابن الصالح وقيدوم علجية وتوفي في 18 ماي 2007.  المجاهد مصطفى مراردة أهم أعماله الثورية انخرط في صفوف الثورة التحريرية الجزائرية كمناضل منذ 14 نوفمبر 1954 حيث قام بأعمال عديدة منها مسؤول مركز مكلف بالمخابىْ والاتصال والعمليات، وتخريب مصالح المستعمر. التحق بصفوف جيش التحرير الوطني في ماي 1955 بعد اكتشاف خلية الفدائيين التي كان ينشط فيها استشهد أربعة منهم. رافق الفقيد آنذاك مسؤول ناحية باتنة اعبيدي محمد الطاهر المدعو الحاج لخضر أعبيدي بعد مؤتمر الصومام عين ملازما أول عضواً في الناحية الرابعة بريكة من المنطقة الأولى مكلفاً بالاتصال والأخبار وذلك في أواخر أكتوبر 1956.ثمّ مسؤولا بنفس الناحية في أواخر 1957. ثم عضوا في مجلس المنطقة الأولى باتنة للولاية الأولى أواسط سنة 1958 محتفظاَ بقيادة الناحية، ثم رقى إلى رتبة نقيب مسؤول عن المنطقة الثانية أريس بداية سنة 1959. ثم مسؤولاً للولاية بالنيابة بعد خروج الحاج لخضر إلى تونس بداية أفريل 1959 إلى أفريل 1960. عند تجديد مجلس الولاية رقي رائدا عضو مكلف بالأخبار والاتصال وعضواً في مجلس الثورة الجزائرية أوائل 1960. عمل ملحقا عسكريا في بغداد من جانفي 1965 إلى جويلية 1967 ثم قائداً لمدرسة أشبال الثورة في تلمسان من جويلية إلى نوفمبر 1970 ثمّ عضواً في المجلس الشعبي الوطني عن ولاية باتنة في 1976 إلى 1982 ثم عضواً بالمجلس الوطني للمجاهدين منذ سنة 1990 إلى غاية وفاته. ************************************************** **************** مقداد سيفي مقداد سيفي  1940م-) سياسي ورئيس حكومة سابق، من مواليد 21 أفريل 1940 بمدينة تبسة الواقعة على الحدود الجزائرية – التونسية، ويحمل اجازة في الفيزياء من جامعة الجزائر ثمّ أكمل تعليمه في فرنسا حيث حصل على شهادة في الهندسة الالكتروميكانيكية، وفور عودته من الجزائر عمل في شركة الغاز ثمّ شغل مناصب في وزارة الصناعة إلى أن عينّه بلعيد عبد السلام رئيس الحكومة الأسبق وزيرا للتجهيزات والأشغال العموميّة، وبقيّ في نفس المنصب عندما عينّ رضا مالك رئيسا للحكومة خلفا لبلعيد عبد السلام. ومقداد سيفي رجل تكنوقراطي، وعرف عنه أنه رجل حوار موال للرئيس اليمين زروال، وعندما شكلّ حكومته اختار لها تقنيين وتكنوقراطيين، وأقصى الصقور الذين كانوا في حكومة رضا مالك كالعقيد سليم سعدي ،وكانت حكومته على الشكل التالي : 1940م-) سياسي ورئيس حكومة سابق، من مواليد 21 أفريل 1940 بمدينة تبسة الواقعة على الحدود الجزائرية – التونسية، ويحمل اجازة في الفيزياء من جامعة الجزائر ثمّ أكمل تعليمه في فرنسا حيث حصل على شهادة في الهندسة الالكتروميكانيكية، وفور عودته من الجزائر عمل في شركة الغاز ثمّ شغل مناصب في وزارة الصناعة إلى أن عينّه بلعيد عبد السلام رئيس الحكومة الأسبق وزيرا للتجهيزات والأشغال العموميّة، وبقيّ في نفس المنصب عندما عينّ رضا مالك رئيسا للحكومة خلفا لبلعيد عبد السلام. ومقداد سيفي رجل تكنوقراطي، وعرف عنه أنه رجل حوار موال للرئيس اليمين زروال، وعندما شكلّ حكومته اختار لها تقنيين وتكنوقراطيين، وأقصى الصقور الذين كانوا في حكومة رضا مالك كالعقيد سليم سعدي ،وكانت حكومته على الشكل التالي :طاقمه الحكومي
تقلد منصب رئيس الحكومة الجزائرية من 11 أفريل 1994 خلفا لبلعيد عبد السلام إلى 30 ديسمبر 1995 أي في فترة حكم اليمين زروال خلفه أحمد أويحي ************************************************** *************************** أحمد قايد صالح هو رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري ولد في 13 يناير 1940 بعين ياقوت بولاية باتنة. حياته التحق وهو مناضل شاب في الحركة الوطنية، في سن السابعة عشر من عمره، يوم أول أوت 1957 بالكفاح، حيث تدرج سلم القيادة ليعين قائد كتيبة على التوالي بالفيالق 21 و29 و39 لجيش التحرير الوطني. غداة الاستقلال وبعد إجراء دورات تكوينية بالجزائر والإتحاد السوفياتي سابقا، تحصل خلالها على شهادات، لاسيما، بأكاديمية فيستريل، كما تقلد بقوام المعركة البرية الوظائف التالية: قائدا لكتيبة مدفعية، ثم قائدا للواء، ثم قائدا للقطاع العملياتي الأوسط ببرج لطفي/الناحية العسكرية الثالثة، ثم قائدا لمدرسة تكوين ضباط الاحتياط/البليدة/الناحية العسكرية الأولى، ثم قائدا للقطاع العملياتي الجنوبي لتندوف/بالناحية العسكرية الثالثة، ثم نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة، ثم قائدا للناحية العسكرية الثالثة، ثم قائدا للناحية العسكرية الثانية. تمت ترقيته إلى رتبة لواء بتاريخ 05 جويلية 1993، بتاريخ 1994 تم تعيين اللواء أحمد قايد صالح قائدا للقوات البرية، منذ تاريخ 03 أوت 2004، تم تعيينه قائدا لأركان الجيش الوطني الشعبي خلفا للفريق محمد العماري . قلد رتبة فريق بتاريخ 05 جويلية 2006. أحمد قايد صالح حائزا على وسام جيش التحرير الوطني وسام الجيش الوطني الشعبي الشارة الثانية وسام الاستحقاق العسكري ووسام الشرف و بتاريخ 11 سبتمبر 2013 عين نائبا لوزير الدفاع الوطني يصلاحيات وزير الدفاع كما احتفظ بمنصبه قائدا للاركان كما اعطيت له صلاحيات قيادة المخابرات العسكرية و مديرية الاتصال. يعتبر أحمد قايد صالح رجل من الرجال الألغاز في الجزائر ،إذ لا يزال الغموض يلف حيثيات التقائه مع الساقية، و بتوليه المنصب الجديد سيؤثر بالفعل في مسار تاريخ الجزائر. عرف و لايزال يعرف بقوة شخصيته المندفعة دائما في اتجاه الأزمات و المشاكل. عرف الجيش منذ توليه مناصب القيادة تغيرات جذرية كرست من خلالها أفكار و مبادئ ثورية تنشد العصرنة و التشبيب . عائلته هو متزوج وأب لسبعة (07)أبناء السيد الفـريق أحمـد قايــد صـالــح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ولد الفريق أحمد قايد صالح في 13 يناير 1928 بولاية باتنة. التحق وهو مناضل شاب في الحركة الوطنية، في سن السابعة عشر من عمره، يوم أول غشت 1957 بالكفاح، حيث تدرج سلم القيادة ليعين قائد كتيبة على التوالي بالفيالق 21 و29 و 39 لجيش التحرير الوطني. غداة الاستقلال وبعد إجراء دورات تكوينية بالجزائر والإتحاد السوفياتي سابقا، تحصل خلالها على شهادات، لاسيما، بأكاديمية فيستريل، كما تقلد بقوام المعركة البرية الوظائف التالية: قائدا لكتيبة مدفعية، قائدا للواء، قائدا للقطاع العملياتي الأوسط ببرج لطفي/الناحية العسكرية الثالثة، قائدا لمدرسة تكوين ضباط الاحتياط/البليدة/الناحية العسكرية الأولى، قائدا للقطاع العملياتي الجنوبي لتندوف/بالناحية العسكرية الثالثة، نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة، قائدا للناحية العسكرية الثالثة، قائدا للناحية العسكرية الثانية. تمت ترقيته إلى رتبة لواء بتاريخ 05 جويلية 1993، بتاريخ 1994 تم تعيين اللواء أحمد قايد صالح قائدا للقوات البرية، بتاريخ 03 أوت 2004، تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي. تقلد رتبة فريق بتاريخ 05 جويلية 2006. منذ 11 سبتمبر 2013 تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع الوطني ، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي. الفريق أحمد قايد صالح حائزا على وسام جيش التحرير الوطني وسام الجيش الوطني الشعبي الشارة الثانية وسام الاستحقاق العسكري ووسام الشرف ************************************************** ************************************** علي بن فليس علي بن فليس (8 سبتمبر 1944 بباتنة الجزائر) سياسي جزائري. تقلد عدة مناصب في الحكومة الجزائرية أهمها: وزيرا للعدل ورئاسة الحكومة , وهو رجل قانون في الأساس .متزوج و أب لأربعة أولاد. ولد السيد علي بن فليس في الثامن من شهر سبتمبر من عام ألف و تسعمائة و أربعة و أربعين (08/09/1944) بباتنة، في الأوراس، من عائلة ثورية، فهو ابن شهيد و أخ شهيد فقدهما و هو لا يتجاوز سن الثالثة عشر، درس الطور الابتدائي في باتنة وواصل دراسته بقسنطينة في الطور الثانوي بثانوية حيحي المكي و منها تحصل على شهادة البكالوريا. بعد أن حصل البكالوريا (الثانوية العامة) التحق بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بالجزائر العاصمة ليتخرج منها عام 1968 حاملا شهادة الليسانس. مشواره المهني شغل بن فليس منصب قاض بمحكمة البليدة في أكتوبر 1968، ثم أصبح قاضيا منتدبا بالإدارة المركزية في وزارة العدل حيث كان مديرا فرعيا مكلفا بالطفولة الجانحة من ديسمبر 1968 إلى نهاية 1969. ثم تقلد وظيفة وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة من 1969 إلى 1971 قبل أن يرقى إلى وظيفة نائب عام لدى مجلس قضاء قسنطينة في سنة 1971 و هي الوظيفة التي شغلها إلى سنة 1974 تاريخ التحاقه بسلك المحاماة. مارس بن فليس مهنة المحاماة بمدينة باتنة، وانتخب نقيبا لمنظمة محامي منطقة باتنة ما بين 1983 إلى 1985. وفي نفس الفترة كان عضو اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحامين. وفي سنة 1987 انتخب للمرة الثانية نقيبا لمحامي باتنة حتى سنة 1988. في سنة 1988 اختير علي بن فليس وزيرا للعدل، واحتفظ بهذا المنصب خلال فترة ثلاث حكومات متتالية (حكومة قاصدي مرباح، وحكومة مولود حمروش، وحكومة سيد أحمد غزالي). مشواره السياسي انتخب في ديسمبر 1989 عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير،وترشح ضمن قائمة حزب الجبهة في انتخابات 1991 مع منافسيه في الجبهة الإسلامية للإنقاذ فهزم في دائرة باتنة وترشح ضمن قائمة حزب الجبهة في انتخابات 5 يونيو 1997 بولاية باتنة حيث فازت لائحته بأربعة مقاعد من ضمن 12 مخصصة للولاية. وفي شهر مارس 1998 أعيد انتخابه عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير وكلف بالعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني (البرلمان). برز السيد علي بن فليس في المجال السياسي حيث انتخب في شهر ديسمبر 1989 عضوا في اللجنة المركزية و في المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، كما حظي بتزكية الحزب له في عضوية المكتب السياسي بإعادة انتخابه على التوالي في 1991 و 1996 و 1998 و 2000. و قد تم انتخابه على رأس الحزب، بصفته أمينا عاما، في 20 سبتمبر 2001 ، و أعيد انتخابه في هذا المنصب في المؤتمر الثامن المنعقد في 18-19-20 مارس 2003. تم انتخابه أمينا عاما لجبهة التحرير الوطني في سبتمبر/ أيلول 2003 خلفا لبوعلام بن حمودة. وقد أعلنت الجبهة عن عزمها ترشيح بن فليس لرئاسيات أبريل 2004 على الرغم من ميل ما يمسى بالحركة التصحيحية (جناح من الجبهة موال للرئيس بوتفليقة) إلى الرئيس الجزائري بوتفليقة. وقد جمد القضاء الجزائري نشاط الجبهة في 30 ديسمبر 2003. تقلد السيد علي بن فليس فيما بعد على التوالي مناصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية و مدير ديوان رئاسة الجمهورية، فمنصب رئيس الحكومة الجزائرية من 23 ديسمبر 1999 إلى 27 أغسطس 2000 أي في فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة. سبقه في هذا المنصب أحمد بن بيتور وخلفه أحمد أويحي. عين مجددا في هذا المنصب في شهر يونيو 2002 و أنهيت مهامه في شهر مايو 2003. ************************************************** ************** اليمين زروال اليمين زروال   الرئيس السابع للجمهورية الجزائرية في المنصب 30 يناير 1994 - 27 أبريل 1999 سبقه علي كافي خلفه عبد العزيز بوتفليقة تاريخ الميلاد 3 يوليو 1941 (العمر 73 سنة) مكان الميلاد باتنة، ولاية باتنة، الجزائر الرئيس السابع للجمهورية الجزائرية في المنصب 30 يناير 1994 - 27 أبريل 1999 سبقه علي كافي خلفه عبد العزيز بوتفليقة تاريخ الميلاد 3 يوليو 1941 (العمر 73 سنة) مكان الميلاد باتنة، ولاية باتنة، الجزائر اليمين زروال (3 يوليو 1941 في باتنة، الجزائر) هو الرئيس السابع للجزائر منذ التكوين والرئيس السابع منذ الاستقلال. ولد بمدينة باتنة عاصمة الأوراس التي شهدت اندلاع ثورة التحرير الجزائرية، التحق بجيش التحرير الوطني وعمره لا يتجاوز 16 سنة، حيث شارك في حرب التحرير بين 1957 - 1962. بعد الاستقلال تلقى تكوينا عسكريا في الاتحاد السوفياتي ثم في المدرسة الحربية الفرنسية سنة 1974. ما أتاح له تقلد عدة مسؤوليات على مستوى الجيش الوطني الشعبي، إذ أنه اختير قائدا للمدرسة العسكرية بـباتنة فالأكاديمية العسكرية بـشرشال ثم تولى قيادة النواحي العسكرية السادسة، الثالثة والخامسة. وعين بعدها قائدا للقوات البرية بقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي.  زروال قائد للأركان الجيش الوطني الشعبي بسبب خلافات له مع الرئيس الشاذلي بن جديد حول مخطط لتحديث الجيش في سنة 1989 قدم استقالته، عين على أثر ذلك سفيرا في رومانيا سنة 1990، غير أنه قدم استقالته عام 1991. لكنه عين لاحقا وزيرا للدفاع الوطني في 10 يوليو 1993. ثم عين رئيسا للدولة لتسيير شؤون البلاد طوال المرحلة الانتقالية في 30 يناير 1994. يعد أول رئيس للجمهورية انتخب بطريقة ديمقراطية في 16 نوفمبر 1995 والتي تقول المعارضة انها انتخابات مزورة، في 11 سبتمبر 1998 أعلن الرئيس زروال إجراء انتخابات رئاسية مسبقة وبها أنهى عهده بتاريخ 27 ابريل 1999. زروال السياسي شخصية الرئيس زروال بسيطة ومنضبطة، وقد أعطت رزانته ثمارها في إدارة أخطر أزمة شهدتها الجزائر في تاريخها. يعرف زروال أيضا بأنه مفاوض قوي، وذو هيبة حيث رفض لقاء الرئيس الفرنسي شيراك في ظل شروط مهينة وضعها هذا الأخير، كما رفض الرضوخ للكثير من مطالب صندوق النقد الدولي مما حفظ حدا مقبولا لمستويات العيش، وقد رفض أيضا الاستمرار في الحكم وقام بتقصير عهدته عندما أصبحت بعض أطراف السلطة تتفاوض سرا مع أطراف في المجموعات المسلحة المتمردة. لقد حكم الرئيس زروال البلاد في أصعب الظروف ويعاب عليه عدم قدرته على التحكم في تناقضات المشهد السياسي للجزائر وعدم مرونته في التعامل مع القضايا المشتابكة للساحة الجزائرية، لكن مناصريه يعتبرون أنه كان شجاعا عندما تحمل مسؤولية الرئاسة في ظروف صعبة، كما أنه الأكثر نزاهة وتواضعا من بين كل رؤساء الجزائر، حيث عاد بعد نهاية عهدته إلى منزله المتواضع في مسقط رأسه باتنة وهو تقليد لا نجده إلا في الديمقراطيات العريقة. كما تنازل عن سيارة فخمة من نوع مرسيدس وفيلا بالجزائر العاصم والله اعلم |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 7 | |||
|
علماء وا دباء ومفكرين وفنانين وشخصيات هامة من منطقة الشاوية :
***الادباء و الفنانين و الروائيين*** الطاهر وطار الطاهر وطار (15 أوت 1936 في سوق أهراس[1] - 12 أغسطس 2010[2]) ، كاتب جزائري ولد في بيئة ريفية وأسرة أمازيغية تنتمي إلى عرش الحراكتة الذي يتمركز في إقليم يمتدّ من باتنة غربا (حركتة المعذر) إلى خنشلة جنوبا إلى ما وراء سدراتة شمالا وتتوسّطه مدينة الحراكتة : عين البيضاء، ولد الطاهر وطار بعد أن فقدت أمه ثلاثة بطون قبله, فكان الابن المدلل للأسرة الكبيرة التي يشرف عليها الجد المتزوج بأربع نساء أنجبت كل واحدة منهن عدة رجال لهم نساء وأولاد أيضا. محتويات حياته كان الجد أميا لكن له حضور اجتماعي قوي فهو الحاج الذي يقصده كل عابر سبيل حيث يجد المأوى والأكل, وهو كبير العرش الذي يحتكم عنده, وهو المعارض الدائم لممثلي السلطة الفرنسية, وهو الذي فتح كتابا لتعليم القرآن الكريم بالمجان, وهو الذي يوقد النار في رمضان إيذانا بحلول ساعة الإفطار, لمن لا يبلغهم صوت الحفيد المؤذن. يقول الطاهر وطار, إنه ورث عن جده الكرم والأنفة, وورث عن أبيه الزهد والقناعة والتواضع, وورث عن أمه الطموح والحساسية المرهفة, وورث عن خاله الذي بدد تركة أبيه الكبيرة في الأعراس والزهو الفن. تنقل الطاهر مع أبيه بحكم وضيفته البسيطة في عدة مناطق حتى استقر المقام بقرية مداوروش التي لم تكن تبعد عن مسقط الرأس بأكثر من 20 كلم. هناك اكتشف مجتمعا آخر غريبا في لباسه وغريبا في لسانه, وفي كل حياته, فاستغرق في التأمل وهو يتعلم أو يعلم القرآن الكريم. التحق بمدرسة جمعية العلماء التي فتحت في 1950 فكان من ضمن تلاميذها النجباء. أرسله أبوه إلى قسنطينة ليتفقه في معهد الإمام عبد الحميد بن باديس في 1952. انتبه إلى أن هناك ثقافة أخرى موازية للفقه ولعلوم الشريعة, هي الأدب, فالتهم في أقل من سنة ما وصله من كتب جبران خليل جبران ومخائيل نعيمة, وزكي مبارك وطه حسين والرافعي وألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة. يقول الطاهر وطار في هذا الصدد: الحداثة كانت قدري ولم يملها علي أحد. راسل مدارس في مصر فتعلم الصحافة والسينما, في مطلع الخمسينات. التحق بتونس في مغامرة شخصية في 1954 حيث درس قليلا في جامع الزيتونة. في 1956 انضم إلى جبهة التحرير الوطني وظل يعمل في صفوفها حتى 1984. تعرف عام 1955على أدب جديد هو أدب السرد الملحمي, فالتهم الروايات والقصص والمسرحيات العربية والعالمية المترجمة, فنشر القصص في جريدة الصباح وجريدة العمل وفي أسبوعية لواء البرلمان التونسي وأسبوعية النداء ومجلة الفكر التونسية. استهواه الفكر الماركسي فاعتنقه, وظل يخفيه عن جبهة التحرير الوطني, رغم أنه يكتب في إطاره. عمله في الصحافة عمل في الصحافة التونسية: لواء البرلمان التونسي والنداء التي شارك في تأسيسها, وعمل في يومية الصباح، وتعلم فن الطباعة. أسس في 1962 أسبوعية الأحرار بمدينة قسنطينة وهي أول أسبوعية في الجزائر المستقلة، ثم أسس في 1963 أسبوعية الجماهير بالجزائر العاصمة أوقفتها السلطة بدورها، ليعود في 1973 ويأسس أسبوعية الشعب الثقافي وهي تابعة لجريدة الشعب, أوقفتها السلطات في 1974 لأنه حاول أن يجعلها منبرا للمثقفين اليساريين. عمله السياسي من 1963 إلى 1984 عمل بحزب جبهة التحرير الوطني عضوا في اللجنة الوطنية للإعلام مع شخصيات مثل محمد حربي, ثم مراقبا وطنيا حتى أحيل على المعاش وهو في سن 47. كما شغل منصب مدير عام للإذاعة الجزائرية عامي 91 و1992. عمل في الحياة السرية معارضا لانقلاب 1965 حتى أواخر الثمانينات واتخذ موقفا رافضا لإلغاء انتخابات 1992 ولإرسال آلاف الشباب إلى المحتشدات في الصحراء دون محاكمة, ويهاجم كثيرا عن موقفه هذا, وقد همش بسببه. كرس حياته للعمل الثقافي التطوعي وهو يرأس ويسير الجمعية الثقافية الجاحظية منذ 1989 وقبلها كان حول بيته إلى منتدى يلتقي فيه المثقفون كل شهر. السيناريوهات مساهمات في عدة سيناريوهات لأفلام جزائرية حيث حول قصة نوة من مجموعة دخان من قلبي إلى فيلم من إنتاج التلفزة الجزائرية نال عدة جوائز. كما حُولت قصة الشهداء يعودون هذا الأسبوع إلى مسرحية نالت الجائزة الأولى في مهرجان قرطاج. مثلت مسرحية الهارب في كل من المغرب وتونس. مواضيع الطاهر وطار يقول إن همه الأساسي هو الوصول إلى الحد الأقصى الذي يمكن أن تبلغه البرجوازية في التضحية بصفتها قائدة التغييرات الكبرى في العالم. ويقول إنه هو في حد ذاته التراث. وبقدر ما يحضره بابلو نيرودا يحضره المتنبي أو الشنفرى. كما يقول: أنا مشرقي لي طقوسي في كل مجالات الحياة, وأن معتقدات المؤمنين ينبغي أن تحترم. عمل الكاتب في كل الميادين والنشاطات السياسية، من مؤلفاته نجد مجموعات قصصية ومسرحيات وروايات، كما قام بترجمة مجموعة من الأعمال الفرانكوفينية. تد رس أعمال الطاهر وطار في مختلف الجامعات في العالم وتعد عليها رسائل عديدة لجميع المستويات. أجمل القصائد التي قيلت في رثاء الاديب الكبير الطاهر وطار بعنوان : ( سلاماً وطّار ) هل ستعود هذا الأسبوع...؟ (حيدر طالب الأحمر) أم طعنات الجزائر قضت عليك ... ! لا ... اعتقد انك عَبرت إلى ضفةٍ أخرى..! هل طرتَ يا وطّار أم انه دُخان قلبُك طار...؟ أم انك تريد الخلاص من الدهاليز ... ! لكنك تحتاج إلى شمعة ! لا أعرف ماذا حل بك يا وطّار ! أم انك تريد الخلاص من الدهاليز ... ! لكنك تحتاج إلى شمعة ! أم انك تمر بتجربةٍ في العشق ؟ أنه ليس زمن الحراشي. بل انه زمن الزلازل يا وطّار نعم انه زمن طعنات الجزائر بل ليس فقط هم ...! بل حتى الولي الطاهر كان معهم هل هذا لأنك شاركت بعرس بغل ؟ حسبك شرقيةٌ ... فالمغربيةُ، هي أصلاً ما تريد وسيبقى الولي الطاهر يرفع يده بالدعاء لك يا وطّار فوداعاً لك ياوطّار.. مؤلفاته المجموعات القصصية
ترجمة ديوان للشاعر الفرنسي فرنسيس كومب بعنوان الربيع الأزرق (َApprentit au printemps) - الجزائر 1986. ************************************************** ********* العربي دحو مؤلفاته
************************************************** *************************************** رشيد بوجدرة رشيد بوجدرة روائي جزائري يكتب باللغتين العربية و الفرنسية، ويعد من بين أهم الوجوه الروائية في الساحة الأدبية الجزائرية. نشأته ودراسته ولد الأديب الجزائري رشيد بوجدرة، عام 1941، في مدينة العين البيضاء. وهو خريج المدرسة الصادقية في تونس. وتخرج من جامعة السوربون - قسم الفلسفة. مهامه عمل في التعليم وتقلد مناصب كثيرة، منها: أمين عام لرابطة حقوق الإنسان، أمين عام اتحاد الكتاب الجزائريين. وهو محاضر في كبريات الجامعات الغربية في اليابان و الولايات المتحدة الأميركية. حائز على جوائز كثيرة، من إسبانيا وألمانيا وإيطاليا[بحاجة لمصدر]. مؤلفاته الروائية
************************************************** ******************* زليخة سعودي زليخة السعودي (20 ديسمبر 1943- 22 نوفمبر 1972 أديبة جزائرية من مواليد منطقة مقادة بولاية خنشلة بالشرق الجزائري . دخلت سنة 1947 الكتاب وحفظت نصف القرآن الكريم، ثم انتسبت عام 1949 إلى مدرسة الإصلاح التي كان يديرها عمها الشيخ أحمد السعودي إلى غاية عام 1956 تاريخ حصولها على الشهادة الابتدائية، واصلت دراستها بالمراسلة لتتحصل على شهادة الأهلية عام 1963 مما أهلها للالتحاق بسلك التعليم، انتقلت إلى الجزائر العاصمة للالتحاق بالإذاعة الوطنية بعد نجاحها في مسابقة إذاعية. تركت الفقيدة وراءها رصيدا من الأعمال الأدبية في مختلف المجالات كالقصة القصيرة والمسرح والمقال إما مخطوطة أو منشورة في المجلات والجرائد الوطنية، كانت زليخة توقع كتاباتها بأسماء مستعارة مثل "أمل"، "آمال"، كما عرف عنها مراسلاتها العديدة لبعض الأدباء الجزائريين. جمع آثارها الأستاذ شريبط أحمد شريبط من جامعة عنابة وأصدرها اتحاد الكتاب الجزائريين عام 2001 يتبع ان شاء الله |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 8 | |||
|
علماء وا دباء ومفكرين وفنانين وشخصيات هامة من منطقة الشاوية :
***الادباء و الفنانين و الروائيين*** شريف مرزوقي شريف مرزوقي فنان تشكيلي جزائري من مواليد 2 فيفري 1951 بقرية منعة مدينة باتنة، تحصل على العديد من الجوائز. توفي سنة 1991. الـشــريــف مــرزوقــي Cherif Merzougui [ 8février 1951 - 4 avril 1991]
************************************************** ********************************* عثمان سعدي من مواليد 1930 بدوار ثازبنت ولاية تبسة.ناضل منذ شبابه المبكر في حزب الشعب الجزائري، وانخرط في صفوف جبهة التحرير الوطني منذ تأسيسها وعمل في ممثليها بالمشرق العربي.هجر المدرسة الفرنسية بعد مجازر 8 ماي 1945 . متخرج من معهد عبد الحميد بن باديس بقسنطينة عام 1951، حاصل على الإجازة في الآداب من جامعة القاهرة سنة 1956 والماجستير من جامعة بغداد سنة 1979 والدكتوراه من جامعة الجزائر سنة 1986. مناضل في جبهة التحرير الوطني منذ تأسيسها. أمين دائم لمكتب جيش التحرير الوطني بالقاهرة في أثناء الثورة المسلحة. رئيس البعثة الديبلوماسية بالكويت 1963 ـ 1964. قائم بالأعمال بالقاهرة 1968 ـ 1971. سفير في بغداد 1971 ـ 1974. سفير في دمشق 1974 ـ 1977. عضو مجمع اللغة العربية الليبي في طرابلس ـ ليبيا. عضو المجلس الشعبي الوطني من 1977 إلى 1982، عضو باللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني من 1979 إلى 1989، رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية منذ عام 1990.. أشرف على إصدار كتاب: [الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية: خمس عشرة سنة من النضال في خدمة اللغة العربية، طبع الجزائر سنة 2005 ]. وهو المدير المسؤول على مجلة [الكلمة] لسان حال الجمعية. رئيس لجنة الإشراف العلمي على إعداد المعجم العربي الحديث، الذي تبنى إصداره الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالثمانينيات، ولم يكتب له الصدور. انتخب عن دائرة تبسة نائبا بالمجلس الشعبي الوطني ( 1977 - 1982 ) . كما انتخب من المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني ( 1979 ) عضوا للجنة المركزية . حاصل على جائزة أهم مؤسسة فكرية عربية وهي مؤسسة الفكر العربي سنة 2005، وعلى جائزة الريشة الذهبية لبلدية سيدي امحمد بالجزائر. ينتمي الدكتور عثمان سعدي إلى أكبر قبيلة أمازيغية وهي قبيلة النمامشة، وهو يملك العربية والأمازيغية. عندما أصدر كتابيه عروبة الجزائر عبر التاريخ (1983) والأمازيغ عرب عاربة (1996)، أورد بهما مختصرين لغويين يؤكدان عروبة اللغة الأمازيغية. من مؤلفاته
************************************************** ************************************** عمار العسكري اهو اسن عمار العسكري مخرج جزائري من مواليد عام 1942 بعين الباردة بالجزائر، درس المسرح والسينما في بلغراد. أهم أعماله
************************************************** ************************************ عيسى جرموني عيسى جرموني رمز الاصالة الشاوية ,أول الأفارقة من غني في الأولمبياد وذلك خلال أولمبياد باريس في عام 1936 حيث استطاع أن يؤدي جميع المقامات والأوزان والطبوع. نبذة هو مرزوق عيسي بن رابح المعروف عيسي جرموني ولد سنة 1885 في دوار امزي المسماة حاليا قرية سيدي ارغيس عين البيضاء ولاية أم البواقي ولكن موطنه الاصلي هو بير إسماعيل(ويسمى أيضا البسان أو الحيمر) ببلدية متوسة ولاية خنشلة وتوفي في 16 ديسمبر 1946 في عين البيضاء ودفن بها بعمر ناهز 61 عام. وتزوج من امرأة فرنسية الجنسية. وكانت أول إسطوانة له سنة 1933 باستديو بارود بتونس. وهو من رفض جميع قوانين المستعمر لاسيما الضرائب، والخدمة العسكرية. وله أغنية في نفس السياق أفوشي نو المسمار وأكرد أنوكير ************************************************** ***************************** فضيلة الفاروق فضيلة الفاروق من مواليد (20 نوفمبر 1967 في مدينة آريس بقلب جبال الأوراس، التابعة لولاية باتنة شرق الجزائر). هي كاتبة جزائرية تنتمي لعائلة ملكمي الثورية المثقفة التي اشتهرت بمهنة الطب في المنطقة، واليوم أغلب أفراد هذه العائلة يعملون في حقل الرياضيات والإعلام الآلي والقضاء بين مدينة باتنة وبسكرة وتازولت وآريس طبعا. حياتها ونشأتها عاشت الكاتبة فضيلة الفاروق حياة مختلفة نوعا ما عن غيرها، فقد كانت بكر والديها، ولكن والدها أهداها لأخيه الأكبر لأنه لم يرزق أطفالا... كانت الابنة المدللة لوالديها بالتبني لمدة ستة عشرة سنة، قضتها في آريس، حيث تعلمت في مدرسة البنات آنذاك المرحلة الابتدائية، ثم المرحلة المتوسطة في متوسطة البشير الإبراهيمي، ثم سنتين في ثانوية آريس، غادرت بعدها إلى قسنطينة لتعود إلى عائلتها البيولوجية، فالتحقت بثانوية مالك حداد هناك. نالت شهادة البكالوريا سنة 1987 قسم رياضيات والتحقت بجامعة باتنة كلية الطب لمدة سنتين، حيث أخفقت في مواصلة دراسة الطب الذي يتعارض مع ميولاتها الأدبية، إذ كانت كلية الطب خيار والدها المصور الصحفي آنذاك في جريدة النصر الصادرة في قسنطينة. عادت إلى جامعة قسنطينة والتحقت بمعهد الأدب وهناك ومنذ أول سنة وجدت طريقها. فقد فجرت مدينة قسنطينة مواهبها، إنضمت مع مجموعة من اصدقاء الجامعة الذين أسسوا نادي الإثنين والذين من بينهم الشاعر... والناقد يوسف وغليسي وهو استاذ محاضر في جامعة قسنطينة حاليا، والشاعر ناصر (نصير) معماش استاذ في جامعة جيجل، والناقد محمد الصالح خرفي مدير معهد اللغة العربية وآدابها بجامعة جيجل، والكاتب عبد السلام فيلالي مدير معهد العلوم السياسية في جامعة عنابة والكاتب والناقد فيصل الأحمر استاذ بجامعة جيجل... كان نادي الإثنين ناد نشيط جدا حرك أروقة معهد اللغة العربية وآدابها في جامعة قسنطينة طيلة تواجد هؤلاء الطلبة مع طلبة آخرين في الجامعة، وانطفأت الحركة الثقافية في المعهد بمغادرة هؤلاء للمعهد. تميزت فضيلة الفاروق بثورتها وتمردها على كل ما هو مألوف، وبقلمها ولغتها الجريئة، وبصوتها الجميل، وبريشتها الجميلة. حيث أقامت معرضين تشكيليين في الجامعة مع أصدقاء آخرين من هواة الفن التشكيلي منهم مريم خالد التي اختفت تماما من الوسط بعد تخرجها. غير الغناء في الجلسات المغلقة للأصدقاء التي تغني فيها فضيلة الفاروق أغاني فيروز على الخصوص وفضيلة الجزائرية وجدت فرصة لدخول محطة قسنطينة للإذاعة الوطنية، فقدمت مع الشاعر عبد الوهاب زيد برنامجه آنذاك " شواطئ الانعتاق" ثم بعد سنة استقلت ببرنامجها الخاص " مرافئ الإبداع" وقد استفادت من تجربة اصدقاء لها في الإذاعة خاصة صديقها الكاتب والإذاعي مراد بوكرزازة. و لأنها شخصية تتصف بسهولة التعامل معها، ومرحة جدا، فقد كونت شبكة أصدقاء في الإذاعة آنذاك استفادت من خبرتهم جميعا، وكانوا خير سند لها لتطوير نفسها، في الصحافة المكتوبة بدأت كمتعاونة في جريدة النصر، تحت رعاية الأديب جروة علاوة وهبي الذي كان صديقا لوالدها، واصدقاء اخرين له، انتبهوا إلى ثورة قلمها وجرأته وشجاعته المتميزة، وقد أصبحت في ثاني سنة جامعية لها صحفية في جريدة الحياة الصادرة من قسنطينة مع مجموعة من اصدقاء لها في الجامعة. كانت شعلة من النشاط إذ أخلصت لعملها في الجريدة والإذاعة ودراستهاالتي أنهتها سنة1993 سفرها وشهرتها سنة1994 نجحت في مسابقة الماجستير والتحقت من جديد بجامعة قسنطينة ولكنها غادرت الجزائر نهائيا في التاسع من أكتوبر(تشرين الأول) سنة 1995 نحو بيروت التي خرجت من حربها الأهلية للتو. و في بيروت بدأت مرحلة جديدة من حياتها. عالم جديد مفتوح وواسع، ثقافات مختلفة. ديانات مختلفة. أفق لا نهاية له... بيروت: مثل الأفلام تلتقي فضيلة الفاروق بصديقها اللبناني بالمراسلة، والذي راسلته لفترة ثلاث سنوات تقريبا، ويقع في حبها. ومع أنه مسيحي الديانة ويكبرها بحوالي خمسة عشرة سنة، إلا انها تقنعه باعتناق الإسلام، وتغيير دينه، ولا تطلب مهرا لها غير إسلامه، تتزوجه قبل نهاية السنة، وتنجب بعد سنتين إبنهما الوحيد[بحاجة لمصدر]. و لكنها في بيروت تصطدم بثقافة الآخر، التي لم تعشها في مجتمعها ذي الثقافة الأحادية والدين الواحد والحزب الواحد أيضا. المجتمع اللبناني له تركيبة مختلفة، عانت لتدخل وتتغلغل فيها. و لعل محطة " الشاعر الكبير والمسرحي بول شاوول" هي أهم محطة في حياتها في بيروت، فقد كان اليد الأولى التي امتدت لها ودعمتها الدعم الفعلي والإيجابي لتجد مكانا لها وسط كل تلك الأقلام والأدمغة التي تعج بها بيروت. جمعتها صداقة متينة ومتميزة مع شاوول، جعلتها تستعيد ثقتها بنفسها وتدخل معترك الكتابة من جديد. في نهاية 1996 التحقت بجريدة الكفاح العربي... و مع أنها عملت لمدة سنة فقط في هذه الجريدة إلا أنها كونت شبكة علاقات كبيرة من خلالها وفتحت لنفسها أبوابا نحو أفق بيروت الواسع... نشرت أعمالها " لحظة لاختلاس الحب" سنة 1997 ومزاج مراهقة" سنة 1999 بدار الفرابي بيروت على نفقتها الخاصة. ثم كتبت تاء الخجل وأرادت أن ترقى بها إلى درجة ارفع، فطرقت بها أبواب دور نشر كثيرة في بيروت ولكنها رفضت. ظلت هذه الرواية بدون ناشر لمدة سنتين مع أنها ناقشت موضوع الاغتصاب من خلال مجتمعنا العربي وقوانينه، ثم عرضت بألم كبير معاناة النساء المغتصبات في الجزائر خلال العشرية السوداء، ولكن الكتابة عن كل ما هو جنسي لم تكن مرغوبة في ذلك الوقت، خاصة حين يكون الاغتصاب الذي يدين الرجل والمجتمع والقانون الذي فصله الرجل على مقاساته[غير محايد]. ظلت الرواية تتجول وترفض إلى أن قدمتها لدار رياض الريسن وقرأها الشاعر والكاتب عماد العبد الله، الذي رشحها للنشر مباشرة، ودعم فضيلة الفاروق دعما قويا تشهد له هي شخصيا. الرواية أهتم بها نقاد من الوزن الثقيل مثل الكاتبة غادة السمان، والدكتور جابر عصفور الذي حرص على دعوتها لملتقى الرواية في القاهرة، والكاتب واسيني الأعرج الذي عرف بأعمالها في باريس واقترحها لتدعى لملتقى باريس للسرد الروائي، كما كتب عنها مقالات مهمة باللغة الفرنسية في جريدة الوطن الصادرة باللغة الفرنسية في الجزائر[بحاجة لمصدر]... بلوغها دار رياض الريس جعل اسمها يعرف على نطاق أوسع... و تعد اليوم من بين الروائيات الأمازيغيات باعتبارها من آريس ولاية باتنة والتي بها أمازيغ يدعون الشاويّة، نستطيع القول أنها أمازيغية ذات بعد عربي ومن المتميزات جدا[غير محايد]، كونها تناقش قضايا هامة في المجتمع العربي، ولها آراء جد مختلفة وأحيانا صادمة. تنادي يتعايش الأديان، والمساواة بين الرجل والمرأة، وتدين الحروب بكل أنواعها. نشرلها بعد تاء الخجل، روايتها اكتشاف الشهوة سنة 2005 و رواية أقاليم الخوف سنة 2010 وهي جميعها صادرة عن دار رياض الريس ببيروت ترجمت تاء الخجل إلى اللغتين الفرنسية والإسبانية، وترجمت مقاطع منها إلى الإيطالية[بحاجة لمصدر] من آريس إلى بيروت من آريس في جبال الأوراس شرق الجزائر إلى عاصمة الثقافة العربية بيروت، رحلة شاقة وصعبة ولكنها جميلة للكاتبة فضيلة الفاروق. ************************************************** ************************************************** ** يتبع ان شاء الله |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 9 | |||
|
علماء وا دباء ومفكرين وفنانين وشخصيات هامة من منطقة الشاوية :
***الادباء و الفنانين و الروائيين*** كاتب ياسين كاتب ياسين كاتب وأديب جزائري مشهور عالميا كل كتاباته باللغة الفرنسية صاحب أكبر رواية للأدب الجزائري باللغة الفرنسية ومن أشهرها في العالم "نجمة"[1]. حياته ولد ببلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة في 6 أوت 1929اصله من عرش بني كبلوت (شاوي) ولاية قالمة بعد فترة قصيرة تردد أثناءها على المدرسة القرآنية بسدراتة التحق بالمدرسة الفرنسية ب بوقاعة lafayette سابقا ولاية سطيف سنة 1935 إلى غاية سنة 1941 حيث بدأ تعليمه الثانوي بسطيف حتى الثامن من شهر ماي 1945. شارك في مظاهرات 8 ماي 1945، قبض عليه بعد 5 خمسة أيام ببوقاعة فسجن وعمره لا يتجاوز 16 سنة، وكان لذلك أبعد الأثر في كتاباته. بعدها بعام فقط نشر مجموعته الشعرية الأولى "مناجاة". دخل عالم الصحافة عام 1948 فنشر بجريدة الجزائر الجمهورية (ألجي ريبيبليكان) التي أسسها رفقة ألبير كامو، وبعد أن انضم إلى الحزب الشيوعي الجزائري قام برحلة إلى الاتحاد السوفياتي ثم إلى فرنسا عام 1951. قبل وفاته تقلد عدة مناصب، منها منصب مدير المسرح بسيدي بلعباس. توفي في 28 أكتوبر 1989م بمدينة غرونوبل الفرنسية، عن عمر يناهز الستين، نقل جثمانه ودفن في الجزائر. كاتب ياسين هو أب لنادية، هانس و أمازيغ كاتب عضو في الفرقة الموسيقية المعروفة ڤناوة ديفيزيون. من مؤلفاته قدم الكاتب الجزائري العديد من مسرحياته على خشبة المسرح في كل من فرنسا و الجزائر.
************************************************** ***************** مصطفى كاتب مصطفى كاتب من مواليد 1920 بمدينة سوق أهراس في أقصى الشرق الجزائري كان مسرحي كبير وسينمائي قدير حيث كان المؤسس لفرقة المسرح العربي بقاعة الاوبرا عام1947 برفقة محيي الدين باشطارزي, شارك الممثل في فيلم "ريح الأوراس" والليل يخاف من الشمس عام 1965 للمخرج مصطفى بديع كما أخرج مصطفى كاتب فيلما بعنوان الغولة عام 1972 ،في عام 1951 شكل فرقة المسرح الجزائري, وأحزرت هذه الفرقة على مجموعة من الجوائز في الكثير من المهرجانات الدولية. في 1958 عين رئيسا للفرقة الفنية التي أنشاتها جبهة التحرير الوطني في تونس، حيث لعبت هذه الفرقة دورا رائدا في مجال التعريف بالقضية الجزائرية للرأي العام العربي والدولي. بعد الاستقلال عين مديرا للمسرح الوطني الجزائري، وأنشأ مدرسة للفنون الدرامية والرقص الشعبي. وفي 1973 عين مستشارا ثقافيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وساهم في بعث الحركة الثقافية والمسرحية في الأوساط الجامعية. في 1985 انتخب بالمجلس الشعبي لمدينة الجزائر، وأسندت له مهمة النشاط الثقافي على مستوى المدينة، حيث أسس خمس مركبات ثقافية ضخمة. وفي 1988 استدعي مرة أخرى لإدارة المسرح الوطني الجزائري، توفي هذا الممثل البارز في تاريخ السينما الجزائرية يوم 28 أكتوبر 1989 بفرنسا بعد أن اعيد تنصيبه مديرا للمسرح الوطني الجزائري. ************************************************** **************** كاتب أمازيغ كاتب أمازيغ هو مغني قناوي جزائري من مواليد 16 سبتمبر 1972 بمدينة سطاوالي بالجزائر العاصمة. هو مؤسس وأحد أهم أعضاء فرقة قناوى ديفيزيون[1] و إبن الروائي جزائري كاتب ياسين[2]، و يلقب غالبا بالمتمر ************************************************** ***************************** كاتشو علي ناصري الملقب "كاتشو" (15 أبريل 1963 - 12 أغسطس 2009) الموافق ل (20 ذو الحجة 1382 هـ - 21 شعبان 1430 هـ)، مغني جزائري من مشاهير الغناء الشاوي مشهور جدا على مستوى بلده الجزائر. ولد بباتنة في 15 افريل 1963 بقرية حملة؛ وتوفي في حادث مرور في 12 أوت 2009 أيام فقط بعد اقامته مهرجان جميلة، كاتشو بعد عودته من الحج في 2005 قررالاعتزال عن الغناء الماجن وقرر التخصص فقد في الأغاني الدينية والمديح. كاتشو متزوج وله ولدين وبنت.وكان المرحوم الحاج علي (كاتشو)يحب مدينة ام البواقي ويحظر كل حفلاتها وكما كانت حفلات دكرا عيسي الجرمني بالمدينة انطلاقته الحقيقية كماكان يكن كل الاحترام والدقير لصديقه بالمدينة السيد عابد فارس فنه "كاتشو معروف جدا في سطيف حيث أن أسلوبه الغنائي يدور بين السطايفي و الشاوي. والطابع الشاوي يِؤدى باللهجة الشاوية لكنه غنى أيضا باللغه العربية الدارجة مما قربه من كل الجزائريين. غنى في عديدالمدن الجزائرية وخاصة في المواسم الصيفية منها الساحلية الكبرى مثل :سكيكدة، عنابة و بجاية... أول ألبومه "بابور يروح" الذي صدر في عام 1987، لم يتجاوز المستوى الإقليمي. موجة المد لشهرته أتت ب "نوارة"، ثاني ألبوم يجتاح البلاد، والذي شكل دائرة أول المشجعين له. هذه الدائرة استمرت في التوسع، وإلى حد كبير خارج الجزائر. في غضون ذلك، فإن هذا الترتيب الذي بدأ متواضعا مع "الاوركسترا تازير" قد أثرت، وتوفير صوت من قائد جوقة الترتيل الشاوي الموسيقى ذاتها. العمل بصفة خاصة بين عامي 1992 و 1993. النمط هو إثراء مساهمات متنوعة والموسيقى، من الأنجلوسكسونية، ونبرة الصوت، والقوة الدافعة، اكتسبت في النقاء والقوة. ليست هي الوحيدة في المنطقة من البلاد التي تتأثر هذه الاغنية جاءت من الأوراس.[1] ************************************************** ************************************************** ليلى أمداح ليلى أمداح هي فنانة تشكيلية [1] ونحاتة [2] عصامية جزائرية، من مواليد 1962م بباتنة، عاصمة الأوراس بالشرق الجزائري. تزاول مهنتها كطبيبة أسنان منذ سنة1989م. نشأت في أسرة مميزة في ثقافتها ومولعة بفن الرسم. أقامت العديد من المعارض، انطلاقا من سنة 1984م أيام الدراسة الجامعية وأخرى بعد التخرج، تنوعت ما بين المعارض الوطنية والدولية [3] أهمها: باتنة، قسنطينة، سطيف، جيجل، عنابة، بسكرة، البليدة، الجزائر [4] العاصمة، فرنسا(سنة2003م) والمملكة العربية السعودية(سنة2007م).[5] تعبر أعمالها الفنية عن تراث الجزائر [6] وقضاياالمرأة والطفل [7]،بالإضافة إلى المواضيع العلمية. ************************************************** ********************************* محمد دماغ محمد دماغ نحات جزائري، ولد في 4 جويلية 1930 بمدينة باتنة، شرق الجزائر. ************************************************** ******************************** وردة الجزائرية وردة الجزائرية (22 يوليو 1939[2] - 17 مايو 2012)، مغنية جزائرية. اسمها الحقيقي وردة فتوكي ولدت في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية من عائلة بيروتية تدعى يموت. لها طفلان هما رياض ووداد. مسيرتها ولدت وردة في فرنسا لأب جزائري ينحدر من ولاية سوق اهراس بلدية سدراته بالجزائر وأم لبنانية من عائلة بيروتية تدعى يموت. مارست الغناء في فرنسا وكانت تقدم الأغاني للفنانين المعروفين في ذلك الوقت مثل أم كلثوم وأسمهان وعبد الحليم حافظ، وعادت مع والدتها إلى لبنان وهناك قدمت مجموعة من الأغاني الخاصة بها. كان يشرف على تعليمها المغني الراحل التونسي الصادق ثريا في نادي والدها في فرنسا, ثم بعد فترة أصبح لها فقرة خاصة في نادي والدها. كانت تؤدي خلال هذه الفترة أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ولـ عبد الحليم حافظ، ثم قدمت أغاني خاصة بها من ألحان الصادق ثريّا. وهي خالة الفنانة إنجي شرف. بدايتها في مصر قدمت لمصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية "ألمظ وعبده الحامولي" ليصبح فاتحة إقامتها المؤقتة بالقاهرة، ولها افلام أخرى اه ياليل يازمن وحكايتي مع الزمان مع رشدي أباظه وليه يادنيا صوت الحب طلب رئيس مصر الأسبق جمال عبد الناصر أن يضاف لها مقطع في أوبريت "وطني الأكبر". أزمتها مع نظام عبد الناصر في مطلع الستينات وأيام الوحدة بين مصر وسوريا كان المشير عبد الحكيم عامر وزير الحربية وقتها عائد لدمشق بعد رحلة إلى مصيف بلودان. وفي الطريق، كانت وردة الجزائرية في طريقها إلى دمشق ولكن سيارتها تعطلت فأمر المشير بتوصيل السيدة الي المكان الذي تريده. كانت وردة الجزائرية حينئذ غير معروفة في مصر ولكنها عرفت بنفسها أثناء الحديث وألحت أن ننقل للمشير رغبتها في مقابلته لتقدم له الشكر. حضرت وردة الجزائرية بالفعل إلى استراحة المشير عبد الحكيم عامر في منطقة أبو رمانة بدمشق. كان اللقاء في وضح النهار ولم يكن المشير وحده وإنما كان معه في الاستراحة أنور السادات واللواء أحمد علوي وعبد الحميد السراج. وصل تقرير سري لهذه المقابلة إلى مكتب الرئيس عبد الناصر وانتشرت الإشاعات وقتها بوجود علاقة بين وردة وبين المشير. وزادت حدة الشائعات لأن وردة ذاتها انتهزت فرصة لقائها بالمشير عامر وحاولت استغلالها لصالحها بعد مجيئها للقاهرة وبدأت توهم المحيطين بها بأنها على علاقة بالمشير وأنها تتصل به هاتفيا. كانت وردة في بداية مشوارها الفني بالقاهرة وراحت تستخدم أسلوب الترغيب والترهيب حتى يتقرب منها أهل الفن فربما يتعرفون على المشير وينالون رضاه من خلالها وأن تخيف كل من يعترض طريقها بعلاقتها المزعومة بالمشير.[3] أدى هذا إلى قيام أجهزة المخابرات بالتحقيق حول هذه الشائعة ومصدرها حتى اتضح أن وردة ورائها. مما أدى إلى صدور قرار بإبعادها خارج البلاد ومنعها من دخول مصر. ولم ترجع إلى مصر إلا في مطلع السبعينيات خلال حكم الرئيس السادات.[3] الاعتزال والعودة اعتزلت الغناء سنوات بعد زواجها، حتى طلبها الرئيس الجزائري هواري بومدين كي تغني في عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972، بعدها عادت للغناء فانفصل عنها زوجها جمال قصيري وكيل وزارة الاقتصاد الجزائري. فعادت إلى القاهرة، وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم طلاقها منه سنة 1979 كان ميلادها الفني الحقيقي في أغنية (أوقاتي بتحلو) التي أطلقتها في عام 1979 م في حفل فني مباشر من ألحان سيد مكاوي. كانت أم كلثوم تنوي تقديم هذه الأغنية في عام 1975 لكنها ماتت. لتبقى الأغنية سنوات طويلة لدى سيد مكاوي حتى غنتها وردة. تعاونت وردة الجزائرية مع الملحن محمد عبد الوهاب. قدمت مع الملحن صلاح الشرنوبي العمل الشهير (بتونس بيك). خضغت مؤخراً لجراحة لزرع كبد جديد في المستشفى الأمريكي بباريس. وفاتها توفيت في منزلها في القاهرة في 17 مايو 2012 إثر ازمة قلبية ودفنت في الجزائر ووصلت في طائرة عسكرية بطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكان في استقبالها العديد من الشخصيات السياسية والفنية ليتم دفنها في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة.[4] وكانت قبل وفاتها قالت «أريد العودة إلى الجزائر فوراً»، تعتبر واحدة من أهم فنانين الزمن الجميل. ************************************************** ********************************* موفق رشيد موفق رشيد نحات و رسام جزائري ولد في 29 يناير 1959 بباتنة الجزائر أشتهر بمنحوتاته المشكلة من المواد المسترجعة *********************** دحمان الحراشي من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة دحمان الحراشي  دحمان الحراشي معلومات عامة البلد  الجزائر الاسم عند الولادة عبد الرحمن عمراني الولادة 7 جويلية 1925 مكان الولادة الأبيار، الجزائر العاصمة الوفاة 31 أغسطس 1980 (العمر: 55 سنة) مكان الوفاة عين البنيان، الجزائر العاصمة الآلات الموسيقية البانجو، الماندول النوع الشعبي المهنة مغن، كاتب أغنية وعازف سنوات النشاط الخمسينات – السبعينات تعديل الجزائر الاسم عند الولادة عبد الرحمن عمراني الولادة 7 جويلية 1925 مكان الولادة الأبيار، الجزائر العاصمة الوفاة 31 أغسطس 1980 (العمر: 55 سنة) مكان الوفاة عين البنيان، الجزائر العاصمة الآلات الموسيقية البانجو، الماندول النوع الشعبي المهنة مغن، كاتب أغنية وعازف سنوات النشاط الخمسينات – السبعينات تعديل  دحمان الحراشي (الاسم الحقيقي هو عبد الرحمن عمراني) (ولد في 7 جويلية، 1925 في الأبيار، الجزائر العاصمة ذو اصول شاوية. فهو ينحدر من قرية جلال جنوب ولاية خنشلة. استقر أبوه في الجزائر العاصمةفي الحراش في حي الفدائيين plm سنة 1920، توفي في 31 أوت 1980 في الجزائر العاصمة، الجزائر) كان موسيقار،مؤلف،ملحّن ومغنّي في نوع الشّعبي العاصمي. دحمان الحراشي (الاسم الحقيقي هو عبد الرحمن عمراني) (ولد في 7 جويلية، 1925 في الأبيار، الجزائر العاصمة ذو اصول شاوية. فهو ينحدر من قرية جلال جنوب ولاية خنشلة. استقر أبوه في الجزائر العاصمةفي الحراش في حي الفدائيين plm سنة 1920، توفي في 31 أوت 1980 في الجزائر العاصمة، الجزائر) كان موسيقار،مؤلف،ملحّن ومغنّي في نوع الشّعبي العاصمي.محتويات شخصي لقد كان أبوه مؤذنا بـالمسجد الكبير في الجزائر العاصمة. لقد اعطى للاغنية الشعبية الجزائرية رونقا خاصا حيث غلب على كافة اغانية طابع المعنى وتميزت اغانيه بأسلوب جميل يعالج قضايا المجتمع. من أهم أغانيه الجمهرة، ورائعة ذائعة الصيت " يارايح ".التي انقد فيها موضوع هجرة أبناء الجزائر إلى فرنسا. والأغنية لا تزال تغنى من جيل إلى جيل حيث اعاداها الفنان الجزائري رشيد طه وقد لاقت ولا تزال تلاقي انتشار لافت في أواسط الشباب من أبناء الجاليات العربية المهاجرة في أوروبا. والأغنية موجهة إلى صديق دحمان الحراشي الذي كان مصرا على الهجرة ظنا منه انه سيجد أحوال معيشية أفضل، فكانت هذه كلمات الأغنية :
دحمان الحراشي (الاسم الحقيقي هو عبد الرحمن عمراني) (ولد في 7 جويلية، 1925 في الأبيار، الجزائر العاصمة، توفي في 31 أوت 1980 في الجزائر العاصمة، الجزائر) كان مغنيا للشّعبي الجزائري. لقد كان أبوه مؤذنا بـالمسجد الكبير في الجزائر العاصمة. لقد اعطى للاغنية الشعبية الجزائرية رونقا خاصا حيث غلب على كافة اغانية طابع المعنى وتميزت اغانيه بأسلوب جميل يعالج قضايا المجتمع. من أهم أغانيه الجمهرة، ورائعة ذائعة الصيت " يارايح ".التي انتقد فيها موضوع هجرة أبناء الجزائر إلى فرنسا. والأغنية لا تزال تغنى من جيل إلى جيل حيث اعاداها الفنان الجزائري الشاب رشيد طه وقد لاقت ولا تزال تلاقي انتشار لافت في أواسط الشباب من أبناء الجاليات العربية المهاجرة في اوروبا. والأغنية موجهة إلى صديق دحمان الحراشي الذي كان مصرا على الهجرة ضنا منه انه سيجد أحوال معيشية أفضل، فكانت هذه كلمات الأغنية : يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي :: شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي :: شحال ضيعت وقات وشحال تصيد ما زال تخلي. يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري :: بيك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري. دحمان الحراشي يعد من اهم رواد الفن الشعبي الاصيل في الجزائر صاحب اغنية المشهورة عالميا يارايح وين مسافر دحمان الحراشي قدما لنا مجموعة من الاغانية الرائعة التي تفيض حكمة وفنا راقيا وصوتا شجيا عذبا يحس بها كل من يستمع اليها من عشاق الطرب الشعبي واصحاب الذوق الرفيع سيعجب بها وينتشي ويحس بمتعة لا حد لها بسبب تناغم الموسقى مع الكلمات هده الاغاني التي تعتبر مورثا شعبيا الدي يتغنى به الكثير الى يومنا هدا في الحقيقة دحمان الحراشي لا يقل مرتبة عن عمالقة الفن الشعبي امثال الهاشمي قروابي و بوجمعة العنقيس و شيخ العنقى حيث كان ابن الحراش شديد التاثر بهم و نجد ان الكثير من يعرف دحمان الحراشي من خلال اغنية يا راايح وين مسافر هده الاغنية التي ظهرت اول مرة فيلم جزائري خلال فترة السبعينيات قام ببطولة الفليم الحراشي نفسه يصور لنا دحمان الحراشي لظاهرة الهجرة خلال هده الفترة خاصة الى فرنسا عندما اعترض دحمان الحراشي من خلال هدا الفليم على احد اصدقائه الدي صمم على الهجرة بحثا عن ظروف افضل الى فرنسا عندها غنى دحمان الحراشي اغنيته المشهور يارايح . والحقيقة ان دحمان الحراشي غير الهاشمي قروابي وغيرهم من الفنانين الدين تلقو دعم من الدولة والاعلام والكثير من الاعانات فضلا عن عيشهم في احياء عريقة من العاصمة لكن ابن الحراش خرج عن هده القاعدة الذي عاش في مجتمع تسوده المشاكل و الافات الاجتماعية ويتضح دلك جليا من خلال اغانيه الدي يعالج فيها مواضيع تخص النميمة الغيبة الحقرة التفكك الاسري الوشاية بين الاقارب العداوة بين الاصدقاء استغلال الانساب.الحسد ......ويضع لنا دحمان هده المواضيع في قالب غنائي من جهة اخرى يدعو دحمان من خلال اغانيه الى التسماح بين الافرا دوالاسر المتفرقة ويدعو الماهجرين الى العودة الى الوطن الام كما يحثنا عن القناعة في الدنيا والتمسك بالخالق ومما يجدر الاشارة ايضا الى ان الحراش لم يتعرض الى الجانب السياسي ودلك بسبب الاستقرار السياسي التي تشهده هده الفترة من السبعينيات ونجد ايضا التميز في الكلمات التي تسمى في الفن الشعبي القصيد حيث يعتمد على لهجة بسيطة وبكلمات معبرة مفهومة اخترت منها من اجمل ما غنى . 1- غير لحب صلاحو موال(كل هدار مسوس ويجب الصدع راسو كل هدار مسوس ويجب الصدع راسو يا ليبك على الفراق علاش تسبب وانا قلبي منك معمر بالمعاني كان كدبت اسال مجرب كان كدبت اسال مجرب ولى اطلب العفومن الرب الفوقاني) غير ليحب صلاحو واحد في المية تصيب في عشرتو شبعان علاش الناس قباحو كل واحد يقول من عندي يا فلان لقلوب قساحولحسود كدة والنيران يا لباغضني ما نسامحلك طول زماني شوف لحالك يا الناقص ما فيك امان تهدر فيا كلام قاسح وتزيد معاني ما نسمعلك عرفك من اهل العديان لعباد بحالك جاحو مل نعاشرهم ما يكون ليا جيران حباب الظنة راحو وانت باقي بحلتك في وجه الكيفان لحسد بسلاحوكل يوم يموتشيان غير ليحب صلاحو واحد في المية تصيب في عشرتو شبعان علاش الناس قباحو كل واحد يقول من عندي يا فلان لقلوب قساحولحسود كدة والنيران بالله عليك عيدلي يا لاهي باحزاني انا صابر في عدابك وانت فرحان حالك صعيب علاش تغدر فيا بلعاني علاش عليك هكدا تقرا في النقصان لي زيان عليه صباحو لاش تعاند في حياتو اعطاه الرحمان الغالط طلب سماحو بنادم مافتشي من بابو هو حيران جواه رياحو على الطاير بلا جنحان غير ليحب صلاحو واحد في المية تصيب في عشرتو شبعان علاش الناس قباحو كل واحد يقول من عندي يا فلان لقلوب قساحولحسود كدة والنيران شحال من ناس طامعين واغواهم الفاني كانه دياب هاجو بين الكيفان وشحال من ناس باسلين من نصبة شيطاني ماعندهم لا عقل لا معنى لا ميزان من قلبي راهم طاحو واحد فيهم ما يقر بالخيرولحسان ياناس لخير ارواحو سبحان الله ما خلق في هدا الزمان لنسى مفتاحو باه يفتح هدوك لبيبان غير ليحب صلاحو واحد في المية تصيب في عشرتو شبعان علاش الناس قباحو كل واحد يقول من عندي يا فلان لقلوب قساحولحسود كدة والنيران. 2- ليدي حق الناس ليدي حق الناس ما يتهنى ماهو لاباس تخمامو ما يخلاص متحير حالتو في حالة تخمامو ما يخلاص متحير حالتو في حالة نوصيك ياوليد الناس ننصحك خود طريق قبالة الوقت راه عساس والزمان مطوع رجالة كونك فهم قياس الى فهمت كلام العقالة الغالط عاقلو غاس ما قرا في قلبو البسمالة ليدي حق الناس ما يتهنى ماهو لاباس تخمامو ما يخلاص متحير حالتو في حالة تخمامو ما يخلاص متحير حالتو في حالة ليبني دار الساس ليعمل خير ما قوليش لالة ولي يقطع الياس نيتو في باتو مدبالة لي فيه الوسواس تقول طاح في الشبكة الخبالة الله يجعل حد باس والعفو من ربنا تعالى ليدي حق الناس ما يتهنى ماهو لاباس تخمامو ما يخلاص متحير حالتو في حالة تخمامو ما يخلاص متحير حالتو في حالة هدا كلامي لناس نعيدلك يا لي شاري دالة الغالي علاش رخاص عاد محقور بين الرجالة الذهب غالي على النحاس حتى الحر ما ينباع في دلالة الكريم هو الخلاص ولخبر يجبوه التوالة ليدي حق الناس ما يتهنى ماهو لاباس تخمامو ما يخلاص متحير حالتو في حالة تخمامو ما يخلاص متحير حالتو في حالو الحق عليه النورغير البطال يقهر من والة الانسان علاش يدور في كلامو صلاتو بطالة يشهد شهادة الزور ما يخاف ما يقادر سلالة غارق في وصت البحور كما غرقو اهدوك الجهالة 3- ساعفني ونساعفك موال(سيدي سيدي نساعفك حتى ترضى شحال غريت بيا وانا صابر بيك يا قطب لخيزران يا خد الوردة يا قطب لخيزران يا خد الوردة وكلام قسيح ارميه لا يعديك) ساعفني ونساعفك قادرني ونقادرك عاهدني ونعاهدك ما تسبقني بالعار الله يخلينا حباب طول الدهر وليام والله يقرقنا بلا دنوب الله يفرقنا بلا دنوب ويعطينا على حساب لقلوب يدير علينا شي حجوب عالظالم والمغيار هو ينجينا من العيوب والجار حبيب الجار تعاشرتي ونعاشرك تصبرني ونصبرك بكلام الخير نبشرك ادا طالت لعمار ياك لبغاه ربي تاب نهار مايظلام وما ريجعش لعمايلو ساعفني ونساعفك قادرني ونقادرك عاهدني ونعاهدك ما تسبقني بالعار الله يخلينا حباب طول الدهر وليام والله يقرقنا بلا دنوب لعشرة بينتنا تدوم بالقلب الصافي كل يوم ما تلوم عليا ما لوم اسمع ليا واختار ما ترمني ا ولا نعوم في اوقات كبار ما عندي علاش نخالفك نرد سلامي نواجبك غير اسمحلي ونسمحلك يسمحنا الغفار شوف ندير لحساب ياك دين الله هجار قالو سادتنا في الكتوب ساعفني ونساعفك قادرني ونقادرك عاهدني ونعاهدك ما تسبقني بالعار الله يخلينا حباب طول الدهر وليام والله يقرقنا بلا دنوب. 4- مابيني وبينك غير الخير مابيني وبينك غيرالخير يا باغضني وعلاش تغير تخصمت معك كيفاش ندير يهديك الله عف عليا يا باغضني حالك صعيب لارحمة معك ولا هنيا واش باغي عندي واش تصيب وعلاش هكدا لاهي بيا ما نديرك جاري ولا حبيب غير انساني دير مزيا الحسد بعلو ياك يريب يستهل من عندي هديا مابيني وبينك غيرالخير يا باغضني وعلاش تغير تخصمت معك كيفاش ندير يهديك الله عف عليا يا باغضني وعلاش تزيد فيكلام يجرح فيا قلبك تقول ارجع حديد شكون لبعتك ليا نوكل غير ربي الوحيد هو العالم بيك وبيا ما زالني معك نسمع ونزيد مازال نشوف بعينيا مابيني وبينك غيرالخير يا باغضني وعلاش تغير تخصمت معك كيفاش ندير يهديك الله عف عليا يا باغضني باين عليك باين عليك مافيك حتى نيا الحسد منو واش يجيك ما تربح منو عقليا يا سايمني انا نوصيك نوصيك وصايا قويا الحسد بلاك يساميك بلاك تحيكيلو سريا مابيني وبينك غيرالخير يا باغضني وعلاش تغير تخصمت معك كيفاش ندير يهديك الله عف عليا يا باغضني حوالو عينيك كل يوم تبدل في قصيا انا راني خايف عليك تعيا وتطيح في يديا القصد لجفاني يجفيك انت لتندم عليا يا باغضني الله يهديك وعلاش خارج من الشريا مابيني وبينك غيرالخير يا باغضني وعلاش تغير تخصمت معك كيفاش ندير يهديك الله عف عليا. 5- عذروني يا لحباب عذروني يا لحباب وفهموا كلامي ظاهر قلبي تعمر وداب وانا مازالني صابر حسدوني في لغزال هداك السر الكامل حسدوني في لغزال هداك السر الكامل غير قولولي وعلاش غزالي بطى ماجاش كيف حالو ما نلقاش وقيلى راه نساني ربيت بتبشاش عليه ما نتهناش هكدا ولا مايشقاش كان مربي في مكاني خلالي ضيقت الخاطر وبقى مع فكري يتمايل خلالي ضيقت الخاطر وبقى مع فكري يتمايل عذروني يا لحباب وفهموا كلامي ظاهر قلبي تعمر وداب وانا مازالني صابر حسدوني في لغزال هداك السر الكامل حسدوني في لغزال هداك السر الكامل بلا غزالي ما تحلاش كيدك ما نبراش اليلة حسبتها بتناعش جوزت معه زماني الولف غالي ما يشراش ساوم تعرف قداش فراقو ما يسواش يا وعدي وين رماني قلبي في داتي صابر وانا في منامي تخايل قلبي في داتي صابر وانا في منامي تخايل عدروني يا لحباب وفهموا كلامي ظاهر قلبي تعمر وداب وانا مازالني صابر حسدوني في لغزال هداك السر الكامل حسدوني في لغزال هداك السر الكامل غزالي كي لهلال نشوفو يضوالي لحال ما نفارقوش محال غرامو راه الداني شوفو الوعد كيف طوال الولف تقول دبال يسوى الدينا بالمال كان مربي في جناني خلالي عقلي حاير وجرحي في داتي طاير خلالي عقلي حاير وجرحي في داتي طاير عدروني يا لحباب وفهموا كلامي ظاهر قلبي تعمر وداب وانا مازالني صابر حسدوني في لغزال هداك السر الكامل حسدوني في لغزال هداك السر الكامل. 6- الى كانك عوام الى كانك عوام ساعف الموجة في البحر وساعف الزمان العام فيه اتناعش شهر شي ظاهر يا انسان ما يفريها غير الصبر شي ظاهر يا انسان ما يفريها غير الصبر خد ماعطاك الرحمان اطلب الصحة و الستر مكسي ولا عريان مرفه ولا بالفقر اصبر على المحان خد ما عطاك السعد والزهر واش قالو ناس زمان الحق لازمو يندكر اجعل روحك حمام لي طابو حجارو على الجمر ولا اجعل روحك في منام زاهي وضاوي عليك لقمر كون فاهم يا انسان اللهم هدا ولا اكثر كون فاهم يا انسان اللهم هدا ولا اكثر الى كانك عوام ساعف الموجة في البحر وساعف الزمان العام فيه اتناعش شهر شي ظاهر يا انسان ما يفريها غير الصبر شي ظاهر يا انسان ما يفريها غير الصبر قبلك فاتو شبان كي بحالك وقالو اكتر انت همك وين يبان يا الغافل ما جبتش شي خبر القلق من الشيطان والميزان يمشي بلعبر ولي قلبو شبعان عاطي الدنيا بالظهر اجعل روحك جنان عشطان يسقى في المطر ولى اجعل روحك سلطان ساكن في سريا وقصر كن عاقل يانسان كاين مسكين لما فطر كن عاقل يانسان كاين مسكين لما فطر الى كانك عوام ساعف الموجة في البحر وساعف الزمان العام فيه اتناعش شهر شي ظاهر يا انسان ما يفريها غير الصبر شي ظاهر يا انسان ما يفريها غير الصبر يا لغافل رد البال كي تستر روحك تنستر اسمع لهدا الفال باركة زيادة في لعمر الحرام ما يكون حلال دين الله يا اخي جهر كل واحد واش يسال في نفسو بلاك يندعر اجعل روحك برهان سعادة والحمد والشكر ولى اجعل روحك فرحان في بابور ماشي لسفر كن صابر يا انسان ولي ما يصبرش ينقهر كن صابر يا انسان ولي ما يصبرش ينقهر الى كانك عوام ساعف الموجة في البحر وساعف الزمان العام فيه اتناعش شهر شي ظاهر يا انسان ما يفريها غير الصبر شي ظاهر يا انسان ما يفريها غير الصبر. 7- والله مادريت الغدرة في مضرب لمان والله ما دريت بالغدرة في مضرب لمان وانا صافي بنيتي ما عندي نقصان والله مادريت باحبابي يرجعولي عديان وعلاش علاش هكدا خلو النيران وعلاش علاش هكدا خلو النيران لو كان عرفت هكدا يصرالي يا ناس نقرا حدري نعود هاني نرجع لاباس لو كان عرفت هكدا كنت نقطع الياس ما نخالطهم ماندير في فكري وسواس لكن انا بنيتي ما شفو شي بحالتي ما ننساهم طول دينيتي علاش ماهم حنان والله ما دريت بالغدرة في مضرب لمان وانا صافي بنيتي ما عندي نقصان والله مادريت باحبابي يرجعولي عديان. وعلاش علاش هكدا خلو النيران وعلاش علاش هكدا خلو النيران لو كان عرفت ما نخالطهم شي بزاف هوما هوما سباب ضري رماوني في الكاف كي نتفكر ماصرالي نرجع نخاف ولي صرالو كي بحالي عندو ما شاف هاد سباب حيرتي معاهم ما صبت راحتيمنهم ما برات كيتي كواوني بالنيران والله ما دريت بالغدرة في مضرب لمان وانا صافي بنيتي ما عندي نقصان والله مادريت باحبابي يرجعولي عديان وعلاش علاش هكدا خلو النيران وعلاش علاش هكدا خلو النيران لوكان عرفت هكد يسقوني بمرار ما نعشرهم ونقول استر يا ستار وعلاش علاش هكد سبقوني بالعار ما ننسهم في حياتي عديان كبار هده هي قصيتي يقروها في بريتي ونهار نخلف دالتي يظهر البرهان والله ما دريت بالغدرة في مضرب لمان وانا صافي بنيتي ما عندي نقصان والله مادريت باحبابي يرجعولي عديان وعلاش علاش هكدا خلو النيران وعلاش علاش هكدا خلو النيران. 8 - لبهجة بهجة في باب مدخول ورسمك عندو قيمة راني بعتلك مرسول واجبني ياعاصمة من قصبة لراس المول لقواس لجنينة مرسى قابلة لبحور وزما قصر قديمة باب جديد زوز عيون من كاني لرميلة بوفريز يلقى اصول وسيد دالية لقديمة باب الواد فيه الهول وباب عزون رزينة باب الاله محلول حتى نوصل نضرب تحميمة سيدي ربي غفور نلحق لباب الخيمة بهجة في باب مدخول ورسمك عندو قيمة راني بعتلك مرسول واجبني ياعاصمة في رمضان على السحور في سوسطارة تلقينا هدي مدة وشهور على بالي تخميمة الاصل فيك مشكور انت بخيرك تكفينا وطلع عليك النور ما صبت مثلك في مدينة بوزريعة بن عكنون لبيار عالي علينا صالمبي وبلكور طراف لعلجة وليمة الاسم فيك مشهور زيد ينحي لغبينة يا بلادي عليك ما دور يا لو كان نقطع بسفينة بهجة في باب مدخول ورسمك عندو قيمة راني بعتلك مرسول واجبني ياعاصمة الجنيان على الوان بير خادم فيه تشينة سحاولى شراقة ويدان تم لرياح تحينة من صابني معك في منام نقدر نقول زهينة والليل يكون فيه عام والصباح نقول ما بطينة القبة جنان بالرمان حتى لحراش مدينة وينهم ادوك الجيران والحومة بقات حزينة واد بريش واد سيسبان دركانة عندها قسيمة ميمون حمام الواد فربيع رانا جرينا بهجة في باب مدخول ورسمك عندو قيمة راني بعتلك مرسول واجبني ياعاصمة في قدر والديان والنسمة فيك نعيمة ورد ياسمين وسيسان هاديك بنية ما نسينة هدرو عليك في اليمان الجزائر راكي زينة زادت مصر والشام ما نخطيك حتى بليلة سهلي يا رحمان برضاك انت تعفينة مداهب ربع اركان في شهادة ما تنسينة نختم قولي بقوال الصلاة على نبينا الله يجمعنا باحسان ولي ماتو برحيمة بهجة في باب مدخول ورسمك عندو قيمة راني بعتلك مرسول واجبني ياعاصمة. 9- الحركة والسكون الحركة والسكون الا بإدن الله و البركة فيك تكون كي تستقنع بلعطاك والستر عليك يدوم وكي تدعي قول ان شا الله بيبان الله كثير كلش عندو ساهل يرزق عبدو بالخير ويعلم بالقلب الباخل ما تتنوى ماتحير ماتكونش تاني جاهل ماتديري واش يصير والفاهم ديما عاقل ما بين الكاف والنون يفتح ربي برضاه ولو تكون وين تكون مريح ولا في شقاقك البارح ماشي كاليوم وغدوى نهار يجب خيرومعاه الحركة والسكون الا بإدن الله و البركة فيك تكون كي تستقنع بلعطاك والستر عليك يدوم وكي تدعي قول ان شا الله مع القدرة واش تدير والزمن فيك يقابل معاندك باش تطير كونك فاهم وعاقل فضل الاله كبير بلاك تنسى يا غافل على كلش قدير ويسلك الي حاصل البراكة في القليل الناس بها تتماثل التقنع لقليل ولي هو يستاهل يا النايم فيق وقوم وشكر الله بالخير لعطاه الحركة والسكون الا بإدن الله و البركة فيك تكون كي تستقنع بلعطاك والستر عليك يدوم وكي تدعي قول ان شا الله يا ربي يا الحنين نحيلي ضيقت الخاطر يزهى قلبي في الحين ترزقني بلحاضر الا تبغي يا الكريم لنت عندك كلش ساهل سبحان الله العظيم الي في ملكو يامر نطلبك يا الجليل في قلبي راني صابر نطلبك طول اليل وفكري دما معاك هدا وعدي مختوم كمتوب هكدا ما لقيتلو دواه الحركة والسكون الا بإدن الله والبركة فيك تكون كي تستقنع بلعطاك والستر عليك يدوم وكي تدعي قول ان شا الله. 10- يانكارة الملح والطعام اللي حبكم علاش تخليوه يموت طال في مرضو لا بغى ينساكم يجي لباب داركم يطلب في القوت لا طعمتوه ولا سقيتوه ماكم هذا حال العاشق ديما يتبع في هواكم يا نكارة الملح والطعام علاش عليك بالجهر هذا الشي محال انسيتي العشرة بعد السفر أنا وياك مشينا حتى عيينا بديناها من الغرب للقصر جلفة لغواط بوسعادة لمسيلة ناسهم كي ناس الحضر على البارود والنسا بتولويلة زدنا على البلاد العشر بجاية وسطيف والخروب وقسنطينة هادوك هوما ناس الوتر والمسافر اللي جايز عندو قيمة مشينا من تم بالخبر في تبسة سكيكدة وفي عنابة تهاوينا تمة تمنيتلي قصر غير المكتوب ما قدرش عيلنا الحقنا لبلاد الرسم تلمسان وهرن لمستغانم الزينة حطتهم تحت الكرم والعرضة عندهم غير بالتحليلة الحقنا لبلاد البحر البهجة بيضة شفناها وحيينا على الرملة والقمر فرح قلبك بين ميل التبسيمة قعدنا في سيدي فرج سميشة باهية والقيطون فيه قليلة البابور من المرسى خرج شوف داك الزمان كي تفكرت الليلة بالعود والطار والرباب واستخبارات على هواهم زهينا ياك تمة قلبك داب يا خي حطات كانوا في ديك المدينة طبسي واحد بالمعاش مغيرفة وحدة والبركة تكفينا نايظة الصبحة من الفراش صبتلي القهوة والزهر والماتشينة  ************************************************** *********************************************** وغيرهم و الله اعلم |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 10 | |||
|
علماء وا دباء ومفكرين وفنانين وشخصيات هامة من منطقة الشاوية :
***العلماء و المفكرين*** إبراهيم مزهودي الشيخ إبراهيم مزهودي (9 أوت 1922 الحمامات - 27 فبراير 2010 بتبسة) خريج جامع الزيتونة درس في باريس سنة 1948 بجامعة السوربون، وعمل بمدرسة التدريس بتبسة. أنظم عام 1956 إلى جيش التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية وتحصل على رتبة رائد. كان نائبا للقائد الأعلى للولاية الثانية أثناء ثورة التحرير ومن القيادات البارزة التي حضرت مؤتمر الصومام سنة 1956. شغل منصب أول أمين عام للحكومة الجزائرية المؤقتة. بعد استقلال الجزائر أصبح عضوا في المجلس الوطني الجزائري سنة 1964. كان معارضا شرسا للرئيس أحمد بن بلة مما كلفه الاعتقال بسجن تيميمون بالصحراء الجزائرية، قبل أن يطلق الرئيس الراحل هواري بومدين سراحه ويعهد إليه بمنصب سفير مفوّض فوق العادة بالعاصمة المصرية القاهرة إلى غاية 1974. كما عارض أيضا نظام الرئيس الشاذلي بن جديد. ظل يلقي في الفترة من سنة 1979 إلى سنة 1999 خطبا بمسجد الحمامات بتبسة. كما شغل منصب الرئيس الشرفي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. ************************************************** يتبع ان شاء الله والله اعلم |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 11 | |||
|
علماء وا دباء ومفكرين وفنانين وشخصيات هامة من منطقة الشاوية :
***العلماء و المفكرين*** بشيشي بلقاسم اللوجاني الشيخ بشيشي بلقاسم اللوجاني الشيخ بشيشي بلقاسم اللوجاني الذي ولد سنة 1881 في منطقة واد الشارف الواقعة بين مدينة قالمة وسدراتة، واشتهر في التاريخ الإسلامي كداعية ومرب وكان من مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تكوينه وتعليمه يرجع الفضل في تكوينه إلى والده الشريف بن بلقاسم ثم التحق بزاوية لبناقرية بعد أن حفظ القرآن الكريم حيث درس الفقه وأصول الدين ثم رحل إلى تونس لمواصلة دراسته ومكث فيها قرابة السنتين تعلم من خلالها التفسير وعلوم اللغة والأدب والنحو والصرف والبلاغة ثم انتقل إلى جامع الزيتونة ودرس في هذا المعلم الإسلامي قرابة أربع سنوات نهل فيه من مختلف العلوم والمعارف العودة إلى مسقط رأسه عاد إلى الجزائر في حوالي سنة 1918وبالضبط إلى مسقط رأسه ببلدية سدراتة ولاية سوق أهراس، فكون الشيخ بلقاسم اللوجاني في الثلاثينيات جمعية دينية من أعيان المنطقة كالشيخ بارح والشيخ إبراهيم بن سليمان روايسية وماضي خليفة وغيرهم... حيث تتكفل هذه الجمعية بجمع التبرعات لبناء المسجد العتيق الذي يعد واحدا من بين 14 مسجدا حرا على الصعيد الوطني، ملأه الشيخ بلقاسم علما ومعرفة وتوجيه ودروس مختلفة في جميع العلوم، وكما طلب الشيخ في سنة 1921من بعض أعيان البلدة رخصة فتح نادي للشباب سماها "نادي المسلم" ولم يسمح له الاحتلال بذلك إلا بعد سنوات وفاته فاضت روحه إلى بارئها يوم الإثنين 7 سبتمبر سنة 1954،رحم الله شيخنا رحمة واسعة. ************************************************** *************** يتبع وغيرهم و الله اعلم |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 12 | |||
|
علماء وا دباء ومفكرين وفنانين وشخصيات هامة من منطقة الشاوية : ***العلماء و المفكرين*** الأديب الداعية الشيخ الدكتور أحمد شرفي الرفاعي  هو من مواليد 1934 ببلدية خنشلة ولاية خنشلة حسب بطاقة التعريف ،وفي 1350هجري المناسبة ل1932 م ببوحمامة ولاية خنشلة حسب شهادات الأقارب ،متزوج وأب لستة أبناء ،درس بقسنطينة في معهد عبد الحميد بن باديس من 1948 إلى 1952 وانتقل إلى جامع الزيتونة بتونس ودرس به سنوات 1954 -1956 ،ودرس بالأزهر في القاهرة سنوات 1956 -1957 ،ودرس بجامعة بغداد سنوات 1958 -1961 ،وواصل دراسته العليا بكلية الآداب جامعة القاهرة سنتي 1961 -1962 . المؤهلات العلمية: حائز على الأهلية من تونس سنة1953 ،وعلى الثانوية العامة “الباكلوريا” من الأزهر سنة 1957 كما درس بكلية دار العلوم بالقاهرة سنة 1957 -1958 ،وحائز على ليسانس الآداب من بغداد سنة 1961 ،وحائز على شهادة النجاح للسنة التمهيدية للماجستير في الآداب من كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة 1962 ،ودكتورا الطور الثالث من جامعة الجزائر سنة 1979 . الحياة المهنية: مدرس بالتعليم الثانوي من 1962 إلى 1972 ،ومدرس بمعهد الآداب واللغة العربية بجامعة قسنطينة من 1972 إلى 1987 ،وأستاذ مشارك في تدريس الحديث النبوي الشريف وفقه السيرة في المعهد الوطني للتعليم العالي في الشريعة بباتنة 1996 ،ومدير لمعهد الحضارة الإسلامية بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية من 1987 إلى 1989 ،ورئيس المجلس العلمي لمعهد الآداب واللغة العربية 1989 -1990 الإنتاج العلمي: له ما يقارب 22 مؤلفا من أشهرها التعريف بالقرآن الكريم،وجراح التاريخ وعاهاته،والسيرة النبوية الشريفة دلالات وعبر،ومفهوم جماعة المسلمين عند الإمام أبي يعلى ومقتضياته،وهو تحت الطبع….ويدرس حاليا دروسا بمسجد أبي أيوب الأنصاري بقسنطينة. يتبع والله أعلم |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 13 | |||
|
علماء وا دباء ومفكرين وفنانين وشخصيات هامة من منطقة الشاوية :
***العلماء و المفكرين*** الداعية والمفكر المتألق الدكتور الطيب برغوث  الأستاذ الطيب برغوث من موليد 20 أفريل 1951م في بلدة رأس العيون بالقطر الجزائري، لأبوين مجاهدين شاركا في أحداث الثورة التحريرية الجزائرية. وهو يعتز بكونه ابن مجاهد عريق في الجهاد، التحق بالثورة الجزائرية الكبرى منذ بداياتها المبكرة 1954، وظل وفيا لمعاني الجهاد وثوابته وروحيته حتى وفاته رحمه الله، وهو ما كان له تأثيره الكبير في كل أبنائه وجيله. درس العلوم الشرعية في معهد التعليم الأصلي بباتنة طيلة مرحلتي المتوسط والثانوي، حتى تحصل على شهادة البكالوريا في العلوم الشرعية سنة 1395هـ /1975. التحق بقسم علم الاجتماع بجامعة قسنطينة حتى نال شهادة الليسانس في علم الاجتماع سنة 1393هـ / 1979. واصل دراساته الجامعية العليا في علم الاجتماع الثقافي، بمعهد علم الاجتماع بجامعة الجزائر، حيث نال المرحلة الأولى من الدراسة بأطروحة أولية عن: ((نظرية مالك بن نبي في الثقافة)) سنة 1401هـ / 1981م. اشتغل بعد تخرجه من الجامعة سنة 1979 في حقل الإعلام الإسلامي التابع لوزارة الشئون الدينية الجزائرية حتى سنة 1407هـ / 1987، حيث أشرف على مجلة الرسالة، وكان عضوا في هيئة تحرير جريدة العصر ومجلة الأصالة. بدأ الكتابة الصحفية منذ أن كان طالبا في نهاية مرحلة التعليم المتوسط، حيث نشر عدة مقالات في جرائد ومجلات جزائرية مختلفة. وكانت القراءة والكتابة والكتاب والأفكار.. حبه وهمه ومتعته الكبرى منذ صغره، حيث يمضي أكثر من 12 ساعة يوميا في القراءة والكتابة والعمل الفكري والتربوي والدعوي المتواصل، منذ أكثر من 30 عاما. التحق بقسم الدراسات العليا، بمعهد الشريعة وأصول الدين بجامعة الجزائر، وأنجز أطروحة أولية عن: ((التدابير الوقائية من الطلاق في الإسلام)) سنة 1404هـ / 1984م. التحق بهيئة التدريس بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة منذ 1407هـ/ 1987م. وشغل بالجامعة عدة مناصب علمية وإدارية، منها نائب مدير معهد مكلف بالدارسات العليا في معهد الدعوة وأصول الدين، وعضو دائم بمجلسه العلمي، ونائب مدير مركز الأبحاث والدراسات التابع للجامعة. كان عضوا مؤسسا بجمعية أصدقاء جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية. كان عضوا بالمجلس العلمي بمديرية الشئون الدينية بولاية قسنطينة منذ تأسيسه. وهو مؤسسة علمية ثقافية مهمتها الإشراف على التوجيه الفكري والتربوي والثقافي والاجتماعي من منظور شرعي متكامل. درّس بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية: مناهج الدعوة، وتاريخ الدعوة ورجالها، والدعوة في العصر الحديث، وفقه السيرة، ومدخل إلى الإعلام، والفكر الإسلامي المعاصر... تحصل على شهادة الماجستير في مناهج الدعوة سنة 1412هـ/ 1992م. وأنهى إنجاز شهادة دكتوراه الدولة في نفس التخصص سنة 1417هـ/ 1997 م. ولم يتمكن من مناقشتها إلا سنة 2009، بسبب الظروف الصعبة التي مر بها في السنوات الأخيرة. انخرط في العمل الدعوي الفكري التربوي منذ وقت مبكر من دراسته الشرعية في المرحلتين الإعدادية والثانوية، وساهم في حركة بناء الصحوة وترشيد مسيرتها على طريق الأصالة والفعالية والتكاملية المطردة. عمل مرشدا دينيا متطوعا منذ أن كان طالبا بالمعهد الإسلامي حتى اليوم. كان له دور فاعل في الحركة الطلابية الإسلامية الجامعية منذ التحاقه بالجامعة سنة 1975 حتى خروجه من الجزائر سنة 1995 ، حيث شارك بفعالية في النشاط الفكري والتربوي والدعوي والاجتماعي للحركة الطلابية الجامعية على النطاق الوطني. متأثر بالإمام العلامة عبد الحميد بن باديس، الذي يعتبره من جيل الصحابة المعاصرين؛ في علمه وروحانيته، ووطنيته ورساليته، وجهاديته النموذجية، وعبقريته الحركية الفذة، وإنجازيته المتميزة، وبالإمام العلامة البشير الإبراهيمي الذي كان قمة شامخة من قمم العلم والفكر والإصلاح والرسالية في هذا العصر بحق. ويرى في التجربة التاريخية لـ "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين" نموذجا ناجحا في الوعي والفعل الحركي الفعال. يعيش منذ عام 1995م خارج الجزائر، واستمرارا في أداء مهمته في المجال الفكري والتربوي والدعوي وحوار الأديان والثقافات والحضارات. يدير بالخارج جمعية مهتمة برعاية شئون الجالية المسلمة المتكونة من أكثر من ثلاثين جنسية إسلامية مختلفة، ويساهم في حركة تبليغ الإسلام والتعريف به، وحوار غير المسلمين بشأنه وشأن تجربته وخبرته الحضارية الغنية. أعمال ومؤلفات بدأ الأستاذ الطيب برغوث التأليف منذ وقت مبكر في حياته. وكان كثير القراءة والإطلاع شغوفا بالبحث والتأمل والتفكير. وكان يقضي جل وقته إما في القراءة أو الكتابة أو المحاضرة أو النظر والتأمل في مشكلات وقضايا الأمة والفكر الإسلامي. وقد ألف ونشر الكثير من الكتب، كما درج على نشر مقالات ودراسات في موضوعات متنوعة في الكثير من المجلات والجرائد. ومن أهم مؤلفات الأستاذ الطيب-بالإضافة إلى المقالات والدراسات المنشورة-: القدوة الإسلامية في خط الفعالية الحضارية. الواقعية الإسلامية في خط الفعالية الحضارية. الدعوة الإسلامية والمعادلة الاجتماعية. التغيير الإسلامي خصائصه وضوابطه. معالم هادية على طريق الدعوة. الخطاب الإسلامي المعاصر وموقف المسلمين منه. موقع المسألة الثقافية من استراتيجية التجديد الحضاري عند مالك بن نبي. المنهج النبوي في حماية الدعوة ومنجزاتها في (جزأين. ماجستير + دكتوراه). الأبعاد المنهجية لإشكالية التغيير الحضاري. الأبعاد المنهجية للفعل الدعوي في الحركة النبوية. مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافية: قراءة في سنن التغيير الاجتماعي. الفعالية الحضارية والثقافة السننية. التغيير الحضاري وقانون النموذج. مدخل إلى تجربة جماعة البناء الحضاري الإسلامية في الجزائر. حركة تجديد الأمة ومشكلات في الوعي والمنهج. حركة التجديد على خط الفعالية الاجتماعية. مفاصل في الوقاية الاستراتيجية للصحوة. التغيير الحضاري وقانون النموذج. صفحات من تجربة حركة البناء الحضاري الإسلامية الجزائرية. زواج المسلمة بغير المسلم: تكريم أم حرمان. مدخل للتعريف بالإسلام. العالم: رجل وامرأة وطفل وفكرة. |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 14 | |||
|
علماء وا دباء ومفكرين وفنانين وشخصيات هامة من منطقة الشاوية : ***العلماء و المفكرين*** المصلح والمربي الشيخ أحمد تيمقلين السرحاني رحمه الله، من علماء الأوراس المولد و النشأة ولد الشيخ أحمد تيمقلين المدعو-السرحاني-يوم -20اكتوبر1912 –بكيمل حوز آريس،من أبوين ينتميان لأسرة محافظة اشتهرت بالعلم و الإصلاح،متوسطة الحال تشتغل بالفلاحة. حفظ القرآن الكريم على شيخ قريته مصطفى بن محمد المالحي-أحد تلامذة الشيخ عبد الحميد بن باديس- وهو ابن سبع سنوات،كما أخذ عنه المبادئ الدينية واللغوية:فقه،فرائض،ونحوه.ثم انتقل الى زاوية الشيخ الصادق بلحاج بـ:تيبرماسين،ومنها إلى خنقة سيدي ناجي التي زاول فيها دراسته الابتدائية والإعدادية على يد العديد من الشيوخ على رأسهم الشيخ الصديق بلمكي خريج جامع الأزهر الشريف . غير أن شغفه بالعلم وتوقه للمعرفة ونهمه للتفقه دفعة إلى طلب المزيد ، خاصة بعد أن سمع الكثير عن الشيخ عبد الحميد بن باديس وما اشتهر به من مستوى عال ونباغة علمية وسعة أفق ، فقرر التوجه إلى قسنطينة قاصدا الجامع الأخضر . وفي سنة -1936- التحق بالجامع الأخضر حيث يدرس الشيخ الإمام،فاجتاز المسابقة بتفوق وتم تسجيله،فزاول دراسته من نفس السنة في الطبقة الثانية-الثانوي-ولازمه الي وفاته-رحمه الله –في:16أفريل1940. العمل قبل الثورة: كان طوال مدة وجوده بقسنطينة من:1936الى1940 ينشر الدعاية للعلم،و يشهر في محاضراته و دروسه و خطبه بربوع الأوراس بالأعمال الشنيعة التي ارتكبها المستعمرون و حكام الاحواز المتغطرسون و ينشر كل، وينشر كل مخازيهم في جريدة البصائر لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، ويكتب في مجلة الشهاب أيضا.. الأمر الذي أغاظ حكام الاحواز وأذنابهم ، فراحوا يطاردونه ويضيقون عليه، حتى اضطر ألا يمر أبدا ببلدة آريس !مقر حاكم الحوز آنذاك. وفي شهر سبتمبر من سنة 1941 ألقي عليه القبض بدوار كيمل مسقط رأسه، بتهمة حث الجماهير على عصيان فرنسا في خطبه ، وتوعيتهم وإرشادهم بأن هذا هو أوان ثورة الشعوب المغلوبة على أمرها، لأ فرنسا مشغولة مع حلفائها بحرب دول المحور، وكان مما قوى التهمة أن وجد لديه خليفة حاكم الحوز – موريزو- الذي جاء خصيصا لإلقاء القبض عليه: أكثر من سبعين أصلا لمقالات نشرت ، ورسائل إخبار إلى الشيخ ابن باديس، وجرائد مشرقية من جملتها : القبس لسان الكتلة الوطنية بسوريا، وجريدة القلم الحديدي لعرب المهجر بأمريكا. وتواريخ : الأمير عبد القادر، وعبد الكريم الخطابي، وعمر المختار، وفرحان السعيد... فزج به في سجن آريس بأمر الحاكم – فابي – مدة ستة شهور، ثم نفي الى حوز مسكيانة مدة ثمانية شهور، وفي نوفمبر من سنة 1942 أطلق سراحه. وفي سنة 1943 عين من قبل الجمعية معلما بمدرسة مشونش وكان مع ذلك مديرا ومرشدا وإمام جمعة ومشرفا على مدارس الجمعية بأوراس الى سنة 1948 ومن جملة تلاميذ هاته الفترة ، الذين كانوا يعدون آنذاك : 156 تلميذا، الأستاذ زروق موساوى ، الأستاذ وفرحات نجاحي. وفي عامي 1948/1949 عين معلما بمدرسة الو لجة حوز خنشلة ، وفي عامي 1950/1951 عين معلما بمدرسة كيمل ومن تلاميذ هاته الفترة : عبد القادر زبادية ، محمد الصغير هلا يلي ، محمد تغلسية ، محمود غواطي ، عبد المجيد سعداوي. وفي سنوات 1951الى صيف 1955 عين- ثانية- بمدرسة مشونش ، ومن جملة تلاميذ هاته الفترة : محمد مهري ، محمد منصوري ، فرحات بوذيبة وملاوي... العمل في الثورة : بدأ العمل من أول شهر نوفمبر سنة 1954 بمشونش،حيث كان له اتصال وثيق جدا بـ :" ابنه الروحي" أحمد بن عبد الرزاق :القائد الحواس قبيل اندلاع الثورة قبيل اندلاع الثورة، وبطلب من الحسين برحايل ورمضان حوني كان أول من أدخل المال للثورة من بسكرة على يد عبد الرحمن البركاتي والعرافي والشيخ مرحوم. وفي شهر سبتمبر من سنة 1955 نفي من أوراس بأمر من عامل عمالة قسنطينة- بارلانج – [الذي كان ضابطا مكلفا بشؤون الأهالي في المغرب الأقصى، حيث كان يجيد التكلم بالعربية ، ثم جلب الى الجزائر لما له من تجربة في سياسة التنكيل بالشعوب ] ** فلجأ الى قسنطينه، حيث علم في بالمعهد الباديسي –1955/1956- . وبعد شهر من نفيه أخرجت عائلته من مشونش فكفلها إخوانه المناضلون : عبد الرحمن البركاتي والعرافي والهاشمي بن دراجي ببسكرة . وفي قسنطينة كان على اتصال دائم بالمناضلين فى الأوراس منهم : محمود الوعي حيث أرسل الأدوية وأدوات الجراحة والبوصلات والمجاهر – المنظار المكبر – والمال والمذاييع ... و بعد حادثة قسنطينة التي استشهد فيها أكثر من خمسين مناضلا منهم الشهيد الأستاذ أحمد رضا حوحو ، لجأ صحبة بعض الإخوان إلى الجزائر العاصمة ، و فيها لم يفتر عن العمل مع الشيخ أحمد حماني و الشيخ مصطفى بوغابة و الشيخ محمد حفناوي ، و كان على اتصال مع المجاهدين الذين أوفدوا آنذاك من الأوراس إلى جهة بوسعادة و من جملتهم الصادق جغروري . بعد أكثر من ثلاثة أشهر رجع إلى بسكرة بأمر من الشيخ الشهيد الأستاذ العربي التبسي بعد إلحاح من الإخوان السابق ذكرهم ، فدخل بسكرة خفية صحبة الأخ الهاشمي بن الدراجي فعين معلما و مديرا بمدرسة التربية و التعليم سنة -1956/1958- إلى أول أكتوبر من السنة حيث أقفلت جميع مدارس التربية و التعليم في شهر مارس من سنة -1958- . و في بسكرة كانت داره مأوى للفدائيين : يكتب لهم الوصلات و رسائل الشكر و التهديد و على رأسهم الأخوين : بلقا سم وشن وأحمد البوزيدي ، و كان عضوا في لجنة جبهة التحرير ببسكرة مع الإخوان البركاتي و الهاشمي بن الدراجي ، و لم تنقطع صلته أبدا بالقائد الحواس و مسؤولي أوراس . بعد إقفال مدارس الجمعية و استشهاد بعض الفدائيين منهم : بلقا سم وشن و بوزيدي اتصل بابنه الروحي أحمد بن عبد الرزاق القائد سي الحواس ، فطلب منه الالتحاق بالثوار في الجبل فأشار عليه بالذهاب إلى الصحراء لأنها في حاجة إلى دعاية و توعية و تحسيس . كانت رحلته رأسا إلى الزاوية الكحلاء – فور فلاتيرس – بالهقار ، ثم وادي ريغ و وادي سوف رفقة المناضل مصطفى بن حسين . و في الصحراء كان يقوم بالدعاية للثورة و السير رواء جبهة واحدة و حكومة واحدة ، و لم يفتر عن الصعود إلى بسكرة حاملا الوصولات إلى أصحابها ، و كم لاقى من عنت يفي مراكز المراقبة ، خاصة – السطيل - . و في سنة - 1959 – اهتدى إلى اسمه أحد الوشاة ، و لكن لحسن الحظ لم يعرفوا اللقب ، و قد نقلت عائلته إلى – الكوميسارية - بسكرة و لم يحصلوا منها على أي شيء . و في الصحراء قام مع الدعاية و جمع المال بدعوة الشبان إلى التجنيد من جملتهم السيد محمد موهوب بن حسين . و في آخر سنة - 1960 – طلب منه أن يصوغ بعض الأناشيد للثورة ، فنظم مجموعة منها :" الرصاص فصل الخطاب" نشر في العدد السابع من جريدة الأحرار ، و "تحية الجيش " نشر في العدد الثاني من نفس الجريدة ، و " نشيد النجاح المثلث" ....و غيرها . العمل بعد الإستقلال : أسندت للشيخ بعد الاستقلال مباشرة العديد من الوظائف ، كان أولها : مفتشا لوزارة الأوقاف للأوراس الكبير و عنابه من سنة – 1963/1965 – حيث قضى هذه الفترة في التنقل و التفتيش من بلدة غلى أخرى و من دشرة إلى دشرة ، يقيم المساجد و يعين القيمين عليها و يسهر على سيرها الحسن و تأدية وظيفتها على أكمل وجه . ثم أستاذا و مديرا لثانوية عباس الغرور – باتنة – في الفترة الممتدة من – 1965/1968- و هي أول ثانوية معربة في المنطقة ، فقام بترميمها و تنظيمها و تسييرها و بعث التعليم العربي الإسلامي فيها ، فأضحت مركزا شعاع علمي في المنطقة. إلى جانب عضويته بالمجلس الإسلامي الأعلى – لجنة الثقافة و النشر - ، و كان من بين الحاضرين عند تأسيسه ، و لم يبخل أبدا بآرائه السديدة طيلة حياته لهذه الهيئة الإسلامية و كان عضوا شرفيا في المجلس القضائي بباتنة ، يستشار في القضايا الشائكة ، ويستدعى لعقد الصلح بين المتخاصمين . و يمكن أن تصنف نشاطاته – باختصار شديد – في هذه الفترة إلى : النشاط الميداني : (01) : المساهمة في إنشاء المعاهد الإسلامية ، منها معهد باتنة مع المجاهد محمود الواعي و الشيخ عمر دردور ، الذي دشن في 29/04/1963 . (02) : عمل جاهدا من أجل تعليم المرأة و تنويرها خاصة في الأوراس ، فحثها على ضرورة الالتحاق بالمعهد الإسلامي بباتنة حيث خصص قسمين للفتيات . (03) : أسلم على يده 20 مسيحيا و مسيحية ، و سلمت لهم شهادات تثبت إسلامهم عن طريق المفتشية . (04) : حارب الشعوذة و الدجل عن طريق الخطب و الدروس في المساجد بالأوراس و عنابه والجنوب ، و عن طريق إذاعة باتنة و إذاعة قسنطينة الجهويتين . (05) : عمل على إنشاء بيوت للصلاة في كامل المؤسسات و المدارس خاصة في دائرة عمله . (06) : حارب منح رخص بناء المواخير ، و بعث دور البناء الرسمي ، و احتج عن ذلك بواسطة رسائل نصح لمختلف المسؤولين . النشاط التأليفي : (01) : ألف كتابا في النحو العربي – المستوى الثانوي - ، لم يطبع إلى يومنا رغم المحاولات الجادة ، و قد أقرضه الشاعر الفحل محمد العيد آل خليفة بقصيدة عنوانها – هي الهمة القعساء – الديوان ص 541 . (02) : خلف مجموعة كبيرة من الدروس الخاصة بالتربية و التعليم ضمنها آراءه ، أفكاره . (03) : خلف مجموعة كبيرة من الدروس الفقهية منظمة و مرقمة حسب إذاعتها عبر إذاعة باتنة . (04) : خلف مجموعة من الخطب القيمة – خطب جمعة – تعتبر كنموذج كانت ترسل إلى مختلف الأئمة في عنابه و الأوراس . (05) : خلف مجموعة من الأناشيد في الثورة و في الاستقلال منها ما صدر في الجرائد و المجلات و بعضها مازال مغمورا. (06) : ألف بعض المسرحيات الهادفة تروى بعض مآثر و معارك الثورة ، و أخرى في الشخصيات التاريخية . (07) : خلف مخطوطا رصد فيه كل مساجد الأوراس بمعناه الكبير و عمالة عنابه ، من حيث : العدد المساحة و النوعية و القائمين عليها و فذلكة تاريخية عن النشأة في الفترة الممتدة من 1963 إلى سنة 1965 . وفـــــــاته : كانت يوم – 17/06/1968 – في قسنطينة بعد مرض عضال ألم به ، و دفن في مقبرة باتنة في موكب مهيب، وبذلك انطفأت شمعة من شموع العلم و المعرفة . يتبع والله اعلم |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 15 | |||
|
علماء وا دباء ومفكرين وفنانين وشخصيات هامة من منطقة الشاوية : ***العلماء و المفكرين*** العربي التبسي الشيخ العربي التبسي أحد أعمدة الإصلاح في الجزائر، وأمين عام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والمجاهد البارز الذي خطفته يد التعصب والغدر الفرنسية عام 1957م. محتويات
نشأته وتعلمه ولد العربي بن بلقاسم بن مبارك بن فرحات التبسي بقرية " ايسطح " النموشية (نسبة إلى قبيلة النمامشة الأمازيغية الكبيرة ) جنوب غرب تبسة -وتبعد عنها بنحو مائة وسبعة عشرة كيلو متر- وذلك في سنة 1312هـ (1895م). في عائلة فلاحية فقيرة، وكان والده إلى جانب عمله في الزراعة يتولى تحفيظ القرآن لأبناء القرية في الكتاب. ابتدأ العربي التبسي حفظ القرآن على يد والده في مسقط رأسه وقد توفي والده حوالي سنة 1320هـ(1903م) ، وفي سنة 1324هـ (1907 م) رحل إلى زاوية ناجي الرحمانية بـ" الخنقة " جنوب شرق خنشلة فأتم بها حفظ القرآن خلال ثلاث سنوات، ثم رحل إلى زاوية مصطفى بن عزوز بـنفطة جنوب غرب تونس في سنة 1327هـ (1910م) ، وفيها أتقن رسم القرآن وتجويده ، وأخذ مبادئ النحو والصرف والفقه والتوحيد ، وفي سنة 1331هـ (1914م) التحق بجامع الزيتونة بتونس العاصمة حيث نال شهادة الأهلية واستعد لنيل شهادة التطويع ولم يتقدم إلى للامتحان، و رحل إلى القاهرة حوالي سنة 1339هـ (1920م) ومكث فيها يطلب العلم في حلقات جامع الأزهر ومكتباتها الغنية إلى سنة (1927م)، ثم رجع في السنة نفسها إلى تونس وحصل على شهادة التطويع ( العالمية ). نشاطه الدعوي نشاطه قبل تأسيس الجمعية  مع الرعيل الأول المؤسس لجمعية العلماء عاد الشيخ رحمه الله إلى الجزائر عام 1347هـ الموافق لـ 1927م ليبدأ نشاطه الدعوي في مدينة تبسة التي أصبح ينسب إليها ، وذلك في مسجد صغير يدعى مسجد ابن سعيد فبدأ الناس يلتفون حوله ويزدادون يوما بعد يوم حتى ضاق بهم هذا المسجد ، فانتقل بعدها إلى الجامع الكبير الذي تشرف عليه الإدارة الحكومية ، لكن سرعان ما جاءه التوقيف عن النشاط من الإدارة بإيعاز من الطرقيين ، فعاد إلى المسجد العتيق ابن سعيد ليواصل نشاطه بالرغم من ضيقه بالناس الذين استجابوا لدعوة الإصلاح واقتنعوا بها. وكانت دروس الشيخ للعامة تلقى بعد صلاة العشاء فترى الناس يسرعون من معاملهم ومنازلهم لأداء الصلاة وسماع الدرس فيمتلئ بهم المسجد ، وكانت طريقة الشيخ أن يختار نصا قرآنيا أو نبويا يناسب موضوعه، فيفسره تفسيرا بارعا يخلب ألباب السامعين ، فيريهم حكمة الشرع ومعانيه السامية، ثم يتدرج إلى بيان الأمراض الاجتماعية فيشرحها ويبين أسبابها وعواقبها في الدنيا والآخرة ، ومن ذلك نقضه لبدع الطرقيين الضالين وتنبيهه على إفسادها للعقيدة الإسلامية وسلبها لعقول الناس ، فيظهر بطلانها ويكشف حقيقة أدعياء التصوف الدجالين. ولما لاحظ الفرنسيون نشاط الشيخ والتفاف الناس حوله ، أخذوا في مضايقته ومضايقة أنصاره حتى في ذلك المسجد الصغير الخارج عن إدارتها ، ولما تفاقم الأمر نصحه الشيخ ابن باديس بالانتقال إلى مدينة سيق في الغرب الجزائري التي أبدى سكانها استعدادا لقبول إمام من أئمة الإصلاح ، فانتقل إليها بداية سنة 1930م، ففرح أهلها بقدومه وأقبلوا على دروسه واستفادوا من علمه وخلقه وتوجيهاته فمكث فيهم إلى آخر سنة 1931م ، وفي هذه المدة تمكن من بث الدعوة الإصلاحية السلفية ليس في مدينة سيق فحسب، ولكن في أنحاء كثيرة من الغرب الجزائري. دعوته إلى إنشاء الجمعية  لقد كان تأسيس جمعية للعلماء والدعاة العاملين على ساحة الدعوة تجمع الجهود لتصب في اتجاه واحد، وتوقظ الأمة وتنشر فيها الوعي والعلم وتجدد لها أمر دينها أمنية من أماني الشيخ العربي التبسي ، وقد كان ممن هيأ الأجواء لتأسيسها بمجموعة من المقالات نشرت له في الشهاب ومن أصرحها في ذلك المقال الذي نشره سنة 1926م بعنوان "أزفت ساعة الجماعة وتحرم عصر الفر د" والذي قال فيه: "فإن هذا العصر عطل الفرد ونبذ حكمه ، وأمات مفعوله، وتجاهل وجوده، فأينما أملت سمعك أو أرسلت نظرك في الشرق أو الغرب، لم تجد إلا أمة فحزبا فهيأة منها وإليها كل شيء، فهي التي تذب عن الهيأة الاجتماعية، وتحرس الأمة في نوائب الدهر وعادية الأيام ، وتغار على كرامتها وحسن الحديث عنها ، وتأخذ بيدها قبل أن تغرق عند هبوب السماسم ولفح الأعاصير ، وتكون لسانها الناطق بطلباتها ، وحسها المتألم لألمها". وقد تألم الشيخ أكثر لعدم شعور الأمة بحالها المزري ولطول نومها وسباتها ، تألم ألما لم يقدر على كبته فسطر مقالات عناوينها صيحات، أراها لا تزال صالحة أن يخاطب بها أهل زماننا فقال: "هذه جزائركم تحتضر أيها الجزائريون فأنقذوها". وقال: "ألا أيها النوام هبوا". وقال: "الجزائر تصيح بك أيها الجزائري أينما كنت". واسمع إلى هذه الكلمات المعبرة التي أبيت إلا نقلها : "بكائي على الإسلام ومبادئه ونحيبي على وحدة الدين الذي أضاعه بنوه ، الذي أمر بالجماعة وحث عليها ، بل وجعل المنشق عنها في فرقة من الدين وعزلة عن الإسلام وعداء لأهله . والذي فلق الحب وبرأ النسمة لو أن امرأ مسلما مات أسفا وحزنا على حالة هذه الأمة لكان له عند الله العذر . أيطيب لنا عيش مع هذه الحالة؟". وتحقق ذلك الأمل في 5 ماي 1931م بتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. أهم نشاطاته بعد إنشاء الجمعية
موقفه من تدخل الحكومة في الشؤون الإسلامية  المجلس الإداري لجمعية العلماء - 1949. (الجلوس، من اليمن إلى الشمال) أحمد بوشمال، عبد اللطيف سلطاني، محمد خير الدين، محمد البشير الإبراهيمي (نائب الرئيس)، العربي التبسي، أحمد توفيق المدني، عباس بن الشيخ الحسين، نعيم النعيمي، (الوقوف من خلف) مجهول، حمزة بوكوشة، أحمد سحنون، عبد القادر المغربي، الجيلالي الفارسي، أبو بكر الأغواطي، أحمد حماني، باعزيز بن عمر، مجهول، مجهول. ومن مواقفه الجريئة ما نشر من مقالات يطالب فيها بمنع تدخل الحكومة الفرنسية في شؤون المساجد ، وذلك لتبقي المساجد لله لإقامة شعائر الدين وللتعليم العربي والإسلامي ، ولكي لا تصير المساجد وأوقافها خادمة للحكومة وسياستها، ومما قاله في هذا المعنى : "والباقية أي المساجد على ملك الحكومة التي تعمرها بموظفين منفذين لسياستها وما ترمي إليه ، المختارين منها بسلوكهم وتفانيهم وطاعتها لا في طاعة الله ، فإن الإسلام الحقيقي لا تقام شعائره الدينية فيها، ولا تقرأ علومه الإسلامية النافعة ، ولا يرخص لعامة المسلمين وخاصتهم أن يكونوا أحرارا في تلك المساجد ، التي بصفتها بيوتا لله أذن لعباده أن يكونوا فيها متساوين ، ومن قبل فيها ما تشاؤه الحكومة لا يشاؤه الله ، فإنه اتبع غير سبيل المؤمنين وتسقط عدالته ، وهو ممن قال الله فيهم:" منكم من يريد الدنيا"". موقفه من فكرة الإسلام الجزائري ومن الأفكار التي روجها الاستعمار ولا زالت رائجة إلى اليوم فكرة الإسلام الجزائري ، التي أرادت من خلالها تشويه دعوات الإصلاح باعتبارها دعوات وافدة وليست أصيلة ، وقد أنكر الشيخ هذه الفكرة إنكارا شديدا ونسبها إلى مصدرها وكشف عن الشر المختفي وراءها، وكان مما كتبه في نقدها قوله رحمه الله : "الإسلام الجزائري في حقيقته ترتيب سياسي من تراتيب أنظمة الاستعمار في الجزائر ، ومعابده نوع من الإدارة الفرنسية ، وموظفوه فوج من أفواج الجندية الاستعمارية ، وأمواله قسم من أموال الدولة. ذلك هو الدين الجزائري الذي تبغيه فرنسا ولا تبغي الإسلام الحقيقي دين الله ولا تأذن له بالاستقرار في الجزائر". دفاعه عن السلفية والسلفيين كتب بعض الطرقيين مقال ينتقص السلفيين ودعوتهم وألزمهم أن يكون مثل الصحابة وإلا كانت دعواهم غير صحيحة ودعوتهم باطلة ، فتصدى للرد عليه الشيخ رحمه الله وكان مما قاله : "وهذه الطائفة التي تعد نفسها سعيدة بالنسبة إلى السلف وأرجوا أن تكون ممن عناهم حديث مسلم (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة) الحديث . فقد وُفقوا لتقليد السلف في إنكار الزيادة في الدين ، وإنكار ما أحدثه المحدثون وما اخترعه المبطلون ، ويرون أنه لا أسوة إلا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أو من أمرنا بالإتساء به ، فلما شاركوا السلف وتابعوهم في هذه المزية الإسلامية نسبوا أنفسهم إليهم ، ولم يدع أحد منهم أنه يدانيهم فيما خصهم الله به من الهداية التي لا مطمع فيها لسواهم". وقال أيضا : "أما السلفيون الذين نجاهم الله مما كدتم لهم فهم قوم ما أتوا بجديد، وأحدثوا تحريفا ، ولا زعموا لأنفسهم شيئا مما زعمه شيخكم ، وإنما هم قوم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر في حدود الكتاب والسنة ، ونقمتم منهم إلا أن آمنوا بالله وكفروا بكم". تضحيته في مجال الدعوة إلى الله أما تضحية هذا الإمام فلا تحتاج إلى وصف ، فأعماله التي نقلت إلينا عناوينها دالة على ذلك وشاهدة ، قال الشيخ يوما مخاطبا إدارة الجمعية : "فلتكن الأخوة رائدنا وليكن الإخلاص رابطنا ، ولتكن النزاهة شعارنا ، وليكن نكران الذات القاسم المشترك الأعظم بيننا. إنه لا يمكن إرضاء الإسلام والوطن، وإرضاء الزوج والأبناء في وقت واحد ، إنه لا يمكن لإنسان أن يؤدي واجبه التام إلا بالتضحية ، فلننس من ماضي الآباء والأجداد كل ما يدعو إلى الفتور وإلى الموت ، ولنأخذ من ماضيهم كل ما هو مدعاة قوة واتحاد". وكان الشيخ قد اعتقل عدة مرات وسجن إثر حوادث 8 ماي 1945م، وبقي مدة تحت الإقامة الجبرية في المشرية وغيرها حتى أفرج عنه في ربيع 1946م، ولم يثن ذلك من عزيمته ولا أنقص من عمله، وقد كان مثالا يقتدي به إخوانه ويتصبرون به، وكان مما قاله في يوم افتتاح معهد ابن باديس في كلمة ألقاها على مسامع المشايخ والمعلمين : "أيها الإخوان إن التعليم بوطنكم هذا في أمتكم هذه ميدان تضحية وجهاد ولا مسرح راحة ونعيم ، فلنكن جنود العلم في هذه السنة الأولى ولنسكن في المعهد كأبنائنا الطلبة، ولنعش عيشهم ، عيش الاغتراب عن الأهل ، فانسوا الأهل والعشيرة ولا تزورهم إلا لماما ، أنا أضيقكم ذرعا بالعيال وعدم وجود الكافي ، ومع ذلك فها أنا فاعل فافعلوا وها أنا ذا بادئ فاتبعوا". وقد حكى الشيخ الإبراهيمي أن التبسي لم يكن يرضى أن يأخذ مقابلا على أعماله قال : "أما هو فلم يزل مصرا على التبرع بأعماله خالصة لله وللعلم". موقفه من الجهاد ضد فرنسا يقول أحمد الرفاعي : "سمعت من الشيخ الطاهر حراث رحمه الله وغيره أن الكثيرين من أصدقاء الإمام رحمه الله حاولوا إقناعه بالخروج من الجزائر بعد أن أصبح هدفا ضخما وواضحا لغلاة المعمرين ، فكان جوابه دائما: إذا كنا سنخرج كلنا خوفا من الموت فمن يبقى مع الشعب ؟". بل نقل آخرون عنه أنه قال: "لو كنت في صحتي وشبابي ما زدت يوما واحدا في المدينة ، ولأسرعت إلى الجبل فأحمل السلاح وأقاتل مع المجاهدين". وظل في دروسه يحث على الجهاد بأسلوب حكيم ، وقد نقل الشيخ عبد اللطيف سلطاني أنه تلقى في أول أفريل 1957م رسالة كتب فيها: "إلى الشيخ العربي التبسي نطلب منك أن تخرج من الجزائر حينا قبل أن يفوت الوقت". فحاول إقناعه بأن يعمل بها فأبى واختار البقاء ، كما ذكرنا لتخطفه الأيادي الغادرة الآثمة. ثناء أهل العلم والفضل عليه
حادث الاختطاف قد علم المستعمرون أن الشيخ العربي التبسي يتمتع بشعبية كبيرة وأنه مؤيد للجهاد وأحد محركي القواعد الخلفية له، فأرسلوا إليه عن طريق إدارتهم في الجزائر عدة مبعوثين للتفاوض معه بشأن الجهاد ومصيره ولدراسة إمكانية وقف إطلاق النار، فاستعملوا معه أساليب مختلفة من ضمنها أسلوب الترغيب والترهيب، وكان جواب الشيخ دائما إن كنتم تريدون التفاوض فالمفاوض الوحيد هو جبهة التحرير، ذلك أنه شعر بأن مقصودهم هو تفكيك الصفوف، وربح الوقت والحد من حدة المواجهة العسكرية ليس إلا، وبعد رفضة المستمر للتفاوض باسم الأمة، رأى المستعمرون أنه من الضروري التخلص منه، ولم يستحسنوا اعتقاله أو قلته علنا لأن ذلك سوف يزيد من حماس الأمة للجهاد ومن حقدها على المستعمر، فوجهوا إليه تهديدات عن طريق رسائل من مجاهيل تأمره بأن يخرج من البلاد، وبعد أن أصر الشيخ على البقاء ، ويئس الكفار منه قاموا باختطافه بطريقة جبانة، ننقل وصفها من بلاغ نشرته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في البصائر بمناسبة حادث الاختطاف : "وفي مساء يوم الخميس 4 رمضان 1376هـ - 4 أفريل 1957م، وعلى الساعة الحادية عشر ليلا اقتحم جماعة من الجند الفرنسي التابعين لفرق المظلات –المتحكمين اليوم في الجزائر – سكنى فضيلة الأستاذ الجليل العربي التبسي ، الرئيس الثاني لجمعية العلماء ، والمباشر لتسيير شؤونها ، وأكبر الشخصيات الدينية الإسلامية بالجزائر ، بعد أن حطموا نوافذ الأقسام المدرسية الموجودة تحت الشقة التي يسكن بها بحي بلكور طريق التوت ... وكانوا يرتدون اللباس العسكري الرسمي للجيش الفرنسي ... وقد وجدوا فضيلة الشيخ في فراش المرض الملازم له ، وقد اشتد عليه منذ أوائل شهر مارس ... فلم يراعوا حرمته الدينية ، ولا سنه العالية، ولا مرضه الشديد ، وأزعجوه من فراش المرض بكل وحشية وفظاظة ، ثم أخذوا في التفتيش الدقيق للسكن ...ثم أخرجوه حاسر الرأس حافي القدمين ...ولكن المفاجأة كانت تامة عندما سئل عنه في اليوم الموالي بعده في الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والشرطية والعدلية ، فتبرأت كل إدارة من وجوده عندها أو مسؤوليتها عن اعتقاله أو من العلم بمكانه". وكان أن نشر الأستاذ علي مرحوم في مجلة الأصالة لسنتها الثامنة ، بلاغين لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين أصدرتهما إثر الحادث [1]. كيفية إعدام الشيخ رحمه الله اختلف المؤرخون في الجهة الاستعمارية المختطفة له وكيفية إعدام الشيخ العربي التبسي رحمه الله، وحكى الباحث أحمد عيساوي حكاية أسندها عن المجاهد أحمد الزمولي عن إبراهيم جوادي البوسعادي الذي كان ضمن تشكيلة القبعات الحمر وحضر معهم يوم اختطاف الشيخ من بيته، كما حضر مراحل إعدامه وكان منظر الإعدام سببا في التحاقه بالمجاهدين كما ذكر، وجاء في هذه الرواية ما يلي : "وقد تكفل بتعذيبه الجنود السنغاليون والشيخ بين أيديهم صامت صابر محتسب لا يتكلم إلى أن نفذ صبر "لاقايارد" -قائد فرقة القبعات الحمر-، وبعد عدة أيام من التعذيب جاء يوم الشهادة حيث أعدت للشيخ بقرة كبيرة مليئة بزيت السيارات والشاحنات العسكرية والاسفلت الأسود وأوقدت النيران من تحتها إلى درجة الغليان والجنود السنغاليون يقومون بتعذيبه دونما رحمة وهو صابر محتسب ، ثم طلب منهم لاقايارد حمل الشيخ العربي يتبع والله اعلم |
|||

|
 |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| علماء ، ادباء ، الشاوية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc