

|
|
|||||||
| منتدى قبائل الجزائر كل مايتعلق بأنساب القبائل الجزائرية، البربرية منها و العربية ... فروعها و مشجراتها... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
![]() ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
السلام عليكم شكرا أخ رمزي على نشرك لموضوع قبائل بني مرين التي تعتبر من أهم القبائل الزناتية والأمازيعية لكن وددت لو أننا تطرقنا لبقايا فروع بني مرين ومواطنها شكرا وصح فطوركم
|
||||

|
|
|
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله
اهلا اخي غمراسن ؛صح صيامك ، اعتدر على عدم التطرق الى الكثير من الجوانب في هدا الموضوع ، ودالك لبعض المشاغل ، ولكني بحول الله ، لن يتوقف الموضوع هنا أما فيما يخص بقاياهم فيمكن القول انهم في العصر الدي كان فيه ابن خلدون كانو في اقليم توات وقبالة غدامس با ليبيا وكانو بنواحي الحامة جنوب تونس ، كما كانو مجاورين لبني عبد الواد وبطالسة وغيرهم بوادي ملوية ، وكان منهم بحوز فاس و نواحي تامسنا ربما مندرجين في بني عمومتهم مديونه ومناطق اخرى في افريقيا و المغرب هدا في عهد الن خلدون اما بعد دالك فساحاول البحث في لاحق الايام ان شاء الله ونرجو من الاخوة ممن لديهه اطلاع ان لا يبخل علينا و السلام عليكم |
||||

|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
[CENTER]ملامح روحية وفكرية عند الدولة المرينية [/CENTER] |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 4 | |||
|
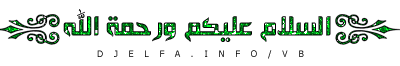 نرجو اثراء الموضوع وشكراا |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 5 | |||
|
الوزارة فى دولة بنى مرين الوزارة فى دولة بنى مرين أنقسمت إلى نوعين ؛ ففى الشطر الأول من الدولة كان السلاطين المرينيين يتميزون بالقوة والطموح فاتخذوا لأنفسهم وزراء ، ولم يسمح السلاطين لوزرائهم بأن يتخذوا أى قرار إلا بعد الرجوع إليهم فكانت الوزارة فى هذا الشطر ما هى إلا وزارة تنفيذ واستمر ذلك حتى وفاة السلطان أبى عنان المرينى عام 759 هـ / 1357م ، إذ بدأ يتولى عرش الدولة سلاطين ضعاف سيطر عليهم وزراء أقوياء فصار الأمر والنهى كله فى الدولة لوزرائها ليبدأ هنا عهدٌ جديدٌ يمكن أن نسميه (عهد نفوذ الوزراء) ، وكان من أشهر وزراء هذا العهد الوزير عمر بن عبد الله ؛ ولم يكن للوزير سواء عهد قوة الدولة أو عهد نفوذ وزرائها مهام محددة أو أختصاص بعينه فحيناً نجده قائداً عسكرياً يقضى على فتنة ما ، أو على رأس جيش يجاهد بأرض الأندلس وفى نفس الوقت يعود ليتولى ولاية مدينة مغربية بأمر السلطان ، وأحياناً أخرى يجلس للقضاء أو يتولى ديوان الإنشاء .ولقد تناولت الفترة موضوع البحث نظام الوزارة فى دولة بنى مرين بالمغرب الاقصى (610هـ ـ 1213م / 869هـ ـ1465 م ) . فبرغم الاهمية الكبرى التى تمتع بها الوزير فى العصر المرينى إلا أن الدراسات التى تناولت هذا الموضوع نادرة جداً ، كما أنها وإن تناولت شيئاً فإن هذا التناول لم يكن بصوره واضحة تشبع فكر الباحثين خاصة فترة عهد نفوذ الوزراء التى اتصفت بندرة المصادر والمراجع ، ونظراً لطبيعة الموضوع قسم الباحث الرسالة إلى ستة فصول يعالج كلاً منها ناحية قائمة بذاتها داخل الاطارالعام للبحث ومع ان فصول الدراسة ذات مواضيع مستقلة إلا أن كل منها مرتبط ببعضه البعض هذا فضلاً على تناوله مدخل للدراسة تحدث فيه الباحث عن التطور السياسى لدولة بنى مرين كما تحدث عن نظام الوزارة فى العالم الاسلامى نشأته وتطوره إلى قبيل قيام دولة بنى مرين بالمغرب الاقصى .وجاء الفصل الأول من الرسالة تحت عنوان الوزارة والدولة تناول فيه الباحث الحديث عن الوزراء والفتن وما كان للوزراء من دور فى صنع هذه الفتن ، وكذلك دورهم فى القضاء عليها وكيف كان تاثير هذه الفتن والأضطرابات على الدولة ، ثم تناول الحديث عن علاقة الوزير بالسلطان المرينى وكيف تردى وضع السلطان المرينى عهد نفوذ الوزراء إذ صار لعبة فى يد الوزير ، وتناول أيضاً دور الوزراء فى مبايعة السلطان الجديد و كيف خدم مبدأ وراثه العرش طموح وزراء الدولة المرينيه ، هذا إلى جانب الحديث عن وزراء الدولة ودورهم في ولاية المدن والأقاليم وتعرض الباحث للحديث عن الوزراء الذين نجحوا في هذا الدور .وفى الفصل الثانى : تناول الباحث الحديث عن الجهاد الأندلسى ودور وزراء الدولة المرينية فى العلاقات الخارجية مع غرناطة ، فأشار لدور الوزراء فى الجهاد بأرض الأندلس ضد نصارى أسبانيا وعندما ضعف دورهم فى الجهاد الأندلسى منذ معركة طريف بدأ الباحث فى الحديث عن العلاقات الخارجية بين غرناطة وفاس وأشار لدور الوزراء فى سير هذه العلاقات وهل كانوا عامل مودة وتوافق أم عامل بعد وتناحر بين الدولتين .أما الفصل الثالث : تناول دور الوزراء فى العلاقات السياسية الخارجية للدولة المرينية سواء مع الدولة التلمسانية أو الحفصية أو العلاقات الخارجية مع مصر .وفى الفصل الرابع : تناول الباحث الحديث عن الوزراء والحياة الأقتصادية فتناول دورهم فى الزراعة و الصناعة والتجارة ، ثم تحدث عن النقود وكيف كان وضعها عهد قوة الدولة والحال الذى آلت إليه من زيف وتدليس عهد نفوذ الوزراء وكيف أثر ذلك على الناحية الأقتصادية ثم أشار إلى دور الوزراء فى السياسة الجبائية للدولة ، وكيف أن السياسة الجبائية المجحفة عهد نفوذ الوزارء أدت للإنهيار الأقتصادى آواخر الدولة المرينية .أما الفصل الخامس من الرسالة تناول فيه الباحث الحديث عن الوزراء ودورهم فى الحياة الأجتماعية فتناول علاقة الوزراء بالعامة وباليهود والأحباس والحسبة ثم تناول الحديث عن الوزراء والتصوف والأشراف وأخيراً تناول الحديث عن الوزراء والآفات الأجتماعية كالزنا واللواط وشرب الخمر والسرقات وقطع الطرق وكيف أدت مثل هذه الآفات إلى الأنهيار داخل المجتمع المرينى .أما الفصل السادس والأخير من الرسالة تحت عنوان ” الوزراء ودورهم فى الحياة الثقافية والعمرانية ” تناول الباحث فيه الحديث عن الوزراء والحياة الأدبية والعمرانية وتناول الحديث عن التعليم وكيف كان وضع العملية التعليمية عهد قوة الدولة وعهد نفوذ الوزراء . كما تحدث عن أهم العلوم التى تم تدريسها ودور الوزراء السلبى أو الإيجابى فى كل من هذه النواحى .وأخيراً تكون الخاتمة والتى تتضمن أهم النتائج التى توصل إليها الباحث عن موضوع الدراسة |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 6 | |||
|
زناته في منطقة القبائل
الزناتيين منهم : بعض الشاوية ، بعض القبائليين ، بنو مزاب ، من الشلحة ، من الشنوة ، من المستعربين المسمون عرب ونحن اخوة مهما اختلفت افكارنا و ثقافتنا ما دفعني للكلام في هدا الموضوع هو الغلط الكبير والتقسيم الغير مبرر من طرف المؤرخين الفرنسيين وهو أيديولوجي بحت هدفه التفرقة بين الجزائريين في البداية ، الكلام عن اصل زناته ليس له دليل تاريخي وما يقال حولها مجرد اساطير اختلفت من مؤرخ لآخر ومن عصرلعصر غيره يقول ابن خلدون وهو محق في دالك ((فأما أولية هذا الجيل [زناتة] بإفريقية، والمغرب؛ فهي مساوقة لأولية البربر؛ منذ أحقاب متطاولة؛ لا يعلم مبدأها إلا الله قبيلة زناته في منطقة القبائل متأصلة كا غيرها من مناطق الوطن ، أصالتها لا يعني أنها من رحمها ولكنها من مواطنها الأولى كا غيرها من مناطق الأوراس و الغرب الجزائري و كامل الدول المغاربية ، الحديث عن مبتدأها عبث لا يجب ان نتكلم عن هدا لنفتخر على بعضنا البعض ولكن لنتوحد في ما بيننا فكلنا مستعربين ، شاوية ، عرب ، قبايل ،مزاب لنا نفس الانتماءات و نفس المصير لا أحد يمكن له تأصيل تلك القبيلة الكبيرة وما يقال فيها هو عبارة عن أساطير مختلفة و مبنية على أيديولوجيات و تخمينات و بعض الدراسات عندما نتكلم عن قبيلة زناته في منطقة القبائل نتكلم عن بنو مرين ملوك المغرب الأقصى فقد دكرهم ابن أبي الزرع أن جبل ايكجان شمالي سطيف كان من مواطنهم و أما ابن الأحمر فقد جعله موطن جدهم ماخوخ ، فقال : هم أعزهم الله تعالى (بنو مرين ) -من ولد الأمير ماخوخ الزناتي ، وكان أميرا على زناته بوطنه من أرض زاب افريقية و الزاب الأسفل ،[COLOR=Navyو هم من جبل هناك يقال ايكجان فحسب ابن الأحمر الدي تفرد بهدا ا القول من مؤرخي العصور الوسطى يعتبر هدا الموطن أصيل لجد هم ماخوخ الدي كان حسب ابن ابي الزرع كان يسكن في الخيام و كانت مواطنه مابين التل والصحراء على حسب حياة جدهم في زاب افريقيا و الحقيقة أن ابن أبي الزرع لم يتطرق الى مبتدئهم رغم أنه يعتبر موطن جدهم مادغيس هو الشام هم في الحقيقة كانو يتكلمون على ماض غابر معتمدين في دالك على ما يرويه بعض ملوكهم من بني مرين الدي في حد داتهم كلنو مختلفين بين أصلهم من زناته و بين أصلهم الشريف بانتسابهم الى علي رضي الله عنه ومهما كان دالك فمنطقة ايكجان بلا ريب كانت من مواطن بني مرين لعقود كثيرة ان لم نقل لقرون ولا نعود الآن للجدال الدي دار بين المؤرخين حول أولية زناته الدي جعل بعضهم أن جانا أبو زناته أول ماجاء الى المغرب نزل في واد الشلف ومنهم من جعل أول موطيء لهم بالمغرب الأقصى مدينة طنجة وسميت مدينة افريقية ، وهناك من جعل أول موطيء لهم هو بجوار المصامدة في جبالهم بالمغرب الأقصى ومن المؤرخين الفرنسيين مثل كاريت الدي جعل صاحب قبر امدغاسن الملكي النوميدي المسمى قبر مادغوس عند البكري وغيره أنه هو مادغيس الأبتر المدكور من طرف ابن خلدون وهناك بعض المؤشرات التي قد توضح بعض المسائل في قضية نسب زناته و غيرها في ما يخص مادغيس ايمدغاسن أو مادغوس عند البكري و صفكو أي صيفاكس حسب بعض الباحثين ، هؤلاء الملوك الدين نسي النوميديون تاريخهم ضلت أسطورتهم قائمة ليس كا ملوك ولكن أصبحو على رأس شجرة أنسابهم يعني قد يكونو أسلافهم من الملوك و ليس بالضرورة على رأس أنسابهم وبهدا قد تضرب كل المحاولات التي تنسب زناته الى منطقة معينة أو الى نسب معين يمكن اعتبار هؤلاء كأب روحي وقد حدث في قبائل كثيرة أن صار القائد، والزعيم الأول للقبيلة جدا تنسب إليه، فيقال في النظام القبلي بنو فلان وهم ليسوا بنيه ولكنهم أتباعه قبل أن تتحول التبعية إلى بنوة والرئاسة إلى أبوة]). فالزعيم هو الأب الحنون على الجميع في المفهوم الروحي للسلطة. وهي تدل أيضا على عراقة زناته في الجزائر كا غيرها من الدول جاءت الكثير من الأافكار التي تحدثث عن نسب زناته ورد في كتاب “قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان ” للقلقشندي: “زناتة من البتر من البربر: زناتة، بفتح الزاي والنون وألف بعدها تاء مثناة من فوق ثم هاء. قال في العبر: واسم زناتة: جانا، بالجيم، ويقال: شانا، بالشين المعجمة. وهو: جانا بن يحيى بن صولات بن ورساك بن ضري بن رحيك بن مادغش ابن بربر. وقيل: جانا بن يحيى بن ضريس بن جالوت بن هريك بن جديلات بن جالود بن ريلات بن عصى بن بادين بن رحيك بن مادغش الأبتر بن قيس عيلان بن مضر، فيكون من العرب المستعربة. وبعضهم يقول: جالوت بن جالود بن ديال بن قحطان بن فارس، فتكون من الفرس. قال في العبر: ونسابة زناتة تزعم الآن أنهم من حمير ومن التبابعة. وبعضهم يقول: إنهم من العمالقة، وإن جالوت من العماليق. ما أريد إيصاله هنا هو علينا أن نؤكد على وحدتنا من خلال شعوبنا وليس لنعادي بعضنا فنحن شعب واحد و دم واحد ، دراستنا للتاريخ هدفها التعلم من أخطاء الماضي فقط الزناتي : عربي ، شاوي ، قبايلي ، مزابي ، شلحي ، شنوي ....... كلنا اخوة و الحمد لله تحيا الجزائر واحدة موحدة ، وربي يهدي القلوب ******************************************** مجهود شخصي لا اقول أنه صحيح ولكن يمكن أن أضعه في خانة الفرضيات فقط : بنو واسين من قبائل زناته أو قبائل الفيسين الجيتول أحد قبائل حلف الاوتولول من شعوب جيندانيس الدين كانو جيران الغرامنت كما يرى المؤرخ اليوناني سترابون (64 أو 63ق.م ـ 21م) (فرضية) قبائل زناته أو الجيندانيس الدين دكرهم هيرودوت فالقرن 5 قبل الميلاد قبائل جيندانيس أوأو Gendaes Gendanis من قبائل الجيتول (Gaetulii=Gétules) فرضية يقول المؤرخين على رأسهم ابن خلدون أن الأصل في تسمية زناته هو جانا بن يحيى المذكور في نسبهم. وهم إذا أرادوا الجنس في التعميم الحقوا بالاسم المفرد تاء فقالوا جنات و للجمع يقولون جناتن نرى أن هده التسمية GENIDANES قريبة جدا من اسم قبيلة زناته المعرب و يتجلى دالك بوضوح بالنسبة لقبيلة أخرى المعدودة من عصبتها وهي زواغة حيث نجد نفس الصيغة لها مدكورة من طرف المؤرّخ اللاتيني بلين الأكبر Pline L’ancien 79 (ق.م) تحت اسم زوغيتانيس ZEUGHITANES قبيلة جندانيس شعب قديم جدا كانت مجالاته بالمنطقة الطرابلسية الجبل الغربي بليبيا و كان مترحل تتصل مجالاته بقبائل المكاي و الاوسيانس و الاترانتيون و أما الغرامنت فكانت أكثر انتشارا حيث اتصلت في عصر سترابون الى غاية خليج سرت ومن الطبيعي التقاءها بالقبائل الأخرى و كانو في الواقع جيران هده القبائل التي سميت في وقت غير معروف بالجيتول وكانو جيران الغرامنت شعب الغرامنت : الغرامنت شعب من شعوب الصحراء القديمة وردت أخبارهم كثيرا في المصادر اليونانية والرومانية؛ فأول مصدر أشار إليهم هو هيرودوت المؤرخ اليوناني من القرن الخامس قبل الميلاد، والذي حدد موقعهم على بعد عشرة أيام من واحة أوجيلا، فذكر أن بلادهم فيها نخل كثير، ووصف أسلوبهم في الزراعة وممارستهم لحرفة الرعي، ومن خلال هذه المعلومات التي أوردها هيرودوت يمكننا معرفة بعض ملامح حياة الغرامنت في القرن الخامس قبل الميلاد من حيث أن نمط حياتهم يندرج ضمن أشباه البدو الذين جمعوا بين حياة الزراعة التي تتطلب الاستقرار والرعي الذي يتطلب التنقل بحثا عن الكلأ والماء. . والغرامنت عند هيرودوت هم ليبيون يسكنون في البقاع الشمالية من إفريقيا ويجاورون الأثيوبيين حيث أن الغرامنت توسعوا على حساب الأثيوبيين بفضل عرباتهم التي تجرها أربعة أحصنة. أشار سترابون- الجغرافي اليوناني من القرن الأول قبل الميلاد- بطريقة مبهمة إلى وجود الغرامنت بالقرب من خليج السرت؛؛ فهم يتموقعون بين الجيتوليين في الشمال والأثيوبيين في الجنوب وتحدث بلين القديم عن حملة القائد الروماني كرونليوس بالبيوس إلى بلاد الغرامنت في القرن الأول قبل الميلاد ) واحتلاله لعاصمتهم غرمة. من خلال هذه المصادر نستنتج أن الغرامنت عاشوا في أقصى صحراء المغرب القديم، ولكنهم كانو قد تواصلوا مع الشعوب الأخرى، حيث مارسوا تجارة العبور مع الفنيقيين منذ القرن التاسع قبل الميلاد، كما أن الرومان وجهوا حملات عديدة إلى بلاد الغرامنت بهدف الاستيلاء على تجارتهم وهذا الاتصال بين الغرامنت والشعوب الأخرى هو الذي ساهم في ثراء بلادهم وقيام مدن في الصحراء الكبرى وقد دكر سترابون وبالتالي كانوا يشكلون جزءا أساسيا من شعوب الصحراء الكبرى قديما، أما عاصمتهم مدينة غرمة فموقعها الحالي في الجنوب الليبي على بعد 80 كلم من مدينة مرزوق الحالية. يتبع ............. شعب الجيتول : ((يمكن العودة إلى تاريخ أبعد فقد كانت سفوح الأطلس الجنوبية مجالات لقبائل الجيتول (Gaetulii=Gétules) والقرامنت (Garamantes) منذ فترة الملوك النوميد (حوالي 1200 ؟ - 46 ق.م. ) ومن تلك القبائل الأمّ تفرعت قبائل أخرى أهمّها زناتة (les Zénètes ou Zenata) وهوارة (Howara) والتوارق (Touarègues pl. de Targui) وهي قبائل في تعداد شعوب تنتشر في منطقة شاسعة من طرابلس (Tripolitaine) إلى المحيط الأطلسي ويصل البعض منها في انتجاعه إلى السهول العليا (Hauts-Plateaux) وهي كلها في لغتها وأصولها العرقية من ذات الشعب الأمازيغي أصيل الشمال الأفريقي من واحة سيوة في مصر إلى جزر الكناري.* كما يقول غابرييل كامبس : ما كان هؤلاء الزناتيون ينحدرون من النوميديين والموريين، بل إنهم حلوا محل الجيتوليين واحتووهم في تجمعات قبيلة جديدة الشعب الثالث الدي يعمر أفريقيا الشمالية يسمى الجيتول من طرف القدامى ، ومناطق تمركز هؤلاء الجيتول (gaetulii) غير محددة بدقة لأن النصوص أشارت الى الى تواجدهم في المغرب و الجزائر وتونس في دات الوقت ، وانطلاقا من خط عرض معين يحمل الليبيون هدا الاسم تلقائيا ، وهو اسم ظهر في فترة متأخرة في المصادر الأدبية ، ويعتبر سالوست أقدم كاتب أشار اليه وخص الجيتول بلعب دور مهم في تكوين الشعب النوميدي ، أما تيف ليف فأشار الى أنهم يشكلون بعضا من جيوش هانيبال ، وفي الفترة السابقة للحرب البونية أطلق اسم نوميد ، ليبيين ، ومور على أناس يعمرون منطقة جيتولية ، وقد جمع استيفان اقزال عددا من المؤشرات النادرة التي سجلها الكتاب القدامى و التي تسمح بتحديد مناطق تواجد عدد من القبائل الجيتولية ، وهناك شي قليل يضاف الى ما أشار مؤلف التاريخ القديم لأفريقيا الشمالية وهو أن بعض وجهات نظره عن الجيتول ينبغي أن تكون محل مراجعة و أولها تتعلق بالقبائل أو با الأحرى الكنفدراليات الجيتولية في المغرب الأطلسي فهو يرى ومعه كاركوبينو أن جيتول الأوتولول كانو يتواجدون في البداية بجوار واد بورقرق ومدينة سلا الرومانية ، وكانو يهددون خطوط الاتصال بالأطلس وقد افترض كاركوبينو أن الأوتولول (autololes) طردو تبعا لدالك نحوى الجنوب من طرق قبيلة الباقواط التي نزحة الى موريطانيا الطنجية ، وتبين دراسة عميقة لفريزول أنهم لم يكونو مجبرين على التنقل جنوبا وكان موطنهم بين رأس صوليس (cap cantin) ومنطقة السوس (le quosensus) وكانو يعمرون في الواقع اقليما يمتد مابين سلا و الأطلس الكبير ، وخلال تمددهم نحوى اشمال سوف يشغل الجيتول البانيور والاتولول اقليما هو المنطقة الأصلية للمور يرى سترابون أن هؤلاء الجيتول كانو جيرانا لشعب الغرامنت الدين أشار بأنهم موحودو ن في خليج سرت ومناطقهم بالصحراء الى جرمة عاصمتهم وهدا ما يدعونا للدهاب الى المنطقة الطرابلسية حيث القبائل الراحلة التي أرشدنا اليها هيرودوت الدي سبقه بعدة قرون يتبع ...... بنو واسين من قبائل زناته أو قبائل الفيسين الجيتول أحد قبائل حلف الاوتولول من شعوب جيندانيس الدين كانو جيران الغرامنت كما يرى المؤرخ اليوناني سترابون (64 أو 63ق.م ـ 21م) (فرضية) يتبع بنو واسين الفيسون من حلف الجيتول الاوتولول يرى بعض الباحثين أن اسم واسين دكرو من طرف مؤرخي الرومان باسم فيسون أو فيسين وكانت مجالاتهم بلاد الجيتول وخاصة الجنوب الغربي للجزائر ناحية عين الصفراء و جبال القصور حسب بلين, الذي أورد أن جيتول ناحية الجنوب الغربي كانوا يسمون سنة 72 ب" فيزون" و كونوا فرعا من اتحاد الأتولول الدي كانت مجالاته خاصة جنوب المغرب الأقصى الى الأطلس الكبير و بفضل "بطليمي" علمنا أيضا أن السلسلة الجبلية المسماة حاليا جبال القصور كانت تدعى " مونس مالتيبالوس " Mons Malethubalus. نلاحظ غيابا للمصادر اعتبارا من بطوليمي في القرن الثاني. فالجيتول لم يستعملوا سوى لغة غير مكتوبة. لم يبدي الرومان أي اهتمام لجنوب البلاد, فلقد عزلوه بحائــط أقيم جنوب سبدو و قرب سعيدة يدعى " ليماس" و كل البلاد التي كانت جنوبه كانت تدعى بلاد البربر. أما الوندال و البيزنطيون الذين كانوا يحتلون إفريقيا الشمالية بين القرن 5 و 7 لم يأتوا إلى هذه المنطقة التي كانت مستقلة تماما -- يمكن للمهتمين بهذه الفترة الإطلاع على اللمحة التاريخية للجنوب الغربي الجزائري ( الجزء 1 ) من الأصول إلى ظهور الإسلام--. لم يتم الحصول على معلومات أخرى إلا بعد الفتح الإسلامي أواخر القرن 7 (1 هـ) خاصة بفضل مؤلفين عرب مثل أبن الحاكم (ق 9), البكري (ق11), ابن الأثير (ق 12), ابن العذري (ق 13) و الأخوين ابن خلدون (ق 14 ). دخل الإسلام ناحية الجنوب الغربي مع بداية القرن الثامن اين كانت واسين تنتجع نواحي سلجسامة الى طرابلس (بداية بلاد الزاب ) وما بينهما، . استنادا إلى النويري و عبد الرحمان ابن خلدون تمت الأسلمة بين 708 و 720 (89 إلى 101 للهجرة) في عهد موسى بن نصير و بمساهمة من القائد المغربي طارق بن زياد الذي كان يعمل لحساب الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. لم يبعث المسلمون جيوشا ناحية الجنوب الغربي, وإنما اكتفوا بتكليف مبعوثين لطلب الموالاة إلى رؤساء قبائل و قصور الجنوب فخضعوا لذلك و التزموا بترك الوثنية و تبني الدين الجديد الذي تم تعليمه لهم بواسطة " طلبة " من ناحية تلمسان, فبنوا لجل ذلك قاعات للصلاة. التزموا كذلك بدفع الزكاة و تجنيد المقاتلين لفتح إسبانيا. تجدر الإشارة أن في وقت الأسلمة لم تحدث أي هجرة للعرب إلى الجنوب. استمر السكان في تكوين النسق البربري المتجانس الذي لا يستعمل اللغة العربية إلا أثناء الصلوات و بصفة جزئية أثناء الدروس الدينية التي يلقيها "الطلبة". خلال النفوذ الإسلامي, كان بربر الجنوب الغربي و حضر القصور و البدو الرحل من زناتة من عرش " وسين" . لم يخف بعض المؤلفين معرفتهم لأصل كلمة "وسين" الذي يعود إلى " فيسون " المستعمل من طرف الجيتول. يستنتج من ذلك, بما أن الجنوب الغربي لم تحدث به هجرات كبيرة خلال القرون السابقة لدخول الإسلام فإن الزناتة وسين يعود أصلهم إلى الجيتول الفيسين. وهي تدخل في ما كان يعرف بكنفدرالية الأتولول ، يرى جيروم كاركوبينو أن جيتول الأوتولول كانو يتواجدون في البداية بجوار واد بورقرق ومدينة سلا الرومانية ، وكانو يهددون خطوط الاتصال بالأطلس وقد افترض كاركوبينو أن الأوتولول (autololes) طردو تبعا لدالك نحوى الجنوب من طرق قبيلة الباقواط التي نزحة الى موريطانيا الطنجية ، وتبين دراسة عميقة لفريزول أنهم لم يكونو مجبرين على التنقل جنوبا وكان موطنهم بين رأ س صوليس (cap cantin) ومنطقة السوس (le quosensus) وكانو يعمرون في الواقع اقليما يمتد مابين سلا و الأطلس الكبير وقد رأى المؤرخ سترابون أن هؤلاء الجيتول كانو يجاورون الغرامنت يقول ابن خلدون في كتابه المقدمة فصل في أولية هذا الجيل وطبقاته: أمّا أولية هذا الجيل بإفريقية والمغرب فهي مساوية لأولية البربر منذ أحقاب متطاولة لا يعلم مبدأها إلاّ الله تعالى، وكانت مواطن هذا الجيل من لدن جهات طرابلس إلى جبل أوراس والزاب إلى قبلة تِلْمِسَانِ، ثم إلى وادي مَلَويّة. مايرويه بعض الاخباريين و محاولة تأكيدهم للحياة البدوية مثل ابني أبي الزرع و الملزوزي و ابن خلدون و غيرهم يصب في صالح القبائل البدوية التي دكرهم هيرودوت مابين مصر و شط الجريد ومنها Gendaes أو Gendanis الدين كانو عكس قبائل غرب الجريد الى أعمدة هرقل الدين كانو في وقته قد استقرو تماما مثلما يقول هيرودوت مادكره الاخباريين حو الحياة البدوية لزناته رغم اختراعهم لأساطير ما أتى الله بها من سلطان ؟! جاء في كتاب الأنيس المطرب لأبي الزرع هده الرواية : (مات بر ابن قيس في بلاد أخواله فنشأ ولده مادغيس ودريته في البربر حتى كثرو وسارو ألوفا لا تعد ولا تحصى ، لسانهم بلغتهم ناطق ، وحالهم بحالهم وافق ومطابق ، يسكنون البراري والسباسب ويركبون الخيل والنجائب ، ناطقين بأحسن لغاتهم آخدين بأحسن سيرتهم ومناهجهم ............. وبدالك يقول صاحب أرجوزة نظم السلوك عبد العزيز الملزوزي فجاورت زناته البرابر فصيرو كلامهم كما ترى ما بدل الدهر سوى أقوالهم ولم يبدل منتهى أحوالهم تشابه الاسم بين جناتن و الجندان : يقول المؤرخين على رأسهم ابن خلدون أن الأصل في تسمية زناته هو جانا بن يحيى المذكور في نسبهم. وهم إذا أرادوا الجنس في التعميم الحقوا بالاسم المفرد تاء فقالوا جنات و للجمع يقولون جناتن نرى أن هده التسمية GENIDANES قريبة جدا من اسم قبيلة زناته و يتجلى دالك بوضوح بالنسبة لقبيلة أخرى المعدودة من عصبتها وهي زواغة حيث نجد نفس الصيغة لها مدكورة من طرف المؤرّخ اللاتيني بلين الأكبر Pline L’ancien 79 (ق.م) تحت اسم زوغيتانيس ZEUGHITANES قرب موطن الجندانيس Gendanis من الغرامنتيين Gar mantes : يرى سترابون المؤرخ اللاتيني أن الجيتول gaetulii ومنهم الفيسين الدين سبق و تكلمنا عنهم الدين كانو ضمن حلف الاوتول في المغرب الأقصى كانو قبل دالك جيران للغرامنت Gara mantes و هؤلاء الأخيرين عند هيرودوت هم ليبيون يسكنون في البقاع الشمالية من إفريقيا ويجاورون الأثيوبيين حيث أن الغرامنت توسعوا على حساب الأثيوبيين بفضل عرباتهم التي تجرها أربعة أحصنة. وقد أشار سترابون- الجغرافي اليوناني من القرن الأول قبل الميلاد- بطريقة مبهمة إلى وجود الغرامنت بالقرب من خليج السرت؛؛ فهم يتموقعون بين الجيتوليين في الشمال والأثيوبيين في الجنوب رأي في الربط بينهم قبيلة جندانيس شعب قديم جدا كانت مجالاته بالمنطقة الطرابلسية الجبل الغربي بليبيا و كان مترحل تتصل مجالاته بقبائل المكاي و الاوسيانس و الاترانتيون و أما الغرامنت فكانت أكثر انتشارا حيث اتصلت في عصر سترابون الى غاية خليج سرت ومن الطبيعي التقاءها بالقبائل الأخرى و كانو في الواقع جيران هده القبائل التي سميت في وقت غير معروف بالجيتول هناك أيضا الروايات المتداولة بين بني مزاب احدى قبائل بني بادين من واسين حول أن أصولهم ترجع الى جوار جبل نفوسه وهي في حقيقة الأمر نفس بلاد الجندان GENIDANES ندوة ترحيب و كلمة الأستاذ إمناسن خلال زيارة اخواننا من جبل نفوسة الى وارجلان https://www.dztu.be/watch?v=m2CRDvHZlVk ملاحظة : هده مجرد آراء خاصة وليست حقيقة لأن التاريخ ليس علوم دقيقة و خاصة الأخبار التي تتكلم عن الماضي الغابر و الله أعلم |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 7 | |||
|
السلام عليكم |
|||

|
 |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مختصرات, أرجو |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc