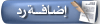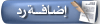عمدة الفقه (المستوى السابع)
الدَّرسُ الأول
فضيلة الشيخ/ د. عبد الحكيم بن محمد العجلان
{بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزَّاء في حلقةٍ جديدةٍ من حلقات البناء العلمي، وفي مطلع هذه الدروس المباركة أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلًا وسهلًا بكم فضيلة الشيخ}.
حيَّاكَ الله، وحيَّا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وإن شاء الله إطلالة جديدة نسأل الله لنا ولكم التَّوفيق والسَّداد.
{نشرع في هذا الدرس -بإذن الله- من كتاب اللعان من كتاب "عمدة الفقه" للموفق ابن قدامة.
قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (باَبُ اللِّعَانِ.
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، الْبَالِغَةَ اْلعَاقِلَةَ، اْلحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ اْلعَفِيْفَةُ بالزنا، لَزِمَهُ اْلحَدُّ، إِنْ لَمْ يُلاَعِنْ)}.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم وباركَ على نبيِّنا محمد، وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدِّين.
أمَّا بعدُ؛ فأسألُ الله -جلَّ وَعَلَا- أن يشرح صدورنا بالعلم، وأن يرفعنا به، وأن يجعله بُلغةً لنا في الدنيا، وأجرًا لنا يوم لقاه، وأن يزيدنا وإيَّاكم من الخير والهدى والبر والتقوى.
في إطلالة هذه اللقاءات المباركة وبداية هذا الفصل الدراسي الجديد الذي نرجوا من الله -جلَّ وَعَلَا- أن يكون لنا مُعينًا، وأن نكون فيه من المخلصين، وأن نكون من عباد الله الموفَّقين، ما أحسن أن نتذاكر وأن نتراجع ما يجب أن يكون مستصحبًا معنا في مثل هذه المجالس وفي مثل هذا الميدان، وهذا الطَّريق الذي هو طريق العلم بتجديد النيَّة، واصطحاب القصد لوجه الله -جلَّ وَعَلَا-، فإنَّ الإنسان أسرعُ ما يتغيَّر عن حُسنِ القصدِ، وسلامة النية، وطلب رضا الله -جلَّ وَعَلَا-، فيتزيَّنُ بالعلمِ، ويتكثَّرُ بهِ، ويُريد به البروز على أقرانه والظهور على إخوانه، وأن يُصدَّر في المجالس، أو أن يُرجَع إليه في الأقاويل، فما أكثر ما يستغل ذلك الشيطان ليصرف الإنسان عن النية الصالحة.
لذلك وجبَ عليَّ وعليكَ وعلى كلِّ مَن حضر هذا المجلس المبارك من المشاهدين والمشاهدات أن يُجدِّدَ العزمَ، ويُصلحَ القصدَ، وأن يطلبَ رضا الله -جلَّ وَعَلَا- وأن يستشعرَ قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا» ، يعني: لم يجد ريحها، فهذا أعظم ما يكون من التَّحذير، وأبلغ ما يكون من التَّخويف في البعد عن سوء القصد، وتغيُّر التَّوجُّه إلى الله -جلَّ وَعَلَا.
لمَّا كان الأمر كذلك؛ فإنَّه مما ينبغي التَّنبيه عليه أنَّ التَّوفيق إلى العلم مِنَّةٌ ربَّانيَّة، ورحمةٌ إلهيَّة، يمنُّ الله -جلَّ وَعَلَا- بها على عباده، فإذا ما رأيتَ مَن حولكَ وإذا ما التفتَّ إلى مَن سواكَ ورأيت كثيرًا من الناس ينشغلون بدنياهم، ويُشغَلون بشهواتهم، ويملؤون أوقاتهم -في أحسنِ أحوالهم- بالمباحات؛ إن لم تكن المكروهات والمحرمات؛ فإنَّ ذلك منَّةُ الله عليكَ، فإنَّ: لم تُحصِّل ذلك بقوَّتك وقدرتك، واختيارك لنفسك، وإنَّما هو اختيار الله -جلَّ وَعَلَا- لعباده، وتيسير الله -جل وعلا- لأوليائه؛ فاحمد اللهَ على هذه النِّعمَة، وأدِّ حقَّها، وتذكَّر الحديث الذي به تُستفتح هذه اللقاءات وتُختم، وفي إطلالة كلِّ موعدٍ من مواعيدها، وهو قول النَّبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الحديث الذي في الصحيح: «مَنْ يُرِدِ اللّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» ، جاء في بعض الروايات كعند الطبراني وغيره: «ومن لم يَتَفَقَّهْ في الدِّينِ لم يُبَالِ اللهُ بهِ» ، فأعظم ما تكون به طمأنينة القلب لمَن كان عالمًا ويعبد الله على بصيرة، فإنَّه يعلم صحَّة وضوئه وتمام صلاته، وكمال عبادته، وصحَّة معاملته، وإتيانه لما أُمرَ به ممَّا يصح به كل أعماله وأفعاله وأقواله، ويُبعد عن نفسه الوقوع في الممنوع، أو تعاطي الحرام، أو التَّعرض للعقوبة، أو الوعيد في الدنيا أو الآخرة، ولا يتأتَّى ذلك إلا لمن عرفَ الأحكام وتعلَّم السُّننَ، واهتدى بهدي النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فلأجل ذلك فإنَّ في هذا خير كثيرٌ ومنَّةٌ عظيمة، وإذا كان كذلك من حيث الأصل الذي هو العلم -ميراث النبوة- فإنه أحوج ما نكون إليه في مثل هذه الأوقات المتأخرة والأزمنة المتباعدة التي كثر فيها انصراف الناس عن العلم وابتعادهم عنه.
ثم أيضًا لمَّا كان العلم بركةً للإنسانِ في نفسه، فإنَّه عاصمًا للإنسان من الوقوع في الفتن وتعاطي المحرمات، والانجرار إلى الموبقات والمهلكات، وربما يقول قائل: نحن ربما ندرس تفصيل مسائل لا علاقة لها بكثير من الوقائع، كباب الظِّهار وباب اللِّعان أو الحضانات وغيرها!
نقول: هذا إن كان كذلك من حيث التَّفريعات إلا أنَّه من حيث الأصل فإنَّ للعلم بركة، ومَن شغلَ نفسَه بالعلم والهدى والقرآن والسُّنة وقولِ الله -جلَّ وَعَلَا- وقول رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فإنَّ الله يجعل له في أحلك الظروف وأشدِّ الأحوال ما يكون له سلامةً من البلايا وخلاصًا وفكاكًا له من النار والعذاب وشدَّة البلاء في الدنيا والآخرة، فإن الله -جلَّ وَعَلَا- بيده مقاليد الأمور وتصريف الأحوال وحفظ العباد، ومن حفظ الله حفظه الله، ومن حفظ كتاب الله وسنة رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فإن الله يكون معه، كما جاء ذلك في الحديث المشهور الذي تحفظونه في وصية النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لابن عباس: «احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظُكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ» ، وليس شيء أعظم من التَّعرُّف إلى الله -جلَّ وَعَلَا- بالصلاة والعبادة والعلم والهداية وطلب العلم والتفقه في الكتاب وفي سنة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ولذلك أُوصي الإخوة والأخوات جميعًا أن يتواصوا على هذا الخير وأن يُقيموا عليه، وأن يثبتوا في الاستمساك بحبله، وعدم الضعف أو التَّكاسل أو التَّواني أو التَّسويف عن البقاء في ميدانه والحرص عليه؛ هذه منَّةُ الهم عليكم، وإنكم ستلقون أحوج ما تكونوا إليه يومَ أن تلقوا ربكم، وأن تخلص هذه الدنيا، وتفتح الصحائف، ويُحاسب العباد على الأعمال؛ فإنَّه لن يجد الإنسان أعظم من صالح عمله، واهتدائه بسنَّة نبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وتعلمه للأحكام، والبعد عن سيء الأعمال، وهذه فضيلة تفضل الله -جلَّ وَعَلَا- بها علينا.
هذا من جهة على سبيل العموم والاستهلال والبداية، وإذا أردنا أن نكمل ما توقفنا عنده فإنَّ الإخوة جميعًا يذكرون أننا بحثنا في الفصل الماضي ما يتعلق بالطلاق والإيلاء والظهار، ثم ها نحن نبتدئ أحكام اللعان.
والفقهاء -رحمهم الله- يذكرون في هذه الأبواب مجمل ما تحصل بها الفرقة، أو يؤول إليها، سواء كانت فرقة صحيحة كفُرَقِ الطلاق ونحوها، وإن كان في ذلك تفاصيل قد مرَّ بيان أحكامها، متى يجب ومتى يُكرَه ومتى يُباح ومتى يُسن، إلى غير ذلك من التفاصيل.
ثم تكلَّم الفقهاء على الظِّهار، الذي هو طلاق أهل الشرك قبل الإسلام، وما فيه من الحرمة، وما فيه عن الوعيد من الله -جلَّ وَعَلَا- وعن رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وكذلك اللعان يؤول إلى الفرقة -كما سيأتي بإذن الله جل وعلا- وهو دراسة لحالٍ خاصَّةٍ تكون بين الزَّوجين، على ما سيأتي بيانه -بإذن الله جل وعلا.
واللعان: من اللعن، وهو الطَّردُ والإبعادُ عن رحمةِ الله -جلَّ وَعَلَا.
وتسمية هذا الكتاب بــ"اللعان" ذلك أنَّ الزَّوجين يتلاعنان، فإذا حصلَ أن قذف الزوج زوجته ولم يأتِ ببينة وطالبت الزَّوجة بالقذف؛ فإنَّه يُدرأ عنه الحد بملاعنته لزوجته.
فهذا هو أصل مشروعيَّة اللعان، وفيه قصة مشهورة، في قصة عويمر العجلاني وهلال بن أمية، لما ذكر للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقال: "إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ"، فلما ذكر للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما وقف عليه من حال زوجه، قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ» ، ثم دعا بهما فأمر بما أمر الله به من التلاعن، فأنزل الله: ï´؟وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَï´¾ [النور: 6،7]، فمن هذا أُخذ تسمية هذا الكتاب وصار أصلًا في هذا الباب.
إذن هذه الآية هي دلالة الكتاب عليه، ودلالة السُّنة حديث عويمر وحديث هلال بن أمية، ويُجمع أهل العلم على أنَّ الزوج إذا قذف زوجته واكتملت الشُّروط؛ فإنَّ له أن يُلاعنها مُسقِطًا للحدِّ عليه، ومفرِّقًا بين الزَّوجين إذا اكتمل اللعان بينهما، ونافيًا للولد إذا نفياه بقولهما تصريحًا أو ضمنًا. هذا من حيث الأصل.
وهنا بين يدي ما يتعلَّق باللعان لابدَّ من التَّنبيه على مسألةٍ، وهي أنَّ حقيقة اللعان أنَّ الزَّوج يقذف زوجته، يعني: بالزنا فيقول: هذه زانية.
وينبغي أن يُعلم -أيها الإخوة- أنَّ اللعان لا يُبنى على الشُّكوك، وأنَّ الزَّوج لمجرد أن يرى بعض سلوكيات زوجه في سوء تعاملها أو في تبذُّلها وتركها للحجاب، أو بعض ما يكون منها من محادثةٍ للرجال أو نحو ذلك؛ أن يحكم بزناها! لا، فإنَّ هذا من الشُّكوك ومن تلاعب الشيطان ومن الوساوس، وعلى الزوج أن يؤدِّبَ زوجته، وأن يربيها، وأن يمنعها من هذه الأفعال السيئة، وأن يحفظها، ولكن لا يجوز له أن يتجرأ بقذفها بالزنا، وإنما ذلك فيمَن رآه عيانًا بيانًا ووقف عليه وتيقَّن حصوله، ولا يلتفت حتى إلى الأخبار، فإنَّ من الناس من يكون شامتًا ومَن يريد بذلك الوقيعة بين الزَّوجين، ومَن يظن وهو جاهل، ومَن يحمل الأمور على غير وجهها، وقد يتبدَّى له ما لا ليس على وجهه؛ فبناءً على ذلك لا ينبغي أن يُدخل في هذا الباب لأدنى شبهةٍ، أو لأقلِّ وسوسةٍ يوسوس بها شيطانُ إنسٍ أو جنٍّ، فيَلَغَ الإنسانُ في الأمرِ العظيمِ.
يقول المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ)، أي: قذفها بالزنا بخصوصه، فيقول: وقعَت في الزنا في قُبُلها أو دبرها، أما لو قذفها في غير الزنا كأكلها للحرام أو ببعض السِّباب والشِّتام؛ فهذا مما يكون به تعزير ولا يصل إلى أمر اللعان، ولكن إذا حصل القذف في مثل هذه الحال وهو مبني على أمر مشهود معلوم؛ وإلا تبوأ الإنسان بالعذاب الأليم، ولذلك فإنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في قصَّة المتلاعنين لَمَّا لاعن الرجل زوجته، فجاء في الرابعة وقال: "أشهد بالله أنَّها زنت" وقالها أربعًا؛ فأمر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يُمسك على فمه ويقول: "إنها الموجبة، واتقِ الله، ولعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة".
فقال أمية: "كَذَبْتُ عَلَيْهَا يا رَسولَ اللَّهِ إنْ أمْسَكْتُهَا" ، أو كما جاء في الحديث.
وهذا يدلُّ على أنَّ اللعان إنما يكون بين زوجين، ولذلك لو قذف الرجل أجنبيَّةً أو في وطءٍ بشبهةٍ أو أمة؛ فإنَّه لا لعان بينهما، إذن هذا مخصوص في أمر الزَّوجين، لأنَّ من حيث الأصل أن الأعراض مصونة في الإسلام، لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا» ، فمن تجرَّأ على الأعراض فإنَّه يُحدُّ حدَّ القذف، وهذا أمر مقطوع به، لكن لمَّا كان للزَّوج من الغيرةِ على بيتهِ والحفاظ على أهله وعدم التَّعرض لهم بسوء وما يلحقه من العار فيما لو حصل ذلك؛ يعني: أن الزوج لا يحمله على أن يقذف زوجته إلا الوقوع، وإلا فإنَّه لا يُتصوَّر أن زوجًا يتشفَّى في امراته أو يُظهر عليها عارًا ليس فيها؛ فلما كان الأمر كذلك استثناه الله -جلَّ وَعَلَا- من حدِّ القذف إذا لاعن زوجته، وهذا ليس على الإطلاق أن يقذف الأزواج زوجاتهم، ولكن إذا قذفها فيُمكن أن ندرأ عنه حد القذف إذا لاعن، فمعنى ذلك أنه لن يُلاعن زوجته بعد تجرئه على قذفها إلا أن يكون متيقنًا مما جرى وحصل.
وبناء عليه؛ لو أنَّ رجلًا قذف زوجته فقال لها: يا زانية، يا عاهرة.
نقول: في مثل هذه الحال: لو تبيَّن للزَّوج أنَّه مخطئ في ذلك فلا يجوز له أن يُقدم على اللعان، وعليه أن يرضى إن طالبت هي بالعقوبة وبحد القذف، ويلحق به من التَّطهير ما يلحق، ولكن لا يدخل بابًا لا يجوز له دخوله ويدعو على نفسه باللَّعن والطَّردِ والإبعاد عن رحمة الله، ويُعرِّض المرأة لهذا التَّشهير والابتلاء العظيم، ويُفضي به أيضًا إلى انقطاع الزَّوجيَّة بينهما، وما يلحق ذلك من معرةٍ على الأولاد وتصدُّع البيت وغير ذلك.
قال: (الْبَالِغَةَ اْلعَاقِلَةَ)، لابدَّ أن تكون بالغةً عاقلة، وكونها بالغة لأنَّها ستشهد وتدعو على نفسها بالغضب، وهذا لا يكون من الصَّغير ولا يتصوَّر منه، فالشهادات والأيمان لا تُقبَل إلا من البالغ، فالصغيرة لا يكون منها لعان.
أما لو قذف الصغيرة؛ فليس أمامه إلا أمرين:
الأول: إما أن يأتي بالبيِّنة على أنَّها فعلت المنكر، فيرتفع عنه الحد.
الثاني: يُعزَّر وما عليه حدّ؛ لأنَّ الحدَّ في القذف إنما يكون على المحصنة، والمحصنة هي أن تكون مسلمة حرة عاقلة عفيفة، وأن تكون ممن يُجامع مثلها؛ فإذا توفَّرت هذه الشروط فبناء على ذلك يكون عليه حد القذف.
وأمَّا غير العاقلة كالمجنونة ونحوها فلا يكون لها لعان؛ لأنَّه لا يتصوَّر منها الشهادة والدُّعاء على نفسها بالطرد والإبعاد عن رحمة الله -جلَّ وَعَلَا.
قوله: (اْلحُرَّةُ)، يُخرج غيرها.
والكلام هنا في المرأة التي يحصل بها الحد إذا قذفها، فهذا بيان لما يحصل به إحصان المرأة، أن تكون بالغة عاقلة حرة عفيفة مسلمة، ولكن من حيث اللعان فإنَّه يكون بين الزَّوجين سواء كانا مسلمين أو كانا كتابيين، فاسقين، أو غيرهما، حرين أو عبدين؛ لأن الله -جلَّ وَعَلَا- قال: ï´؟وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْï´¾، ولكن أراد المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أنَّ من قذف الزوجة التي هذه أوصافها فإنَّ عليها الحد، والحد إنما يُدرأ باللعان.
فهذه المرأة البالغة العاقلة الحرَّة العفيفة التي لا تُعرَف بالفواحش، أما المرأة التي عُرفَت بأنها بغي، أو ظهر في الناس فسقها وفجورها وتعرِّيها وتعرضها للمنكرات؛ فإنَّ مَن قذفها لا يحد، ولكن لا يعني ذلك جواز قذفها، لكنه يُعزَّر، ويُدرأ عنه الحد لعدم عفَّتها ويجب عليه التعزير لئلا يتطاول الناس على النساء والأعراض، ويبتلوا الناس في أنفسهم.
وأما قذف غير المسلمة فلا حدَّ فيه، وستأتي الإشارة إليه في باب الحدود.
قوله: (بالزنا)، يعني بالزنا الصَّريح بأن يكون في قُبُل أو دبر، فلو قال: قبَّلها فلانٌ أو ضمَّها فلان؛ فهذا نوعٌ من القذف لكنه ليس قذف بالزنا، فليس فيه حدُّ القذف وإنما فيه التعزير.
قوله: (لَزِمَهُ اْلحَدُّ إِنْ لَمْ يُلاَعِنْ)، إذن يُقابل لزوم الحد اللعانُ، فإذا لاعن انتفى عنه الحد لما جاء في هذه الآيات ودلالة الأحاديث.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَإِنْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً أَوْ أَمَةً، فَعَلَيْهِ التَّعْزِيْرُ)}.
إذا كانت الزَّوجة ذميَّة -كتابيَّة- نصرانيَّة أو يهوديَّة؛ فلا حدَّ على مَن قذفها، ولكنه يُعزَّر مثلما قلنا لئلا يتطاول الناس على النساء بأدنى الشكوك أو بالظلم والعدوان.
وقوله: (أَوْ أَمَةً)، لو كانت أمةً عنده فإنَّه لا يجب عليه الحد بقذفها، ولكنَّه يُعزَّر في قوله كونها زانية.
قوله: (فَعَلَيْهِ التَّعْزِيْرُ إِنْ لَمْ يُلاَعِنْ)، الكلام هنا في الزوجة سواء ذميَّة أو أمة، فإذا لاعنها فإنه يُدرأ عنه الحد والتعزير.
{قال المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَلاَ يُعَرَّضُ لَهُ حَتَّى تُطَالِبُهُ)}.
يعني: لو قذفها لا يُحدُّ ولا يُجلد إلا لو طالبت المرأة، فنستكمل الأمور ونقول: عليك حد القذف أو التَّعزير في الحال التي يجب فيها التَّعزير، فإذا طلب اللعان فله أن يُلاعن من زوجته في تلك الحال بالشروط المعتبرة عند الفقهاء.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَاللِّعَانُ أَنْ يَقُوْلَ بِحَضْرَةِ اْلحَاكِمِ أَوْ نَائِبِهِ، أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّيْ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ، فِيْمَا رَمَيْتُ بِهِ امْرَأَتِيْ هَذِهِ مِنَ الزِّنَى، وَيُشِيْرُ إِلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً سَمَّاهَا وَنَسَبَهَا، ثُمَّ يُوْقَفُ عِنْدَ اْلخَامِسَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: اتَّقِ اللهَ فَإِنَّهَا اْلمُوْجِبَةُ، وَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ اْلآخِرَةِ، فَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ فَلْيَقُلْ: وَإِنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ اْلكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُ بِهِ امْرَأَتِيْ هَذِهِ مِنَ الزِّنَى)}.
قوله: (وَاللِّعَانُ أَنْ يَقُوْلَ بِحَضْرَةِ اْلحَاكِمِ أَوْ نَائِبِهِ)، هذه صفة اللعان وصيغته.
فشرطه: أن يكون قذف الرجل امرأته، وأن يكون القذف بالزنا، وألا يُحد حد القذف.
فإذا دُعيَ إلى اللعان وكان بحضرة الحاكم أو نائبة، حضرة الحاكم هو القاضي، أو بحضرة مُحكِّمٌ؛ لأنه سيأتينا أن المُحكِّم يقوم مقام القاضي، فإذا لم يوجد في بعض البلدان حاكم وتداعيا إلى القذف واللعان فقالوا نُحكِّمُ فلانًا فإنَّه يكون بمثابة الحاكم، فله أن يُمضي هذه الأحكام إذا كان عارفًا بها وقادرًا على العلم بتفاصيلها وإمضائها على ما أمر الله -جلَّ وَعَلَا- به وأمر به رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال: (وَاللِّعَانُ أَنْ يَقُوْلَ بِحَضْرَةِ اْلحَاكِمِ أَوْ نَائِبِهِ: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّيْ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ، فِيْمَا رَمَيْتُ بِهِ امْرَأَتِيْ هَذِهِ مِنَ الزِّنَى)، فلابدَّ من الإشارة إليها؛ لأنه قد يكون له أكثر من امرأة، فحتى ينتفي الاشتباه، وهذا من المواطن العظيمة التي لا يُقبَل فيها التَّلكؤ أو التَّردُّد أو يُحمل على أكثر من وجه؛ فلابدَّ من القطع، وليس قطعٌ أعظمَ من التَّعيين، وأعلى درجات التَّعين هي الإشارة ثم التَّسمية.
قوله: (وَيُشِيْرُ إِلَيْهَا)، فإذا أشار إليها فيكفي ذلك.
قال: (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً سَمَّاهَا وَنَسَبَهَا)، كيف لا تكون حاضرة؟!
يقولون: في اللعان لابدَّ أن يكون في حالٍ معظمة في مكان وزمان، كأن يكون بين الأذان والإقامة، أو بعد العصر، أو يكون في المسجد، فلو كانت المرأة حائضًا فإنَّه في مثل هذه الحال يكون الرجل في المسجد وهي ليست في المسجد فلا تكون حاضرة، فيقول: امرأتي فلانة بنت فلان الفلاني...، وهكذا.
قال: (ثُمَّ يُوْقَفُ عِنْدَ اْلخَامِسَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: اتَّقِ اللهَ فَإِنَّهَا اْلمُوْجِبَةُ).
هذا من الوعظ، ووعظ المتلاعنين سنَّة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما ذكرنا قبل قليل في حديث هلال؛ ولأن مثل هذا الأمر -وهو شهادة الإنسان على غيره بالزنا الذي هو من الموبقات- ودعاء الإنسان على نفسه باللَّعن والطَّرد عن رحمة الله من أعظم ما يكون، فلما كان الأمر بهذه المثابة، وما يلحق الإنسان في التَّلكؤ أو التَّراجع من العار وحد القذف وما يلحقه من نقيصة الناس وكلامهم؛ فاحتيج في هذا إلى وعظِه وأن يُذكَّر، فحتى ولو لحقك ما لحقك من البلاء فلعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فما يلحقك من قذف أو نقيصة الناس أو ما يلحقك من بعض العار أهون من أن تمضي اللعان وأنت تعلم كذب نفسك وجرمك على زوجك، وفعلك الفعل المشين برميها بهذا الأمر العظيم، ولأجل هذا قال: (فَإِنَّهَا اْلمُوْجِبَةُ)، وهذا يدل على أنَّ اللعان من الأمور العظائم، وهو موجب للعذاب والنكال الشديد عند الله -جلَّ وَعَلَا.
قال: (وَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ اْلآخِرَةِ، فَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ فَلْيَقُلْ: وَإِنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ اْلكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُ بِهِ امْرَأَتِيْ هَذِهِ مِنَ الزِّنَى)، فهذه هي الخامسة التي هي تمام لعانه، وكمال قوله ولفظه على ما جاء في الآية ï´؟وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَï´¾ [النور: 7]، نعوذ بالله -جلَّ وَعَلَا- من ذلك.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَيَدْرَأُ عَنْهَا اْلعَذَابَ: أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَانِيْ بِهِ مِنَ الزِّناَ، ثُمَّ تُوْقَفُ عِنْدَ اْلخَامِسَةِ وَتُخَوَّفُ، كَمَا خُوِّفَ الرَّجُلُ، فَإِنْ أَبَتْ إِلاَّ أَنْ تُتِمَّ، فَلْتَقُلْ: وَإِنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِيْ بِهِ زَوْجِيْ هَذَا مِنَ الزِّناَ)}.
قوله: (وَيَدْرَأُ عَنْهَا اْلعَذَابَ)، يعني: إذا لاعن الزَّوج فقد أدَّى ما عليه، ففي هذه الحال يندفع عنه الحد، أو التَّعزير -إن كان الواجب عليه التعزير- لكون زوجته ذمِّيَّة أو أَمَة أو نحو ذلك، فبمجرد أن يُلاعن فإنه يرتفع عنه العذاب في أصح القولين عن أهل العلم.
ثم تؤمر المرأة باللعان، ولا يخلو:
- إمَّا أن تُقر: فإذا أقرَّت فإن عليها عقوبة الزنا -نسأل الله العافية- ويلحقها ما يلحق حد الزنا من الأحكام والأحوال، بحسب حالها وبحسب دخول زوجها بها ونحو ذلك، وهذا له تفاصيل ستأتي.
- أن تُقدم على اللعان: وسيأتي تفاصيل كلام الفقهاء في الألفاظ التي يقول على نحو ما ذكر المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.
- أما لو تلكَّأت: فلا هي التي أقدمت ولا هي التي اعترفت؛ فيقول أهل العلم: إن تلكُّؤها يدل على أنها يُمكن أنها فعلت، ولكن هذا ليس مقطوع به، وبناء على ذلك لا يكون تلكُّؤها ووقوفها بموجبٍ للحد عليها.
ويقول أهل العلم: يجب في مثل هذه الحال أن تُحبَس وتُعزَّر حتى تقر بالزنا أو تُمضي الملاعنة.
لماذا لا يُقال عليها الحد بمجرد تلكُّؤها؟
يقولون: لأنَّ من المتقرر عند أهل العلم أنَّ المرأة لو أقرَّت فقالت: "زنيتُ" ثم رجعت عن إقرارها فإنَّها لا تُحدُّ حدَّ الزنا؛ لأنَّ الحدود تُدرأ بالشُّبهات، فلما كان حال المقر إذا رجع أن يؤخَذ بذلك ويُدفَع عنه الحد، فمن باب أولى ألا يؤاخذ المتلكِّئ السَّاكت بذلك، ولما كان الأمر هنا لا يحتمل أمرًا ثالثًا؛ فلا يُمكن أن نطْلِقَها، فنحبسها قد تقر أو تلاعن حتى ينفَّذ فيها الحكم الذي يلائهما ويليق بها.
يقول المؤلف: (وَيَدْرَأُ عَنْهَا اْلعَذَابَ) وهو الحد، أو التعزير إذا كان لا يجب عليها حد في هذه الحال.
والحدُّ إمَّا أن يكون بالجلد أو الرَّجم، فيجب عليها الجلد إذا كانت زوجة غير مدخول بها، وبناء على ذلك لا تكون ممن أحصنت فجومِعَ مثلها، لأنَّها لابدَّ أن تكون ممن يُجامع مثلها حتى يجب عليها الرجم.
قوله: (أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ)، تقول: أشهد بالله أنَّ زوجي فلان من الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم تُوقَف عند الخامسة فتُذكَّر بالله وتُوعَظ وتُخوَّف؛ لأنَّ ما يلحقها من العار لو اعترفت أخف مما يلحقها من عذاب الآخرة، ولعظم ما فعلت من إفساد الزوجية.
فيقول المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَتُخَوَّفُ، كَمَا خُوِّفَ الرَّجُلُ) على ما جاء في الحديث الذي تقدَّم معنا.
قال: (فَإِنْ أَبَتْ إِلاَّ أَنْ تُتِمَّ)، أي: تُتم الخامسة، واللفظ الخامس لفظ مختصٌّ كما نصَّت على ذلك الآية، وكما جاء بذلك قول الله -جلَّ وَعَلَا: ï´؟وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَï´¾ [النور: 9]، فتقول: أشهد بالله أنَّه كاذبٌ فيما رماني به، وأنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
والفقهاء يجعلون الضمير في قوله: "عليها" للغائب؛ لأنَّه لا يحسب بالإنسان حتى ولو كان على سبيل الحكاية أن ينسب إلى نفسه أمرًا مشينًا، فالأصل أن تكون: "أنَّ الغضب عليَّ" بياء المتكلِّم، وهذا لا يحسن ولا يليق بالإنسان حتى ولو كان على سبيل الحكاية، وذلك جرت عادتهم أن يجعلونه على ضمير الغائب، ولكن أحيانًا يعسُرُ فهمه على بعض الناس ممن هو جديد في العلم والتَّعلُّم، فما تستقيم عنده العبارات، فيحتاج إلى توضيح ذلك، وإلَّا فهذا هو الأصل.
وكما أنَّه لا يحسُن أن ينسب الإنسان الأمر المشين إلى المخاطب، فتقول: لو أنَّكَ ضربتَ فلانًا أو قتلته! هذا ليس بجيد، أما لو كان أمرًا جيدًا كأن تقول: لو تصدَّقتَ بكذا وكذا لكتب لك كذا...، أما لو جئت في الأمر المشين تقول: لو أنَّ فلانًا سبَّ، أو لو أنَّ رجلًا قتل؛ فتجعله في أمرٍ مجهولٍ، لأنه لا يحسن نسبة الشر إلى متكلم ولا مخاطب، وهذا من رفيع اللفظ وجميل الأخلاق وطيِّبِ الأقوال.
قال المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (ثُمَّ يَقُوْلُ اْلحَاكِمُ: قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا، فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ تَحْرِيْمًا مُؤَبَّدًا)}.
إذا تلاعن الزَّوجان فلا نكاح بينهما، ولذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما أتمَّ اللعان: «لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا».
هل يحتاج في ذلك إلى حكم حاكمٍ أم هو بمجرد حصول اللعان؟
كأنَّ المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لما قال: (ثُمَّ يَقُوْلُ اْلحَاكِمُ: قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا) أنَّه لابدَّ من حكمه، والظاهر في هذا أنَّه قصد الخروج من خلاف مَن يقول أنَّه لابدَّ من الحكم، وإن كان الأصل أنَّ اللعان بمجرد حصوله تحصل بينهما الفُرقة الأبديَّة، فقد قضى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في المتلاعنين ألا يجتمعان أبدًا، ومع ذلك يقوله الحاكم حتى يزيد الأمر قطعًا، وحتى يُخرَج من خلاف مَن يقول أنَّه لابدَّ أن يُفرِّق بينهما الحاكم، فلأجل ذلك قال المؤلف: (قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَكُمَا) لزيادة التأكيد ونفي الخلاف لمن خالف في ذلك وقال لابدَّ من تفريق الحاكم.
قال: (فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ تَحْرِيْمًا مُؤَبَّدًا)، يعني لا يُمكن أن يتزوَّجها بعدَ ذلك لا بعقدٍ جديد، ولو تزوَّجت زوجًا أو زوجين أو ثلاثة أو مائة؛ حتى قال بعض أهل العلم: حتى لو أكذبَ نفسه، فلو جاء بعدما تلاعنا وقال أنا كنتُ كاذب عليها؛ فإنَّه لا سبيل له عليها.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَنَفَاهُ انْتَفَى عَنْهُ، سَوَاءٌ كَانَ حَمْلاً أَوْ مَوْلُوْدًا مَا لَمْ يَكُنْ أَقَر َّبِهِ، أَوْ وَجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلى اْلإِقْرَارِ بِهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ اْلوَلَدَ بِاْلأُمِّ)}.
قول المؤلف: (وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَنَفَاهُ انْتَفَى عَنْهُ)، هذا ممَّا يترتب على اللعان وأثره، وهو إذا تلاعَن الزَّوجان فلا يخلو:
إمَّا أن يكون فيها حمل من أثر الزَّنا -المُدَّعى به- فهل يلحقها انتفاء الولد بمجرد اللعان أو لا؟
يقول الفقهاء في المشهور عنهم: إنَّه لابدَّ أن ينفيه حتى ولو كانت حاملًا، فإذ لم ينفِه فالأصل بقاء النَّسب، والشَّرعُ متلهِّفٌ إلى حفظ أنساب الناس وعدم الاستعجال في نفيها، فإذا رأى أنَّ هذا الولد قد نشأ من غير مائه ودخل عليه من ماء هذه الفعلة الشَّنيعة التي حصل بزناها من ذلك الرَّجل الأجنبي؛ فينتفي من الولد، أمَّا إذا لم ينتفِ فإنَّه لا يُعتبَر ذلك، ولذا قال المؤلف: (وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَنَفَاهُ انْتَفَى عَنْهُ)، فيُفهَم منه أنَّه إذا لم ينفِه فإنَّه يبقى الولد على ما هو عليه.
وقوله (وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ)، دلَّ على أنَّه لو كان بينهما حملٌ ولو نفاه فإنَّه لا يكفي حتى يُولَد ثم ينفيه، لأنَّه لمَّا كانَ حملًا يُمكن أن يكون حملًا صحيحًا ويُمكن ألَّا يكون، فما الحاجة إلى أن ينفيه في تلك الحال، ويقع النَّفي على شيءٍ غير واضح، وبناء على ذلك قالوا أنَّ النَّفي يكون بعدَ الولادة.
وهذا محل خلاف شديد بين الحنابلة أنفسهم وبين الفقهاء على سبيل الإطلاق، فقال من قال من أهل العلم -وله اعتبار: أنَّه إذا تُيُقِّنَ الحمل خاصَّة في مثل هذه الأزمنة التي تُعرَف بالفحوصات المستجدَّة والحديثة التي يُقطَع معها بوجود الحمل؛ فيُمكن نفي الولد؛ لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا لاعنَ هلال وزوجته فإنَّه نُفيَ عنه ولدها، ولم يُذكر أنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمر بملاعنتهما مرة ثانية بعد الولادة؛ فدلَّ على أنَّ اللعان الأول ما دام أنه قد اشتمل اللفظ على انتفاء الولد كافٍ في ذلك، وهذا محتملٌ، ولكن لابدَّ من التَّصريح وأن يقول: هذا ليس بولدي، أو أن يكون ذلك ضمنًا كأن يقول: وما في بطنها ليس ولدي أو نحوه.
المهم أنهم يقولون أنَّ نفي الولد لابدَّ أن يكون بالتَّصريح أو ضمنًا.
قوله: (وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ سَوَاءٌ كَانَ حَمْلاً أَوْ مَوْلُوْدًا)، المؤلف هنا ذهب إلى القول الآخر، وأنَّ الاكتفاء بالانتفاء يكون مطلقًا حتى للحمل، خلافًا لمشهور المذهب وقول بعض الفقهاء من أنَّه لابدَّ أن يُولَد حتى يُنتفَى منه.
هنا ذكر قيدًا وشرطًا مهمًّا للانتفاء، فقال: (مَا لَمْ يَكُنْ أَقَر َّبِهِ، أَوْ وَجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلى اْلإِقْرَارِ بِهِ)، يعني ما يُمكن أن يأتي الإنسان إلى ولده وقد كتب اسمه أنَّه فلان بن فلان الفلاني، ثم يقول هذا ليس بولدي!
فبمجرد أن تحمل فيعرف أن هذا الحمل نشأ من زنا فيقول: هذا بولدي. أو إذا وُلِدَ له فبارك الناس له؛ فنقول له: قل ولا تسكت، ولذلك قيل: إذا هنَّأه الناس فسكت فهذا إقرار على أنَّه ولده، فلا يجوز له أن ينفيه.
إذن؛ لابدَّ ألَّا يسبق نفي الولد إقرار به، سواء كان إقرارًا صحيحًا أو إقرارًا ضمنيًّا، أمَّا إذا حصل منه إقرار فليس له أن ينفيه بعدَ ذلك.
واستثنى بعض أهل العلم من ذلك ما لو كان عامِّيًّا ولا يدري أنَّ له انتفاؤه للولد؛ فقد يُقبل منه في تلك الحال، وهذا له وجه، فقد يُقبل منه في الحال الذي يُقطَع فيه أنَّ هذا الشَّخص لا يدري أنَّ له الانتفاء من الولد، كما لو كان من الجُهَّال أو ممَّن نشأ في القُرَى بعيدًا عن أماكن العلم والتَّعلُّم، وهذا ممكنٌ ومحتملٌ لِمَا ذكرناه.
قوله: (فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ اْلوَلَدَ بِاْلأُمِّ)، فيُقال: هذا فلان بن فلانة، وذكر بعض العلم أنَّه لا يجوز بعدَ ذلك أن يُقذف الولد فيُقال له أنت ابن زنا، فهو إنَّما انتفى نسبه لوالده بسبب اللعان لا بسبب قطعنا أنَّها زانية وأنَّها فاعلة للمحرم، ولا يجوز أن يُقال للمرأة هذه زانية، فانتفاء الولد ونسبته إلى أمِّه لا يعني ذلك صحَّة القذف وأنَّه ابن زنا ونحو ذلك؛ بل لا يجوز أن يُفعل هذا، ومَن قذف هذا الولد أو قذف أمَّه فإنَّه يؤاخذ بذلك ويكون عليه العقاب، ويؤخذ بذلك عند القاضي ويُحاسَب عليه.
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (فَصْلٌ فِيْ لُحُوْقِ النَّسَبِ
وَمَنْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ الَّتِيْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا وَلَدًا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ، لَحِقَهُ نَسَبُهُ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اْلوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ اْلحَجَرُ»)}.
هذا الفصل في لِحَاق النَّسب، فالأصل أنَّ مَن تزوَّج امرأةً وأمكن لقاؤه بها ودخوله عليها؛ فإنَّ الولد ولده، ولذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اْلوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ اْلحَجَرُ».
وبناء على ذلك؛ لو زنا رجل بامرأة، وقال هذا الولد ولدي -وهو عاهر وهي لها زوج- فلا يُمكن أن نقول إنَّ هذا الولد الذي في بطنها هو ولد هذا العاهر، حتى ولو أقام مائة دليلٍ على أنَّه نشأ من زناه أو حصل من فعلته المشينة؛ لأنَّ الولد للفراش، والفراش هو فراش الزَّوجيَّة، وكل ما يتعلق بالزَّوجيَّة يُنسَب إلى زوجها الذي دخل بها أو عقدَ عليها.
ومَبنى الأحكام في هذا الباب عند الفقهاء على الأمور الظَّاهرة؛ لأنَّ الحكم بأنَّ هذا الذي واقعها أمرٌ لا يُتصوَّر، فنرجع إلى الأصل أنَّها زوجة فلان والأصل أنَّ المرأة تنام مع زوجها، فلما كان هذا هو الظَّاهر كان المصير إلى الحكم به، وهذا هو أصل قول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اْلوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ اْلحَجَرُ»؛ لأنَّ أمور الجماع والمعاشرة وما ينتج عنها أمور خفيَّة، حتى لو افترضنا أنَّ هذا جامع وهذا جامع؛ فأيُّهما الذي نشأ منه الحمل؟! لا ندري! وبناء على ذلك فإنَّنا لا نعطي هذه الأشياء المتوهَّمة اعتبارًا؛ بل الاعتبار بالأصل وهو أنَّ الولد للفراش.
ولو علم الزَّوج أنَّه ليس ولد له فقذف المرأة فنعود إلى أصل اللعان، ولكن من حيث الأصل فلا يُمكن لأحدٍ أن يدخل على امرأةٍ ويقول: هذا ولدي ويُنازع أبًا في ابنه، وإلا لأفضى ذلك إلى ضياعٍ وإفسادٍ لبيوتات النَّاس وتشكيكهم في ولدهم، فالولد للفراش والزَّوجيَّة قاضية، والحكم بهذا هو حكم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال: (وَمَنْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ الَّتِيْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا وَلَدًا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ)
معنى قوله: (يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ)، يعني: أن يكون مثله ممن يطأ عادةً، والذي يطأ عادة عند الفقهاء هو ابن عشر سنين، فقالوا هنا ما قالوه في المسألة السابقة، فلم يقولوا هو البالغ؛ لأن البلوغ يحصل بأشياء خفيَّة أحيانًا مثل: الاحتلام، فلا ندري هل احتلم أو لا، حتى ولو وجدنا ماءً مثلًا فلا ندري.
وبناء على ذلك قالوا: إن الغالب أنَّ ابن عشر سنين يُمكن أن يبلغ، فلمَّا كان هذا مقطوع به فإذا ادَّعاه فإنَّه يُمكن أن يكون منه ويُمكن أن يُصدَّق؛ لأنَّ ابن عشر سنين يُمكن أن يطأ وأن يُنزل، وبناء على ذلك نحكم بأنَّ ابن عشر سنين يلحق به الولد، ويُفهم منه أنَّه لو كان دون عشر سنين فإنَّه لا يُمكن أن يُقبَل منه ادِّعاء الولد، لأنَّ مثله عادة لا ينزل لو وطأ، فهو يُمكن أن يطأ ويُنعِظ لكنه لا يُمكن أن يُنزِل، وبناء على ذلك يقول الفقهاء (يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ لَحِقَهُ نَسَبُهُ)، يعني سواء في الزَّوجة التي تزوجها أو الأمة التي وطئها، لقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اْلوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ اْلحَجَرُ».
{قال -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَلاَ يَنْتَفِيْ وَلَدُ الْمَرْأَةِ إِلاَّ بِاللِّعَانِ، وَلاَ وَلَدُ اْلأَمَةِ إِلاَّ بِدَعْوَى اسْتِبْرَائِهَا)}.
لا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، فما دام أنَّ هذا الولد ولدُ فراشٍ فلا يُمكن أن يأتي إنسان ويقول: هذا ليس بولدي، وأنا أتبرَّأ منه، وأنت ولد فاسد، أو أنَّ أمك كذا وكذا..!
نقول: هذا لا يُقبَل، وحتى لو اشتهر إنسان بينَ أهل قريته أو بلده أو في الدنيا كلها أو أعلن ذلك في الجرائد وقال هذا ليس بولدي؛ فلا يعتبر ذلك، والأبوَّة باقية، والأحكامُ مستمرَّة من لزوم النَّفقة والتَّوارث، ووجوب البرِّ على الولد، حتى لو كان أبوه سيئًا مفسدًا ينفيه عن نفسه ويُلحق به الأوصاف السَّيئة، فلا يمنع ذلك من أنَّ الولد يُحسن إلى أبيه.
متى نقول إنَّ هذا ليس ولد فلان وقد وُلد على فراشه؟
في حال واحدة: إذا حصل اللعان بشروطه المعتبرة، فيكون قد قذف الزَّوجة في القبل أو الدُّبر، وتمَّ اللعان بينهما وحصل التَّفريق بينهما وكان فيه انتفاء للولد.
قال: (وَلاَ وَلَدُ اْلأَمَةِ إِلاَّ بِدَعْوَى اسْتِبْرَائِهَا)، لابدَّ من استبراء الأمة، وبناء على ذلك لو أن شخصًا كانت عنده أمة فقال: أنا لم أبعها حتى حاضت عندي حيضة، وإذا حاضت المرأة عُلمت بأنها ليست بحامل، ولذلك النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» .
وهذا في الإماء ليُعلم براءة رحمها وأنه لا حمل لها، فإذا قال: أنا استبرأتها، ثم جاءت وقالت: لا، هذا الحمل من فلان! فإذا ادَّعى الاستبراء فيُقبل ذلك منه إذا تمَّ عند الحاكم وقضى به بالبيِّنة أو يمينه على ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله تعالى.
أظن أنَّ الوقت انتهى، لعلنا نقف ونكمل -بإذن الله جل وعلا- ما يتعلق بباقي هذا الباب في لقاء قادم.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسَّداد، وجزاك الله خيرًا وجزى الله القائمين على هذه المؤسسة وهذا البناء العلمي خير الجزاء، وجعلهم موفَّقين في أحسن حال، وأن يزيدهم الله من الهدى والتَّوفيق والإعانة والتَّسديد، وأن يتمَّ عملهم، وأن يُجريَ أجرهم، وأن يُبقيَ بناءهم بناءً قويًّا سديدًا، وأن ينفع بهم العباد والبلاد، وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد.
{وفي الختام نشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
هذه تحيَّةٌ عطرةٌ من فريق البرنامج ومنِّي أنا محدثكم عبد الله بن أحمد العمر، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته}


![]() ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .