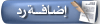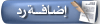الهواتف
لم أدرِ ما أقوله له، وأشحتُ بوجهي بعيدًا، فوقعت عيناي على طاولةٍ قريبةٍ، فوقها سبعة هواتف ذكية، جميعها متشابهة الحجم والشكل، أو هكذا بدت لي. فسألته بنفاد صبر: ـ وما فائدة اقتناء سبعة هواتف متشابهة؟ أجاب بهدوءٍ رتيب، كأنّه يلقي درسًا حفظه عن ظهر قلب: ـ هي ليست متشابهة. الأول له نظام تشغيل مختلف، والثاني مخصص للعمل، والثالث للقراءة، والرابع للتواصل الاجتماعي، والخامس لحساباتي البنكية، والسادس مُبرمج لتتبّع صحتي، والسابع احتياطي للطوارئ. لكلٍّ منها دوره، ولكلٍّ إشعاراته ونغماته الخاصة.
قلتُ له، كأنني ألمّح إلى هوسه بالتقنية: ـ كنتُ أظنّ أنّ أجدادنا لم يكونوا مهتمين بالوقت كما نحن اليوم، فلم يكن لديهم هذه الأجهزة التي تنبّههم كل لحظة. نظر إليّ باستغرابٍ وقال: على العكس، كانوا دقيقين في تحديد الوقت رغم غياب التكنولوجيا. حتى إنهم خصصوا أسماء لكلّ ساعة من النهار والليل، فمثلاً ساعات النهار هي: الذرور، البزوغ، الضحى، الغزالة، الهاجرة، الزوال، الدلوك، العصر، الأصيل، الصبوب، الحُدُور، والغروب. سرد تلك الأسماء بطلاقةٍ أثارت إعجابي. على مدار الأيام، لاحظتُ أن حياته تُسيّرها نغمات هواتفه. إشعارٌ يوقظه لصلاة الفجر، آخر يذكّره بموعد الاستحمام، وثالثٌ يُخبره أن وقت الإفطار قد حان، ورابعٌ يعلن لحظة الخروج من المنزل، وخامسٌ يرشده إلى موعد المحاضرة، وسادسٌ ينبّهه لانتهائها. كانت حياته سلسلةً من التنبيهات المتوالية، وكأنّه تخلّى عن إرادته لصالح أجهزته. مع مرور الوقت، توثّقت صداقتنا، وأصبحت أقرب الناس إليه. لم يُدهشني كونه يعيش وحيدًا، فلا امرأة يمكنها احتمال حياةٍ تحكمها أصوات الإشعارات المتواصلة. أمّا خادمه العجوز، فقد اكتشفتُ أنّه أصمّ، وربما كان ذلك سرّ تحمّله لهذه الحياة الرتيبة.
وذات يوم، مرض صديقي. كنتُ أزوره باستمرار، فأدهشني صمت هواتفه، كأنّها توقفت احترامًا لحالته. طال مرضه، وبقيت أجهزته خامدةً بلا أصوات. وفي صباح يومٍ حزين، هاتفني خادمه العجوز، طالبًا حضوري فورًا. أسرعتُ إلى منزله، ودخلتُ غرفته. كان مسجًى على سريره، بلا حراك. فارق الحياة. وفجأة، بدأت جميع هواتفه ترنّ في الوقت ذاته، بإشعارات متواصلة، كما لو كانت تنعاه بطريقتها الخاصة.


![]() ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .