

|
|
|||||||
| الجلفة للمواضيع العامّة لجميع المواضيع التي ليس لها قسم مخصص في المنتدى |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
![]() ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
’’ السعودية ’’ إسقاط الجهاد واغتصاب المقاومة .... د. أكرم حجازي
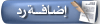 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
’’السعودية ’’
|
||||

|
|
|
رقم المشاركة : 2 | |||
|
شكرا اخي على الموضوع الجيد ولكن اخي ابشر فقد قال رسول الله لا تزال طائفة من امتي على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله ، وقد اسقطت المقاومة في غزة كل حساباتهم .والله يفعل ما يريد. |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
و الله موقف غريب |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 4 | |||
|
..جزاك الله عنا كل خير أخي في الله السيف ..فكل يوم يمرّ علينا ، تزداد فيه الأمور وضوحا ..ولكن وهن القلوب ..نسأل الله أن يحيي الجهاد في أمّة نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم ..ويخزي الكافرين والمنافقين ..ويردّهم بغيضهم لا ينالوا شيئا . |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 5 | |||
|
السلام عليك و رحمة الله وبركاته |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 6 | |||
|
لاننتظر من من بدّل شريعة الله خيرا أخي الكريم جيرو..فالله مولانا ولا نطيع غيره..والقرآن بين أيدينا حجّة علينا ..تعلّم كتاب الله ولاتتبع أهواء حكام الدول العربية ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 7 | |||
|
"هم يريدون و نحن نريد و الله يفعل ما يريد" فلسطين ستظل مرابطة إلى يوم الدين. و مهما فعل أو قيل ستظل المقاومة صامدة ضد المحتل الغاشم الذي لم يرحم أحدا لا يشر و لا حيوانات ولا حتى الشجر .
جزاك الله كل خير أخي asif على الموضوع |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
اقتباس:
لكنني لا اتبع اهواء الحكام ...انما هي وجهة نظري و التي ارى انها وجهة نظر موضوعية.وفقا لمعطيات الموجودة ولا الزم بها غيري - وليكون النقاش في اطار واضح فانا ارى ان المقاومة او الجهاد في فلسطين حق شرعي من الواجب ان يدعمه جميع المسلمين........وهذا تقديري لامور وليس فتو ى......... وخلافنا حول هل الدول العربية في ظل الرهانات الحالية تستطيع مواجهة الكيان الصهيوني .هذه النقطة التي أثرتها وقلت ان المواجهة تحتاج الى عدة وكتاب الله يأمرنا بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد مناول يوم لبعثته ........بل بعد خمسة عشرة سنة والجهاد مسالة من المسائل الشرعية فلنتركها لاهلها .....فالفتوى توقيع عن رب العالمين . ومن نكون نحن حتى نوقع عن رب الارباب |
||||

|
|
|
رقم المشاركة : 9 | |||
|
يا أخي السعودية عميلة للكيان الصهيوني وأمريكا منذ زمن لكن ليس هنا المشكلة ولكن المشكلة |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 10 | |||
|
لا يهمني راي السعودية و لا اي شيء و انا عندما اصلي لا اتوجه لملك السعودية او لاهل السعودية و انما اتوجه للكعبة و السعودي كغيره هم ليسو اوصياء على الدين انا عندما اريد المشورة اقرا كتاب الله و سنة رسوله و لا اقرا يوميات ملك السعودية ثم من قال لكم ان كل اهل السعودية سيدخلون الجنة |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
اقتباس:
انما تعودنا على مثل هذه الحجج منذ صار الجهاد بعد سقوط الاتحاد السوفييتي حرام .. فكل مرة يتم فيها دحض حجة الا سمعنا بعدها بسنين حجّةأخرى .. وكلها تعطل أمر الله البيّن ..ولا حول ولا قوة الا بالله .. فالباع طويل بيننا ..والسجال بدأ منذ بدأت الولايات الأمريكية تريد السيطرة على بلدنا المسلم أفغانستان ..وتلاحق المجاهدين الأحرار.. المدافعين على أرضهم ودينهم وعرضهم .. والحجة الأخيرة سمعتها منذ مدة ...وكانت مفاجئة لي فهي لم تستند كما في عادة الحجج السابقة الى اقتطاف بعض الأحاديث والآيات الموافقة ..بل اعتمدت على آية واحدة تقول ولاتلقوا بأيدييكم الى التهلكة ..وبعد دحض هذه الآية على أساس أنها نزلت في الأنصار عندما فكروا في ادخار أموالهم بسبب كثرة المتطوعين للجهاد حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سحبوا هذا الدليل واكتفوا بتصوير أننا في بداية الرسالة المحمدية أي في زمن وء د البنت وامتلاء الكعبة بالأصنام وقبائل المشركين تطبل وتزمر حول الكعبة ولا حول ولا قوة الا بالله .. ياأخي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا قبل وفاته أن نتمسك بكتاب الله وسنة نبيه وسنة الخلفاء الراشدين ولم يزد .. كما أوصانا باخراج المشركين من جزيرة العرب .. وأحاديث الطائفة المنصورة المقاتلة كثيرة والحمد لله ..وصفات الفرقة الناجية موجودة في المجاهدين والحمدلله ، فلا أشبه حالهم من حال رسول الله وأصحابه الذين عفوا عن زخرف الحياة وظلّوا يجاهدون حتى الرمق الأخير .. وقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه .. حين سمع الناس يقولون.. انتهى الجهاد ..قام محتنقا وقال الآن بدأ الجهاد .. وفي حديث آخر قال ( بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده .) والدعوة الى دين التوحيد لن تنجح بدون سيف ، لأن السيف يخبت الأهواء ..ويزلزل عروش الطواغيت التي تمنع شريعة الله .. لذلك على الجماعة المسلمة دائما أن تجتهد لكمال نصابها ..من العدد والعدة ..وليس الاسترخاء وتحميل العجز لما يحيطنا من ضروف عالمية .. واعتبروا من حرب غزة التي أثبتت بطلان موازين القوة ..وأثبت الله للجميع أنه ينصر من ينصره ويثبت قدمه .. أما سبب ذلتنا فأخبرنا عنها رسول الله انه الوهن ..يعني حب الدنيا وكراهية الموت ..وهذا ما جعلنا نترك الجهاد ..وهذا ما جعل الذلّ مسلّط علينا . ان اجتماعنا في هذا المنتدى الطيّب انما هو بأمر الله حتى يتخذ منا شهداء . اللهم فاني بلّغت . |
||||

|
|
|
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
اقتباس:
اخي الحبيب ماجد ليست السعودية وحدها العميلة لامريكان واليهود وانما جميع حكام دوال المسمات بالاسلامية بارك الله فيك وفي جميع الاخواة اللدين تفاعلوا مع هدا الموضوع |
||||

|
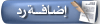 |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc