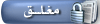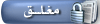1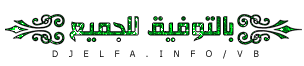 أما التصوف، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فالأصل فيه هو هذا الزهد الذي عرفه المسلمون من صنيع رسول الله ، والذي لم يزل ديدن أصحابه وتابعيهم من الصدر الأول من القرون الخيّرة حتى لكأنه شعار لهم جميعاً، ولم يتكلم أحد عن التصوف إلا رد أصله إلى هذا الزهد المعروف من الإسلام الذي هو سلوك حسنٌ، وذوقٌ طيبٌ، ومذهب حميد يتخلص به الإنسان من حب الدنيا، ومن الرغبات في جمع خيراتها، ومن محبّه ما لا يستطيع أن ينفقه أو يستمتع به: من المال، والجاه، وما إليه. لذلك قال ابن خلدون فيمن يميلون إلى هذا، قال: إنهم جماهير الناس، أما الصفوة فهم الذين يتخذون الزهد سبيلا، وترك الدنيا شعاراً، والإعراض عن ملذاتها منهجاً وطريقاً، يصلون به إلى الله تبارك وتعالى: ولو بقي الأمر عند هذا الزهد ووقف فيه عند ذلك الحد لهان الخطب في التعرف على حقيقته وإدراك آثاره في دنيا الناس لكنه (أعني التصوف) شأن كل معنى من المعاني، التي تعامل معها الناس أخذاً وعطاءً، تطور ليسري في جسد الأمة كله من أوله إلى آخره، ينحاز إليه ويعرفون به، فأنت ترى الرجل صوفياً سنياً من أهل أي مذهب كان من المذاهب الأربعة، بل لعلك لا تجد عالماً يعتد به في هذا المذاهب المتبوعة اليوم إلا وله في التصوف نسب بل إن الذين ترجموا لعلماء الصوفية وفقائهم وسادتهم وقادتهم بدؤوا تراجمهم بسيرة رسول الله ثم ثنوا بالخلفاء الأربعة ثم أوردوا عشرات الصحابة بل أكثر من العشرات كما فعل ابن مالك في (الكواكب الدرية) وقالوا: إن هؤلاء كانوا جميعاً على مذهب أهل التصوف أو هم الذين أسسوا له وشادوا بناءه أولاً ورد عليهم من رد وردوا هم على من رد عليهم لكن العبرة ليست في ذلك، وأعلامهم إلى مذهبهم، وليس أحد من هؤلاء إلا وفيه قدر من الزهد، وليس أحد من هؤلاء إلا وفيه قدر كبير من كراهة الدنيا وتفضيل الآخرة عليها، وليس أحد من هؤلاء إلا وأعطى من ماله ومن جاهه ومن علمه ومن عمله ما يقوم به أمر الإسلام، بحيث يكون عطاؤه أكثر من أخذه على عكس الكثيرين ممن نعيش بين ظهرانيهم الآن الذين يحبّون الأخذ ويفضلونه على العطاء وربما لا يعطون أبداً.
أما التصوف، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فالأصل فيه هو هذا الزهد الذي عرفه المسلمون من صنيع رسول الله ، والذي لم يزل ديدن أصحابه وتابعيهم من الصدر الأول من القرون الخيّرة حتى لكأنه شعار لهم جميعاً، ولم يتكلم أحد عن التصوف إلا رد أصله إلى هذا الزهد المعروف من الإسلام الذي هو سلوك حسنٌ، وذوقٌ طيبٌ، ومذهب حميد يتخلص به الإنسان من حب الدنيا، ومن الرغبات في جمع خيراتها، ومن محبّه ما لا يستطيع أن ينفقه أو يستمتع به: من المال، والجاه، وما إليه. لذلك قال ابن خلدون فيمن يميلون إلى هذا، قال: إنهم جماهير الناس، أما الصفوة فهم الذين يتخذون الزهد سبيلا، وترك الدنيا شعاراً، والإعراض عن ملذاتها منهجاً وطريقاً، يصلون به إلى الله تبارك وتعالى: ولو بقي الأمر عند هذا الزهد ووقف فيه عند ذلك الحد لهان الخطب في التعرف على حقيقته وإدراك آثاره في دنيا الناس لكنه (أعني التصوف) شأن كل معنى من المعاني، التي تعامل معها الناس أخذاً وعطاءً، تطور ليسري في جسد الأمة كله من أوله إلى آخره، ينحاز إليه ويعرفون به، فأنت ترى الرجل صوفياً سنياً من أهل أي مذهب كان من المذاهب الأربعة، بل لعلك لا تجد عالماً يعتد به في هذا المذاهب المتبوعة اليوم إلا وله في التصوف نسب بل إن الذين ترجموا لعلماء الصوفية وفقائهم وسادتهم وقادتهم بدؤوا تراجمهم بسيرة رسول الله ثم ثنوا بالخلفاء الأربعة ثم أوردوا عشرات الصحابة بل أكثر من العشرات كما فعل ابن مالك في (الكواكب الدرية) وقالوا: إن هؤلاء كانوا جميعاً على مذهب أهل التصوف أو هم الذين أسسوا له وشادوا بناءه أولاً ورد عليهم من رد وردوا هم على من رد عليهم لكن العبرة ليست في ذلك، وأعلامهم إلى مذهبهم، وليس أحد من هؤلاء إلا وفيه قدر من الزهد، وليس أحد من هؤلاء إلا وفيه قدر كبير من كراهة الدنيا وتفضيل الآخرة عليها، وليس أحد من هؤلاء إلا وأعطى من ماله ومن جاهه ومن علمه ومن عمله ما يقوم به أمر الإسلام، بحيث يكون عطاؤه أكثر من أخذه على عكس الكثيرين ممن نعيش بين ظهرانيهم الآن الذين يحبّون الأخذ ويفضلونه على العطاء وربما لا يعطون أبداً.


![]() ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .