

|
|
|||||||
| تاريخ الجزائر من الأزل إلى ثورة التحرير ...إلى ثورة البناء ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
![]() ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
كيف نشات اللهجة الجيجلية حسب وليام مارسي
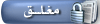 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
اقترح و.مارسي على القرّاء أن يرجعوا إلى التاريخ مستعينين بأضواء الجغرافية؛ ويستنتج أنّ تلك المجموعات الأربعة من الكلام هي قروية لا يتكلّم بها البدو. ولكلّّ منطقة من المناطق الأربعة عاصمة جهوية، وأنّ البحر يحدّها شمالا، وقد شيِّدت فيها طرق تربط فيما بين المدن الداخلية ثمّ بين العاصمة وبين الموانئ. ومن هنا تقدّم مارسي بفرضية مفادها أنّه لم يكن يوجد عرب في المرتفعات الجزائرية، فقد عاشت في المرتفعات الجزائرية عناصر ريفية أمازيغية مارسوا اللغة العربية التي اكتسبوها من خلال معاملاتهم التجارية مع المدن الكبرى، واعتبر الباحث تلك اللغة لغةً عربيةً غريبةً اختلقها مزارعون أمازيغ بعد تشويههم اللغة المشتركة بين مختلف فئات المجتمع المدني علمًا أنّ أفراد كلِّ واحدةٍ من هذه الأرهاط كانوا يتكلّمون بلهجة خاصّة بهم، وقد أدّت هذه اللهجة الغريبة دورًا كافّيا في تيسير التفاهم بين جميع من كان يتلفّظ بها. لقد درس وليام مارسي لَهجات مختلفة لسكّان شَمال إفريقيا فلاحظ نموذجا جديدا لا هو لأهل المدن ولا هو من كلام البدو في منطقة تكرونة بتونس، وجد فيه مُميّزاتٍ شبيهةً بتلك التي سَمعها في نواحي جيجل، وتلمسان، ولاسيّما عند قبيلة ترارة، وفي شَمال المغرب الأقصى عند قبيلة جبالة. لقد أطلق على هذا النوع الجديد من الكلام العبارة «كلام سكّان القرى =الكلام القروي» وهو المبادرة الأوّل الذي أتى بِها في مقدّمة رسالته حول تكرونة فكتب : «نَحن مستعدّون على أن نعتبرَ هذه الأصناف من الكلام ذات الأصول المتنوّعة، أنّها اللغة العربية التي كان يُتكلّم بِها في بعض جهات الريف المغربي قبل قدوم بني هلال وبني سليم، ويعود أصلُها إلى حديث قاطني المدن العريقة التي كانت مراكز إشعاع للتعريب، وكانت هذه اللَّهجات لهجات عربية مغاربية مدنية أدخل فيها الفلاّحون الريفيون الأمازيغيون بعض التغيُّرات، وكانت أهميّتها الكبرى بالنسبة إلينا، أنّ مناطق – المغرب الأقصى والجزائر- التي أجرينا فيها دراساتنا، قد شيِّدت في جنوبها ابتداءً من عام 1100م مدينة رئيسية كانت عاصمة جهوية وفي الشمال عدّة موانئ ورُبطت كلّ بلدة جنوبية بالمدن الساحلية؛ فقسنطينة مع القل وجيجل، وتلمسان مع هنين ورشغون، وفاس مع طنجة وسبتة وباديس. ثمّ خلال القرون التالية، تسرّبت جماعات بشرية ذات لهجة خاصة في مناطق الواد الكبير، وفي حوضي واد تافنة الأسفل والأوسط، وفي واد سبو، حملها على ذلك أمراء أو ظروف أخرى فعزلت تلك المجموعات البشرية قسنطينة وتلمسان وفاس عن ضواحيها حيث سكن أُناس تكلّموا بكلام أصحاب الريف (الكلام القروي) فاتّجه كلّ من كلام المدن وكلام القرى اتّجاها خاصا معيّنا، وقد ركّز كلّ نوع على المميّزات التي انفرد بِها وحدَه، منذ البداية، حينئذ نتج عن اختلاف الطبع، كثرةُ المبادرات ». وهكذا ظهرت لأوّل مرّة عبارة «الكلام القروي» الذي سيكون له حظّ وافر وأهمية قصوى في علم اللّهجات المغربية. فهذا النوع من الكلام الذي واجه احتقارًا مرارًا قد جلب أنظارَ الباحثين ففحصوه بِجدٍّ ومن كلّ جوانبه لما كان يحتوي من قيم تاريخية عميقة وأهمية كبرى، تساعدُهم على فهم تاريخ اللّهجات العربية خاصّةً وتاريخ اللغة العربية عامّةً في المغرب الكبير. ثمّ يتابع وليام مرسي حديثَه عن وضعية الساحل التونسي الذي يَمتاز في نظره بِمكانة خاصّة فيقول: «إنّ الشريط الساحلي التونسي الضيّق الذي تَمركزت فيه جلّ القرى مَملوءٌ، منذ أكثر من ألف عام، بالطرق التي تربط بين مدينة القيروان وهي أمّ المدن المغربية، وبين مينائها الدائم سوسة، ثمّ بينها وبين المهدية التي نافستها طيلة قرن تقريبًا، وأخيرًا بينها وبين مُنستير وهي بلدة العبادة والاعتكاف. ويبدو أنّ فلاّحي هذا الشريط تعلّموا اللغة العربية من سكّان تلك المدن ثمّ نقلوها إلى بيئتهم الخشنة ثمّ بعد تطوّر طويل وبطئ طُبعت تلك اللغة بطابع خاص، ورغم هذه الحقيقة فإنّها تبقى قريبةً من الكلام المدني لكنها تَختلف عن الكلام البدوي بناءً على نظام الحركات والسكنات وعلى قواعد الصرف والنّحو، ولذا لا يَجوز أن تُنسب إليه أو أن يقال إنّها فرع منه. فهذه الأسباب تتيح لنا أن نصرّح أنّ كلام الساحلِ التونسي وقبيلتي جبالة وترارة وسكّان منطقة القبائل الشرقية(الشمال القسنطيني) ،أنّ هذا الكلام لغة عربية مدنية ألحق بِها سكّان الأرياف بعض التغيُّرات.» قدّم مارسي فرضيَة وجود نوعين من الكلام في المغرب الكبير قبل حَملة الهلاليين هما : الكلام المدني والكلام القروي وهما يتعارضان حسب نظريته مع الكلام البدوي.لبني هلال وبني سليم وقد كان الاثنان يُمارسان في جهات بعيدة عن بعضها البعض؛ فزيادة عن الساحل التونسي فإنّا نراهما في القبائل الصغرى وفي تلمسان وندرومة وفي فاس ومن ثَمَّ سجّل الباحث الإبداعات الناتِجة عن مَجموع هذا الكلام، وشرح أسبابَها المتمثِّلة في وجود نوع من النقص في التوازن اللغوي، مشيرًا إلى الاستحداثات في ميادين الفنولوجية وتركيب الكلمات وقواعد الصرف والنّحو والمعاجم الموجودة إلى يومنا هذا في هذه الأنواع من الكلام . وبالفعل، كلّما يُدخَل ابتداع في نظام لغوي معيّن، يتولّد فيه اختلال في التوازن لابدَّ أن يُعوّض وقد نُسبت تلك الابتداعات الجزائرية والمغربية إلى تأثير اللغة الأمازيغية التي تكلّم بِها أبناء الجزائر والمغرب قبل وصول الإسلام إلى منطقتهم. فتأكّد العلماء من هذه الحقيقة في مَجالات الفونتيك والمعجمية وتركيب الكلمات واشتقاقها وقواعد الصرف والنحو. دقّق مارسي الدراسة والتحليل في وضعية تكرونة بتونس، وألَّح أنّها وضعية استثنائية لأنّ تأثير الأمازيغية فيها ضعيفٌ بالنسبة لِجارتَيْها الجزائر، والمغرب. فالأمازيغة اختفت في القطر التونسي وبقي حوالي %1 من التونسيين يستعمل هذه اللغة . * فالساحل التونسي كان، إذن، من الناحية اللغوية، سبّاقًا في تقبّل التعريب وعمقه، وتفوّقه بكثير، على المناطق الأخرى في المغرب الأوسط والأقصى. وخلاصة قوله أنّ تعريب تلك المناطق لم يتمّ إلاّ عن طريق تلك المدن القديمة التي ربطتها عدّة علاقات تجارية واقتصادية واجتماعية، وكلّ هذه العناصر تظهر بمثابة عواملَ ذات وظيفة تتجلّى في دفع آلية التفاعل اللساني بين أفراد هذه المناطق عبر فضاء جغرافي، ويمكن اعتبارها عناصر محفِّزة لعملية التفاعل اللهجي في الخريطة اللهجية
|
||||
|
|
رقم المشاركة : 2 | |||
|
اتقي الله في نفسك يا مريومة و ابتعدي عن العنصرية .
|
|||
|
|
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
حبذا لو نصحت العروبيين الذين يتهجمون على عرقك و يتغنون بالعروبة لو كنت تدافع عن الاسلام فعلا لدافعت عن الهوية الاسلامية و فقط لان الاسلام هو الذي جعل سكان المغرب الكبير يحبون العربية و يتكلمونها و ليس شيئا اخر الاسلام هو الذي يوحدنا و ليس العروبة اذا كنت تصغي الى المدعو علام فاعلم ان هذا الانسان متشبع بالفكر البعثي الشيوعي لا يهمه الاسلام و هو ان تكلم عن الاسلام فذلك لاستغلاله لخدمة اديولوجيته القومية البعثية هذا الانسان معقد اكثر مما تتصور لم يترك منتدى الا ودخله للدعاية للقومية العربية ثم ما دخل موضوعي في العنصرية |
||||
|
|
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
يا مريومة : اعلمي أنّ المسلمين يشتركون في عقيدة واحدة و يتوجب علينا نبذ التخلخل و الله المستعان....عيد مبارك مريومة.
|
||||
|
|
رقم المشاركة : 5 | |||
|
اتق الله في نفسك وتوقف عن اثارة مواضيع العنصرية والمذهبية والخلافات بين المسلمين وخدمة الصهاينة وليكن لديك احساس بالانتماء الى الامة الاسلامية في هذا اليوم المبارك
|
|||
|
|
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
لا حياة لمن تنادي يا أخانا ، لكن بوركت
على نصحيتك فالمسلم لا يخشي لومة لا ئم وفقت |
||||
|
|
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
لماذا مصطلحات عنصرية مثل المغرب العربي الجزائر عربية لماذا لا تقول الجزائر اسلامية اليس هذا افضل بكثير اخي الكريم كما يحق للاخوان العرب المسلمين ان يقولو نحن عرب نحن ايضا يحق لنا ان نقول نحن امازيغ اذن ينبغي علينا ان نحترم بعضنا كمسلمين وان لا يتعالى احد منا على الانتماء الى الامة الاسلامية كلنا سواء تحت مضلة الدولة الاسلامية |
||||
|
|
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
اقتباس:
لكن أخي الكريم أجدادك خدموا اللغة العربية و لم يراعوا نسبهم لأنهم كانوا يعتبروا أنفسهم مسلمون و العربية تجمعهم و لم نسمع شخصا ينادي بهذه الثقافة ،نحترمها نعم ، لكن أن ينكر بعض الأمازيغ الللغة العربية ، و هويتنا العربية و لم ينكرها أجدادكم ، أما المغرب العربي فهو الأنتماء لا غير ، فكما يوجد دول عربية إسلامية ، يوجد دول إسلامية غير عربية ، و هذا الانتماء لا يغير من الأمر شيئا، و نُسمي بالمغرب العربي لأننا أمم ناطقة بالعربية ، فلا ضير أن نسمى بالمغرب الإسلامي أو العربي فلا أعرف هنا أين الضرر الذي لحقكم من هذه التسمية.
|
||||
|
|
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
اللغة الرسمية للدولة ولغة الدين ليست هي من يحدد انتماء الشعوب فالمغرب الاسلامي كان الى وقت قريب يسمى المغرب الامازيغي في كتب التاريخ وكانت الشعوب لا تسمى بالعرب حتى لو كانت لغتهم الرسمية وتاثرت لهجتهم بها الهوية الثقافية يا اخي هي العادات والتقاليد لهجة التخاطب اليومية والعديد من الامور التي تستطيع ان تميز بها اختلاف الشعوب واستقلالها ثقافيا عن بعضها |
||||
|
|
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
|
|
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
اقتباس:
بارك الله فيك اخي الكريم و امل ان يفهم بعض الاعضاء قصدك جيدا |
||||
|
|
رقم المشاركة : 12 | |||
|
عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير |
|||
|
|
رقم المشاركة : 13 | |||
|
كلام البربر بلا مصادر فهو بلا أساس فهو باطل
أظن هذا الموضوع حذف و أعيد بعثه من جديد الرجاء تدخل من المشرفين لاستئصال الشر منه أعاذنا الله من مكركم |
|||
|
|
رقم المشاركة : 14 | |||
|
انت اول من يجب استئصاله ايها الحقود ماهي العنصرية الموجودة في موضوعي ايها الماكر
|
|||
|
|
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
اقتباس:
أذا رفع الحياء من الفتاة ماذا ننتظر منها ، موضوعك حذف من قبل بسبب حقدك المشين ، أنت الورم الخبيث الذي يجب أن يستأصل .
|
||||
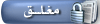 |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مارشي, اللهجة, الجيجلية, وأدام, نصاب |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc