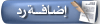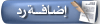عُمدَةُ الفقه (6)
الدَّرسُ الأول (1)
د. عبد الحكيم بن محمد العجلان
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرحبُ بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزَّاء في حلقةٍ جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الحكيم بن محمد العجلان. فأهلًا وسهلًا بكم فضيلة الشيخ}.
أهلًا وسهلًا، حيَّاك الله، وحيَّا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
{نستأنف في هذا الفصل -بإذن الله- باب "عشرة النساء" من كتاب "عمدة الفقه" لابن قدامة}.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، أمَّا بعدُ؛ فلعلك أن تأذن لي -حفظك الله- في استهلال هذا الفصل، أو هذه الحقبة الجديدة، والإطلالة التي جاءت بعد هذا التَّوقُّف؛ فحاجتنا طلبة العلم، ومَن مشى في هذه الأكاديمية، ومَن بنى نفسه في هذا البناء العلمي، ومَن أراد الخير في هذه المجالس المباركة؛ عليه أن يستحضر مسألةً مُهمَّة، لا نستغني في كلِّ حالٍ وفي كلِّ حينٍ، وفي كلِّ آنٍ، وفي تقلُّبِ الأيَّام والزَّمان في استحضارها، وهو الإخلاص لله -جلَّ وعلا.
وقال بعض السَّلف: "لم أجد شيئًا أعظم مُعالجةً من النِّيَّة، فإنَّها تتقلَّب"، وما سُمِّيَ القلب قلبًا إلا لكثرة تقلُّبه، فإنَّ الإنسانَ إذا جمعَ علمًا وخرجت نفسه وأُعجِبَت بما أوتيت، وإذا حدث للإنسان نُقلةٌ في منزلته، أو تغيُّر في حاله، أو وجدَ مكانًا في مجتمعهِ؛ فسرعان ما يجتذبه الشَّيطان إلى شَرَكهِ، ويُريد به الشَّرَّ والسُّوء، فلأجل ذلك نحن بحاجةٍ إلى أن نبدأ وأن نُعيد وأن نُكرِّر وأن نتحدَّث عن هذا الأمر المهم، فإنَّنا لا غنى لنا عن الإخلاص لله -جلَّ وعَلا- ونحن إنما تعلمنا، وإنما درسنا، وإنما جلسنا واجتمعنا، وإنما أُنشئَت مثل هذه المنارات، وإنَّما وأُقيمت مثل هذه الأكاديميَّات لغرضٍ واحدٍ؛ وهو تحقيق الإخلاص لله -جلَّ وعَلا- والقيام بعبوديته -سُبحَانَه وَتَعَالَى، فلا خير فينا إن لم نتواص على ذلك.
ومن أول من تُسعَّر بهم النار وم القيامة عالم، يُقال له: ماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الله وآناء النهار، فيقول الله له: كذبت، إنَّما قرأت ليُقال قارئ، ثم يؤمر به إلى النار.
يا إخواني أنا أعرف أننا أعدنا هذا الحديث، وأعرف أنكم تحفظونه، لكن أعظم ما يكون حُجَّةً علينا إذا حفظناه وأعدناه ثم لم نزل تفوت علينا النيَّة أو يُدركنا الشيطان أو ننصرف، أنا أتحدث عن نفسي وأنا أعظم ما أكون فتنةً في مثل هذا الموقف وأنا أمام هذه العدسات وإبَّان انتقال هذه الصور والشَّاشات إلى أقطارٍ مَعمورة، والإنسان يعرف أنه لا يحمل كثير علمٍ، ولا أن يجمع أصلًا أصيلًا منه، وإنما هي شتاتٌ جمعَه، وكلامٌ ألَّفَ بينه، والله يتولانا برجمته، فيأتي الشيطان ويقول كذا وكذا وكذا، يأتي علي، ويأتي عليك، ويأتي على الآخر!
فنحن بحاجة إلى أن نستعين بالله -جلَّ وعَلا- وأن نستعيد إخلاصنا لله -سُبحَانَه وَتَعَالَى- إخلاصًا وتمحيصًا وتوضيحًا، حتى يكون قصدنا وجه الله، وحتى نريد ما عند الله -سُبحَانَه وَتَعَالَى- وحتى نتخلص من جميع أهوائنا وحظوظنا وما يلحق بأنفسنا، فإنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا؛ لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .
ثم أنتم في مرحلةٍ من مراحلِ التَّعلم؛ فلتعلموا أنها مِنَّة عظيمة، فكما يمنُّ الله -جلَّ وعَلا- على أناس بالدُّنيا، ويمنُّ على أُناسٍ بالوظائف، ويمنُّ على آخرين بالمساكن، ويمنُّ على آخرين بشهوات الدُّنيا وفسحتها، أو زوجةٍ أو غير ذلك؛ فإن كل هذه المنن وكل هذه الشَّهوات لا تساوي شيئًا فيما يفتحه الله -جلَّ وعَلا- على عبده من الهدى والعلم والبصيرة وطلب العلم، والاهتداء بسنة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فإنَّ الدُّنيا عمَّا قليل ذاهبة، وإنَّ الأيام راحلة، وإنَّ الإنسان ملاقٍ ربَّه، فتذهب الدنيا بعجرها وبجرها وبلائها وشدَّتها ولأوائها ونصبها، ويقبل الإنسان على آخرته بما قدَّم وبما عمل، وبما أنجز، وبما استغفر، وبما تعلم، وبما علم، وبما عمل، وبما اهتدى به من سنة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فطيبوا نفسًا بما هداكم الله له من العلم، وكونوا أشدَّ عزيمةً في الإقبال عليه، والاهتداء بسنَّة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والتَّمسُّك بها، والتَّشبُّث بحبلها، والاستمساك على صراطها، وعدم الحيد أو الحيف أو الانحراف عن طريقها، فإن هذا هو الهلاك.
وزيدوا منها بلًا وعطاءًا وتحصيلًا وتعلُّمًا حتى تلقوا الله -جلَّ وعَلا- ربَّكم على هدًى وسنةً.
الحقيقة أنا لا أريد أن أطيل في مثل هذه المقدمات، ولكن لابد لنا من الوقوف عندها، ولابدَّ لها من أن نسترجعها، ونحن إنما نُذَكِّر أنفسنا، وعسى الله أن يعفو عنَّا مع ما نتذكَّر، ومع ما نستحضر، ومع ما نجدد، ومع ما نعالج؛ فإنَّه لا يخلو أحد منَّا من أن ينتهز منه الشيطان ضعفًا، وأن يلحق منه حالًا، فربما عثر، وربما ضعف، وربما أدركه شيءٌ من الانصراف، فإذا ما كان للإنسان نيَّةٌ صالحةٌ وحاول المعالجة فإن الله يُعينه على الخير ويُقويه عليه ويبلغه المنزلة، ويتجاوز عنَّا في العثرة والخطيئة، عسى الله أن يستر وأن يعفو، وأن يتجاوز، وأن يصفح، وأن يوفقنا للعلم والهدى، وأن يبلغنا البر والتقى، وهذا أوان الدخول فيما نحن بصدده، والولوج فيما قصدناه من البحث والمدارسة والمراجعة في هذه الأبواب المباركة -بإذن الله -جلَّ وعَلا.
{قال المؤلف -رحمه الله تعالى: (باَبُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ.
وَعَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ معَاشَرَةُ صَاحِبِهِ بِالْمَعْرُوْفِ مِنْ غَيْرِ مَطْلٍ وَلاَ إِظْهَارِ اْلكَرَاهَةِ لِبَذْلِهِ)}.
العشرة: هي الاجتماع والائتلاف، وما يتبع ذلك من المؤانسةِ والمقاربة؛ وهذا الباب من أهم الأبواب، وهو مناسبٌ لما سبقه من باب الصداق، فإن الإنسان إذا بذل صداقه وأنجز عقده؛ فإنه لم يبقَ إلا دخوله على زوجه ومعاشرته لها، ومعاشرتها له، وما يحصل بينهما من المؤانسة، وَلَمَّا كان الأمر كذلك؛ فإن الفقهاء -رحمهم الله تعالى يذكرون من الأحكام ما كان مُناسبًا، ويرتبونه ترتيبًا صحيحًا بما يكون أنظم للعقل، وأقرب للفهم، وأقرب للمراد، فالمراد أن العشرة حاصلةٌ بعد كتب النكاح وبذل الصداق؛ فلم يبقَ إلا ما يكون بينهما، وهذا فيه من المسائل ربما ظاهرها السهولة والقرب، وعدم الصعوبة؛ لكن في أثنائها مما يجب على كلٍّ من الزوجين بذله وحملُ النفس عليه بما تقرب به وشيجة الزوجيَّة، وتقوى أواصرها، ويحصل خيرها، وتستظل بظلال الأنس والمودة، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21]، فنحن أحوج ما نكون إلى دراسة مثل هذا الباب، ونحن في كل يومٍ وفي كل حالٍ نسمع من حالات الطلاق والفراق والاختلاف والنِّزاع وما يتبع ذلك من تفرُّق الأولاد، وما يحصل تبعًا لذلك من البلاء الشديد على الزوجين وعلى غيرهما، فتذهب عليهم الأموال، وتفوت عليهم السَّكينة، ويحصل بينهم من البغضاء والضَّغينة، ويُيتَّم الأطفال وآباؤهم أحياء، ويحصل بسببِ ذلك أحيانًا من التَّناحر، وتبقى الحرب قائمة حتى يموت أحدهما أو يموتا جميعًا من سوء ما فعل الشيطان بهما، كل ذلك لَمَّا فات عليهم العلم بما أوجب الله -جلَّ وعَلا- على كلٍّ من الزَّوجينِ. فالأهميَّة بالنِّسبة لهذا الموضوع أهمِّيَّة بالغة.
ثم المسألة الثانية: العشرة الزوجيَّة هي عبادة لله -جلَّ وعَلا- فما يفعله الزَّوج لزوجه إنما هو قُربة وطاعة وأجر وحسنة عند الله -سُبحَانَه وَتَعَالَى- ولذلك قال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» ، والأهل هو ما يتأهل به الإنسان من زوجةٍ ونحوها، فهذا أعظم ما ينبغي أن يستشعره الزوج، فأنت حينما تبذل لا تنتظر من زوجتك مقابلًا، ولا تنتظر منها عوضًا، ولا تبذل لتأخذ، وإنما تبذل وتفعل وتعمل وتبادر لتطلب ما عند الله -جلَّ وعَلا.
في ما يُقابل ذلك: على الزوجة أن تعلم أنها ما تقربت بقربة بعد واجباتها التي افترضها الله عليها من التوحيد والصلاة أعظم من طاعة الزوج والقيام عليه، والحرص على بيته، وحفظ حقِّه، فإنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذكر أن المرأة التي «ذَا صَلَّتِ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ» ، فلم يكن شيءٌ أعظمَ من ذلك، فإذا علمت النساء ذلك؛ فلأن تتخفف من كثير من النوافل والعبادات وتقوم على زوجها إحسانًا وبذلًا؛ والله لهو أزكى عند الله -جلَّ وعَلا- ولأجل ذلك لم يكن للمرأة أن تصوم صيامًا نفلًا إلا بإذن زوجها، ولم يكن لها أن تقوم الليل إلا أن يكون زوجها راضيًا، فإذا أرادها أو طلبها، أو كان له بها حاجة، أو احتاج إليها في خدمة؛ فإنَّ قيامها عليه أولى وأتم، وعملها معه أفضل عند الله -جلَّ وعَلا- وأكثر أجرًا؛ فلتفقه النساء ذلك، فإن هذا من الأمور العظيمة.
ثم المقدمة الثالثة: أنَّ ما يذكره الفقهاء في هذا الباب، وكل ما يذكره العلماء في نحو هذه المسائل فالغالب أنهم يذكرون الحدود الواجبة، والأمور المتعينة التي تُطلب عند حصول النزاع أو قيام الخلاف، وإلا فالأصل أن القوامة في الزَّوجيَّة مبناه على المواضعة لا المحاققة، لا أن يقول: هذا حقي، وتقول هي: هذا حقي!! فكل يومٍ يكون لهم صراخ وصياح ونقاش وجدال؛ فيطلب كل واحدٍ منهما ما على صاحبه، هذا لا يكون له فيه أجر، ولا يعظم به الأمر، بل لربما كان سببًا لفتح أبواب الشياطين عليهم، والله -جلَّ وعَلا- يقول في حق الزوجين: ﴿وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ﴾ [البقرة: 228]، فما يعرفه النَّاس من حُسنِ التَّعامل، من طيبِ الخُلُق، من جميلِ الصَّنيع، من التَّغاضي عن الخطيئة، من حمل النَّقيصة، من ستر العيبة، من إبداء الخير، من التَّقرب بالهدى، ولأجل ذلك يذكر الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في مطلع هذا الباب قالوا: (وَيُسَنُّ) أي: لِكُلِّ مِنْهُمَا (تَحْسِينُ الْخُلُقِ لِصَاحِبِهِ وَالرِّفْقِ بِهِ وَاحْتِمَالِ آذَاهُ)، وهذا فيه أدلة كثيرة، والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» ، كما في حديث معاذ. وقال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في المقابل للرجال: «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا، كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا» .
وبعض أهل السُّوء والسَّفه والفسق والمجون يحمل الحديث على أنه انتقاص للنساء، وحاشا رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن ينتقصهنَّ، أو أن يكون في هذه الملَّة ما هو نقيصة لهنَّ أو إزراء بهنَّ؛ بل هذا فيه من إعلام الرجال بما جبلت عليه النساء من العاطفةِ والليونة التي لا يُمكن أن يُطلب منها الأمور على وجه واحدٍ؛ بل لابد أن يكون فيها شيء من المرونة والليونة والهدوء والتَّجاوز، لأنك لن تسلم من وقوع وحصول الخلل، وذلك لما جُبلَت عليه من عاطفةٍ وضعفٍ ونحو ذلك مما يليق بها في القيام على زوجها والقيام على ولدها، وشدَّةِ رحمتها وكمال شفقتها ونحو ذلك، فهو في جانب يحصل به لها التَّمام والكمال، وفي جانب الرجال لابد أن تلحظوه فأنتم تعلمون أنه سبب خيرٍ لكم عليكم وعلى أولادكم، لكنَّه في جانب آخر لابدَّ أن يكون منكم المواضعة وأن تغضوا الطرف، وأن تتسامحوا، وأن تلينوا، وأن تتساهلوا، وهذا من الأمور المهمَّة التي لا يكاد يقف عندها كثير من الرجال أو الأزواج، فنحن في هذا الموطن وفي استهلال هذا الباب وفي بداية هذا الفصل، وأول درسٍ من دروسنا هذا؛ ندعوا كل زوجٍ وكل زوجةٍ وكل طالب علمٍ وكل طالبة علمٍ؛ إذا أُعيدت الأحاديث في مثل هذه المسائل؛ فأولى ما يُطلب من الأزواج لزوجاتهم والزوجات لزوجهنَّ الإحسان والمعروف، وبذل الخير، وطلب الهدى، والإعانة على البر، وأن يُترَك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا من طلب الحقوق والمنازعة، والخصومة، والرعونة في الأشياء، وطول الصوت، وكثرة المجادلة، وقلب البيت إلى أن يكون لهيبًا وأن يكون مثل المقلاة، إنما حالهما يتقلبان، يومًا يشتدُّ بهما حرارة، ويومًا تذهب قليلًا، وهكذا...، حتى يأتي فرجٌ من الله -جلَّ وعَلا.
ولمَّا كانت الحال على هذه وجدتَّ أن كثيرًا من الأزواج لا يأنسون إلا حينما يخرجون من بيوتهم، وكثير من الزوجات لا يأنسنإلا بأخواتها وصويحباتها، ولو كان بيت الزوجية قائمًا؛ لكان أنس كل واحدٍ منهما بصاحبه أشد من أنسه في خارج بيته، لا بصاحبٍ ولا بصديق، ولا بقريبٍ ولا بحبيبٍ، والله -جلَّ وعَلا- قال: ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ﴾ [النساء: 36]، ذكر بعض أهل التفسير أن المقصود به: كل واحدٍ من الزوجين لصاحبه.
فهذه مسألة مهمَّة ينبغي أن تكون حاضرة في أذهاننا في إطلالة هذا الباب المهم.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- كلامًا مكمل لما ذكرناه: (وَعَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مَعَاشَرَةُ صَاحِبِهِ بِالْمَعْرُوْفِ)، فمن أساء أو قصَّرَ أو أنقصَ فإنَّما هو إثمٌ يحتمله يوم القيامة، وسوءٌ يكون في جريرة سيئاته، وفي صحائف أعماله، ويلقى به ربه -سُبحَانَه وَتَعَالَى- ولذلك معاشرة صاحبه بالمعروف لابد أن يحسن بذلك، وهذا المعروف جعله الله -جلَّ وعَلا- هيِّنًا سهلًا، وهو ما تعارف عليه الناس، فلا يُطلب منك أكثر ممَّا تعارف عليه عقلاء الناس، وجرى بينهم، وقامت به البيوت، وأنسَ به الأزواج.
ثم قال: (وأَدَاءُ حقِّه الوَاجِب)، الحق الواجب سيأتي بيانه، وهو ما لكل واحدٍ من الزوجين على صاحبه، سواء كان ذلك من الاستمتاع، أو القيام ببعض الحقوق، أو الخدمة -إن قلنا بوجوبها- أو ما يكون من النَّفقة على الزوج والسُّكنَى، وما يكون من الكسوة ونحوها؛ فكل ذلك داخلٌ في الواجبات التي يجب على كل واحدٍ من الزَّوجين على صاحبه، فعلى الزوجةِ واجبٌ لزوجها، وهو تمكينه من الاستمتاع بها، وما يتبع ذلك من الخدمة -على ما سيأتي- وعلىالزوج ما يجب على عليه من نفقة وكسوة وسُكنَى، وما تبع ذلك مما يلحقه.
قال: (مِنْ غَيْرِ مَطْلٍ وَلاَ إِظْهَارِ اْلكَرَاهَةِ لِبَذْلِهِ)، هذا من الأهمية بمكانٍ، فكثير من البيوت لو رأيتم، فإن كل واحد منهما يفعل ما يطلب صاحبه، ولكن لا يفعله له حتى تطيب النفس وحتى يعظم الشِّقاق وحتى يشتدَّ النِّزاع، فلا يكونا سَلِما من النِّزاع، ولا حصَّلا المعروف بما بذله!
فلو أنهما بذلا من غير مُماطلةٍ -والمماطلة هي الممانعة- أي: يمتنع أو يبتعد أو ينصرف أو يُعرض حتى تنشف نفوسهما، ثم يُقبل فيعطيه ما أراد! وهذا لا يُجدي على صاحبه شيئًا، فلو أنهاطلبت النفقة، قال لها: أبشري. ثم قالت: أعطني النفقة! قال: إن شاء الله. ثم قالت: أعطني النفقة! حتى إذا وصلت إليها النفقة وصلت وهي في حالةٍ من التَّكرُّه لها، فالمماطلة إذن مفسدةٍ لأنس الزوجين ببعضهما، وذلك أيضًا فعل للمحظور، فبذل المعروف أن يكون من غير مماطلة، والمماطل فاعل للمحرَّم، سواء من الزوج لزوجته في النفقة والكسوة والسُّكنَى، أو من الزوجة فيما يجب عليها من الاستمتاع وما يكون من الخدمة -على ما سيأتي بيانه في لزوم ذلك.
قال: (وَلاَ إِظْهَارِ اْلكَرَاهَةِ لِبَذْلِهِ)، يعني: لو لم يُماطل ولكن إذا أنفق عليها؛ قال لها: خذي -بكراهية، إمَّا في طريقة الكلام أو بطريقة في الفعل- فذلك نوعٌ من السوء، ومثل ذلك أيضًا هي، إذا جاءت إليه فقدمت إليه طعامًا؛ فألقته عنده بشيءٍ من التَّكره، أو ضربت بالأواني حتى سُمِعَ صوتها، فهذا كراهية في البذل.
وكذا مما يكون بين الزوجين من الاستمتاع، فقدمت نفسها بشيءٍ من التَّكرُّه أو تمعُّطِ وجهها وتغيُّر نفسها، فإن ذلك من عدم المعروف الذي يكون بين الزَّوجين، وأطلنا في هذا لأهميَّته، ولعظم ما يتعلق به، ولأن ما يأتي من المسائل فهي متفرعة عن هذا.
{قال -رحمه الله: (وَحَقُّهُ عَلَيْهَا تَسْلِيْمُ نَفْسِهَا إِلَيْهِ، وَطَاعَتُهُ فِيْ اْلاِسْتِمْتَاعِ مَتَى أَرَادَهُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ)}.
إذا عقد الزوج على زوجته وأعطاها مهرها وصداقها؛ فلم يبقَ إلا تسليم نفسها، ولذلك يقول الفقهاء: هل يلزمه أن يجعل لها فسحةً في الجهاز وتهيئة نفسها؟
فيقولون: يستحب، ولو في ثلاثة أيامٍ ونحوه.
وعلى كل حال؛ فيجب عليها تسليم نفسها.
قوله: (وَحَقُّهُ عَلَيْهَا)، إذن هو حق، وما دام أنه حق فهو واجب ما لم يكن ثَمَّ مانع، كأن تكون صغيرة لا تطيق الجماع، أو أن يكون بها مانعٌ كمرضٍ أو علَّةٍ، أو غيرِ ذلك من الأمور، أو كان ثمَّ شرطٌ بينهما في أنه لا يكون دخوله بها إلا بعدَ وقتِ كذا وكذا؛ فإذا وُجد شيء من ذلك فهما على ما اتفقا عليه، وإذا لم يوجد فإنَّ الواجب أن تسلم نفسها لأول وهلةٍ.
قال: (وَطَاعَتُهُ فِيْ اْلاِسْتِمْتَاعِ مَتَى أَرَادَهُ)، المعقود عليها في النِّكاح هو حلُّ الاستمتاع، فهذا هو الأصل ولا شكَّ في ذلك، قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ [البقرة: 187]، عبَّر الله -جلَّ وعَلا- باللباس في أعظم تعبيرٍ وألطفه، تكنيةً عمَّا يكون لكل واحدٍ من الزوجين من الاستمتاع بصاحبه، وجماع الرجل لامرأته ومعاشرته لها. إذن هذا هو الواجب.
هل يجب شيء غير ذلك؟
ظاهر مذهب الحنابلة -رحمهم الله تعالى: أنَّ الواجب على المرأة هو الاستمتاع لا غير.
وفي رواية ثانية عند الحنابلة، وهو قولٌ لابن تيمية وجماعة من أهل العلم: أنَّ الواجب على الزَّوجة ما يليق بها بالمعروف، فإذا كان بنات جنسها يلينَ مهنةَ البيتِ والقيامَ على إصلاحه وإصلاح طبخِ الزَّوج؛ فإن هذا يكون واجبًا عليها، ولأجل ذلك كانت عائشة تخدم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في بيته، وجاء عن أسماء أنها كانت تعلف خيل الزُّبير ونحوه، فذكر بعض أهل العلم استنادًا إلى ما جاء في نحو ذلك من الأدلة أنه يجب عليها الخدمة بالمعروف.
وكما قلنا لكم: إنَّ محلَّ هذا إنما هو بيان الحق الواجب، وإلا فنحن نقول أصالةً: أنه ينبغي لكل واحدٍ من الزوجين أن يبذل لصاحبه ما استطاع، فإنه في ذلك مأجور، وإنه أسعد لحياته، وأتمَّ لأنسه بزوجه، الزوجة بزوجها والزوج بزوجته، وأدوم لحياتهما، وأمنع من حصول الشيطان بينهما.
إذن نقول: قوله وَطَاعَتُهُ فِيْ اْلاِسْتِمْتَاعِ)، على ما قصد المؤلف واشتهر عند الحنابلة، وكما قلنا: إنَّ القول الآخر هو الذي عليه العمل، وهو الذي لا يسع الناس إلا القول به، وهو الذي عليه عامَّة بلاد المسلمين وبيوتاتهم؛ أنها تخدمه بنحو ما استطاعت، إلا من كانت عادتهم ألا يخدمن كالوجهاء وذوات الأحساب، ومن بلغت في الوجاهة مبلغًا، ولزمها خادم يخدمها، ومن يقوم على شؤونها، فيكون ذلك حقٌّ لها.
وَطَاعَتُهُ فِيْ اْلاِسْتِمْتَاعِ)، على ما قصد المؤلف واشتهر عند الحنابلة، وكما قلنا: إنَّ القول الآخر هو الذي عليه العمل، وهو الذي لا يسع الناس إلا القول به، وهو الذي عليه عامَّة بلاد المسلمين وبيوتاتهم؛ أنها تخدمه بنحو ما استطاعت، إلا من كانت عادتهم ألا يخدمن كالوجهاء وذوات الأحساب، ومن بلغت في الوجاهة مبلغًا، ولزمها خادم يخدمها، ومن يقوم على شؤونها، فيكون ذلك حقٌّ لها.
قال: (مَتَى أَرَادَهُ، مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ)، قلنا: إنها إن كان لها عذر فإن ذلك يكون مانعًا من الوجوب ولها أن تمتنع حتى يرتفع عذرها، كمرضٍ أو إحرامٍ، أو نحو ذلك.
{قال -رحمه الله: (وَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ، فَلَهَا عَلَيْهِ قَدْرُ كِفَايَتِهَا مِنَ النَّفَقَةِ، وَاْلكِسْوَةِ وَاْلمَسْكَنِ، بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَالِهَا، وَاْلمَسْكَنِ، بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَالِهَا، فَإِنْ مَنَعَهَا ذلِكَ أَوْ بَعْضَهُ، وَقَدَرَتْ لَهُ عَلى مَالٍ، أَخَذَ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهَا وَوَلَدِهَا بِالْمَعْرُوْفِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لِهِنْدٍ حِيْنَ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيْنِيْ وَوَلَدِيْ، فَقَالَ: «خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ»)}.
قوله: (وَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ، فَلَهَا عَلَيْهِ قَدْرُ كِفَايَتِهَا مِنَ النَّفَقَةِ)، المؤلف هنا -رَحَمَهُ اللهُ تَعَالَى- أدرج نفقة الزوجة في باب العشرة، فهي قريبةمنها وداخلةٌ فيها، وإن كان عادة جمعٍ من الفقهاء أن يذكروا نفقة الزوجة في بابٍ مُستقل في "كتاب النفقات" فيبدأ بنفقة الزوجة، ثم نفقة الرقيق والوالدين والأقارب من الأولاد وغيرهم، وعلى كل حالٍ فنحن على ما درج عليه المؤلف من وجوب النفقة.
النَّفقة لازمة للزوجة على زوجها، وهذه النَّفقة واجبة سواء كانت فقيرة أو غنيَّة، موظَّفة أو غير موظَّفة، طلبت ذلك أو لم تطلبه، فإنَّ النَّفقة واجبة ما لم تسقط حقها، فإذا قالت لا أريد منك نفقة؛ فإنَّ حقها الذي ذهب سقط، وحقها الذي يأتي لا يسقط؛ لأنَّ الشَّيء لا يسقط قبل وجوبه، فبناءً على ذلك لو أنَّ امرأة تزوجت رجلًا وقالت: لا أريد منك نفقة، ثُمَّ ظنَّت مثلًا أنه يكون منه حُسن معاشرة؛ فبانَ ظنُّها على خلافه، فطلبت نفقتها فليس له أن يقول: إنكِ أسقطتِ نفقتكِ، وإنما ما أسقطت من نفقتها في سالف أيامها فليس لها أن تُطالب به، لكن ما يتجدد من أيَّامها فتتجدد معه النفقة الواجبة.
قال: (فَلَهَا عَلَيْهِ قَدْرُ كِفَايَتِهَا مِنَ النَّفَقَةِ وَاْلكِسْوَةِ وَاْلمَسْكَنِ، بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَالِهَا).
من جهة الواجب هذا ظاهر، فإن الله -جلَّ وعَلا- قال: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه﴾ [الطلاق: 7]، فواجبة عليه النفقة.
ما قدر النفقة الواجب؟
إذا كان حال الزوجين موسرين، فتكون النفقة نفقة الموسرين.
وإن كانا متساويين في الفقر والفاقة؛ فتكون نفقتهما حال نفقة الفقراء والمعسرين.
ولكن الإشكال فيما إذا اختلفت حالهما، فكان الزوج مثلًا فقيرًا وهي غنيَّة، أو العكس، فما الواجب وما المعتبر؟ هل هو حال الزوحة أو حال الزوج؟
الجواب: هذا مما جرى فيه كلام للفقهاء كثير، فبعضهم نزع منزع الزوج للآية: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه﴾، وبعضهم نزع منزع الزوجة لحديث هند: «خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ».
وظاهر كلام المؤلف -رَحَمَهُ اللهُ تَعَالَى- لما قال: (بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَالِهَا)، واستدلاله بحديث هندٍ أنَّ المعتبر حال الزوجة فقرًا وفاقة أو غنًى ويسار، وإن كان مشهور المذهب عند الحنابلة، والذي يعتبر الإمام الموفق بن قدامة من أشياخه؛ أن المعتبر حالهما جميعًا، وقالوا: لما جاء من دلالة الكتاب والسنة، فلا ننفك من الجمع بينهما، فنرى أن يكون الاعتبار بحالهما جميعًا، فإذا كان مُوسرًا وهي فقيرة فإن نفقتهما نفقة متوسطة، وإذا كان العكس بأن تكون هي غنية وهو فقير، فتكون النفقة نفقة المتوسطين اعتبارًا بحالهما جميعًا، وفي ذلك إعمال لدليلين، قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه﴾، وحديث هند.
وكما قلنا: إن هذا مشهور المذهب عند الحنابلة، وإن كان قد يُفهم من كلام المؤلف أنه نحا منحى اعتبار حال الزوجة كما هو مذهب لبعض الفقهاء-رَحَمَهُم اللهُ تَعَالَى.
قال المؤلف: (فَإِنْ مَنَعَهَا ذلِكَ أَوْ بَعْضَهُ، وَقَدَرَتْ لَهُ عَلى مَالٍ، أَخَذَ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهَا وَوَلَدِهَا بِالْمَعْرُوْفِ).
يعني لو كان ما يُعطيها النفقة، وتتجدد كل يومٍ حاجة طعام، وحاجة لقيامها على ولدها ونحو ذلك، أو كان يعطيها قليلًا مما يجب لها، ولا يُكمِّل لها الواجب، فالنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما شكت إليه هند وضع أبي سفيان؛ قال لها: «خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ»، قال بعض أهل العلم: إن هذا حكمٌ عامٌّ في أن كلَّ امرأة إذا أنقصها زوجها نفقتها؛ فإنها تأخذ كفايتها ولا غضاضة عليها، وهذا ظاهر كلام المؤلف-رَحَمَهُ اللهُ تَعَالَى- هنا.
وبعضهم قال: إن حديث هندٍ لم يكن دعوى قضائية، ولو كانت كذلك لاحتاج النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يستدعي سفيان ليسمع منه، فربما كان له عذر أو ثَمَّ مانع ونحوه، مما يدل على أنها فتية.
وإن كان بعض أهل قال: إنَّ هذا حكم من النَّبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لهند، وقد لا يكون غيرها مساويًا لها، والنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يعلم منها أنها تنصف من نفسها ولا تزيد على حقها؛ فكان هذا حكمًا لها.
فأيًّا كان في ذلك؛ فإنه لا ينبغي للمرأة إذا كان زوجها لا يُؤدي لها النفقة الواجبة أن تتطاول بما يزيد عن نففقتها، والنفقة الواجبة هي قليلة لحال الناس، إذا ما نظرنا إلى ما ذكره الفقهاء -رَحَمَهُم اللهُ تَعَالَى، فينبغي أن تتورع النساء أن تطال يدها على مال زوجها فتكون عليها تبعةٌ يوم القيامة، فإذا كانت واثقةً أو متيقنةً أنَّ ما تعطاه هو دون ما تستحقه بأن عرضت ذلك على فقيهٍ وذكرت حالها وحال زوجها على شيءٍ من التَّوضيح والتَّفصيل الذي ينتفي معه الجهالة والإبهام فإنه يُمكن أن يُقال: إن للمرأة أن تأخذ، وأمَّا الواقع فإن أكثر الأزواج ينفقون النفقة الواجبة، وإنما حال كثير من الزوجات أنهن يَطلبن شيئًا من التَّوسُّع وشيئًا من السَّعةِ وربما شيئًا من الانفتاح في أوجهٍ مُباحة، وربما في بعض الأحيان انفتاح في الأمور المكروهة كالتَّوسُّع في الألبسة أو الأطعمةِ أو غير ذلك، وهذا ليس بلازمٍ ولا واجبٍ على الزَّوج.
قال -رَحَمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلى اْلأَخْذِ لِعُسْرَتِهِ، أَوْ مَنَعَهَا، فاَخْتَارَتْ فِرَاقَهُ، فَرَّقَ اْلحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كَبِيْرًا أَوْ صَغِيْرًا).
إذا لم تجد النفقة عند الزوجة، وهي الآن محبوسةٌ عليه باقية في بيته؛ فهل يتصور أن يُطلب منها الصبر مع كونه معسرًا؟
فنقول في مثل هذا: إن كانت تقدر على الصَّبر وإسقاط حقها والتَّنازل عنه، أو إن كان لها نفقة واعتاضت بالإنفاق على نفسها من مالها حتى يوسر الزوج؛ فهذا هو الأتم، وهي مأجورة فيما صبرت عليه، ومأجورة فيما أنفقت من مالها، وتنتظر من الله -جلَّ وعَلا- الأجر العظيم، وحقها باقٍ على زوجها، فإن لم يُنفق عليها -مثلًا- ثلاث سنوات ثم أيسر، فلها أن تطلب نفقتها، إلا أن تكون قد أسقطتها، كأن تقول: لا أريد منك شيئًا؛ فليس لها بعد ذلك أن تطلب ما أسقطته، فإن السَّاقط يسقط بمجرد الإسقاط، حتى ولو قال الزوج حقك سيأتيك؛ فإنها بمجرد أن أسقطت حقها عن الزوج فإنه يسقط؛ لأنَّ بعض النساء تسقط النفقة ولا يسقطها الزوج، ثم يتغير الحال وتعود الزوجة وتطلب، والصَّواب أنها ليس لها أن تطلب إلا إذا كانت لم تسقط حقها.
إذن؛ إن قدرت على الصبر صبرت ولها حقها وهي مأجورة في الصبر وفيما يتبع ذلك من النفقة.
وإن لم يكن لها صبر؛ فلها أن تطلب الطلاق، ويكون الطلاق على المعاوضة؛ لأنَّ لها النفقة، فإذا فاتت النفقة لم يكن لها أن تصبر على ذلك ولا أن تُحبَس عليه.
قال المؤلف: (أَوْ مَنَعَهَا)، بعض الأزواج فيه شحٌّ شديد أو فيه كراهيةٌ لها، ويُريد أن يكون منها نُفرة -نسأل الله السلامة والعافية- ولو فعل ذلك لكان آثمًا، وعليه تبعة ذلك عند الله -جلَّ وعَلا.
قال: (أَوْ مَنَعَهَا، فاَخْتَارَتْ فِرَاقَهُ، فَرَّقَ اْلحَاكِمُ بَيْنَهُمَا)، وإذا لم تطلب الفراق؛ فالحاكم يطلب الزوج ويُلزِمه بالنفقة إن كان ممتنعًا، أمَّا المعسر فليس للقاضي أن يُلزمه، إنما عليه أن يحسب ما لها من النفقة، فإن أيسرَ أعطاها وإلا ذهب ذلك.
ولو قالت: أنا لا أريد هذا ولا نفقة، وطلبت الفراق؛ فذاك شأنها، فلا يفرق الحاكم بينهما إلا بطلب الزوجة؛ لأنَّ ذلك حق لها، وقد يكون في صبرها مع ما فيه من الشقاء والعناء أهون ما يكون في الفراق مع ما تتخلص به من هذا الزوج الشَّحيح الذي يماطل ويمنع الحقوق.
قال: (سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كَبِيْرًا أَوْ صَغِيْرًا)، فإنَّ الحاكم يقوم بفسخ النِّكاح مقامه إذا طلبت المرأة ذلك وكان منه امتناع عن حقها.
{قال-رَحَمَهُ اللهُ تَعَالَى: (وَإِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً لاَ يُمْكِنُ اْلاِسْتِمْتَاعُ بِهَا، أَوْ لَمْ تُسَلِّمْ إِلَيْهِ، أَوْ لَمْ تُطِعْهُ فِيْمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا، أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ بِإِذْنِهِ فِيْ حَاجَتِهَا، فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ)}.
هذه أحوال تسقط فيها نفقة الزوجة:
إذا كانت صغيرة لا يُمكن الاستمتاع بها؛ فيقول الفقهاء: إنَّ النَّفقة مقابل الاستمتاع، فكما أنه يستمتع بها وتقوم عليه، فكذلك النفقة مقابل ذلك.
وكما قلنا: إنَّ الفقهاء ينصُّون على الاستمتاع؛ لأنَّ هذا هو الواجب عليها، والنَّفقة تُقابل ذلك، وإذا قلنا: إنَّ الواجب الاستمتاع وما يتبع ذلك مما هو معروف من حال أمثالها من خدمة ونحوها، فإنَّ النَّفقة تستحق بقدر ما يكون منها من القيام بما وجب من الخدمة والاستمتاع، أو الاستمتاع وحده بحسبِ ما يكون من حالهما.
قال: (أَوْ لَمْ تُسَلِّمْ إِلَيْهِ)، لو امتنع أهلها من تسليمها له، أو امتنعت هي من تسليم نفسها، ولا نقول: إنها امتنعت بعد شهر أو شهرين من تسليم نفسها وذهبت إلى القاضي وقالت: إنه لم يُعطها نفقة الشهرين! نقول: أنتِ لم تُسلمي نفسك!
وفي هذه الحالة يحكم القاضي أن لا نفقة لها إلا من أول يوم تكون عند زوجها.
قال: (أَوْ لَمْ تُطِعْهُ فِيْمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا).
إذا كانت ناشزًا فلا نفقة لها، فكما أنها ترفَّعت عن حقه؛ فلا يجب عليه الحق الذي لها؛ فإن الحق مقابل لما تبذله.
قال: (أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ).
لأنها لو سافرت بغير إذنه لفوَّتت الحق الذي عليها، فإذا كانت لا تصوم ولا تصلي النفل إلا بإذنه؛ فمن باب أولى ألا تسافر إلا بإذنه، وأنها لا تخرج من باب الزوجية إلا بإذنه؛ لأنها محبوسة عليه، وممنوعة من الخروج إلا بإذنه كما دلَّت على ذلك الأدلة.
قال: (أَوْ بِإِذْنِهِ فِيْ حَاجَتِهَا)، كأن تكون تذهب مع والدها أو ترافق والدتها أو تسعى على أختها، أو غير ذلك من الحاجات التي تكون لها، أو ذهبت في وظيفة، فإنها لا نفقة لها عليه واجبة، إذا أحسَنَ أو بذل وتبرع فهذا ما يكون من تمام ما يكون بين الزوجين من الأنس والمؤانس، والمواضعة والمحبة والألفة؛ فيكونمأجورًا، ولكن من حيث الواجب فلا يجب عليه شيء من ذلك، ولذا قال المؤلف: (فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ).
{قال-رَحَمَهُ اللهُ تَعَالَى: (فَصْلٌ: حَقُّ الزَّوْجَةِ فِي الْمَبِيْتِ وَحُكْمُ اِلإِيْلاَءِ.
وَلَهَا عَلَيْهِ الْمَبِيْتُ عِنْدَهَا لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَمَانٍ إِنْ كَانَتْ أَمَةً)}.
عقد المؤلف -رَحَمَهُ اللهُ تَعَالَى- هذا الفصل فيما يتعلق بما يجب لها من المبيت، وذكر المؤلف هذا الفصل في باب القَسْم؛ فلو أنه جمعه في هذا لكان أولى، ولكن أيًّا كان نذكر ما يذكر المؤلف هنا، ثم نعيده في الباب القادم.
قال: (وَلَهَا عَلَيْهِ الْمَبِيْتُ عِنْدَهَا لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً)؛ لأنَّ الرجل له أن يتزوج أربع نساء حرائر، فبناء على ذلك نفترض أن لديه أربع نساء؛ فإنه يبيت ليلة عند كل واحدة.
ولو انفرد ثلاث ليالٍ فإنَّ المشهور في المذهب عند الحنابلة أن ذلك صحيح.
وأصل ذلك: أنَّ امرأة ارتفعت إلى عمر -رضي الله عنه- فذكرت ما عليه زوجها من العبادة والصلاح وكثرة قيام الليل ونحوه، فقال عمر: ما أحسن هذا! فاستحيت المرأة فانصرفت، وكان بحضرة كعب بن يسور، فقال: لقد أبلغت في الشكوى يا أمير المؤمنين. قال: وما ذاك؟ قال: إنها تشتكي أن زوجها لا يقوم بحقها. قال: ما أحسن هذا، فأمر بها فرجعت. فقال عمر لكعب: احكم فيها، فإنك فهمت منها ما لم أفهم. فقال: أفرضُ لو كان لها ثلاث ضرائر، فيكون لها ليلة من أربع، فأذن للزوج أن ينفرد ثلاث ليالٍ يُصلي ما شاء، ولكن الليلة الرابعة يكون عند زوجته ويقوم بحقها. فقال عمر: ما هذا بأقل من أمرك الأول.
فكان دليلًا على فقهه وحسن نظره، ولذلك ولَّاه عمر -رضي الله عنه- قضاء الكوفة بعد ذلك.
قال: (وَمِنْ كُلِّ ثَمَانٍ إِنْ كَانَتْ أَمَةً)، هذا على ما يذكره الفقهاء من أنَّ الأمة على النِّصف من الحُرَّة، وهذا محل إجماع بينَ أهل العلم لِمَا جاء في قول الله -جلَّ وعَلا: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، وما جاء عن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- فقضوا أن العبيد والإماء في الأصل على النصف، إلا ما استثني، وذلك في مسائل قليلة ربما تأتي الإشارة إليها.
هل للأمة ليلة من كل ثمانٍ أو من كل سبعٍ؟
مشهور المذهب عند الحنابلة: لها ليلة من كل سبع؛ لأنهم يقولون: ثلاث حرائر وأمة، فالثلاث حرائر لهن ست ليالٍ، والليلة السَّابعة للأمة.
ولكن هنا اعتبروا أربع حرائر يعني ثمان ليالٍ، فجعلوا لها واحدة من ثمان، وهذا أحد القولين عند الحنابلة، وإن كان خلاف المشهور من المذهب عندهما.
قال: (إِذاَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْر)، أمَّا إذا كان له عذر فإن له أن ينصرف، كأن يعرض له سفر، أو يكون هذا رزقه يحتاج فيه إلى أن ينشغل في ذلك أربع ليالٍ أو خمسًا أو أسبوعًا أو نحوه، فهو على ما عليه من العمل، ولا يلزمه أن يجيبها إذا طلبته، ولا أن يأنس بها إذا أرادته وهو في شغل أو فيما يتحتم عليه من أمر الدنيا أو سوى ذلك.
سيذكر المؤلف بعد ذلك أحكامًا تتلعق بالإيلاء، فلعنا -إن شاء الله- نجعلها في الحلقة القادمة.
{وفي الختام نشكركم فضيلة الشَّيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم}.
وأنا أشكركم وأشكر الإخوة، وأستبيحكم عذرًا على ما جرى من الاسترسال في بعض المواضع والإطالة فيها، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
{جزاكم الله خيرًا. هذه تحيَّة عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته}.


![]() ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .