

|
|
|||||||
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
![]() ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
*«•¨*•.¸¸.»منتدى طلبة اللغة العربية و آدابها «•¨*•.¸¸.»*
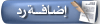 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
جماليّة الإيقاع في المعلّقات قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبيبٍ ومَنْزِلِ بِسِقْطِ اللِوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فحَوْمَلِ إنّ الصوت الأوّل في النّص كأنّه يأتي بمثابة إعلان عن الهويّة الإيقاعية للصوت الأخير فيه. والصوت الأوّل في البيت، يؤذن بالهويّة الإيقاعية للصوت الأخير منه... إنّا نُحِسُّ، منذ الوهلة الأولى، أنّنا أمام نظام إيقاعيّ مُتماسِكٍ تتركّب أنغامُه، خصوصاً، من أصوات وطيئة (من مخفوضات متلاحقة). ولكن هذه الأصواتَ المنخفضة المتلاحقة، المتضافرة المتغافصة، والآخِذَ أوّلُها بتلابيب آخرها: هي، في نهاية الأمر وأوّله أيضاً، جزء من نظام صوتيّ تقوم جماليَّتُه على حميميّة المضمون، وعلى سياق الحال، فأفضى إلى نظام للتركيب الإيقاعيّ الداخليّ الذي هو بمثابة الخزّان الجماليّ للإيقاع الخارجيّ الذي ماكان ليأتي، في الحقيقة، إلاّ تتويجاً لهذه الخلفية المتناغمة التي ازدانت بها منطوقات هذه القصيدة. ولقد نؤول أنّ الصوت المخفوض، أو المنكسر، أو الوطيء، هو أليق بالذات، وأولى بحميميّتها من سَوَائِهَ في هذا المَقام، وذلك على أساس أنّه يتلاءم، في اللغة العربيّة، مع ياء الاحتياز ( ياء المتكلّم) الدّالّة على الامتلاك والأحقّيّة. وَلِمَّا اقتنعْنا بهذا التمثّل ربطناه بنصّ معلّقة امرئ القيس الذي بصرف الطرف عن الأحشاء، والأعاريض والأَضْرُبِ، والأضْرُبِ، بلغة العَروضيّين، أو الفونيمات بلغة الصَّوْتانِيّينّ، والتي تمثّل أواخِرَ المصاريع خصوصاً - وهي تمتدّ على مدى نصّ المعلّقة -فإنه اشتمل على سِمَاتٍ لفظيّة كثيرة: إمّا لأنّها تنتهي بصوت وطيء، أو منخفض، وهو الصوت الذي زعمنا أنه يرتبط بالذات، ويتمحض لباطن النّفس، وذلك لأنه كثيراً مايرتبط بياء الاحتياز؛ وإمّا لأنّها تدلّ على حميميّة المدلول. إنّ الإيقاعَ الداخليّ، كما يجب أن يتبادَرَ إلى الأذهان، نقصد به إلى العناصر الصوتيّة، أو السمات اللّفظية، التي تأتَلِفُ منها الوحدة الشعريّة (البيت) بِجَذاميرها، والتي تشكّل هي في ذاتها، مع صِنْوَتِها، هيئة النص الشعريّ المطروح للقراءة، بحذافيره. وقد كُنّا لاحظّنا منذ قليل أنّ هذا الإيقاع، في تشكيلاته الكبرى، يتحكّم فيه الصوت المنخفض الدالّ، في رأينا، على الانهيار، والبّثّ، والحزن، والحرقة، وإذا غَضَضْنا الطْرف عن الصوت الساكن الذي لا يأتي في الكلام إلاَّ لِلْحَدِّ من الحركة الصوتيَّة وقمعها، أو التلطيف من غلوائها وعنفوانها؛ فإنّ العناصر الصوتيّة المنخفضة، هنا، هي السائدة المهيمنة، والماثلة المتحكِّمة. ولعلّ هذا الأمر أن يندرج ضمن هذا الوضع المتدّنّي لمعنويّات يندرج ضمن هذا الوضع المتدّنّي لمعنويّات نفس النّاصّ. ونحن حين جئنا نتابع العناصر اللفظية المُفرزة للأنغام، ونتقصّى طبيعة أصواتِها، ألفينا مالا يقل عن عشرين عُنْصَراً اتّخذ له الصوت المفتوح (منها اثنا عشر صوتاً مفتوحاً ممدوداً): قِفَا- ذِكْرَى- اللِّوَى- بَيْن- فَتُوضِح- رسْمُها- لِمَا- نَسَجَتْها- تَرَى- بَعَرَ- عرصاتِهَا- قِيْعَانِهَا- غَدّاةَ- يَوْمَ- لَدَى- بِهَا- عليَّ- لا- وإنَّ- عِنْدَ (وقد رصَدْنا ذلك من الستة الأبيات الأولى من المعلّقة). ودلّت الهيمنة النسبية للصوت المفتوح على أنّ حال الشاعر كانت تستدعي البثّ والشكوى، والحنين والبُكى، لأنّ الذين يَشْكِي أو يبكي مضطرّ، في مألوف العادة، إلى أن يرفع عقيرته كَيْما يَسْمَعُهُ الناسُ ويلتفتوا إليه. ولأمر ما كانت حروف النداء، في اللغة العربيّة، مفتوحةً كلّها (أ- أيْ- يَا- أيّا- هيّا....): ولعلّ ذلك من أجل أن يُسمَع المُنادِي حاجته، ويبلّغَ لهم رسالتَه، وَيَسْتَبين عمّا في نفسه من كوامِنِ الأسرار، ومكنون الأخبار، الدعاءُ مدٌّ للصّوت، والشكوى مدٌّ، أيضاً، لهذا الصوت، والحنينُ، من بعض الوجوه، مَدٌّ للصوت. ويكون الصوت في مثل هذه الأطوار مفتوحاً لينفتح به الفم، ولتنطق به الحنجرة حال كونها مفتوحةًً، ولتنادي به العقيرة في الهواء، ولترتفع به في الفضاء. أمّا العناصر الصوتيّة المنخفضة الأخرى، والمشكّلة للإيقاع الداخليّ، أو لكثير منه، في الطليّة المرقسيّة؛ فإنها بلغت، هي أيضاً، زهاء ثمانيةَ عَشَرَ عنصراً صوتيّاً، وهي (وراعينا في ذلك النطق الفعليّ، لا الحالة النحويّة في مثل "في"، وفي مثل "كأنّي"): نَبْكِ- ومنزل- بسِقْط- الدُّخولِ- فَحَوْمَلِ- فالمقراةِ- وشمأَل- الاْرآمِ- في -فُلْفِل، كأنّي- البينِ -سَمُراتِ- الحيِّ- الحيّ- حَنْظّلِ- صَحْبِي- وتجَمَّلِ- شِفَائِي- مُعَوَّلِ. وإذا توسّعنا في استقراء القراءة وجاوزّنا بها الستةَ الأبيات الأولى إلى مابعدها نصادف سِماتٍ كثيرةً تنتهي منخفضةَ الصوت. ودالّة على الحميميّة والامِتلاك.. مثل قوله: (شِفائِي- دَمْعي- مِحْمَلي- مَطِيَّتي- يا امرأ القيس- بعيري- ولا تُبعِديني- وتحْتي- صَرمْي- أغرّكِ- مِنّي- حُبَّكِ- ساءَتْكِ- فسُلّي- ثيابِي- أمْشي- فُؤادي- هواكِ- فيكِ- مِنّي- حَرْثي- أغتدي- بعيني- أصاح- وصَحْبَتِي... وإذا حقّ لنا أن نؤوِّلَ هذا السعيَ الماثل في النّص، فسيكون، مثلاً، أنّ الناصّ إنما اصطنع الأصوات المنخفضة على دأبه في التعامل مع المنخفضات من الأصوات، من أجل أن يدلّ بها، في رأينا على الأقلّ، على انقطاع الماضِي، وموْت الزمن الفائت، وذهاب الحال، واستحالة الأمر. وقد لاحظنا أنّ الأصوات المكسورة [والمكسور، من الوجهة اللغويّة، مقهور- ومن الوجهة الإحصائية] متقارِبَةُ العدد مع الأصوات المفتوحَةِ الآخِرِ: ولعلّ ذلك لتناسب حالة الحنين والشكوى والبثّ المعبَّر عنها بالأصوات المفتوحة الممدودة، وغير الممدودة، بحالة الزمن المنقطع، والماضي المندحر، والأمس المندثر. فهناك إذن تلاؤُمَ تامّ، وانسجامٌ عجيب، بين الأصوات المنفتحة، أو الأصوات الممتدّة إلى نحو الأعلى، والأصوات الممتدة إلى نحو الأسفل: في التعبير عن الراهن من الحال، والدّلالة على الوضع القائم في ذات الناصّ ونفسه. وهناك سمات صوتيّة أخراةٌ تَرِدُ في النسج الداخلي للإيقاع، بعضها حميميّ خالص، وبعضها له صِلَةٌ بالحميميّة حين يُذابُ في النسيج العامّ للنّصّ، وذلك مثل: عَقَرْتُ- دَخلْتُ- فقُلْتُ- فألهَيْتُ+ها- تمتَّعْتُ- تجاوزْتُ+ فجئت-خرجت+ هصرت-فقلت- جعلت- قطعت+ه- فقلت. -طرقت.- عقرت... ومثل: بنا- وراءنا- أثرَيْنا- يا (امرأ القيس)- وما (أن أرى)- انتحى- بنا- أرخى- عصامها- لمّا- عَوَى... إنّ الصوت الخارجيّ (الرّويّ) الطاغِي على النّصّ ليس إلا صورة للأصوات الداخليّة المُتتالية المتناغمة، والتي تتّخّذ لها سَلالم صوتيّة مختلفة بين الامتداد المفتوح، والانكسار المخفوض، وكُلُّها ذو صِلَةٍ بحميميّة النفْس، وجوانيّة الذات للناصّ: التي كانت بمثابة المُرْتَكَزِ الحصين الذي يرتكز عليه الصوت الخارجيّ، وإذا وَفُرَ للإيقاع، بنوعيهْ، أصواتٌ داخليّة تدعمّه وتُثريه، وصوت خارجي، يُزِيْنُه ويُؤْوِيه، كان غنيّاً سَخِيّاً، وطافحاً عبقريّاً.
والحميميّة التي ردّدناها، والتي نردّدها كًثيراً في هذه المقالة، كما رأينا بعد، ترتبط ارتباطاً داخليّاً بنفس الناصّ، وحُبّه، وسيرته، وهمومه، فالذات، في هذا النّص، هي الطاغية؛ إذ لم يكد يخاطب إلاّ بعض أصحابه، وبعض حبيباته، وبعضَ ليلهِ، وبعضَ ذئابه (على الرغم من أنني أذهب مع من يذهبون من القدماء، إلى أنّ الأبيات الأربعة التي يتناول فيها الذئبَ ومحاورته ليست له). وماعدا ذلك فصوت الناصّ هو الطاغِي، وذاتيّته هي الطافحة، وحميميّته، هي البادية الماثلة. إنّ الإيقاع في معلّقة امرئ القيس لم يكن، من منظورنا على الأقلّ، اعتباطِيّاً تركيبُه، ولكنه ينهض على نظام صوتيّ موظّف عبر النسج الشعريّ بحيث نلفي الدالّ -وهو السمة التي تمثّل الصوت- يُحيلُ على المدلول؛ والمدلول يحيل على الدّالِّ، في انتظام وانسجام، وتناسق والتحام. ولا يُصادفنا إلا شَيءٌ من ذلك حين ننزلِق إلى الحديث عن معلّقة طرفَة التي تطالعنا فيها حميميّة طاغية. وإنما قلنا: طاغية؛ لأنّ دوالَّها أوفرُ كثرةً، وأوسَعُ انتشاراً في هذا النصّ، من معلّقّة امرئ القيس نفسها، كما نصادف فيها فيْضاً من "الفونيمات" المنخفضةِ الأصواتِ التي كانت هي أيضاً بمثابة خزّانِ سخيّ للمنظومة الصوتيّة العامّة التي يتركّب منها نسج المعلّقة. ومن العجيب أنّ أوَّلَ حرف، في أوّلِ لفظٍ، في أوّل بيْتٍ، في هذه المعلقة يبتدئ بالخفض: مثل أوّل حرف، في أوّل لفظ، في أوّل بيت -أيضاً في معلّقة امرئ القيس، حَذْوِ النعلِ بالنعلِ. ونلاحظ في نصّ طرفة أيضاً فئتين اثنتيْن من الأصواتِ: فئة الأصوات المنخفضة، وهي التي تركض، فيما نزعمه، في مركض الحميميّة التي تَسْتَمِيزُ بها قصيدة طرفة، وفئة الألفاظ التي وإن لم تكن منخفضة من حيث هي سِماتٌ صوتية، إلا أنها دالة على ذلك من حيث هي مدلولات. ويمكن أن نمثّل للفئة الأولى ببعض مايلي: صَحْبي-وإنّي- صاحِبي- تَبْغِني- تلْقَني- تلتَمسْني- تُلاقِني- تَشْرابي -ولذَّتي- وبِيْعي- وإنفاقي- طريفي- ومُتْلَدِي- تحامَتْني- سْبقي- وكَرّي- فَما لي- أرانِي- وابنُ عَمِّي- عَنّي- يلومني- لامَنَي- وأيأسَنِي.... وهلمّ جرّا ما تَكَلُّفُ إدراجِه، كلّه، قد يثقل كاهِل هذه المقالة، ويمدُّ في طولها، فعسى أن يكون هذا التمثيل كافياً لمن أراد أن يتابع ذلك في معلّقة طرفة حيث وصلّنا به، نحن، إلى زهاء إحدى وستّين حالة منطلقة من ذات الناصّ، أو صابّة في فيضه الذاتيّ الثرثار. أمّا الشقّ الثاني لحميميّة هذا النّصّ، تلك الحميميّة التي نربطها بالإيقاع الخارجيّ المنخفض الصوت: فيتمثّل، هو أيضاً، في فيض من السِّمات الصوتية الضاربة في هذه الحميميّة، الحائلة عليها، أو المنطلقة منها، وذلك مثل: وإنّي -لأمْضي- وإن شئتُ- وإن شئتُ- وإن شئْتُ- أمْضِي- خِلْتُ- أنّني- عنيت- لم أكْسَلْ- لم أتبلَّدْ- أحَلْتُ- ولسْتُ- أَفِرْدْتُ- رأيت- أبادر- أحفل- أرى- أرى- أرى- أدرى- نشدت- أغفل- قرّبت- وأنْ أدع- أكُنْ- أشهدَ- أجهدَ- أسقهم- أحدثته... وهلمّ جرّا ممّا عَفَفْنا عنه من ألفاظ أخراةٍ باقية كثيرة تدلّ على حميمية المعنى، وذاتيّة المدلول، ويكون لها أثناء ذلك دور في إغناء الإيقاع بالأنغام الصوتية المتماثلة، أو القريبة التماثل... ويأتي عنترة في المرتبة ذاتها، أو في مرتبة من الحميميّة قريبة من مَرْتَبَتَيْ ضَرْبَيْهِ امرئِ القيس، وطرفة. وواضحّ أنّ ذلك يعود إلى طغيان الذاتيّة لدى هؤلاء الثلاثة المعلّقّاتيّين لأنّ غايتهم، من قول الشعر، لم تكن للحكمة أساساً، ولا لالتماس صلح بين قبائل متحاربة (زهير)، ولا لالتماس الفخر بالقبيلة والتغنّي بأمجادها (عمرو بن كلثوم)، ولا لتجسيد اللوم والتثريب، والتوبيخ والتقريع، لخصوم القبيلة (الحارث بن حلّزة)؛ لكنّها كانت للتعبير عن النفسْ، والترويح عن القلب، والتغنّي بالذّات، ووصف ماله صلة بها كالرّكوبة، والحبيبة، والفَرَس، ومجالس اللهو، والشراب... علاقة الإيقاع بالنسج الشعرّي لدى عنترة ولمّا كانت الميم شَفَويّةً، فكأنها حرف الذات، وصَوْتٌ للنفس، إذ الشفتان تنضمّان عليه كما تنضّم الرّحِمُ على الجنين، وكما ينطوي الكِمُّ على الوَرْدَةِ قبل أن تنشق عنه، وكما يَشُّدُّ كُلُّ امْرئٍ على ذي قيمة. ونلاحظ أنّ الميم حين تكسر، تظلّ محتفظة بالصوت، وحين تخرجه، لدى نهاية الأمر، تُلْقِيَ به نحو الأسفل، نحو القلب، نحو الجوانح... كذلك نتمثّل أمر وظيفة هذا الصوت... على حين أنّه حين يُفْتَح، يطيرُ به الصوت في الهواء، وينتشر في الفضاء. أمّا حينَ يُضَمُّ، فإنّه يتلاشى في الهواء، ولكن نحو الأمام من وجهة، ولمَدَّى من الانتشار، يقلَّ عن الانتشار الذي يتمخّض للصوت المفتوح -وخصوصاً حين يمتدّ- من وجهة أخراة. من أجل كلّ ذلك وافَقَ صوْتُ الميم المنخفض دلالة النسج على المدلول، وهو هذه الحميميّة التي تصادفنا في معلّقة عنترة حيث إنّ هناك مالا يقلّ عن ستٍّ وسبعين حالةً يقترن فيها السِّمَةُ الصوتيّة بياء الاحتياز، أو همز الأَنَا، أو تاء المتكلّم، أو مافي حكم ذلك.. ممّا يجعل من معلّقة عنترة، من الوجهة النسجيّة: نصّاً يدور في دائرة معلّقتي امرئِ القيس وطرفة حيث كنّا رأيناهما، هما أيضاً تحملان كثيراً من هذه السمات الصوتيّة: الرويّ المكسور غير الممدود، وهو الصوت المقترب من النفس والذات، واستعمال اللاّم التي يمكن أن نطلق عليها لام الامتلاك، واصطناع الدال، وهي حَرْفٌ صوته يقترب من النطق الشفويّ (تُصَنَّفُ الدالُ حَرْفَاً لَثَوِيّاً، لأن مبدأ نطقها من اللّثّة) الذي يعني شَيْئَاً من الحميميّة والانغلاق على النفس، والانْزِواء داخل حيز الذات... فلو كان حرف الرويّ الذي هو الميم، هنا، مضموماً لكان رمى بكلّ شيء إلى الخارج، ولألْقَى بكلّ القيم الدلاليّة نحو العَدَم؛ لكنّ هذه الميم خُفِضَتْ؛ فكان خفضها من أجل إرسالِ هذه القيم الدلاليّة إلى نحو الأسفل، إلى نحو القلب والذات، والإحالة بها على الماضي الغابر على أساس أنّ النُّصَّاصَ، هنا، يسردون ذكرياتٍ وأحداثاً ممّا كان وقع لهم في بعض ذلك الماضي. ولقد ظاهرت هذه السِتَّةُ والسَّبْعُونَ عُنْصَرَاً المكسورة الآخِرِ، وفي نصّ معلّقة عنترة، على التمكين لِمّا نُطْلِقْ عليه حميميّة الإِيقاع الناشئة عن اغتفاص هذه الاحْتِيازات الكثيرة، والتي منها ناقِتي- وحشيّتي_ مخالقتي- مالي- وعِرضي- شمائلي- وتكرّمي- يدايّ- كِفّي- عهدي- لبّي- جاريتي- نعمتي - عمّي- مقدمي- دمي...- لي- إليّ... وهناك سِمات أخراة تحيل على الذَّات، والداخل، والحميميّ، ولكن لا يعبّر عنها بياء الاحتياز، ولكن بأدوات أُخراةٍ مثل تاء المتكلّمْ، وهمزة المضارع الدالّ على المفرد المتكلّم، مثل: فوقفت- أقتل- أبيت- ظُلِمْتُ- أظلم- تركت- شَرِبْتُ- صَحْوتُ- أغشى- فشكَكْتُ- فتركتُه- نزلت- قطعتُ+ـهُ- فبعثْتُ- نُبِّئْتُ- حفظت- رأيت- مازلت- شئت... كما أنّ هناك سماتٍ دالّةً على الذات؛ ولكن بصورة غير مباشرة مثل: مِنّي- راعَنِي- دُونِي- إنني - عَلَيَّ - بي - ولكنّني- مشايعي... وكلّ ذلك كان من أجل التمكين للنسج من أن ينسجم مع المنسوج، وجعل الدّالِ يتماشى مع المدلول؛ إذْ لمّا كان الإيقاع الخارجيُّ مكسوراً فإنه كان- والحال إنّ الشعر جمالٌ وسحر وقول يبهر ويدهش، وكلام يمتع ويؤنس- مُنْتظَراً أنْ تتلاءَمَ مُعظمُ النسوج (الألفاظ، أو السمات الصوتية، المنتسجة منها الجُمَلُ داخل النّص) بأن تنتهي، هي أيضاً، بالكسر، أو بياء الاحتيازِ (ياء المتكلّم) الناشئة عن الكسر، أو المُنْشِئَة لهذا الكسر المُحيل على الذات الدّالَّة على الحميميّة المتقبّلة كلّ ما يأتيها من الخارج لتختزنَه في الداخل المضطرِبِ فَتَزْدَخِرَ بِهَ ازْدخاراً... فهؤلاء المعلّقاتيّون الثلاثةُ، كما رأينا، (وإن لم نعمّق تحليل الإيقاع في نصوص معلّقّاتهم، لأسباب منهجيّة...) تشيع في قصائدهم الحميميَّةُ بمعنَيَيْهَا لدينا: ياءِ الاحتيازِ، وضمير المتكلّم المفرد. ويمكن أن نصنّف لبيداً ضمن الخاصيّة النسجيّة الأولى حيث وردت في معلّقته سِماتٌ صوتيّة كثيرة تَرْتَكِضُ مُرْتَكَضَ الثلاثة أتيْنا عليهم ذِكْراً في هذه المقالة. وقد أحصيْنا من ألفاظ الحميميّة في معلّقته ما أناف على الثلاثين. فكأنّ لبيداً يمثّل حلقةَ وصْلٍ بين السبعة، وكأنّه يقترب، في هذه الخاصيّة الإيقاعيّة، من الثلاثة الأوائل دون أن ينضِويَ، مع ذلك في لِوائهم، ويدرج في فَلَكهم، فكأنَّه، إذن، في الوقت ذاته، يَزْدَلِفُ من الثلاثة الأواخِر (ولفظ "الأواخر" هنا لا يعني إصدار حكم قيمة، وأنّ هؤلاء الثلاثة أدنى شاعريّةً من الثلاثة الذين توقفنا، في هذه المقالة، لدى بعض عناصر الإيقاع في شعرهم، ولكنه يعني مجرّد نظام الحساب...) على نحو ما... إنّ حميميّة لبيد لا ترقى إلى تشكيل ظاهرة نسجيّة، تمثّل جهازاً صوتيّاً يمدّ الصوت الخارجيّ بالأنغام على نحو ما كنّا ألفيناها لدى طرفة، وبدرجة أقلّ لدى امرئ القيس، فإنما كان لبيد يصف حالاً، ويتحدّث عن وضع كأنه كان يعيشه قبل، أو قُبَيلَ، إنشاءَ هذه المعلّقة التي يبدو أنها تعرضت لتنقيح شديد... فنسْج شعره يقوم إيقاعُه على مايمكن أن نطلق عليه الروح السرديّة أكثر ممّا يقوم على الحميميّة. وينهض إيقاعه على الإحالة على ماضٍ قريب حتّى كأنّه حاضر ملفوف فيه: مُهَا. فالضمّ الوارد قبل الفتح، في الإيقاع الخارجيّ، يُبعدُ الحميميَّة، وهَا الممدودة تُدْنِي النًّسْجَ من الحاضر، بمقدار ما تَزْدَجِيهِ نحو الماضي. فكأنّ الماضِيَ، هنا في تمثّلنا نحن على الأقلّ، يمتزج بالحاضر، والذاتَ تذوب في الآخرَ، كما أنّ الآخَرَ يذوب في الأنّا. من أجل ذلك تمازجت النسوج بالإيقاعات، فكانت تحيل على الخارج، ولكن انطلاقاً من الداخل المتمثّل خصوصاً في صوت الميم الدال على الحميميّة، حتى وإن كان مضموماً فإنه باعتبار ميميّته- أي باعتبار مخرجه الشفويّ الذي يستدعي أن تَضْطَمَّ عليه الشفتان معاً- يظلّ محتفظاً بمسحة من هذه الحميميّة. بينما نُلفي هذه الحميمية تضعُف لدى زهير، وعمرو بن كلثوم، والحارث بن حلّزة، وتحلّ مَحَلّها؛ وخصوصاً لدى الحارث وعمرو، نَا الدّالةُ على الجماعة، المنبثقةُ عن ضمير القبيلة وصوتها الجمّاعيّ. وإذا كان زهير لم يكد يورد من ألفاظ الحميميّة إلاّ زهاء اثني عشر لفظاً، فَبِمَا إغراقهِ في التأمّلّية؛ وَبِمَا نَهْيِهِ عن الانغِماس في رِجْسِ الحرب؛ وبما دعوته الناسَ إلى السلم وترغيبهم في الجنوح لها حيث كانوا، إذ لا يَجْنُون من الحرب إلاّ المآسيَ والشقاء، والإحن والعذاب. ونلفي عمرو بن كلثوم والحارث بن حلّزة يتفرّدان بالإضراب- والشأن منصرف إلى الإيقاع الداخليّ في معلقتيهما-
|
||||

|
|
|
رقم المشاركة : 2 | |||
|
الصورة الأنثويّة للمرأة في المعلّقات ما أكثر ماتحدّث الناس عن المرأة في الشعر الجاهليّ، وما أكثر ماتوقّفوا لديها فتحدّثوا عن رمزيّتها، وواقعيّتها، ووضعها الاجتماعِّي... لكنّ أحداً، في حدود مابلغْناه من العلم، لم يتناول المرأة الجاهليّة على هذا النحو الذي عليه نحن تناولناه: فالأَوْلَى: إنّ الكتابات التي كُتِبَتْ عن العصر الجاهليّ، والتي أتيح لنا الإِلمام عَلَيْهَا، لم تحاولْ تناوُلَ المرأة، من خلال النصوص الشعريّة، على نحوٍ أُحاديٍّ: متمخِّض لها، ووقف عليها، ولكنها تناولها إمّا عَرَضَاً، وإمَّا مُعَوِّمَة إيَّاهَا في القضايا الأخراة التي عرض الشعر الجاهليّ لها. وفي ذلك شيء من الإجحاف بحقّ المرأة العربيّة، وتقصير في ذاتها. والثانية: إننا عالجنا وضع المرأة الجاهليّة، أو المرأة العربيّة قبل الإسلام، وعلاقتها بالرجل من خلال نصوص المعلّقات السبع وَحْدَها، وقد تعمدّنا وَقْفَ هذه الدراسة على هذه المعلّقات تخصيصاً، توخّياً للتحكّم في البحث، إذا لو وسَّعْنا دائرة سعْيِنا إلى الشعر الجاهليّ كلّه لَخَشِينا أن لا ننتهي إلى رأيٍ رصين، وأن لا نتمكّن من إصدار حكم مبين. والثانية: إننا حاولنا معالجة هذا الموضوع بمنهج ركّبناه، في مجازاتٍ متعدّدة منه: من السيمائيّة والأنتروبولوجيا معاً، وذلك ابتغاء الكشف عن وضع المرأة في المجتمع الجاهليّ، ونظرة الرجل إليها، وهي النظرة التي كانت تقوم، في الغالِب، على اعتبار أُنْثَوِيَّتها وأُنُوثتها جميعاً، وليس على اعتبار أنها كائن إنسانيّ عاقلّ، حسّاس، وأنّها شقيقة الرجل، وأنّها ، إذن، عضو فعّال ومؤثّر في المجتمع.. وربّما فزعنا، أثناء تحليل الأبيات المستشهَدِ بها حَوالِ المرأةِ في المعلّقات، إلى الإِجراء الجماليّ، أيضاً. والأخراة: إننا لم نُرَكِزْ على الآَراء المعروفة التي قُرِرت من حول المرأة الجاهليّة - إلاّ ماكان من مناقشة الدكتور البهبيتي الذي ذهب إلى رمزيّة المرأة في المعلّقات - قبلنا، هنا وهناك. وتوّخينا التقاط الأَبَاِييتِ التي تحمل دلالةً ما: إمّا سيماءَوِيَّةً، وإمّا أنتروبولوجيّة: اعتقاداً منّا بأنّ مالم نتناولْه، نحن في هذه الكتابة، قد يكون سَوَاؤُنَا تناولَه قبْلَنَا: منذ الأعصار الموغلة في القدم، وإلى هذا العهد. ***** أوّلاً الحضور الاجتماعي ّ للمرأة في الجاهليّة إنّ وَأْدَ كِنْدَة - وقبائل أخراةٍ كانت تحذو حذْوَها -بناتِهَا في الأَسْنَانِ المُبَكِّرةِ لَبُرْهَانٌ خِرّيتٌ على قوّة حضور المرأة في الجاهليّة، وعلى قوّة شخصيّتها، وعلى رِفْعَة مكانتها، في المجتمع العربيّ قبل الإسلام: لا على ضعف قوّتها، وقلّة حيلتها، وانحطاط منزلتها. وإنّ الآية على ذلك أنّ الوَأْدَ كان يقع للصبايا وهُنَّ في سنّ الرضاعة أو نحوها. وكان الحامل على ارتكاب تلك الجريمة البشعة هو خوف العار، فيما كان الوائدون يزعمون، ولكنّ القرآن العظيم فضح أولئك اللئام بأنّ وَأدَهُمْ بناتِهمْ، لم يكُ خشْيَةََ العار، ولكنه كان خشية الوقوع تحت ضائقة الفقر والإملاق(1). وقد صوّر القرآن الكريم الحال الحزينة التي تقارف بعضَ لِئَامِهِمْ حين كان تولد له جاريَةٌ؛ فقد كان وجُهه يسودّ، ومُحَيَّاهُ يَربَدُّ؛ فكان يُلِمُ عليه، من أجل ذلك، الحزنُ والعبوسِ، والكلوح والقطوب (2). ويبدو أنّ قرار الوأد، كما يفهم ذلك من نصّ القرآن الكريم، كان يتمّ، غالباً، في الأيّام الأولى من ميلاد الصبيّة. وكان الأعرابيّ ربّما غضب على امرأته وزايلها إذا لم تنجب له صبياً. وقد كان الناس يعتقدون أنّ الحليلة هي المسؤولة عن صفة جنس المولوَد، وذلك على الرغم من أنّ أعرابيّة أجابت بعلها حين غضب عليها وهجرها حولاً كاملاً: أَن وَضَعَتْ له صِبْيَّةً، بأنها لا تلد، في حقيقة الأمر، إلاّ ماكان يُزْرًعُ فيها(3). ولعلّ رجز تلك المرأة العربية يوحي بأنّ النساء كن يَرَيْنَ في أمر تحديد صفة جنس الجنين غير ماكان الرجال يرون. لم يكن أهل الجاهليّة، إذن، يئدون صباياهم لأنهم كانوا يخشَوْنَ أن يلحَقَهُم من جرّائِهَنَّ العارُ والشنار، ولكن الحق ماقاله القرآن. أي أنه كانوا يخشون الفقر والإملاق. وإنما كانوا يخشون ذلك لعلل كثيرة منها، في تمثّلنا: 1- إنّ الصبيّة في السنّ الأوّلى ربما أسهمت في النهوض ببعض الأعمال الاقتصاديّة اليوميّة البسيطة مثل رعي الأغنام، على مقربة من الحيّ، وذلك لانتفاء الظنّ عن تعرّضها للاغتصاب، ولِمَا لا يجوز من التخوّفات عليها 2- لكنّ الجارية مجرّد أن تقترب من سنّ المراهقة تُحْبَسُ في البيت حَبْسَاً، خَوْفَاً عليها مِمَّا لا يجوز.... وكان ينشأ عن ذلك السلوك أَنّ أباها، أو أخاها، هُوَ الذي يتولّى الإنفاق عليها، إذ تغتدي محرومةً من الإسهام في الحياة الاقتصادية الخارجيّة للأسرة: فإذا هي لا تذهب إلى الأسواق، ولا تزاول الأعمال التجارّية بنفسها، ولا تحتطب إلاّ من الأماكن القريبة جداً من الحيّ بحيث لا تغيب عنها عيْنُ الحيّ. وحينئذ ينحصر دَوْرَها في البيت الذي لم يكن مركز النشاط الاقتصاديّ للأسّرة... وتظلّ تنتظر الرجل الذي سيختطبها. ولعلّ من أجل هذا العامل الاقتصاديّ الخالص كان يتّمّ تزويج العربيّات في سنّ مبكّرّة جداً، ولا يبرح هذا الوضع قائماً إلى يومنا هذا في بعض البلدان العربيّة مثل اليمن؛ على الرغم مِنْ أنَّ تلك الأسبابَ زال بعضُها... والفتاة الشقية هي تلك التي كان يطول مُقامها في بيتِ أهلها فتَعْنس ولا تتزوّج... بينما شأن الفتى شأنٌ آخر. لا يخاف أبوه عليه، صغيراً وكبيراً. وهو إلى ذلك يستطيع أن يكلّفه ببعض المهمّات منذ بلوغه الأوّل. وهو في أسوأ الأحوال قادر على الإغارة مع القبيلة، كما يُعَدُّ للدفاع عن نفسه أوّلاً بِحَدِّ السيف؛ ثم الدفاع عن القبيلة آخِراً إذا دُهِيَتْ بداهية، وتعرّضُ أمْنُها للأخطار... الفتاة لا؛ لم تكن في منطق الظروف الحضاريّة البدائيّة السائدة قادرةًً على الدفاع لا عن نفسها، ولا عن قبيلتها، إلاّ من الإسهامات الخلفيّة للمعركة كَقَوْتِ الخيْلِ، وتضميد كِلامَ الجرْحَى؛ كما سنستنتنج بعض ذلك من بعض معلّقة عمرو بن كلثوم. فكانت المرأة من ذلك المنظور الجاهليّ اللّئيم عالةً على أسرتها؛ فكان يسارع بعض الطّغامِ إلى وأدها مجرّد ميلادِها. من الغريب في هذا الأمر أنّ الوائدينَ كانوا يَفْزَعونَ إلى المرأة زَوْجَاً، ويحرصون على مودّتها وإكرامها، كما كانوا يُحبّون، ويُحْبُونَ، معاً أخواتِهِمْ، ويحمونَهُنَّ مثل البنات والحليلات حين كانوا يُصَبَّحُوَنَ بالغارات. وكانت المرأة العربية إذا زُوِّجَتْ في الغُرباء ربما جَزِعَتْ وَحَزِنَتْ لمُزايَلَتِها مغانِيَ قبيلتها، ومفارقتها ديارَ عشيرتِها، كما يؤكد ذلك بيتان من الشعر ينسبان إلى امرأة من بني عامر بن صعصعة وقد زوّجت في طيئ : فاستوحشت المقام بين أهل بعلها، فقالت: لا تَحْمَدنَّ الدهرَ أُخْتٌ أخاً لَها ولا تَرْثِيَنَّ، الدَّهْرَ، بِنْتٌ لِوَالِدِ هُمُ جعلوها حيْثُ ليْسَتْ بِحُرَّةٍ وهُمْ طرحَوها في الأقاصي الأباعِدِ(4). ولعلّ تخوفّ المرأة العربيّة، على عهد الجاهلية، وجزَعها من التزوّج في غير بني قومِها: يعودان إلى انغلاق ذلك المجتمع، وبدائيّة وسائل المواصلات فيه: إذْ كان التنقل من صُقْعٍ إلى صُقْعٍ يتطلّب أيّاماً طِوالاً من السفر الشاقِّ، مع انعدام أمْنِ الطُرقاتِ، وقلّة موافاة القبائل؛ القبائل الأخراة. وإذا كانت المرأة، لدى امرئ القيس، وطرفة وعنترة: كأنّها لم تَكُ إلاّ للَّذاتِ والمُضاجعاتِ؛ فإنها، لدى عمرو بن كلثوم، كانت لذلك أيضاً، وذاك أمرٌ طبيعيّ؛ ولكنها كانت تُسهِمُ في الحروب مع الرجل، وكأنّ النساء كانت بمثابة القاعدة الخلفيّة التي يستمدّ منها الرجال القوّة، ويستلهمون من جمالها ولطفها الشجاعة وحسن البلاء في ساح الوغى: حمايةً لها، وحُبَّاً فيها، وتعلٌّقاً بأطفالها، وَنْضَحَاً عن شَرَفِها: على آثارِنا بيضٌ حِسانٌ نُحاذِرُ أن تُقَسَّمَ أو تَهُونا فقد كان الرجال -ولا يبرحون- من أن يقع نساؤهم تحت السبي فتُقَسَّمَ تقسيماً بين المُغيرين، أو تقع تحت وطأة المَهانة والعار. فكانت مشاركة النساء في الحروب مزدوجةً الفائدة: أنهن كنّ يَقُتْنَ خَيْلَ البُعولةِ، ويُشْرِفنَ على تمريض الكَلْمَى. كما كُنَّ، في الوقت ذاته، يَحْضُضن أولئك البعولَ على الثَّبات في ساحة الهيجاء، وإِلاّ تعرَّضْن للسَّبْي والغصب: يَقُتْنَ جِيَادَنا ويَقُلْنَ لَسْتُمْ بعولَتَنَا إذا لم تَمْنَعُونَا لقد تفرّد عمرو بن كلثوم، إذن، من بين كلّ المعلقّاتييّن؛ بتسجيل هذه الصورة الراقية لدور المرأة في العربية في ذلك المجتمع المتطاحِن المتحارِب المتصارع من أجل البقاء، بل من أجل الاستعلاء، إذ ليست المرأة لدى معظم المعلّقاتييّن، إلاّ لعبة جميلةً يتلذّذ بها الرجل، لأنّها تصلح لأن يُشْبِعَ منها رَغْبَتَه الجنسيّة: ثمّ لاشيءَ من وراء ذلك يوجد فيها من غَناء! على حين أنّها لدى عمرو بن كلثوم عضو مؤثّر في المجتمع: لها كامل الحقوق، وعليها كلّ الواجباتِ - ضَمْناً على الأقل- إذْ مَنْ يشارك في الحرب يكون له السهم المُعَلَّى في بقيّة مظاهر الحياة الأخراةِ: وهي دون الحرب خَطَراً، وأهون منها شأناً. ومن الآيات على شرف مكانة المرأة، وسمّو منزلتها على عهد الجاهليّة، وحرص الرجل الشديد على حمايتها في ذلك المجتمع المضطرب الذي لم يكن الاستقرارُ يعرفُ إليه سبيلاً : أنّ عمرو بن كلثوم قَتَلَ عمرو بن هند، وقد كان مَلِكَاً للحيرة؛ لأنّ الملك أزمَعَ على إِهَانَة عمرو بن كلثوم في شخصِ أمِّه ليلى ابنة مهلهل بن ربيعة: بأن دسّ لها أُمَّهُ هِنْداً لتطلب من ليلى مناولتَها الطبَّق وهي لديها ضَيْفٌ، فاعتذرت ليلى لهند أوّلاً؛ فلمّا أعادت عليها الطلب وألحّت، صاحت ليلى: "واذلاَّهُ! يالتَغلِب!"(5) فلَمَّا سمِعَها ابْنُهَا عمرو بن كلثوم عَمَد إلى سيف كان معلّقاً قريباً من عمرو بن هند فقتله به... وقد كانت المرأة العربيّة على عهد الجاهلية شاعرةً تفْهَم الشعر، وناقدة تستطيع التعليق عليه، وتمييزَجيّدهِ من رديئهِ، ولا يعني ذلك إلاّ أنّها كانت بلغت مقداراً صالحاً من الثقافة الشعريّة حيث تزعم أمّهات التراث العربيّ أنّ امرأ القيس وعلقمة بن عبدة -الفحل- تنازعا في أيّهما أشعر؛ ولم يُسَلِّمْ أحدُهما للآخر فاتفقا على أن يحتكما لحليلة امرئ القيس، يومئذ، أمّ جُنْدُب التي حَكَمَتْ لعلقمة على امرئ القيس مما أحفظ الملكَ الضَّلّيِلَ فطلّقها(6). فإنّ صحّت هذه الحكاية فإنّ ذلك يعني أنّ المرأة لم تَكُ شاعرةً فحسب، ولكنها كانت أيضاً ناقدة تُصْدِرُ الأحكام، وتُجرى التعليقات، في كفاءةً مدهشة. ولعلّ، ممّا قد يؤيّد هذه الحكاية، في مضمونها على الأقلّ، خبر آخر يزعم أنّ الخنساء (تماضر بنت عمرو بن الشريد السُّلميَّة) بارَتْ في سوق عكاظ، أمام النابغة الذبياني، حسّانَ بْنَ ثابتٍ فَحَكَمَ النابغةُ لها عليه(7). وجاء في الأخبار أيضاً أنّ ابنةَ حسانَ بْنِ ثابتٍ كانت شاعرة، وأنّ حَسّاناً أرِقَ ذاتَ ليلةٍ فارتجل بيتيْن اثنيْن من الشعر فسمعتْه ابنتُه فأجازَتْهُ مرّتين متتاليتيّن، فقال لها أبوها: "لا أقول بيتَ شعرٍ وأنت حَيَّةٌ."(8). لكنّ الفتاة أمّنَتْ أباها قائِلَةً: "لا أقول بيتَ شعرٍ مادمتَ (أنت) حيّاً!".(8). كما أنّ الأشعار الكثيرة، المتفرّقة، التي وردتْ شواهد على قواعدِ النحوِ، أو على صحّة اللغة في كتب النحو والمعاجم والأمهات مثل "الكتاب" لسيبويه، و"لسان العرب" لابن منظور: تدلّ على أهمّيّة مكانة المرأة العربيّة في المجتمع الجاهلي؛ إذ هناك العدد الجمّ من أبيات الاستشهاد التي قيلت إمّا في وصف أعضاء معيّنة من جسد المرأة مثل العينين، والثغر، والشعر، والأسنان، والجيد، والكشح، والثديين، والسّاقيين، والأنامل، والقدّ.... وأمّا في وصف علاقة الرجل بالمرأة، أو قالها، في الأصل، نساء... ويفتقر هذا الموضوع إلى بحثٍ على حدة بينما لانكاد نجد مادّة واحدة، من موادّ المعجم العربيّ، لا تُذْكَرُ فيها المرأة على نحو أو على آخر، فكأنّ اللغة العربيّة لغة نسويّة أساساً! وكأنّ هذه التسويّة تستأثر بأمرها إلى حدّ أن العرب تعتبر كثيراً من المسمّيات مؤنّثة على الرغم من خُلِوِّها مِنْ هاءِ التأنيث في آخرِها مثل الحرب، والعَصا، والعين، والأذن، والساق، والرِجلْ، واليد، والنار، والبئر...، بالإضافة إلى الألفاظ الكثيرة التي يجوز تأنيثها وتذكيرها مثل السوق، والحال، والسبيل والرُّوح...وكأنّ العرب كانت تراعي في أصل إطلاق الأسماء على المسمّيات اتّصالَها بالمرأة، أو اعتبارها مؤنّثة لتوهم النَّسوية فيها... على حين أنّنا نلفي الأعضاء الجنسيّة للمرأة، خصوصاً، وما يتّصل بها أيضاً من حركة أو فعل تشكّل مادّة ضخمة في اللغة العربية. ولا يقال إلاّ نحو ذلك في جمع مالا يعقل، وجمع التكسير حيث يعاملان، لدى إعادة الضمير عليهما، معاملةَ المؤنّثِ. حقاً، لم يكن هناك نظام اجتماعيٌّ قائم، وإن كانَهُ على نحو ما، ولا قانون وضعيٌّ صارم، ولا تعاليمُ دينية تحمي المرأةَ في الجاهليّة من عُدّوان نفسِها أوّلاً، ثمّ من تسلّط الرّجل المفرِطْ عليها آخراً: إلى أن جاء الله بالإسلام فقنّن علاقتها بالرجل، وجعلها سيّدة في مالها، ورفع من شأنها في المجتمع حين جعلها شقيقة الرجل، وحين جعل الجنّة تحت أقدامها - حين تغتدي أماً - وحين اشترط في صفة العشرة بينهما أن تكون بالمودّة والمعروف.... ولكن على الرغم من الحقوق المادّية والمعنويّة التي قرّرها الإسلام للمرأة، فإنّه كان في الجاهليّة أعرافٌ وقيم تحفط للمرأة العربيّة شيئاً من حقوقها، وتحفظ لها شيئاً من كرامتها ( ونقصد بذلك المرأة الحُرَّة؛ أمّا الأمَّةُ فظلّت حالُها على هَوْنٍ، ومكانتها على سوء، إلى أن تخلّصت الإنسانيّة من نظام الرِقِّ المَقِيت) فكان الرجل يعاشرها بشيء من المعروف، والمودّة، وربما الوفاء أيضاً... وقد يدلّ على بعض ذلك هذه الوفرة الوافرة من الأشعار التي تتحدّث عن علاقات البعول بحليلاتهم، أمثال أقوالهم: * ذريني للغنى أسْعى فإنّي رأيْتُ الناسَ شرّهم الفقيرُ(9) *ِتلْك عِرْسي غَضْبَى تُرُيد زِيَالِي اَلِبَيْنٍ تريد أم لِدَلال؟(10) * فإن تسألوني بالنساء فإنّني بصيرٌ بأدواء النساء طبيبُ (11) * تِلك عِرْسَايَ تنطِقانِ عَلى عمْـ ــد، لي اليوم قَوْلَ زُورٍ وهتْرِ(12)... إنّ طفوح الأشعار العربيّة القديمة - الجاهليّة خصوصاً- بذكر هذه المرأة، وإنّ التباري بين عامة الشعراء في وصف جمالها، وفي ذكر دلالها، وربما التغنّي بصفاتها الروحيّة الأخراة كما يمثل بعض ذلك في شعر عمرو بن كلثوم: ظعائن من بني جشم بن بكر خَلَطْنَ بميسَمٍ حَسَباً ودِينا لَدليلٌ خِرّيتٌ، وبُرْهان ساطعٌ، على سُمُو مكانة المرأة العربية في المجتمع الجاهلي بعامّة، وفي أَنْفُسُ الشعراء بخاصة. وعلى الرغم من أنّنا نرتاب، ارتياباً شديداً، في صحة نسبة هذا البيت إلى عمرو بن كلثوم، لأنّ هذا الشاعر لم يكن من الوَرَع والتقوى والإيمان -وهو الجاهليّ الوَثَنِّيّ- مايجعله يمتدح في النساء العنصرَ الديني لديهنّ. وكيف لا يرتاب في نسبة هذا البيت إليه وهو الذي يقول في المعلّقة نفسها: ألاَ لاَ يَجْهَلنْ أحدٌ عليْنا فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهْلِ الجاهلينا فهل نصدّق بصحّة هذا البيت أم بصحّة البيت السابق؟ أمّا أَنْ نُصَدِّقَ بصحّتهما معاً، فعلينا أن نكون سُذَّجَاً، وإذن، فإن صحّ لابن كلثوم هذا البيت: الجاهِليُّ، الجاهِلُ، فليكن؛ ولكن على أن لا يصِحَّ له البيت الآخرَ الذي يتغنّى فيه بمكارم الأخلاق، وورع نساءِ تَغْلِب. وإنّ صحّ الآخرُ له، فليكن، ولكن على أن لا يصحّ له هذا. وهبْ سلَّمْنا بمسألة الحسب والنسب في البَيْتِ السابق، لكن مابالُ ذِكْرِ الدِّيْن لدى شاعر مثل عمرو بن كلثوم الذي لم يتورّع في قتل عمرو بن هند لمجرّد حادثة كان يمكن أن يتخلّص منها بمغادرة الحيرة مع أمّه، وكتابة قصيدة هجائية فيه، ويستريح.... ولكنّه آثَرَ سفك الدّم، فقتل.... ثمّ ، إن المرأة المتدّينة - لو كان ماورد في هذا البيت يصدق على نساء بني تغلب- تسمو بنفسها، وتتواضع، وتتلطّف، وتتسامح، وتساعد الآخرين... فكان يمكن، إذن، لليلى أمّ عمرو بن كلثوم، أن تناول هنداً الطبَق -ولو من باب تجاهل العارف- أو لا تناولها إيّاه، ولكنها تتسامى بنفسها، وتتعالى بخلاقِها، وتتسامح بحُكْم، أو بفضل، دينها المزعوم مع تلك الجاهلة الفجَّةِ، الْفَظَّةِ الجِلْفَة، الغليظةِ القلب المتغطرسَةِ في جاهليّتها الجهلاء، والسامدة في ضلالتها العمياء... لكنّ ليلى كانت أجهل من هند، كما كان عمرو بن كلثوم أجهل من عمرو بن هند، في هذه الحادثة. فأين مظاهر الدين في هذا الأمر؟ ومابال التّقى والوَرِع لدى بني تغلب؟ وهل نلوم عمراً أنْ لم يَكُ متديّناً في زمن ومكان لم يَكُ فيهما نبيّ مُرسَل، ولا كتابٌ مسطّرٌ، ولا رسالة إلهيّة... إننا، إذن، لا نعتقِدُ أن يكونَ مِثْلُ هذا الوصف الوارد لدى نهاية البيت الأخير، للمرأة الجاهليّة -من خلال وصف نساء بني تغلب- صحيحَ المتْن، ولا سليمَ الرواية، ولا صادق النسبة إلى صاحبه، لتناقضه مع الوضع الذي كان يعيشه الشاعر، ولتعارضه مع السيرة التي كان يسيرها في حياته العامّة. ولا نَخَالُ ذلك إلاّ من دَسَّ حمّاد الراوية الذي جمع نصوص المعلّقات، ثم رَوّاها الناس (13) (وهي رواية يأتيها الضعف والشكّ من كونها جاءت بعد أكثر من قرنين من الزمن، وأنّه تفرّد بها وحده، وأنّها إذن لَمْ تَكُ رواية متواتِرةً) وهي الرواية الذي كان اشتهر بالكذب، فكان لا يتحرّج في التزّيد في أشعار الناس(14). إنّ كائناً مثل المرأة التي تمثّل الأمّ، والأخت، والبنت، والزَوْج، بالقياس إلى الرجل من وٍجهة، وتمثّل الرٍقًّة المتناهية، والحنان الغامر، وتزدخر بالحبّ العارم، والإحساس الفائض، من وجهة أخراة... وإنّ كائناً كان هو الذي ينهض في ذلك المجتمع الذي كان يحكمه الشَّظَفُ والغِلْظُ، وتَسِمُه الخُشونة والشدّة -بقسط كبير من أعباء الحياة اليوميّة فينسج الملابس ويغسلها إذا اتّسخت، ويصنع الأخبية والخيامَ ويتعهّد نظافَتها، ويطْهُو، إلى ذلك، الطعام، ويُنْجِب الأطفال، ويُرضِعُهُم ويُنْشِئُهُمْ تَنْشِئَةً.....- لَمَجْدُرَةٌ لأنْ يَلْقَى من الاحترام والتقدير، والحبّ والتكريم، والعناية والتعظيم: مانلفيه قائماً في أشعار الجاهليّين التي المعلّقاتُ السبعُ يجب أن تكون أجملّها وأروعَها. وكأنّنا نفترض أن هناك حلقةً مفقودةً من هذا الشعر، وطَرفاً ضائعاً من هذا الأدب، وأنّ الرواة لم يكادوا يحفظون لنا منه إلاّ ماكان وَصْفَاً لجسد المرأة وعلاقتها بالرجل، أو علاقة الرجل بها: وزهدوا ، أو كادوا يزهدون، في كل، أو بعض، ماكان وصْفاً لروحها، وتسجيلاً، ولو على هون ما، لمكانتها الاجتماعيّة، وحياتها اليوميّة: على الوجه الأعمّ، والنحو الأشمل. ****** ثانياً: هل نساء المعلّقات رمزّيات؟ لقد ذهب كثير ممّن يحلو لهم أن يؤوّلوا الأشياء على غير ظاهرها، ويفسّروا الأمور على غير منطوقها، كما يقول علماء الأصول، إلى رمزّية المرأة في كثير من مواطن ذِكْرِها في أشعار الجاهليّين، وأنّها واردة بالمعنى الذي ذكرت عليه بظاهر اللّفظ، وفي صريح النسجْ. ومن ذلك ماذهب إليه أُستاذُنا الدكتور نجيب البهبيتي حول هذا الأمر الذي لا يمكن تقبُّلُه، بدون مناقشة ولا مُقادَحَة. فقد كان الشيخ ذهب إلى أنّ كلَّ امرأةٍ كان ذِكْرُها رمزاً حيث إنّ هذه المرأة، في كلّ مواردها من الشعر الجاهليّ، كانت رمزاً لقيمة؛ وأنّ الأسماء المُطْلَقة على النساء هي أسماء تقليديّة، تجري عند الشعراء دون وقوع على صاحباتها"(15). فيما ذهب إليه الشيخُ قد يصدق على هذه المرأة، أو على هؤلاء النساء إن شئت، في الطلليّات، أو في مطالع القصائد العيون، لكنّه لا يجوز، في تمثّلنا نحن على الأقل، أن يصدق عليها في أصلابِ الطِّوالِ، والمعلّقات السبع، وخصوصاً لدى عنترة وامرئ القيس. بل ربما لدى عامة المعلّقاتيّين الآخرين أمثال الحارث بن حلّزة (أسماء- ميسون- هند)، وزهير (أمّ أوفى)، ولبيد (نوَار). ولعلّ المرأة لم تُرْمَّز إلاّ فيما بعد لدى الشعراء الغزِليين، وخصوصاً لدى أهل التصوّف الذين بلوروا رمزّية المرأة، ووظّفوا قيمتها الجماليّة فاغتدَوْا يُطلْقِون اسمَ ليلى على كلَّ موضوع، وعلى كلّ أمل، وعلى كلّ قيمة معنويّة خِيّرة أو نبيلة، وعلى كلّ غاية كانوا يتعلّقون بها من ابن الحرّاق إلى محمّد العيد(16). وأمّا ماقبل ذلك، فقد كان كلّ شاعر، على الأغلب، يذكر صاحبته التي كان يُحِبُّها باسمها الشخصيّ. وحتّى إذا سلَّمنْا، جَدَلاً، بأنّ هذه الأسماء التي تمتلئ بها الأشعار الجاهليّة بعامّة، والمعلّقات السبع بخاصّة -كما سنرى بعد حين- لم تكُ حقيقيّةً، فهي لم تَرْقَ قَطُّ إلى مستوى الرمز؛ وإنما قد تكون رَقِيَتْ إلى مانطلق عليه نحن "مستوى التَّعْمِيَة" وعلى أنّ القدماء من مؤرّخي الأدب العربيّ - وعلى عنايتهم الشديدة بالشعر الجاهليّ، وعلى إيلاعهم باستيعاب أخبار شعرائه، وخصوصاً في علاقاتهم بالنساء -لم يؤمنوا ، فيما بلغّنا من العلم، قط، إلى أنّ أولئك الشعراء كانوا يتحرّجون في التصريح بأسماء حبيباتهم وعشيقاتهم. بل إنّا ألفينا حكاية "دارة جلجل"، المشكوك في صحّتها لدينا، تُلحُّ على أنّ امرأ القيس كان يتابع العذارى وكان يتعشّق ابنة عمّه عنيزة جهاراً، بل كان يُراكبها على بعيرها، ويقبّلها في خدرها، ويتفرّج على جسدها وهي عارية حين كانت تسبح، وحين أرغمها على أن تخرج من ماء الغدير ليشاهدها عُريانةً: مُقْبِلَةً ومدبرة، فيما يزعم الرواة الأقدمون(17). فما هذا التناقض المريع بين رواية تذهب إلى الإباحيَّةِ المطلقة في العلاقة مع المرأة الجاهليّة، بتواتر الروايات، واتفاق الحكايات، وبيْن رأي يذهب إلى اتّخّاذ هذه المرأة مجرّدَ رمز وقيمة؟ إنّنا إذن نستبعدُ ورودَ أسماءِ النساءِ الجاهليّات في الشعر، في الشعر على ذلك العهد، مَوْرِداً رمزيّاً في ذلك المجتمع الذي لم يكن يكاد يعرف شيئاً كثيراً أو قليلاً من الروحيات، والمعنويّات، ومن باب أولى: الرمزّيات: فكلّ العالم يعرف أنّ عبلة هي ابنة عمّ عنترة. وكلّ العَالَم يعرف أيضاً أنّ عنيزة هي ابنة عمّ امرئِ القيس بالرواية المتواترة، والأخبار المتطابقة ولا يقال إلاّ نحو ذلك في نساء المعلّقاتيّين الآخرين. ففيم تَمْثُلُ، إذن، هذه الرمزيّة؟ وهلا وقفناها على البكاء على الديار؟ وهلا قصرناها على الوصف العامّ لامرأة حبيبة بدونِ ذِكْرِ لاسمها، ولا وَصْفٍ لجَسَدِها، واسترحْنا فأرَحْنَا؟ أمَّا أن نعمّم الترميز، فنجعلَ من الأسماء المختلفة الكثيرة لأُوْلاءِ النساء مجرّد رموز لقيم ومبادئ وآمال؛ فإنما لا نحسب ذلك يجسّد حقيقة، ولا نراه يمثّل تقريراً لوجه من التاريخ الصحيح، والخبر الصريح. فامرؤ القيس بن حجر حين يقول: * قفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ* فذلك، غالباً، لم يكن يعني حبيبةً بعينها، ولا امرأةً بذاتها، بمقدار ما كان يكرّس، مطلعَ قصيدته، تقليداً شعريّاً كان كرّسه، قبله، آخرون منهم امرؤ القيس بن حارثة بن الحمام بن معاوية(18). وأمّا حين يقول، مثلاً: ويوم دخلت الخِدْرَ: خِدْرَ عُنَيْزَةٍ فقالت: لك الويلاتُ، إنكّ مُرْجِلِي فذلك لا يعني، غالِباً ، إلاّ امرأة بعينها، امرأةً عاش معها الشاعر وأحبَّها، فأراد أن يتمتّع بها، كما كان يتمتّع بسَوائِها غَيْرَ مُعْجَلٍ ولا خائِفٍ، فيما يزعم: * تمتّعت من لهوٍ بها غَيْرِ مُعْجِلِ* ولم تكُ هذه المرأة، فيما أجمع عليه مؤرّخو الأدب العربيّ القديم، إلاّ عنيزَةَ نَفْسَها.(19). أم هل كان هذا التمتّعُ تسابِيحَ روحيَّةً، وابتهالاتٍ ملائكيَّةً، نَسَجَهَا الشاعر نَسْجَاً؟ أم هل كان مجرّد عيش وهميٍّ يأتيه مع طَيْفها المُتأَوِبِ، وحُضورها المُحوِّمِ، من نفسه؟ أم كان ذلك اللهوُ مجرّد صورة رمزّية لعلاقة رجل مع امرأة لم تتمّ قطّ.؟ إنّا لا نلفي أيّ أَثَرٍ لهذه الرمزيّة في مثل هذه الأبيات التي استشهدْنا ببعضها، بمقدار ما نلفي فيها حضوراً واقعيّاً لهؤلاء النساء، مثل الوجود الواقعيّ لأولئك الشعراء أنفسهم. وإلآّ فإنّ بالغنا في الذهاب إلى أقصى الحدود في استعمال التأويل؛ فإننا سنْخُرج من حدود التأويل الممكنة، والمشروعة أدبيّاً، ونتولّج في حدود التأويل غير الممكنة، أي أنّنا سنمُرقُ من مستوى تأويل النّصّ، إلى مستوى استعمال النص فنقوِّلُه مالا يقول، ونُحَمِّلُه، مالا يحتمل؛ ونسلكه في مسالك الشَّطَطِ، وندرجه في مدارج التعسُّف، بحيث سنؤَوِّلُ، في هذه الحال، كلّ شيءٍ على غير ماهو عليه، أو على غير ما يجب أن يكون عليه؛ فيُمسي، أو يوشك أن يُمْسِي، كلُّ شيءٍ رمزيّاً، أو قل إن شئت إلاّ شيئاً من الدّقة في التعبير: يُمسي كلُّ شيء وهميَّاً في حياة الجاهليّة التي ماكان أبعَدَها عن الروحيّات والرمزّيات، بمقدار ماكان أقْرَبَها، بل ألصقها بالمادِّيَّاتِ والواقعيّات. إننّا نعتقد، إذن، أنّ الأسماء: أسماء النساء التي وردت في المعلّقات لم ترد بمعاني الرمز ولكنها وردت بمعاني الحقيقة والواقع. ثالثاً: ماذا عن حقيقيّة المرأة الجاهليّة في المعلّقات؟ إذا قلنا، معجميّاً ودلاليّاً معاً: حقيقيّة المرأة، فكأنّما قلنا: عدم رمزيّتها: إمّا على وجه الإطلاق، وإمّا على سبيل النسبيّة، وكان سبق لنا في المحور الثاني، من هذه المقالة، أن زعمنا أنّنا لا ننكر، جملة وتفصيلاً، رمزيّة المرأة في الشعر الجاهلي، ولكننا لا نجاوز بها مواطنَ منه معيّنةً لا تعدْوها، ومنها -وربما أهمّها- مايذكر في الطلليّات والمطلعيّات، وما قد تدلّ عليه ظواهرُ الأحوال. وكانت حجَّتُنا، في ذلك، أنّ المؤرخيّن أجمعوا على مادّيّة العصر الجاهليّ، وواقعيّة كثير من المظاهر العامّة فيه، بناء على النصوص الشعريّة التي بلغتْنا منه، ورُوِيَتْ لنا عنه: أكثر ممّا ذهبوا إلى روحيّته ومثاليّته. يضاف إلى ذلك أنّ عامّة المؤرّخين يزعمون أنّ المرأة لم تكن لها مكانة شريفة، في كلّ الأطوار، على عهد الجاهلية، وأن الإسلام وحده هو الذي أنصفها فحقّق لها مالم يكن لديها... ونحن مع إقرارنا واقتناعنا بما أعطى الإسلامُ المرأةَ، وبما حقّق لها من كرامة، وبما حفظ لها من ماء الوجه فاغتدتْ شقيقة الرجل (20)، بل لم يزل يكرّم المرأة الأمّ إلى أن جعل الجنة تحت أقدامها: فإنّا كنّا زعمنا، في الوقت ذاته، أنّ مكانة المرأة، على عهد الجاهليّة، لم تكن من السوء والبؤس، والمهانة والذّلّ، بحيث كانت كلّها شقاء مطلقاً. وقد قنن الاسلام العلاقةَ بين الرجل والمرأة، واجْتَعَلَ لها حدوداً صارمةً -من خلال آيات قرآنيّة كثيرة- لا تعدوها، ومن خلال أحاديث نبويّة جمّة، وخصوصاً ماجاء في خطبة حجّة الوداع... ذلك بأنّ المرأة كانت تتدلّل على الرجل أكثر ممّا نتصوّر من سطحيّة المواقف واستعجاليّة الرأي، فمن ذلكم أنّ الرجل هو الذي كان يُرْكِبُ حليلَتَه لدى الإزماع على التَّظعان، حتى قالت إحدى النساء العربيّات إدْلالاً بنفسها، ووثوقاً من منزلتها لدى بعلها: "احْمِلْ حِرَكَ أَوْ دَعْ"!.(21). وقد علق ابن منظور على هذه القولة التي صارت مَثَلاً، بأنّ ذلك لم يكُ منها إلاّ إدلالاً، وحثّ بعلها "على حَمْلِهَا" ولو شاءت لرَكِبَتْْ"(25). ومن الواضح أنّ لهذا المثل العربيّ القديم دلالةً حضاريّة واجتماعيّة وعاطفيّة ذاتَ بال، وأنّه يدلّ على المنزلة المكينة التي كانت للمرأة في المجتمع الجاهليّ، فعدم ركوب المرأة، بدون مساعدة الرجل لم يكن عن عجز منها عن الركوب، بمقدار ما كان إدلالاً منها، وتغنُّجاً على بعلها، ولقد يُشْبِهُ هذا السلوكُ المتحضِّرُ مانراهُ، على عهدنا هذا، في الأشرطة السينمائيّة لدى الغربيّين، وذلك حين يفتح الرجل باب السيّارة للسيّدة -لدى الصعود والنزول- مع أنها قادرة على فتحه بنفسها، وبدون عناء، ولكنّ الرجل يأتي ذلك لباقةً وتلطّفاً، وترى المرأة تتثاقل لدى الاقتراب من السيّارة حتى يسارع هو إلى فتح الباب لها. وعلى الرغم من اختلاف الأحوال، وتبدّل الأطوار؛ فإنّ النيّة في الحالين الاثنتين واحدة: رجل يعيش على عهد الجاهليّة يُركِبُ حليلته على البعير وهي على ذلك قادرة، ولكنها لا تفعل تدلُّلاً، ورجلٌ يعيش في نهاية القرن العشرين يستبق حليلته، أو خدينَتَه، بابَ السيّارة فيفتحه لها لكي تمتطِيَها، وهي على فتحه قادرة، لكنها تتثاقل وتتباطأ غَنَجَاً. فالنيّة هِيَ، في الحالينْ والعهدينْ، ولكنّ المظهر الحضاري هو الذي تغيّر فاستحال من البعير إلى السيّارة. ويعني ذلك، كما نرى من خلال تحليل مضمون هذا المثل الجاهلي، أنّ الرجل العربيّ سبق الرجل الغربيّ، بقرون طِوالٍ، إلى هذا السلوك المتحضّر. كما أنّ قول امرئ القيس: وما ذرفتْ عيناكِ إلاّ لتضرِبي بسهَميْكِ في أعشارِ قلبٍ مُقتَّلِ برهانٌ ساطع على رقة قلب الرجل العربيّ، وَرَهَافَةِ كِبدِه، ولطافة إحساسه، إزاء المرأة: هذا الكائِن اللطيفِ المُدَمِّرِ معاً. كما يدلّ على بعض ذلك، أيضاً، هذا الفيض الفائض، والوَفْرُ الطافِحُ، من جميل الأشعار التي قيلت وَصْفَاً للمرأة، وتشريحاً لأعضاء جسدها، وتمجيداً لعينيها وثدييها وساقيها وجِيدِها وشعَرِها وثَغْرها وابتسامتها وصوتها ومِشْيَتَهِا التي تترَهْيَأُ فيها... إنّ التغني بجمالِ نساءٍ معيّنات، في جملة من المعلّقات، لدليل قاطع على أنّ هؤلاء الشعراء كانوا يحبّون، حقاً، نساء بأعيانهنّ، ولم يكن ذلك مجرّد رمز من الرموز، ولا مجرّد قيمة من القيم الفنّيّة، أو الجماليّة. فقد كَلِفَ امرؤ القيس بذِكْرِ جملة من أسماء النساء كما ذكر نساءً أخرياتٍ في صور عامّة مثل: * وبيضةِ خِدْرٍ لا يُرامُ خِباؤُها تمتّعْتُ، من لهوٍ، بها : غيرَ مُعْجِلِ * عَذارَى دَوَارٍ في مُلاءٍ مُذَيَّلِ * فظلّ العذارَى يرْتمِينَ بِلَحْمِها * ويوم عقرتُ للِعَذارَى مَطيَّتِي ونلاحظ أن امرأ القيس قد يكون سَيِّدَ المُعَلَّقَاتِيّينَ: لا في وصف المرأة، وصفاً جسدياً، فحسب، فذلك أمر لا ينازع فيه أحدٌ، ولكنْ في تقديره المرأةَ، واحترامه إيّاها في مواقف معيّنة- وذلك على الرغم من أنّه كان أميراً سَرِيَّاً، وفارساً كِمِيَّاً؛ ومن ذلك قولُه، وقد كانت الإيماءة سبقت إليه: وماذرفت عيناكِ إلا لتَضْرِبي بِسَهمَيْكِ في أعشارِ قلبٍ مُقتّل فامرؤ القيس في هذا البيت وفيّ، ومقدّرِ لجمال هذه المرأة وسِحْرها إيّاه، وتعذيبها لقلبه الوامق، ولو كان امرؤ القيس زانياً، كما تصوّره بعض الأخبار المدسوسة(23): لمَا وصفَ حبّه هذه المرأةَ وأبدى تأجّج عاطفتِهِ نحوَها بهذا التقدير الذي جعله يتهالك على حبّها، ويتدلَّه بجَمالها، ويتعذّب بسْحِرْها، فإذا بكاؤُها يُدْلّهُهُ؛ وإذا دموعُها تفطِّرُ كَبدَه، وتكلمُ قلبَه. ومن ذلك أيضاً قولُه في بعض وصف يوم دارة جُلْجُل العجيبِ، لو كانت حكايته ممّا يَصِحُّ لدينا: * فظلّ العذارَى يرْتمِينَ بِلَحْمِها بينما نلفي طرفة بن العبد يعبّر عمّا يشبه هذا المشهد، وهذا المعنى، بقوله: * فَظلَّ الإماءُ يَمْتَلِلْنَ حُوارَها. ولا سِواءٌ شاعِرٌ يذكر عذارَى، وشاعرٌ آخر يذكر إماءٌ. فالإماء مظِّنَةٌ للخدمة والامتهان، والعذارى مظنّة للعزّة والدّلال. فحِسُّ امرئِ القيس، هنا، الشعريُّ أرَقُّ، وذوقُهُ أرقى، وموقفه من المرأة أكرم. فكأنّه أراد باصطناعه لفظ "العذارى" أن يُلغي الفوارق الطبّقية بين امرأة وامرأة، فكلُّ عذراء، لدى نهاية الأمر، تمتلك خصائص العذراء، بصرف النظر عن طبقتها الاجتماعية التي كُتِبَ عليها أن تُجْتَعَل فيها. فَمَعَ مانعلم من رواية الفرزدق عن جدّة، وهي الرواية التي تذهب إلى أنّ الإماء هنّ اللواتي جمعن الحطب "فأجّجن ناراً عظيمة"(24). إلاّ أنّ هذا الشاعر المرهَفَ الإحساسِ، الشاعرَ الإنسانَ؛ كأنَّه تَأَبَّى أن يصف أولئك الفتياتِ الجميلاتِ بالإماء، فِعْلَ طرفةَ بخَدينَاتِهِ؛ فينال من كرامتهن وجمالهنّ: ووَصْفَهُنَّ، تكريماً لهنّ، بالعذارى، كما وَصَفَ نساءَ صَنَمِ دوارٍ بالعذارى أيضاً: * عذارى دوارٍ في مُلاءٍ مُذيّل. إننا لنحسب ذلك التّطوافَ من حول صنم دوار كان عامّاً في النساء والرجال؛ وكان عامّاً في العذارى والمتزوّجات -أو الثيبّات-، ولكن لمّا كان لقب العذراء أكرم للمرأة (بدليل قوله تعالى لدى وصْف نساء الجنّة: (لم يَطْمَثُهنَّ إنْسٌ قَبْلَهُمْ ولا جَانٌ)(25)؛ فإنّه وصف أولئك النساءَ بهذ العُذريّة إِغراقاً في التصوير الجمالِيّ لهنّ. فقد كان يمكنه أن يقول مثلاً: * نساء دَوارٍ... لكنه لو قال ذلك لكان أَذْهَبَ عن هذه الصورة الشعريّة البديعة (التي هي صورة تنهض على حركة كأنها دائريّة حيّة، مصطحبة بأجسام جميلة لطيفة، تجرّر أذيالّها حول بناية تجسّد معتقداً وثنياً... فهي صورة تمثّل شيئاً من جمال الحركة؛ وذلك على الرغم من أنّنا الآن ننظر إليها على أنها تجسّد مجرّد معتقدٍ باطل....). أطرافاً من جماليّتها. بل لاغتدتْ مجرّد صورةٍ لكائنات حيّة تتحرّك، ليس إلاّ. ولقد يسْتَميزُ لفظُ عذارى عن لفظ نساء، كما يستميز وصف مذيّل عن لفظ مُلاء، إذ لو قال: "في مُلاء" وسكت عن صفة هذه المُلاء، لما كان لذلك شيء من الوقْع الشعريّ، ولا مِنْ بَدَاعَتِه، ولا من مائه، ولا من نضارَتَهِ، ولا مِنْ توهُّجه وعُنفُوانه، لكنه لمّا وَصَفِ المُلاء بطول الذْيْل دَلَّ على كرمِ هؤلاءِ العذارى، وعزّتهن لدى قومهنْ، وَسعَةِ أيديهنّ في أُسَرِهِنّ؛ بحيث لا ترتدي المُلاءَة المُذيَّلة -أي الطويلة المتجرْجرة- إلاّ من كانت موسَرِةً مُقْتَدّرَةً على الإنفاق والمُغالاة في التماس أَجْوَدِ الأثواب وأرقِّها نَسْجَاً، وأَدَقّها صُنْعاً، وأبدعها نقشاً. إنّ أسماءً كثيرةً تصادفنا في المعلّقات ممّا يطلق على النساء مثل: فاطمة، وعنيزة، وعبلة، ونوار، وهند، وأسماء ، وميسون، وخولة، بالإضافة إلى الأمّهات: أمّ الحويرث، وأمّ الرباب، وأمّ الهيثم، وأمّ أوفى. ولا نحسب أنّ اختلافَ هؤلاء النساءِ يدلّ على رمزيّتهنّ؛ بمقدار مايدلّ على حقيقتهنّ. وأنّ مايذهب إليه أستاذنا البهبيتي، لدى حديثه عن الحارث بن حلّزة من أن ظاهر الشعر يقتضي "أنّ الحارث يَنْسِبُ بأسماءَ وبهندٍ، وحقيقة الأمر ليست كذلك. وإنّما أسماءُ هذه شخصيّة خياليّة تذكر أيضاً في قصة حبّ المرّقش الأكبر البكريّ الذي خرج على ملوك المناذرة"(26) لا يعدو كونه تحمّساً لفكرة كان الشيخ رَسَمَها في نفسه للعصر الجاهليّ؛ ثم راح يَنْضَحُ عنها بكلّ ما أُوْتِيَ من قوّة عقليّة، وكفاءة فكريّة، وإلاّ فإنّ مايُعَدُّ لديه "حقيقة أمر" لا ينبغي أن يجاوز كونَه وجهةَ نظرٍ، ومن ذا الذي يستطيع أن يكتب عن الشعر الجاهليّ (ويتناول المرأة من خلال هذا الشعر)؛ وذلك بعد أن مضى عليه قريبٌ من ستّةَ عشرَ قرناً: ثمّ يتحدّث، بثقة عجيبة، عن هذه الحقيقة؟ بل لا يزال كذلك حتّى يتعصَّبَ لها، ويدافِعَ عنها، على أساس أنّها عين التاريخ!.... ولِمَ تكونُ أسماءُ الحارثِ بن حلّزة مجرّدَ امرأةٍ خياليّة من حيث لم يكن هذا الحارث إلاّ شاعراً كجَميع شعراء البشر، عبر خمسة وعشرين قرناً من التاريخ الإنسانيّ المسجّل بشيء من الانتظام، يحبّ ويعشق، ويصوّر في شعره مَنْ يحبّ، ويصف مَنْ يَعْشَقُ؟ ولِمَ نَسْعَى إلى حرمان شاعر من أوّل مادّة يقوم عليها شعرُه، وهو الحبّ؟ فليس هناك شاعر حقّ على الأرض لا يحبّ. وإذن فكلّ مَن لا يحبّ لا يكون شاعراً، وماينبغي له. وإذن، ليس هناك شعر حقّ على الأرض لا يتحدّث عن الحبُ، ولا يصف المرأة، ولا يتغزّل بالحبيبة، ولا يتغنّى بجمالها.... فما لِهذا الحارث إذن يكون بِدْعاً من الشعراء قاطبة: من قدم منهم ومن حدث؟ ثمّ إنّا لا ندري كيف يذهب شيْخُنا المذَاِهَبَ الصارِمَةَ في مناقضة طه حسين، ومعارضته في موقفه المتعسّف من العصر الجاهليّ: شعرائِهِ وشعرِه، ثم يأتي إلى أسماءَ بنت عوف بن مالك بن ضبيعة بنت قيس بن ثعلبة (27) فهي إذن شخصيّة تاريخيّة، وهي التي كان يتغزّل بها المرقّش الأكبر (وهو ربيعة بن سعد بن مالك، ومن الناس من يقول: أنه عمرو، وليس ربيعة)(28). فيحرمها من وُجودها التاريخيّ الذي اتّفق عليه جميع القدماء، باسْمِ وُثوقِه بمعرفةِ الحقيقة؟ أنه ينشأُ عن هذا الموقف المنكِر لوجود الأَسْمَاءَيْنِ الاثْنَتَيْنِ: أسماءِ الحارثِ بْنِ حلزةَ، وأسماء المُرقَّش الأكبرِ رَفْضُ الفاطمتَيْنِ الاثنتَيْنِ أيضاً: فاطمةِ امرئِ القيسِ، وفاطمةِ المرّقشِ الأصغرِ (29). ولا يزال الشيخ، رحمه الله، يتعسّف في إنكار هذه الأسماء النسويّة، الجاهليّة، التي لا نرى لإنكار تاريخيّتها أيّ مبرّرٍ مقبولٍ إلى أن يذهب إلى إنكار هندِ الحارثِ بْنِ حلزةَ أيضاً، وأنّ اسم هند "يكاد يقع في شعر كلّ شاعر اتّجه إلى ملوك المناذرة بمدح أو ذم"(30). ونحن نعجب من شيخنا كيف يتناقض مع نفسه في موقف واحد: فبعد أن كان قررّ في الأسطار السابقة، من الصفحة نفسها، من الكتاب نفسه: أنّ أسماءَ شخصيةٌ أسطوريّة، أو خياليّة بتعبيره، نلفيه يعمّم ذلك على هندٍ أيضاً فيزعم أنّها كانت مجرّد اسم تتحلّى بذكره الشعراء على بسيل الاِزدلاف إلى المناذرة كلّما يمّمتْهم مادِحَةً، أو كلّما زايلتْهم قادِحَةً.... وماقول شيخنا في ميسون التي تغنّى بذكرها الحارثِ بْنِ حلّزةَ؟ أهي أيضاً مجرّد شخصيّة خياليّة، وامرأة رمزيّة لا صلة لها بالواقع، ولا صلة للواقع بها؟ ولِمَ ألفينا هندَ ابنةَ عُتبة يبرُزُ دورُها، ويعظُمُ شأنُها، في المجتمع المكِّيِّ حتى يمكن أن نلقبّها سيدة نساء قريش على عهد الجاهليّة؟ ومابال هند أمّ عمرو -ملك الحيرة- حتى بلغت منزلة من السؤدد، وتبوّأتْ مكانةً من العِزّ: قوّة شخصيّة، وعلوّ قدر، ورفعة نفْس: حتّى أمكن نسج حكاية أَنَفَة خدمة ليلى، أمّ عمرو بن كلثوم -وبنت مهلهل بن ربيعة- ومن حولها، وأنّ ليلى هذه هي الوحيدة، من بين نساء العرب، التي كان يمكن أن تأْنَفَ من خدمتها؟ (ونلاحظ ذلك أنّ عمرو بن هند تَسَمَّىَ، على غيرِ ديدَنِ العرب في الانِتساب، باسم أمِّه، وألحق لقبه بها: تكريماً لها، وتشريفاً لمنزلتها). ثم مابالُ هندٍ بنتِ الخُسّ التي كانت من أعقل النساء العربيَّاتِ في الجاهليّة، وأَعزِّهنَّ...؟ ثمّ مابال الهُنُودِ الأخرياتِ اللواتي لا يأتي عليهنّ العّدُّ... ؟ فهل كنّ جميعاً ذوات صلةٍ، أو كان الرجال الذينَ كان لهم بهنّ صلةٌ ما، بالمَناذرة؟... ثمّ، لم ألفيْنا الزبَّاءَ تحكمُ، وبلقيساً تَمْلِكُ، وتُماضرُ تُبْدِعُ، وَسَلّمَّنا بذلك تسلِيماً، وأقررنا به إقراراً؟ ثمّ لِمَ ألفينا هؤلاء النساء جميعاً مذكوراتٍ في التاريخ المضطرَبِ في الشعرُ الجاهليّ فلَمْ ننُكر أسماءَهن، ولا فكّرنا في رفض تاريخيّتِهِنّ، ولا شكَّكْنَا في وجودهنّ: حتّى إذا صادفنا شاعراً من شعراء المعلّقات، أو من شعراء الجاهليّة بعامّة، يتغزّل بامرأة تُسَمَّى هِنْدَاً، أو أسماءَ أو فاطمةَ، أقمْنا القيامة، وأقعدنا الدنيا، وأقلقْنا الكون؛ من أجل أن نزعم للناس أنّ هنداً هذه لا تعدو كونَها أسطورةً في أساطير الأوّلين !؟... إنّ الرأي لدينا يقوم على الاِعتدال، فمَنْ ذَكَرَ الشعراءُ من النساء في المطالع، أو الطلليّات، قد ربّما يكون مجرّدَ رمزٍ، أو مجرّد تقليدٍ شعريّ. وقد يكون هذا المذهب، لدينا، أدنى إلى الوَجاهة والسَّداد، أمَّا النساء اللائي ذُكِرِتْ بأسْمائِهَا، والتي ذكرْنا طائفةً منها، في صلب المعلّقات، وتحت أَسْيَقَةٍ تاريخيَّةٍ لا يُنكِرها أحدٌ من العقلاء، فأَوْلئكَ نِساءٌ حقيقيَّاتُ الوجودِ، تاريخيَّاتُ الشخصيَّاتُ، في أغلب الظنّ. وليس لنا في ذلك من حُجّة سِوَى أنّ الأدب الإنسانيّ منذ كان، وعبر قريب من خمسة وعشرين قرناً من تاريخه؛ أي منذ عهد هوميروس إلى أحمد شوقي: كان الغزل من موضوعاته الكبرى، والتغنّي بجمال المرأة من تقاليده المُثلى. وإلاّ فكيف نَقْبَلُ بأن يكون لعُمَرَ بْنِ أبي ربيعة -وكان يعيش في أول عهد الإسلام- أي لم يكن بعيداً عن عهد الجاهليّة من الوجهة الزمنيّة الخالصة -فاطمةُ، ونُعْمٌ ، وغيرهما، نِساءٌ في حياته، ومغامراته غراميّة في تاريخه، على نحو أو على آخر.... نسلّم بكلّ ذلك حتى إذا أُبْنا الْقَهْقَرَى إلى أقّلَّ من قرنٍ في عهد الجاهليّة خُضنا الباطِل خَوْضَاً: فأثبتنا مالا يُثْبَتْ، وأنكرنا مالا يُنكر؟ إنّا لا نكاد نقول عن عصر عمر بن أبي ربيعة إلاّ ما ألفيناه مدّونَّاً في كتب تاريخ الأدب؛ لكننا إن عُدنا إلى عصر امرئ القيس، وعنترة، والحارث بن حلّزة.... أوّلنا الأشياء على سَواءِ ظاهِرها، وذهبْنا في ذلك المذاهِبَ الغريَبَةَ، واضطربنا المضطرَبَاتِ العجَيبة، وزعمنا للناس أنّ أولئك الشعراءَ كانوا يصطنعون الرمز، قبل أن يغتدِيَ هذا الرمز تقليداً أدبيّاً يعترف به النقد، ويرتاح إليه العِلمْ. وإذن، فقد كانوا يعرفون الرمزيّة قبل أوّانها، ويتعاملون معها قبل زمانها؛ فكانوا يقرضون الشعر ضمن تياراتها. وإذن، فلا حرج ولا إثم أن نجعل من مثل الحارث بن حلّزة، على مذهب أستاذنا البهبيتي، مالارْمِي العرب، بل مالاَرْمِي العرَبِ على عهدِ الجاهليّة؛ وأنه كانّ يرمز بالأسماءِ، أسماءِ النساء؛ دون أسماء الرجال، مثلُه مَثُل أصاحِيبهِ من المعلّقّاتيّين. ذلك هو التعسُّفُ في المذهَب، والتكلُّفُ في الرأْي، والمغالاةُ في التأويل. وإذا كانت نَوار، وأسماءُ، وهِنْدُ، ومَيْسُون، وفاطِمةُ، وعنيزةُ، وعَبْلَةُ، وَخولةُ، وأمُّ الحويرث، وأمُّ الرباب، وأمّ الهيثم، وأمّ أوفى، ومُرِّيَّةُ لبيدٍ، وابنةُ مالكِ عنترةَ!، وجارَيتُه أيضاً، وبيضَةُ خدرٍ امرئِ القيس، وعذارَى دَوارِهِ، وعذارَى دارةِ جُلْجُلِةِ، وحِسَانُ عمرو بنِ كلثوم، وظَعائِنُ بُنِيَ جُشَمٍ: لَمْ يَكُنَّ إلاّ مجرّد رموز في الرموز، وأساطير في الأساطير: فما القول في أثدائِهِنَّ التي كانت تشبه الأحْقاقَ، وكشوحِهِنَّ التي كانت تشبه الجُدُلُ، وسُوْقِهِنَّ الرَّيَّا التي كانت تشبه البَلْنَطَ أو الرُّخام، وشعورِهِنَ المُسْتَشْزَراتِ إلى العلا، وعطورِهِنَ الشذّية التي كانت تعبق من فُرُشِهِنّ إذا نِمْنَ، وتنتشر من حولهنّ إذا تَرَهْبَأْنَ متكسِّرات في المَشِي...؟ أم كان كُلُّ أولئك مجرّد رموزٍ؟ أم يعني ذلك أنّ بعض الناس يريد أن ينكر وجود المرأة، أصلاً، في الحياة من حيث هي، فيحتال على إنكار دورها في المجتمع، وحضورها في أخْيِلَة الشعراء بتلفيق هذا الشيءِ الذي لم يفكّر فيه شعراء الجاهليّة قطّ، والذي يقال له الرمزيّة؟ أم ماذا يُلاصُ من إنكارِ أسماءِ النساءِ؟ فهل هو إنكار لوجودهنّ، ورَفْضٌ لحضورهن، في المعلّقات؟ ****** رابعاً : جماليّةُ المرأة في المعلّقات ربما سنتولّج إلى معالجة هذه الفقرة من آخر ماكنّا أثرّناه من مُساءلاتٍ في أواخر الفقرة السابقة. وإذا كنّا دَأبنا، في كثير من كتاباتنا الأخيرة، على إيثار عدَم الإجابة عن الأسئلة التي نثيرها، فلأننا نعتقد أنّ طريقَتَنا في إِلْقَائِها تجعل الإجابة عنها كامنةً فيها، أو أنها توحي على الأقلّ، بوجه من الوجوه، بِضَرْبٍ من الإجابة عنها.
وإنما ذهبنا إلى مادِّيَّةِ الوصف النسِويِّ في المعلّقات بخاصّة، وإلى مادّيّة الوصف من حيث هو بعامّة: لأنّنا لا نرى أيّ مُبرّرٍ: لا أخلاقيّ، ولا دينيّ، ولا قانونيّ، ولا نفسيّ، ولا اجتماعيّ، كان يحمل أولئك المعلّقاتيّين على التلميح دون التصريح، وعلى الترميز دون التقرير والتوضيح، ولعلّ الأوصاف الدقيقة التي حاول المعلّقاتيّون توصيفَ المرأةِ بها أن تكون من بين الآيات التي نتخّذ منها ظَهِيراً لنا على إِبعاد رمزيّة المرأة، في المعلّقات، |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
مظاهر اعتقاديّة في المعلّقات أوّلاً: معتقدات العرب في الجاهليّة إنّنا نعتقد أنّ المعتقدات، بأنواعها وأشكالها وطقوسها الكثيرة المختلفة، قديمةٌ قِدَمَ الإنسان. ويبدو أنّ مفهوم المعتقداتِ مظهرٌ ذهنيّ عاطفيّ معاً ينشأ لدى الإنسان حين يضعف ويُحِسُّ بالصِّغَر والضَّآلة أمامَ قوى الطبيعة العاتية، وحين يقصُرُ عن تأويل ظواهر القوى الغيبيّة الهائلة التي تَذَرُهُ حيرانَ أمامَ كثيرٍ من المواقف والأحداث التي لا يُلفي لها تَفسيراً مُقْنِعاً، فيذعن لمعتقدات يعتقد أنها تنقذه مِمّا هو فيه، أو تُقَرِّبُه إلى تلك القُوى الغيبية التي يُؤْمِن بها. من أجل ذلك كانت غريزةُ العاطفةِ الدينيّة جبلّةً في سلوك الإنسان ومعتقداته منذ الأزل، ولكنّ طقوسها ومظاهرها هي التي تختلف. ولعلّ حتّى أولئك الذين لا يؤمنون بالله تعالى، أو لا يوحّدونه، تراهم يَعْمَدونَ إلى الإيمان بمظاهر غيبيّة أخراةٍ فيقدّسونها تقديساً، ويعبدونها من دون الله زُلْفَى، طمَعاً في خيرها، ورغبة في أن ينالَهم شيءٌ من بركاتها، فيما يعتقدون. ولعل، من أجل ذلك كثرت الديانات غيرُ السماويّة، فشاعت عبادةُ الأصنام، وتعدّدت مظاهر الوثنية في شبه الجزيرة العربيّة فإذا كُلّ قبيلةٍ كانت تَتَّخِذُُ لها صَنَمَاً بعينه تَزْدَلفُ منه "وتَعْبُده على سبيل الشرك بالله: إمّا جَهْلاً، وإمّا مُكابرةً وعِناداً(1). وقد "كان دينُ الحنيفيةِ غالباً على العرب يَدينون به حتى أنشأ عمرو بن قمعة(2) صنم اللاّت، فهم أوّل من غيّر دين إبراهيم وإسماعيل وكفَرَ بتعاليمهما، فهو، إذن، أوّل مَنْ عَبَدَ اللاّت من العرب. وكانت اللاّتُ صخرةً عظيمة فكان ابن لحي يَلُتُّ عليها الطعام (أي يَبُلُّهُ بالماء، ويَخْلِطُهُ بشيء من السمن)، ثمّ يُطعمه قومَه، فسُمِيَتْ تلك الصخرةُ اللاّتَ(3). ولكن قبل سعْيِ عمرو بن لحي كانت هناك معتقدات عربيّة قديمة تَمْثُلُ في تقديس الشمس والقمر خصوصاً، وقد أومأ القرآن الكريم إلى عبادة أهل اليمن القدماء الشمسَ، وذلك على عهد الملكة بلقيس(4). من أجل ذلك كانوا يسمّون أطفالهم باسم عبد شمس، على سبيل التبّرك والإقرار، ومن ذلك أنّ قَيْلاً من أقيال بني قحطان كان "يسمّى عبد شمس بن يشجب"(5) ويزعم صاحب التيجان أنّ سبأ بن عبد شمس هو الذي بنى سدّ مأرب(6). وكانت العرب، لتقديسها الشمسَ والقمر، لا تفتأ تقول عن مالها مثل عبارة: "استرعيْتُ مالِيَ القَمَرَ (إذا تركَتْهُ هَمْلاً، لَيْلاً، بلا راعٍ)، واسترعْيتُه الشمسَ"(7) إذا أهملتْه نهاراً). وقد عبّر عن هذا المعتقد العربيّ القديم طرفة بن العبد، فقال: وكان لها جارانِ قابوسُ مِنْهُما وبشرٌ، ولَمْ اسْتَرْعِها الشَمسَ والقَمَر(8). فكأنّ الشمس والقمر كانا مُوَكّلَيْنِ، في معتقداتِ قدماءِ العرب، بحفظ أموالهم، ورعاية أبنائهم، وكَلْئِهمْ من شَرِّ الشياطين، وحِفْظِهمْ من نَكَباتِ الدهر، وكأنّ اسم القمر مشتقّ، من بعض الوجوه، من التَقَمُّرِّ الدالِّ على قوّة الخِداع والمِحَال، والقدرة على المُباغتة والمُفاجأة. وكأنّ القمر، إِذن، مأخوذٌ من بعض ذلك، وهو تأويل اشتقاقيٌّ استنبطناه من المعاجم العربيّة القديمة( وقد سرد القرآن شيئاً من تلك الوثنيات التي كانت قائمة في الجاهليّة على تقديس الشمس والقمر، ونهى عن استمرارها، وممارسة طقوسها، كما سبقت الإيماءة إلى ذلك في آَيَتَيِ النمل وفصّلت(10). كما أنّ هذه المعتقدات كثيراً ما كانت تنشأ عن المبالغة في الأخبار، والتزيُّدِ في الروايات، والتهويل في مشاهد الأسفار، وقد ذكروا أنّ العجم كانت "تكذب فتقول: كان رجل ثُلُثُهُ من نحاس، وثلثه من رصاص، وثلثه من ثَلْج، فتعارضها العرب بهذا وما أشبهه"(11). ومن ذلكم اعتقادُ العرب في النار، وزعْمها المزاعمَ حَوالَها، فكانت تزعم في أساطيرها قبل ظهور الإسلام: "إنّ الغيلان توقد بالليل النيران، للعَبَثِ والتَحَيُّل، واختلال السابلة"(12). وقد تحدّثتْ كتب السيرة النبويّة عن نار التحكيم اليمنية التي كانت تحرق الظالم، ولا تضير المظلوم(13). ويبدو أنّ هذه النار العجيبة كانت من نسج أخيلة بني إسرائيل الذين ربطوها بِحَبْريْنِ يهوديَّيْن: فهما اللذان لم تكن النار تُحْرقهما، وهما اللذان كانا يَحْكُمان بتلك النار بين المختصِمين: فهي نار تُحرْق العرب، ولكنها لا تُحْرِقُ اليهود(14). ومن معتقدات العرب القديمة توهُّمُهُمْ أنّ كُلَّ شيءٍ كان يَعْرِفُ وينطقُ، في الأزمنة الموغلة في القدم، وأنّ الصخور كانت رطبة، فكانت تؤثِّرُ فيها الأقدامُ إذا وَطِئَتْها، وأنّ الطّلْحَ كان خَضِيداً: لا شوك عليه(15). وعلى أننا لا نريد أن نذهب، في بحث هذه المسألة اللطيفة، إلى أبعد حُدودها التي، في حقيقة الأمر، خاض الناس فيها خيَاضاً، قَبْلنَا، وإنما آثْرْنا الكلامَ حَوَالَها من باب التمهيد والاستهلال لهذه المقالة. وهي إِشارات تدلّ على أنّ الجوّ الروحيّ، أو النفسيّ، كان مهيّاً، في المجتمع الجاهليّ، لِتُعشّشَ فيه المعتقداتُ، ولتتبوّأ لها مكانة مكينة في نفوس النساء والرجال. من أجل ذلك تعدّدت الديانات، وشاعَت عبادة الأصنام، وكثر التصديق بالأوهام أمثال السَّعالِي، والغيلان، والشِّقّ، والنَّسْنَاس، والرَّئِيّ..(16)، ومثل التصديق بأنّ الجنّ كانت تقرض الشعر وتُبْدِع الأدب الجميل(17). وقد أردنا، أن نقف هذه المقالة على طائفة من المعتقدات العربيّة القديمة المرتبطة بالطقوس الوثنيّة، والتي أومأت إليها المعلّقات السبعُ: كلُّها أو بعضُها، ونحلّلها تحليلاً انتروبولوجيّا مثل الذّبائح، والعَتَائِر، والتَّمائم، ومسألة تقديس الثَّوْر في المعتقدات الجاهليّة، وطواف العذارَى حول بعض الأصنام مثل طوافهنّ حوال صنم دَوارٍ، وغيرها ممّا له صلة بها كلعبة المسير التي كانت طقوسها العجيبة لا تخلو، هي أيضاً، من مظاهر اعتقاديّة. ثانياً: الحيوان في المعلّقات لقد كَلِفَ الشعراء، على عهد الجاهليّة، كلّفاً شديداً بتناوُل البقر والثور ووصفها، ومعالجة الحمار والأتان ونِعْتِهِما.. ولم يَنْبِه النقّادُ القدماءُ، وشارِحُو النصوص، إلى لطف هذه المسألة، وإلى إمكان ربطها بالمعتقدات العربيّة القديمة، وكان علينا أن ننتظر حتّى تتطوّر الدراسات، ويدور الزمن دورة سحيقة، وتتقدّم الأطوار بالمعرفة والعلم، من أجل أن تخصّص دراسات تحاول تأويل مُثِولِ الثور والحمار، في الشعر الجاهليّ، تأويلاً انتربولوجيّا قائماً على ادِّعاء وجود ترسّبات معتقداتية موغلة في القِدَمِ كانت سائدةً، في شبه الجزيرة العربيّة، ثمّ بادت، أو خمدت جَذْوتُها أو كادت.. وهي التي حملت شعراء الجاهليّة بعامة، وشعراء المعلّقات بخاصة، على أن يَعْرِضُوا لها، أو يومئوا إليها في أشعارهم. وإذا كان النقاد الأقدمون لم يُعْنَوا بهذه المسألة ولم يجاوزوا، أو لم يكادوا يجاوزن، شرحَها على ظاهر النصّ، فإنّ المحدثين -وخصوصاً المعاصرين الحداثيّين -من النقّاد لم يفتأوا يتأوّلون التأويلات، ولم يبرحوا يذهبون في ذلك المذاهب حتّى تعسَّفوا، فعَدَوْا طَوْرْ المعقول. ولعلّ ما يذهب إليه الدكتور عليّ البطل من أنّ صورة الحيوان في الشعر الجاهليّ “تُنْبِئُ بأصول أسطوريّة قديمة كالثور الوحشيّ، وحمار الوحش، والظليم، والناقة، والحِصان، وهي من المعبودات الأساسيّة القديمة"(18) يندرج ضمن هذا المنظور. وقد رأينا من خلال ما ذهب إليه الدكتور البطل أنّ كلّ حيوانٍ كان مقدّساً لدى أهل الجاهليّة: ابتداءً من الثور الوحشيّ، إلى الظليم، والناقة، والحصان. وهو مذهب من الصعوبة الموافقةُ عليه، لأنّنا لا نحسبه يستند إلى نصوص موثوقة، ولا إلى منطق مقبول، إذ لو أنّ العرب كانوا يعبدون هذه الحيوانات كلّها، حقّا، لما اصطادوها، ولما أكلوها، ولامتنعوا عن امتطائها في تَظْعانِهم، ولكانوا عَفُّوا عن تسخيرها في حياتهم الاقتصاديّة والحربيّة: فالأولى: أنّ الذي يقدِّسُ حيواناً، ويعبده، لا يسمح لنفسه بايذائِه، بَلْهَ قَتْلَهُ واصطيادَه، بله أكْلَهُ والتهامَه. ولم نَعْثُرْ على نصّ من النصوص التاريخيّة، ولا الأدبيّة القديمة، ما يفيد أنّ العرب كانت تمتنع عن أكل لحمان الناقة،
|
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 4 | |||
|
القديمة، ما يفيد أنّ العرب كانت تمتنع عن أكل لحمان الناقة، والفرس، والثور الوحشيّ، والنعامة، والعير.. والثانية: أننا لم نعثر على نصّ شعريّ جاهليّ يثبت أنّ العرب كانت تعبد كلّ هذه الحيوانات التي ذَكَرَ طائفةً منها الدكتور البطل. ولا نعتقد أن ما اسْتُكْشِفَ من رسوم، هنا وهناك، يَرْقَى، تاريخيّاً، إلى أن يدُلّ على تقديس العرب إياها، على سبيل القطع واليقين. فقد يرسم المرء ما يحبّ، كما قد يرسم ما لا يحبّ. وتظلّ المسألة، هنا، قائمة على التخمين والظنّ، لا على اليقين والقَطْع. والثالثة: أنّ ما ذهبَ إليه الدكتور ابراهيم عَبد الرحمن من "أنه لم يحدث ولو مرة واحدة، أن قتل الصائد ثوراً في شعر الجاهليّين القَصَصِيّ، إلاّ في شعر صَدْر الإسلام"(19): لا نتّفق معه عليه، هو أيضاً، لجُنوحِنا إلى الاعْتقادِ بنقْصِ الاستقراءِ قبل إصدار هذا الحكم. وعلى أنّا لا ندري ماذا كان يعني الدكتور ابراهيم عبد الرحمن بقوله "في شعر الجاهلييّن القصصيّ"، على وجه الدّقّة؟ فهل كان يريد به إلى الشعر الذي يحكي فيه صاحبُه مغامرةَ صَيدٍ، أو نزهة طَرَدٍ، أم كان يريدُ إلى غير ذلك؟ ونحن ألفينا كثيرا من الأشعار الجاهليّة تتحدّث عن قتل الثور، أو العَيْر، وعن أكله -وهي مندرجة بشكل أو بآخر في مجال القصّ -ومن ذلكم قولُ امرئِ القيس: فعادَى عِدَاءً بين ثورٍ ونَعْجةٍ دراكاً، ولم يَنْضَحْ بماءٍ فَيُغْسَلِِ فظّلُّ طُهاةُُ اللَّحِمْ مِنْ بين مُنْضِجٍ صَفِيفَ شِوَاءٍ، أو قَديرٍ مُعَجَّلِ ولعلّ ما يذكره الدكتور إبراهيم عبد الرحمن لم يرد إلاّ في أشعار قليلة منها معلّقة لبيد التي نلفي في بعضها البقرة تنتصر على الصّياد وكلابهِ معاً: لِتَذُودهُنَّ وأيْقَنَتْ إنْ لَمْ تَذُدْ أنْ قدْ أحمّ مِنَ الحُتوفِ حِمَامُها فتقَصَّدَتْ منها كَسَابِ فضُرِجَتْ بِدَم، وغُودرَ في المَكِرّ سُخامُها لكنّ هذه البقرة لم تأتِ ذلكَ إلا بعد أن كانت، في الحقيقة، ابْتُلِيَتْ بعدوان الصيّاد وكلابِه على جُؤْذُرها، وبعد أن كانت أيقنت، بعد سبعِ ليالٍ مَضَّتْها تنتظره لعلّه أن يَؤُوبَ إليها، أنَّ ابنَها قد اُصْطِيدَ: صادَفْنَ مِنْها غِرَّةٌ فأصَبْنَها إنّ المنايَا لا تَطِشُ سِهامُها فكأنّ سلوكَ البقرة وغضَبَها كان ضَرْباً من التعبير عن الحُزْن الذي أصابَها بعد أن فَقَدَتْ جُؤذَرَها. وعلى أنّ المعركَةَ الضارَيَة التي تَحْدُثُ بين الصّيّادِ وبقرةِ الوَحْشِ، في معلّقة لبيد، لا تدلّ على أنّ هذه البقرة كانت مقدّسةً معبودةً لديهم على نحو صريح، بمقدار ما نلفي تصويراً دقيقاً وأميناً لها، قائماً على المُعايشة والمُخالطة والمُعاينة والمُمارسة، نابِعاً من التجربة والمُشاهدة: لِمَا كانَ الصَّيّادُ يكابده لدى اصطياده بَقَرَةً أو ثَوْراً. ولعلَّ مثل ذلك هو الذي حمل امرَأَ القيس على أن يفتخر بفرسه فيجعلَها سابقة إلى درجة خروجها عن مألوف العادة ممّا يعرف الناس من سرعة الخيل، فإذا جوادُه قَيْد الأوابِدِ، ولذلك استطاع أن يعادِيَ بين ثور وبقرة في طلْقٍ واحد دون أن يُلِمَّ عليه العَرَقُ، أو يصيبَه شيء من البُهْر والنَّصَب: فقد استطاع الصيّادُ بفضل هذا الحِصَان السابق أن يجارِيَ ثَوْرَاً ونعْجَةً في وقت واحد، فيتيح لصاحبه أن يقتلهما معاً، ليقدّمهما من بعد ذلك طعاماً شهيّاً لأهلْ الحيّ، فيشوِيَ منهم مَن شاءَ ما يشاء، ويطبخَ منهم مَنْ شاء ما يشاء، مِنْ لحومهما. ثالثاً: أصناف الحيوانات والطير والحشرات في المعلّقات لقد رصدنا من خلال قراءاتنا المعلّقاتِ السبعَ ما لا يقلّ عن ثلاثة وعشرين صِنْفاً من الحيوانات والطير والحشرات مثل الناقة وما في حكمها (البعير -المطيّة الخ)، والأرآم وما في حكمها (الرشأ- الغزال- الظبْي -الخ) والحصان، والنَّعام، والذئب، والثعلب، والبقر، والثور، والأَتان، والعَيْر، والأسارِيع، والمَكاكِيّ، والسباع، والأوْعَال، والحَمام، والحَيّة، والعُقَاب، والذُّباب.. وألفينا امرأ القيس أكثرَهم ذِكْراً لأصنافِها حيث ذكر في معلّقته ما لا يدنو عن أربعةََ عشَرَ صِنْفاً، ثمّ يأتي بعده لبيد وطرفة بذكر تسعةِ أصنافٍ من الحيوانات، ثم عنترة بذكر ثمانية أصْنَافٍ، ثم الحارث بن حلّزة بذكر سبعة، ثمّ زهير بذكر ثلاثةٍ فقط: وهي الناقة، والآرام، والأسَد، ومثله عمرو بن كُلثوم بذكر ثلاثة هي الناقة، والكِلاب، والخيل. وعلى أنّ كثيراً من هذه الحيوانات وَردَ مكرَّراً، وقد بلغ التكرارُ لدى طرفة إحدى عشرة مرّة على الأقلّ للناقة وما في حكمها، وبلغت درجة التكرار لدى عنترة سبع مرات، ولدى لبيد خمساً، ولدى امرئ القيس وعمرو بن كلثوم أرْبعاً، ولدى زهير ثلاثاً، ولَمْ يقع التكرار لدى الحارث بن حلزّة. وربما يأتي ذِكْرُ الخيلِ في المرتبة الثانية، ولكنْ بعيداً عن الناقة التي استأثر ذِكْرها بخمس وثلاثين مرة في المعلّقات السبع، حيث لم نُلْفِ ذِكْرَها يعلو إلاّ لدى عنترة وعمرو بن كلثوم بستّ مرّات، ثمّ لدى امرئِ القيس وزهير بزهاء ثلاثِ مرات. ولم يرد ذكر الخيل في معلّقات لبيد، وطرفة، وزهير، إطلاقاً. ثم يأتي ذِكْرُ الظبي وما في حكمه بتواتُرٍ بلغ سِتَّ عَشْرَةَ مرّةً: أربع مرّات لدى كلٍّ من امرئ القيس، ولبيد، والحارث بن حلزّة وثلاثاً لدى عنترة، ومرّةً واحدةً فقطْ لَدى طرفة. ثم يأتي ذِكْرُ النّعام بتسع مرّاتٍ: ثلاثِ مرّاتٍ لدى كُلٍ من زُهير، والحارث بن حلّزة، ومرّة واحدة لدى كلّ من امرئِ القيس، وطرفة، ولبيد... ولعل قائلاً أنْ يقولَ، ولا نحسبه إلاّ مكابراً مُناوئاً: وما بَالُ هذه الإحصاءات(20)؟ وما قيمتها ما دامت تنهض على جَهْدٍ عَضَليٍّ بَحْتٍ، وما دامت، بحكم يدويّتها، لا تستطيع أن تَبْرأَ من بعض الأخطاء لدى القيام بالإحصاء: إمّا زيادةً، وإمّا نقصاً؟ ولَوْلاَ عَدَلنَا عَنْها إلى إجراءٍ آخرَ أجدى نَفْعاً للقارئ والباحث معاً؟ ونحن مع اقتناعنا بأنّ الإحصاء لم يَكُ قطُّ لدينا غايةً في ذاته، ومع تسليمنا بأنّ نتائج الإحصاء لا تكون مسلّمة على سبيل القطع واليقين، فإننا، مع ذلك، نريد أن نُبْهِتَ هذا المعارضَ المُكابر، ونبْكّتَ هذا المُشاكِسَ المُناوِئَ، بأن نلقي عليه أسئلة أخراةً، وهي: بل ماذا كان يمكن أن نأتي، ونحن نتحدّث عن هذه الحيوانات في نصوص المعلّقات لَوْ لَمْ نَعْمدْ إلى هذا الإحصاء؟ وما الوسيلة الإجرائيّة التي كان يمكن بواسطتها أن نهتدِيّ السبيلَ إلى أنّ الناقة، مثلاً، هي التي استأثَرَتْ بالتواتُرِ لدى المعلّقاتيّين، وأنّها الحيوان الوحيد الذي ألفينا ذِكْرَهُ يَرِدُ في جميع المعلّقات؟ وما ضُرّ هذا الإحصاءِ، في هذه الاِستنتاجات، وقد أتاح لنا، كما أسلْفنا الْقَال، أن نعرف الحيوانَ الذي كان مستْبِدّاً، لدى المعلّقاتيّين، بالاهتمام، مستأثراً بالعناية، حاضراً في الأذهان، عالِقاً بالقلوب: وهو البعير الذي كان يُتّخَذَ رَكوبَةً، وطَعَاماً، كما كان يُتخّذُ لِمَنَافِعَ أخراةٍ كثيرةٍ كالاتّئِادِ والإمْهْار؟ وإذا كُنّا لَمْ نُلْفِ حيواناً، كان أكثرَ استبداداً بالحضورِ في نصوص هذه المعلّقات من البعير، فَبِمَا اتّصاله اتّصالاً وثيقاً بحياة أهل الجاهليّة. والحقُّ أنّ للإبل مكانةً مكينةً في المجتمع العربيّ البدويّ بعامة، والمجتمع الجاهليّ بخاصّة. ولعل من حقّنا، ونحن نحاول التركيز على موضوع الإبل، أن ننصرف بوهمنا إلى دَوْرِها الاقتصادّي في ذلك المجتمع بحيث كانت تُمَثّلُ أساسَ الحياة، بعد الماء، حتّى قالت إحدى بناتِ ذي الإصبع العُدْوانيّ: "الإِبل (...) نأكل لُحمانَها مُزَعاً، ونشْرَبُ ألبْانها جُرَعاً، وتَحْمِلُنا وضَعَفَتَنا مَعاً"(21) فكانت الإبل بالقياس إلى العرب طعاماً يقتاتونَه، وشراباً يتجرَّعونه، ومْركَباً يمتطونه: 1-كانت الإبلُ تُتَّخَذُ غِذَاءً إذْ لَحْمُها مِمّا يُؤكَلُ، في المجتمعات البدوية والصحراوية، إلى يومنا هذا. ويبدو أنّ أهل البادية كانوا يجدون في طَعمه نَكهة خاصّةً كانت تجعلهم يتلذّذون بطعمه تلذُّذاً، وربما كانوا يشوونه كما نفهم ذلك من حكاية امرئ القيس مع النساء يوم دارة جُلْجُل، حيث اقترح الشاعر على العذارى أن يعقر لهنّ ناقتَه، فرحبّن بالفكرة، وتقبّلن الدعوة، فجمع الإماءُ الحطب، وضرَّموا النار فيه، ثمّ أخذوا في شَيِّ لَحِمْ ناقة امرئ القيس: ويوم عَقْرتُ للِعَذارَى مَطيّتي فيَا عَجَباً مِنْ كُورِها المُتَحَمُّلِ فظلَّ العَذارى يَرْتَمينَ بلَحْمِها وشَحْم كَهُدَّاب الدَمقْس المُفَتَّل(22). 2-كانت الإبل تُتّخَذُ للنقل، وتُصْطَنَعُ في الأسفار، فكان يُرْتَفَقُ بها في مُرْتَفَقاتٍ اجتماعيّة كثيرة، لعلّ أعْرَفَها لدينا: أ-إنهم كانوا ينقلون عليها بضائعهم في الأسفار التجاريّة (رحْلَتَا الشتاءِ والصيف لدى قريش)، ويحتملون عليها أمتعتهم في الارتحالات العاديّة التي كانت تقع لهم حين كانوا يتحمّلُونَ من حَيٍّ إلى حَيٍّ، ومن مَرْعى إلى مَرْعى، ومن ماء إلى ماء، ومن صُقع إلى صقع آخر. ب-إنهم كانوا يحتملون على مُتونها نساءَهم في الأسفار التي كانوا يتّخذون هوادج يُركِبون فيها نساءَهم على ظهورهم. ويبدو أنّ هذه الهوادج كانت تتّخذ للحرائر والعقيلات، ولم تَكُ تُتّخَذُ لعامّة النساء، ولطبقة الإماء. وكانت العرب تطلق على الرجل المديدِ القامةِ، الفارِعِها "مُقبّل الظُّعُن"(23). وشاهُد استعمال الهوادج للنساء واحتمالها فوق المطايا، قولُ امرئ القيس مثلاً: ويوْم دخَلْتُ الخِدْرَ: خِدْر عُنَيْزَةٍ فقالَتْ: لكَ الويلاتُ إنّك مُرْجلي تقول وقد مال الغَبِيطُ بنا مَعاً عَقَرْتَ بعيري يا اُمْرأ الْقَيْسِ، فأنْزِلِ 3-كان يُنْتَفَعُ بوبرها انتفاعاً لطيفاً بحيث كانوا يرتفقون به في جملة من المرافق لعلّ أهمّها: أ-كانوا يصطنعونها في نَسْج المَلابس بحيث كان نساؤُهم ينْسُجْنَ وَبَرَها لاتّخاذِها أثواباً يرتدونها. ولا يبرح الناس، إلى يومنا هذا، في جَنوب الجزائر مثلاً، ينسُجون، من هذا الوَبَر، بَرانِسَ. وهِيَ من أغلى الأثوابِ التقليديّة ثمَناً، وأجْملها لباساً عربيّاً، وأبهاها مَرْآةً للرجال، وأجلّها في المجالس والمَآقط. ونحن وإن كنّا لا نمتلك من المعلومات التاريخيّة ما يتيح لنا أن نحكم بِغَلاءِ سِعْرِ الملابس الوَبريّة قديماً، في المُجتمعِ الجاهليّ، إلاّ أننّا وقياساً على ما نعيشه إلى يومنا هذا في المجتمعات البدَويّة، نعرف أنَّ الوبر هو الأغلى، ثمّ يأتي من بعده الصوف، ثم الشَّعَر. وإنما كان الوبر أغلى ثمَناً لأنّه أندرُ وجوداً في الأسواق، وأعزّ مادّةً في الإنتاج، على حين أنّ الصوف أكثرُ كثرةً في هذه الأسواق، وأيسر إنتاجاً لدى مُرَبيّ المواشي. أمَّا الشعر فلِرداءة مادّته، وخُشونتها، وعُسْرَ غَزَلِها ونسْجِها، وتساقُطِ أَسْقاطِ الشعَر منها أثناء الغزْل- وقد يتطاير الشعرَ على الطعام إذا كان منه قريباً، وربما صادف الطاعِمُ شيئاً من ذلك في أصل الطعام الذي يطْهوه النساءُ اللواتي لا يتشدّدن في التزام النظافة- فإنَّ زُهْدَ الناسِ فيه كثيرٌ، ورغبتهم عنْه شديدةٌ على الرغم من أنّ هناك مُرتَفَقاتٍ لا تليق إلاّ به، ولا يليق إلاّ لها، ومن ذلكم نسْجُ الخيام التي تُنْسَجُ أيضاً من الصوف والوبر(24)- بيد أنّ نوعيّة الخِيام الشّعَريّة هي الأردأ والأسوأ بالقياس إلى مادّتِيَ الوبر والصوف. ب-كما كان العرب ينتفعون بالوَبَر في نسْج الأخبية، والبُجُد(25)، خصوصاً. وإنما سُمِّيَ سكّانُ الباديَة أهْلَ الوبر "لأنّ بيوتهم (كانوا) يتّخذونها منه"(26). فوظيفة الوبر حين تربط بهذه الارتفاقات تبيّن لنا أنّ أهميّتّها الاقتصاديّة والعُمْرانيّة والغذائيّة عظيمةُ الشأن، شريفة المكانة، ذلك بأنّه كان يَقِي الناس حَرّ الشمس وَصَبَارَّة الشتاء، كما كان هذا الوبر زينةً في المجالس، وَجلالاً في المَحافل بحيث يُضْفي شيْئاً من البَهاء والسكينة على مُرتديه. بل كان أيْضاً ضرْباً من الطعام يُضْطَرُّ الناس إلى الاقتيات به أيّام المجاعات. ذلك بأنّ الأعراب البادين المحرومين، كانوا في أيّام المحَن والضُّرِّ، يُضطرّون إلى شَيّ هذا الوبر بعد أن يصبّوا عليه شيئاً من الدَّم ابتغاءَ الاقتياتِ به، وذلك هو العِلْهزُ(27). 4-وْديُ القَتْلى: كان من دأب العرب إذا وقعتْ حادثةُ قَتْلٍ بين شخص وشخص آخر، من قبيلتين مختلفتين، خارج إطار حرب معلنة، أو عَداوة مبيّتة: أن يحتكموا إلى حكمائهم لِوَدْي القَتيل، والاّ أُخِذَ بثأره دَمَاً. وكانت دِيَةُ القتيل، في حال الاتّدَاءِ، غالباً ما تتوقّف لدى مائةٍ بعيرٍ للقتيل الواحد، أو لافتكاك الأسير الواحد، فإن أسَرَ أسيراً رجلان اثنان، كان لكلّ منهما مائةٌ مِن البُعْران. فإن كان الأسيرُ سيّداً من سَراةِ القوم وأشْرافهم كانت الدِّية أكثرَ من ذلك كما وقع في افتداء معبد بن زُرارة الذي أسَرَه عامِرٌ والطُّفَيْل، ابنا مالك بن جعفر بن كلاب، فلمّا جاءهما لَقِيط ابْنُ زُرارة، أخو معْبَد، ليفتدِيَه منهما بمائَتَيْ بعير استَقَلاّ الدّيَة، وَقَالا: "أنت سيّد الناس" وأخوك معبد سيّد مضر، فلا نقبل فيه إلاّ دِيَةَ مَلكٍ(28)! وقد نَهَى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يزيد وَدْيُ القتيل عن أكثر من مائة بعيرٍ، وعَدّ ذلك من فعل أهل الجاهليّة(29). 5-مهْرُ النِساء: وكان الرجل الكريمُ رُبَّما مَهَرَ العقيلةَ العربيّة مائةَ بعيرٍ، بل كان ذلك هو الأغلب، وقد ظَلّ قائماً إلى أن جاء الله بالإسلام(30). ويبدو أنّ العرب بدأت تستعيض عن الإبل بالدراهم حين شاع التداول بين الناس بالعملة المسكوكة بعد ظهور الإسلام، وبعد تدفّق الثروات، وتكاثر الأرزاق(31). كما كانت الإبل تمثّل أساسَ الاقتصاد في المجتمع الجاهليّ فكانت هي مصدرَ أموالِهم، ومآل أرزاقهم، فكانوا إمّا أنْ يُرَبّوها فَتُنْتَجَ لهم فَيَبِيعُوا ما يفيض منها عن لُباناتِهم في الأسواق، وإِمَّا أن يُتاجِروا فيها فيتموَّلوا من ذلك أموالاً، ويُحرزوا أرْباحاً، فكان ذلك يحصل لهم، إذن، إمّا بالابتياع، وإمّا بالإنتاج، وإمّا بالاتّداء، وإمّا بالامتهار، وإمّا بالاتِّهاب.. لم يكن البعير سفينةَ الصحراءِ فحسْب، ولكنه كان مصدرَ الحياة والبقاء، ولم يكن أحدٌ يستغني عنه من العرب على ذلك العهد، فالذي كان يُبْدَعُ به في تَظعانِه، من فقراءِ الأعراب ومَحْروميهم، كان ربّما اسْتحْمَلَ السّراة والأكارِمَ من الناس، كما حَدَثَ للأعرابي الذي استحمل الرسولَ عليه السلام قائلاً: "إنّي أُبْدعَ بي فأُحْمِلْنِي"(32) ولعلّ هذا الاهتمام الفائق بالبعير هو الذي أفضى إلى نشوء طائفةٍ من الطقوس والمعتقدات والوثنيّات حَوَالَهُما، فإذا نحن نصادف في هذه الطقوس الفولكلوريّة لُعبةَ الميْسرِ القائمة على نَحْر الإبل، ثم توزيع لُحمانِها على الفقراء والغرباء والضِّيفانِ، كما نصادف معتقدات ووثنيّاتٍ أخراةً تنهض من حولها مثل معتَقَدِيِ البليَّة والعَتيرة وسَوائِهِما. ولنبدأْ في تحليلها بما انتهَيْنا منه. 1-العتيرة: وردت هذه المُعْتَقَدةُ المرتبطةُ بعادات أهل الجاهليّة، الوثنيّة، في معلّقة الحارث بن حلّزة، لدى قوله: عَنَتا باطلاً وظُلْماً كما تُعْـ تُر، عن حَجْرَةِ الربيض(33)، الظّبَاءُ فقوله:/ كما تُعْتَرُ/ إيماءةٌ إلى طقوس وثنيّة قديمة كانت تُمارَسُ في معتقدات الجاهليّين، وظلّت قائمةً إلى أن جاء الله بالإسلام فأبطلَها. وينصرف معنى "العَتْر"، و"العَتيَرِة" إلى جملة من الطقوس المعتقداتيّة، لعلّ أهمّها: أ- أنّ العَتْرَ كان عبارة عن "شاةٍ كانوا يذبحونها في رَجَبٍ لآلهتهم"(34) وكانوا يدَمُّونَ رأس صَنَمِهم الذي كانوا يقَرِّبون له عَتْراً، في هذا الشهر المحرّم: بِدَم العتيرة. وكانوا يطلقون على تلك الطقوس الوثنيّة العجيبة "أيّام ترْجيبٍ وتعْتَارٍ"(35). ب- كانوا يذْبَحون أوّل ما يُنْتَجُ لهم لآلهتهم على سبيل التبرُّك، والتماس الأزدِلاف منها. ج- وهناك المُعْتقدةُ (التي أومأ إليها الحارث بن حلّزة والتي كانت متمِثّلة في أنّ الرجل منهم "كان يقول في الجاهلية: إن بلغت إبلي مائةً، عَتْرتُ عنها عَتِيرةً، فإذا بلغت مائةً ضَنَّ بالغنم فصادَ ظَبْياً فذبَحه"(36). وكانوا في كلّ الأطوار، إذا ذبحوا عتائرهم، يَصُبُّونَ دمها على رؤوس الأصنام المقرّب إليها. وكانت طقوس الذّبْحِ تَتِمُّ، فيما يبدو، في كلّ الأطوار، في شهر رجب. ولعلّ من أجل ذلك كانوا يطلقون على هذه المُعْتقَدةِ الوثنيّةِ: الرجبيّة(37). د- وكان العَتْر بمثابة النَّذْر، في الشؤون العامّة، بحيث كان الرجل، على عهد الجاهليّة، إذا طلب "أمراً: نذَرَ لئِنْ ظَفرَ به ليذْبَحَنّ من غنمه في رجب: كذا وكذا. وهي العتائر أيضاً. فإذا ظفَرَ، فربما ضاقت نفسُه عن ذلك وَضَنَّ بغَنَمِه، وهي الربيض، فيأخذَ عدَدَها ظِباءً فيذبحها في رجب مكان تلك الغنم"(38). وقد شرح ابن منظور بيت الحارث بن حلّزة الذي نحن بصدد تحليل بعض الطقوس الفولكلوريّة فيه، فذهب إلى أنّ "معناه: أنّ الرجل كان يقول في الجاهليّة: إن بلغت إبلي مائةً عتْرتُ عنها عتيرةً، فإذا بلغت مائةً ضَنَّ بالغنم فصاد ظَبْياً فذبحه. يقول: فهذا الذي تَسَلُونَنا اعتراضٌ وباطلٌ وظُلْمٌ، كما يُعْتَرُ الظَّبْيُ عن ربيض الغنم"(39).
فالعتيرة، إذن ذبيحةٌ كان أهل الجاهليّة يتقرّبون بها لآلهتهم كلّما ألمّ عليهم رجَبٌ في طقوس وثنيّة عجيبة إلى أن جاء الإسلام "فكان على ذلك حتّى نسخ بعد"(40)، وذلك بنهْي النبيّ عليه السلام عن ذلك في الحديث المعروف: "لا فرْعَ ولا عَتِيْرَةَ"(41). ولقائِل أن يعترض علينا فيقرّر أنّ أمر هذه العتيرة خالصٌ للغنم، ومتحوّل عنها إلى الظِباء، فما بالُ الإبلِ وهي هنا منشودَةٍ للْعَتْر، ولا مطلوبةٍ للنّحر، ونحن نُجيبه مبكّتين إيّاه: إنّ كلّ هذه الطقوس لم تكن إلاّ من أجل أن يبلُغَ تعدادُ إبل الرجل مائة، فلمّا كانت هذه الإبل هي موضوع هذه الطقوس، وهي الغاية التي كانت من أجلها تتّخذ هذه الوسيلة، فقد اقتضى الأمر أن تكون هي مركزَ الاهتمام، ومِحْوَرَ العنايةِ في هذه المقالة التي انزلقنا فيها من العناية بالإبل، والارتفاق بها، والانتفاع من بَيْعِها إلى حُبّها، والحرص على امتلاكها، إلى درجة إيرادِ شأنها ضمن طقوس كَهْنوِتيَّةٍ كانت تُقامُ كُلّ شهرِ رجب من العام. |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 5 | |||
|
السلام عليكم مشكورة على المجهود ممكن طلب دروس في أي مقياس |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 6 | |||
|
ما شاء الله |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 7 | |||
|
يتبع بحول الله .............. |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 8 | |||
|
السلام عليكم لي رجاء من الاخوة الأفاضل .ابحث عن كتاب الرمز والرمزية في الشعر المعاصر لمحمد فتوح احمد |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 9 | |||
|
ساعدوني في البحث عن مفهوم مصطلح الشعرية....... |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 10 | |||
|
السلام عليكم |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 11 | |||
|
jai des information mais je ne sais pas comments vous les passer sur le forum |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 12 | |||
|
طلب مساعدة |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 13 | |||
|
السلام عليكم,,,, |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 14 | |||
|
المقاييس هي : النحو و الصرف -اللسانيات-البلاغة - المصادر -علوم القرآن - أدب قديم - العروض - النقد القديم - الفرنسية - الانجليزية -الحضارة ع إ |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 15 | |||
|
المقاييس : النحو والصرف ، الأدب المعاصر ، الأدب الجزائري ، الأدب المغربي والأندلسي ، اللسانيات التطبيقية ، علوم القرآن ، علم الدلالة ، البلاغة ، مدارس نقدية ، الأدب الحديث ، النقد القديم |
|||

|
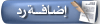 |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| *«•¨*•.¸¸.»منتدى, اللغة, العربية, «•¨*•.¸¸.»*, طلبة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc