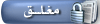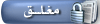تابع / السبئيون
وانتقل "كرب ايل وتر"، بعد ما تقدم إلى التحدث عن حروبه وانتصاراته، فأشار إلى إنه غلب "سادم" "سأد" و "نقبتم" "نقبت" "نقبة"، وأحرق جميع مدن "معفرن" "المعافر"، و قهر "ضبر" و "ضلم" "ضلم" و "أروى" وأحرق مدنهم، وأوقع فيهم فقتل ثلاثة آلاف، وأسر ثمانية آلاف، وضاعف الجزية التي كانوا يدفعونها سابقاً، وفي جملتها البقر والماعز.
ثم انتقل إلى الكلام على بقية أعماله، فذكر إنه أغار على "ذبحن ذ قشرم" "ذبحان ذو قشر" وعلى "شركب" "شرجب"، وتغلب عليها، فأحرق مدنهما، واستولى على جبل "عسمت" "عسمة" وعلى وادي "صير"، وجعلهما وقفاً لألمقه ولشعب سبأ، وهزم "أوسان" في معارك كلفتها ستة عشر ألف قتيل و أربعين ألف أسير، وانتهبت جميع "وسر" من "لجاتم" "لجأتم" حتى "حمن" "حمان"، وأحرقت جميع مدن "انفم" "أنف" و "حمن" "حمان" و "ذيب"، و نهبت "نسم".
ويرى بعض الباحثين إن "لجيت" "لجيأت" "لجيأة"، هو موضع "لجية" في الزمن الحاضر، وأن "حمن" هو موضع يقع على مدخل "وادي حّمان"، أو الموضع المسمى ب "هجر السادة".. وأما "وسر"، فإنها أرض "مرخة" أو جزء منها.
و أصيبت الأرضون التي تسقى بالمطر وهي "رشأى" و "جردن"، بهزيمة منكرة، ونزل بأرض "دئينة" ما نزل بغيرها من هزائم منكرة، وأحرقت مدنها وهتكت مدينة "تفض" واستبيحت ثم دمرت وأحرقت، و نهبت قراها وبساتينها التي تقع في الأرضين الخصبة التي تسقى بماء المطر، وفعلت جيوشه هذا الفعل في الأرضين الأخرى إلى إن بلغت ساحل البحر فأحرقت أيضاً كل المدن الواقعة عليه.
ويظهر من نص "كرب ايل" إن موقع مدينة "تفض"، يجب إن يكون بين أرض "دتنت" والبحر. ولما كانت "دهس" تتاخم "عود" من جهة و "تفض" من جهة أخرى، ذهب بعض الباحثين إلى إن أرض "دهس" هي أرض "يافع" في الزمن الحاضر. أما "تفض"، فأنها الخرائب الواسعة المتصلة بمدينة "خنفر". وقد عرفت "يافع" ب "سروحمير" في أيام "الهمداني". ولا زال أهل يافع يرجعون نسبهم إلى حصر.
وتكوّن الهضاب الواقعة وراء دلتا "أبين" أرض "يافع" في الوقت الحاضر. وقد رأى "فون وزمن" إن "دهس" "دهسم" التي يرد اسمها في النص: REP. EPIG. 3945، هي أرض "يافع".
وذكر "كرب ايل وتر" إنه ضرب "وسر" ضربة نكراء و استولى على كل مناطقها إلى أن بلغ أرض "أوسان" في أيام ملكها "مرتم" "مرتوم"، "مرتو"، "مرت"، "مرة"، فأمر جنوده بأن يعملوا في لشعبها أوسان السيف، واستذل رؤساءه، وجعل رؤساء "المزود" "المسود" وهم رؤساء البلد، رقيقاً للآلهة "سمهت" و قرابين لها، وقرر إن يكون مصير ذلك الشعب الموت والأسر، وأمر بتحطيم قصر الملك "مرتوم" "مرتم" "مرة" المسمى "مسور" "مسر"، ومعالم ما فيه من كتابات اوسانية، وازالة الكتابات الأوسانية التي كانت تزين جدران معابد اوسان، ولما تم له كل ما أراده ورغب فيه، أمر بعودة الجيش السبئي، من أحرار وعبيد من أرض اوسان ومن المقاطعات التابعة لها، إلى ارض سبأ، فعادة إِليها كما صدر الأمر.
وتذكر الكتابة: إن الملك "كرب ايل" أمر عندئذ بضم "سرم" "سرو" سروم" وتوابعها، وكذلك "حمدن" "حمدان" و لواحقها، إلى حكومة سبأ، و سلم ادارة "سرم" إلى السبئيين، وأحاط المدينة بسور، و أعاد الترع والقنوات و مسايل الماء إلى ما كانت عليه. وأما "دهسم" "دهس" و "تبنى" فقد حلت بسكانها الهزيمة، وقتل منهم ألفا قتيل وأسر خمسة آلاف أسر، وأحرقت أكثر مدنها، وأدمجتا ومعهما مقاطعة "دثينة" "دثنت"، في سبأ. أما مقاطعة "عودم" "عود"، فقد أبقيت لملك "دهسم" "دهس". وقد عدّ "العوديون" الذين انفصلوا عن أوسان حلفاء لسبأ، فأبقيت لهم أملاكهم و الأرضون التي كانت لهم.
وكانت "عود" من أرض "أوسان" في الأصل، ثم خضعت ل "مذحي" "مذحيم". ويرى بعض الباحثين إنها "عوذلة" في الزمن الحاضر.
وجاء في هذه الكتابة، وبعد الجملة المتقدمة: إن "انفم" "أنف" وكل مدنها وجميع ما يخصها من أرضين زراعية وما في مما من أودية ومراعي، وكذلك كل أرض "نسم" و "رشاي" "رشأي" وكل الأرضين من "جردن" "جردان" إلى "فخذ علو" و "عرمو"، وكذلك جميع المدن والنواحي التابعة ل "كحد" و "سيبن" "سيبان" والمدن "اتّخ" "أتخ" و "ميفع" و "رتحم" وجميع منطقة "عبدن" "عبدان" ومدنها وجنودها أحراراً وعبيداً، و "دثينة أخلفو" و "ميسرم" "ميسر" و "دثينة تبرم" "دثينة تبر" "وحرتو" وكل المدن والأودية والمناطق والجبال و المراعي في منطقتي "دث" "داث" وكل أرض "تبرم" "تبرم" وما فيها من سكان وأملاك وأموال حتى البحر، وكذلك كل المدن من "تفض" إلى اتجاه "دهس" والسواحل وكل بحار هذه الأرضين، ومناطق "يل أي" و "سلعن" "سلعان" و "عبرت" "عبرة" و "لبنت" "لبنة" ومدنها ومزارعها، وجميع ما يملكه "مرتوم" ملك أوسان وجنوده في "دهس" و "تبنى" و "يتحم" وكذلك "كحد حضنم" "كحد حضن"، وجميع سكان هذه المناطق من أحرار ورقيق وأطفال و كبار، كل هذه من بشر وأملاك جعلها "كرب ابل وتر" ملكاً لسبأ ولآلهة سبأ.
ويظن إن موضع "ميسرم" "ميسر"، وهو من مواضع ارض "دثينة" هو ارض قبيلة "مياسر" في الزمن الحاضر. وقد ذكر بعض السياح إن في أرض "مياسر" سبع آبار ترتوي منها القبيلة المذكورة التي تقطن ارض "دثينة القديمة.
ولفظة "سيبن" "سيبان" الواردة في النص، هي اسم قبيلة، ورد ذكرها في نص متأخر جداً عن هذا النص، هو نص "حصن غراب". و معنى ذلك إنها من القبائل التي ظلت محافظة على كيانها إلى ما بعد الميلاد. فقد أشير إلى "كبر" "كبراء" وإلى "أقيال" "سيبان". وورد "سيين ذ نصف" أي "سيبان" أصحاب "نصف" "نصاف". ويرى بعض الباحثين إن موضع "نصاف" "نصف"، هو الموضع الذي يقال له "نصاب" في الزمن الحاضر.
و اما "ميفع" "ميفعة"، فتقع في الزمن الحاضر في غرب "وادي نصاب" وفي غرب وادي "خورة". واما "رتح" "رتحم"، فهو اسم قبيلة واسم مدينة في ارض "سيبان". وقد ذكر أيضاً في جملة القبائل التي وردت أسماؤها في نصى "حصن غراب". و أما "عبدن" "عبدان"، فانه اسم موضع يقع في جنوب "نصاب" في الزمن الحاضر. وقد قال فيه "كرب أيل" في نصه: "وكل ارض عبدان ومدنها وواديها وجبلها ومراعيها وجنود عبدان احراراً وعبيداً". معبراً بذلك عن تغلبه على كل أهل هذه الأرض من مدنيين وعسكر، حضر وأهل بادية ومراعٍ.
وقد صير "كرب ايل وتر" كل ارض "عبدن" "عبدان" ارضاً حكومية، وتقع في الزمن الحاضر في سلطنة "العوالق العليا"، و يلاحظ إن "وادي عبدان" ما زال حتى اليوم بقراه وبمياهه من ارض السلطان، أي إنه أرض حكومية تخص السلطنة.
واستمر "كرب أيل وتر" مخبراً في كتابته هذه: إنه سجل جميع "كحد" وكل سكانها من أحرار ورقيق بالغين وأطفالاً، وكل ما يملكونه، القادرين على حمل السلاح منهم، وجنود "يل أي" و "شيعن" و "عبرت" "عبرة" وأطفالهم، غنيمة لسبأ. ثم ذكر أنه نظراً إلى تحالف ملك حضرموت الملك "يدع ايل" وشعب حضرموت مع لشعب سبأ في هذا العهد ومساعدتهم له، أمر بإعادة ما كان لهم من ملك في "أوسان" إليهم، وأمر بإعادة ما كان للقتبانيين ولملك قتبان من ملك في "أوسان" إليهم كذلك، للسبب نفسه. فأعيدت تلك الأملاك إلى الحضارمة وإلى القتبانيين.
ثم عاد "كرب ايل" فتحدث عن عداء أهل "كحد سوطم" لسبأ وعن معارضتهم له، فقال: إنه أمهر جيشه بالهجوم عليهم، فأنزل بهم هزيمة منكرة وخسائر جسيمة، فسقط منهم خمس مئة قتيل في معركة واحدة، واخذ منهم ألف طفل أسير وألقي حائك ما عدا الغنائم العظيمة والأموال النفيسة الغالية وعدداً كبيراً من الماشية وقع في أيدي السبئيين.
وتحدث "كرب ايل" بعد ذلك عن "نشن" "نشان"، وقد عارضته كذلك وناصبت " العداء، فذْكر إنها أصيبت بهزيمة منكرة، فاستولت جيوشه عليها، و أحرقت كل مدنها ونواحيها وتوابعها، ونهبت "عشر" و "بيحان" وكل ما يخصها من أملاك وارضين. وذكر إن "نشان" "نيشان" عادت فرفعت راية العصيان للمرة الثانية، لذلك هاجمها السبئيون و حاصروها وحاصروا مدينة "نشق" معها ثلاثة أعوام، كانت نتيجتها ضم "نشق" وتوابعها إلى دولة سبأ، وسقوط آلف قتيل من "نيشان" "نشان" "نشن" وهزيمة الملك "سمه يفع" هزيمة منكرة، وانتزاع كل ما كانت حكومة سبأ قد أجرته من أرضين ل "نشن" و إعادتها ثانية إلى سبأ، وتمليك مملكة سبأ المدن: "قوم" و "جوعل"، و "دورم" و "فذم" و "أيكم"، وكل ما كان ل "سمه يفع" ول "نشن" من ملك في "يأكم" "ياكم"، وكذلك كل ما كان لمعبد الأصنام الواقع على الحدود من أملاك وأوقاف حتى "منتهيتم"، فسجلها باسمه وباسم سبأ.
وصادرت سبأ أرض "نشن" الزراعية وجميع السدود التي تنظم الري فيها، مثل، "ضلم"، و "حرمت"، وماء "مذاب" الذي كان يمون "نشن" وأماكن أخرى بالماء، وسجلت ملكاً لسبأ، وخرب سور "نشن" ودمره حتى أساسه. أما ما تبقى من المدينة، فقد أبقاه، ومنع من حرقه. وهدم قصر الملك المسمى "عفرو" "عفر"، وكذلك مدينته "نشن". وفرض كفارة على كهنة آلهة المدينة الذين كانوا ينطقون باسم اللآلهة، ويتكهنون باسكما للناس، وحتم على حكومة "نشن" إسكان السبئيين في مدينتهم وبناء معبد لعبادة إِلَه سبأ الإلهَ "المقه" في وسط المدينة، وانتزع ماء "ذو قفعن" و أعطاه بالإجارة ل "يذمر ملك" ملك "هرم" "هريم"، وانتزع منها كذلك السدّ المعروف ب "ذات ملك وقه" وأجره ل "نبط على" مللك "كمنه" "كمنا"، ووسع حدود مدينة "كمنه" "كمنا" من موضع سدّ "ذات ملك وقه" إلى موضع الحدود حيث النصب الذي يشير إليه، وسوّر "كرب ايل" مدينة "نشق" وأعطاها سبأ لاستغلالها، وصادر "يدهن" و "جزيت" و "عربم"، وفرض عليها الجزية تدفعها لسبأ.
وانتقل "كرب ايل" بعد هذا الكلام إلى الحديث عن أهل "سبل" و "هرم" "هربم" و "فنن"، فذكر إن هذه المدن غاضبته و عارضته، فأرسل عليها جيشاً هزمها، فسقط منها ثلاثة آلاف قتيل، وسقط ملوكها قتلى كذلك، وأسر منهم خمسة آلاف أسير، وغنم منهم خمسين و مئة ألف من الماشية، وفرض الجزية عليهم عقوبة لهم، ووضعهم تحت حماية السبئيين.
وكان آخر من تحدث عنهم "كرب ايل" في كتابته هذه أهل "مهامر" "مه أمر" "مها مرم" "مهأمر"، و "أمرم" "أمر"، فذكر انه هزمهم وهزم كذلك كل قبائل "مه امرم" "مهأ مرم"، و "عوهبم" "عوهب" "العواهب"، حيث تكبدوا خمسة آلاف قتيل، وأسمر منهم اثني عشر آلف طفل، وأخذ منهم عدداً كبيراً من الجمال والبقر والحمير والغنم يقدر بنحو مئتي آلف رأس، وأحرقت كل مدن "مه أمرم" وسقطت "يفعت" "يفعة"، فدمرت وصادر "كرب أيل" مياه "مه أمرم" في "نجران" و فرض على أهل "مه أمر" الجزية يدفعونها لسبأ.
وقد قص "كرب ايل وتر" في كتابة "صرواح" المسماة ب Glaser 1000B أسماء المدن المذكورة والمقاطعات المحصنة التي استولى عليها، وسجل بعضها باسمه وبعضاً آخر باسم حكومة سبأ و بآلهة سبأ. ومن هذه: "كتلم" و "يثل"، و "نب"، و "ردع" "رداع"، و "وقب"، و "اووم" "أوم"، و "يعرت" "يعرتم"، و "حنذفم" "حنذ فم" "حنذف"، و "نعوت ذت فددم" "نعوت ذات فدد"، و "حزرام" "حزرأم"، و "تمسم" "تمس"، وهي مواضع كانت مسورة محصنة بدليل ورود جملة: " وسور وحصن..." بعدها مباشرة.
وأما المواضع التي أمر "كرب ايل وتر" بتسويرها وبتحصينها، فهي: "تلنن" "تلنان" و "صنوت" و "صدم" "صدوم" و "ردع" "رداع" و "ميفع بخجام" "ميفع بخبأم"، و "محرثم" ومسيلا الماء المؤديان إلى "تمنع" وحصن وسور "وعلن" "وعلان" و "مثبتم" "موثبتم" و "كمدر" "كدار"، وذكر بعد ذلك إنه أمر بإعادة القتبانيين إلى هذه المدن، لأنهم كانوا قد تحالفوا مع "المقه" إله سبأ و "كرب ايل" ومع شعب سبأ، أي إنهم كانوا في جانبهم، فأعادهم إلى المواضع المذكورة مكافأة لهم على ذلك.
ثم عاد "كرب ايل"، فذكر أسماء مواضع أخرى استولى عليها وأخذها باسمه، هي: مدينة "طيب"، وقد أخذها من "عم وقه ذ امرم" "عموقه ذ أمرم"، وأخذ منه أيضاً أملاكه وأمواله في "مسقى نجى"، وفي "افقن" "افقان" و ب "حرتن" "حرتان"، وجبله ومراعيه وأوديته الآتية من "مرس" وكل المراعي في هذا المكان. ثم ذكر إنه أخذ من "حضر همو ذ مفعلم" "حضر همو ذو مفعل"، وهو من الأمراء الإقطاعيين على ما يظهر، هذه المواضع: "شعبم" "شعب"، والأودية، والمراعي التابعة ل "مشرر" إلى موضع "عتب"، ومن "ابيت" "أبيت" إلى "ورخن" و "دعف" وكل الأملاك في "بقتت" و "دنم" "دونم"، فأمر بتسجيلها كلها باسمه، وأمر كذلك بتسجيل "صيهو" باسمه، واشترى "حدنن" أتباع ورقيق "ادم" "حضر همو ذي مفعل" و "جبرم" "جبر" أتباع "يعتق ذ خولن" "يعتق ذو خولان" الذي ب "يرت".
وذكر "كرب ايل وتر" بعد ذلك: إنه وسع املاك قبيلته وأهله "فيشان" "فيشن" وانه اخذ من "رابم بن خل امر ذ وقبم" "رأيم بن خل أمر ذو وقيم"، كل ما يملكه في "وقيم" من أملاك ومن أرضين ومن أودية و مسايل مياه وجبال ومراع، وسجل ذلك كله باسمه، كما إنه استولى على "يعرت" "يعرتم" وعلى جميع ما يتبعها من مسايل مياه وأودية ومراع وجبال وحصون، فسجله باسمه، واستولى أيضاً على أرض "اووم" "أوم" "أوام" وعلى مسايلها، وسجلها ملكاً له.
ثم ذكر إنه صادر كل أموال "خلكرب ذغرن" "خالكرب ذو غوان" وأملاكه في "مضيقت" "مضيقة" وسجلها باسمه، كما سجل أرض "ثمدت" ومسايل مياهها وحصنها ومراعيها في جملة أملاكه ومقتنياته.
ثم عاد في الفقرة الخامسة من النص، فذكر إنه أخذ كل ما كان يلكه "خل كرب دغرن" "خالكرب ذو غران" في أرض "مضيقة" "مضيقت"، و أخذ كذلك التلين الواقعين في "خندفم" "خندف" والأرضين الأخرى إلى مدينة "طبب"، وسجل ذلك كله فيَ جملة أملاكه. وأخذ كذلك كل ما كان يملكه "خالكرب" في "مسقى نجى"، كما أخذ موضع "زولت" وكل ما يتعلق به وما يخصه من مسايل مياه ومراع.
ثم أخذ أرض "اكربي" "اكرّى" ومسايل مياهها، وسجلها باسمه، كما استولى على "نعوت" من حدّ "شدم" و "خام" "خبأم" "خب أم" إلى الأوثان المنصوبة على الحدود علامة لها.
وقطع "كرب ايل وتر" الحديث عن الأملاك التي استولى عليها وسجلها باسمه، وانتقل فجأة إلى التحدث عن بعض ما قام به من أعمال عمرانية، فذكر إنه أتم بناء الطابق الأعلى من قصره "سلحن" "سلحين" ابتداء من الأعمدة و الطابق الأسفل إلى أعلى القصر وانه أقامه في وادي "اذنة" "اذنت" خزان ماء "تفشن"، ومسابله التي توصل الماء إلى "يسرن" "يسران"، وانه شيدّ و حصّن وقوىّ جدار ماء "يلط" وما يتفرع منه من مساق ومسايل تسوق الماء إلى "أبين". ثم قال: إنه شيدّ وبنى وأقام "ظراب" و "ملكن" "ملكان" لوادي "يسرن" "يسران"، كما بنى أبنية أخرى في وسط "يسرن" و "أبين"، وغرس وعمر أرضين زراعية في أرض "يسرن".
ثم عاد فقطع الكلام على ما قام من أعمال عمرانية، وحوله إلى الكلام على أملاكه التي وسعها وزاد فيها، وهي: "ذ يقه ملك" "ذو يقه ملك"، و "أثابن" "أثأب" "أثأبن"، و "مذبن" "المذاب"، و "مفرشم" "مفرش"، و "ذ انفن" "ذو انف" "ذو الأنف"، و "قطنتن" "القطنة" و "سفوتم" "سفوت" و "سلقن" "سلقان"، و "ذ فدهم" "ذ وفدهم"، و "ذ اوثنم" "ذو اوثان"، و "دبسو" "دبس"، و "مفرشم" "مفرش"، و "ذ حببم" "ذو حباب" "ذو حبب"، و "شمرو" "شمر"، و "مهجوم" "مهكوم" "مهجم".
ثم عاد "كرب ايل وتر" فتكلم على الأملاك التي حصل عليها وامتلكها، فذكر إنه تملك في "طرق" موضع "عن . ان" و "حضرو" و "ششعن" "ششون" وذكر إنه تملك موضع "فرعتم" "فرعت" "فرعة" و "تيوسم" "تيوس" و "اثابن" "أثابن" "1 ث ب ن" في ارض "يسرن" وانه تملك "محمين" "محميان" من حدّ "عقبن" "عقبان" حتى "ذي أنف"، وتملك ما يخص "حضر همو بن خل أمر" "حضر همو بن خال أمر" من املاك، وتملك "مفعل" "مفعلم" وكل ما في أرض "ونب" وكل ارض "ونب" وكل أرض "فترم" و "قنت" وكل ما يخص "حضر همو بن خال أمر" من مدن، هي: "مفعلم" و "فترم"، و "قنت" و "جو" "كو" وكل ما فيها من حصون وقلاع وأودية ومراع. ثم ذكر انه باع المدن و الأرضين المذكورة، وهي مدن: "مفعلم"، و "فترم"، و "قنت" و "جو"، التي أخذهما من "حضر همو بن خال كرب" و سجلها باسم قبيلته "فيشان".
وكان قد ذكر في آخر الفترة السابعة من النص وقبل الفقرة الثامنة المتقدمة التي هي خاتمة النص، إنه خرج للصيد فصاد، وقدم ذلك في مذبح "لقظ" قرباًناً للإلَه "عثتر ذي نصد"، كما قدم إليه تمثالاً من الذهب.
وقد أدت حروب "كرب ايل" المذكورة إلى تهدم أسوار كثير من المدن التي هاجمها، فصارت بذلك مدناً مكشوفةً من السهل على الأعراب والغزاة مداهمتها ونهبها، ولهذا اضطر إلى إعادة تسويرها أو ترميم ما تهدم من أسوارها كما اضطر أيضاً إلى تسوير مدن لم تكن مسورة وتحصينها. وفي جهلة المدن التي حصنها وسوّرها أو رمَّ اسوارها، مدينة "وعلان" حاضرة "ردمان"، و "رداع"، و "كدر" "كدار"، ومدن أخرى.
هذا، وأودّ أن الخص الخطط التي سار "كرب ايل" عليها والحروب التي قام بها في الأرضين التي ذكر أسماءها في نصه، على الوجه الآتي: كانت أرض "سأد" أول أرض شرع في مهاجمتها، ثم انتقل منها إلى ارض "نقبتم" "نقبت" "نقبة"، ثم "المعافر"، ثم سار نحو "ذبحان القشر" "ذبحن قشرم" و "شرجب" "شركاب" "شركب" ثم اتجه في حملته الثانية نحو "أوسان"، حيث أمر جنوده بنهب "وسر لمجأت" وبقية المواضع إلى "حمن" "حمان"، وبحرق كل مدن "آنف" في أرض "معن" حول "يشم" "يشبوم" أو "الحاضنة" في الزمن الحاضر، ومدن "حبان" في وادي "حبّان" و "ذياب" في أرض قبيلة "ذياب" شرق حمير في الزمن الحاضر.
ثم أمر "كرب ابل" نبهب "نسم" "نسام" وأرض "رشأى"، ثم "جردن" "جردان".
وعند ذلك وجه "كرب ايل" جيشه نحو "دتنت" حيث أصيب فيها ملك أوسان بضربة شديدة، فأمر بإحراق كل مدن "دشت" ومدينة "تفض" و "أبين"، حتى بلغ ساحل البحر، حيث أحرق ودمر المدن والقرى الواقعة عليه.
ثم عاد "كرب ايل" فضرب أرض "وسر" مرة أخرى، وأصاب قصر ملك اوسان في "مسور"، حيث هدمه، وأمر بانتزاع كل الكتابات الموجودة في معابد اوسان و تحطيمها. ثم سار جيشه كله إلى أرض أوسان،وبعد إن قضى على كل مقاومة لهم عاد إلى بلاده.
ثم قام بغزو أرضين تقع شمال غربي سبأ. ثم وحد "سروم" وأرض "همدان" وحصن مدنهما، وأ صلح وسائل الري فيها.
وحدثت بعد تلك الحروب حرب وقعت في الجنوب، في "دهس" وفي "تبنو"، حيث احرق "كرب ايل" مدنها، ثم ألحقها كلها مع "دتنت" بسبأ، وفصلت أرض "عود" من "أوسان" فضمت إلى "دهس".
واصيب "كحد ذ سوط" بمعارك شديدة، ويظهر إنها ثارت على "كرب ايل" وأعلنت العصيان عليه. وقد ساعدها وشجعها "يذمر ملك" ملك "هرم" وبقية المدن المعينية المجاورة، مثل "نشن" "نشان"، فسار جيش "كرب ايل" إليها، وأنزل بها خسائر فادحة، وأحرق أكثر مدنها، وحاصر "نشان" مدة ثلاث سنين، مما يدل على إنها كانت مدينة حصينة جداً، حتى نحّى ملكها عنها. ثم انصرف "كرب ايل" إلى إعادة تنظيم الأرضين التي استولى عليها، وإلى تعيين حكام جدد للمناطق التي استسلمت له، و إلى إصلاح أسوار المدن ووسائل الدفاع والري.
أما الحملة الأخيرة من حملاته الصغيرة، فكانت على "مهأمر" "ممه امر" و "أمر" حيث بلغت أرض نجران.
لقد أضرت حروب "كرب أي وتر" المذكور في ضراً فادحاً بالعربية الجنوبية فقد أحرق اكثر الأماكن التي استولى عليها، و أمر بقتل من وقع في أيدي جيشه من المحاربين، ثم أمر بإعمال السيف في رقاب سكان المدن والقرى المستسلمة فأهلك خلقاً كثيرا. ونجد سياسة القتل والإحراق هذه عند غير "كرب أيل" أيضاً، وهي سياسة أدت إلى تدهور الحال في اليمن وفي بقية العربية الجنوبية، وإلى اندثار كثير من المواضع بسبب أصحابها وهلاك أصحابها.
وقد عثرت بعثة "وندل فيلبس" في اليمن على كتابة وسمتها البعثة ب Jamme 819 ، جاء فيها: "وبكرب آل و بسمه". أي "وبكرب ايل وسمه". وحرف الواو هنا في واو القسم، و الكتابة من بقايا كتابة أطول تهشمت فلم يبق منها غير الجملة المذكورة. وقد ذهب "جامه" Jamme . ناشرها إلى إنها من عهد سابق لحكم المكربين، و قد زمن كتابتها القرن الثامن أو السابع قبل الميلاد.
كما عثرت تلك البصمة على كتابات أخرى وسمت ب Jamme 550، وب Jamme 552، و ب Jamme 555، و بJamme557 وردت فيها أسماء لم تذكر بعدها جملة "مكرب سبأ" على عادة الكتابات، غير إن ظاهر النص والألفاظ المستعملة فيه، مثل: "قين يدع ايل بين"، يدلان على إنها أسماء "مكربين" حكموا سبأ قبل عهد الملوك.
فقد دوّن في النصف الأول من النص Jamme550 أسماء المكربين: "يدع آل بين" "يدع ايل بين" و "يكرب ملك وتر" "يكربملك وتر"، و "يثع أمر بين". ودوّن في النصف الثاني من أسماء "يدع آل بين" "يدع ايل بين" و "يكرب ملك وتر" "يكر بمللك وتر"، و "يثع أمر بين"، و "كرب آل وتر" "كرب ايل وتر"،أي الأسماء المذكورة في النصف الأول نفسها، ما خلا اسم "كرب ايل وتر". فنحن في هذا النص بنصفيه أمام أربعة مكربين، كانوا من "مذمرم" أي من بني "مذمر".
ومدوّن النص والامر بكتابته شخص اسمه "تبع كرب" "تبعكرب"، و كان كاهناً "رشو" للالهة "ذت غضرن" "ذات غضران"، أي كناية عن الشمس، كما كان بدرجهٌ "قين"، أي موظف كبر مسؤول عن الأمور المالية للدولة أو للمعبد، كأن يتولى إدارة الأموال. وكان "قيناً" لمعبد "سحر"، أي المتولي لأموره المالية والمشرف على ما يصل إلى المعبد من حقوق ومعاملات وعقود من تأجير الحبوس الموقوفة عليه، كما كأن قيناً للمكربين المذكورين. و قد ذكر في نصه إنه أمر ببناء جزء من جدار معبد "المقه" من الحد الذي يحد أسفل الكتابة أي قاعدتها إلى أعلى المعبد، كما أمر ببناء كل الأبراج وما على السقف من أبنية و متعلقاتها، وذلك عن أولاده وأطفاله وأمواله وعن كل ما يقتنيه "هقنيهو" وعن كل تخيله "انخلهو" ب"اذنت" "ادنة" وب "كتم" و ب "ورق" و ب "ترد" و ب"وغمم" "وغم" و ب "عسمت" "عسمة" وب "برام" وب "سحم" وب "مطرن بيسرن"، أي بمنطقة "مطرن" التي في أرض "سرن" "يسران"، وهي تسقى الماء بواسطة قناطر تعبر فوقها المياه، و بمنطقة "ردمن" "ردمان" من أرض "يسرن" "يسران"، التي تروى بمياه السدود، وبأرض "مخضن" الواقعة ب "يهدل".
وقد قام بهذا العمل أيضاً، لأن المقه أوحى في قلبه إنه سيهبه غلاماً، ولأن "يكرب ملك وتر"، اختاره ليشرف على إدارة الأعمال المتعلقة بالحرب التي وقعت بين قتبان وسبأ وقبائلها، فقام بما عهد إليه، وذلك لمدة خمس سنين، وأدى ما كان عليه إن يؤديه على احسن وجه، ولأن الإله "المقه" حرس ووقى كل السبئيين وكل القبائل الأخرى التي اشتركت معهم وكل المشاة "ارجل" الذين ارسلوا على مدينة "تهرجب"، و لأن إلهه حفظه ومكنه من إدارة الأعمال التي عهد الملك إليه، فتولى آمر سبأ والقبائل التي كانت معها، ووجه الأمور احسن وجه ضد الأعمال العدوانية التي قام بها آهل "تهرجب" وغيرهم ضد سبأ، في خلال سنتين كاملتين، حتى وفقه الإلَه لعقد سلام "سلم" بين سبأ و قتبان، فأثابه "يثع أمر بين" على ما صنع.
ويظهر من هذا النص إن "تبع كرب" "تبعكرب"، الكاهن "رشو" و "القين" كان من كبار الملاكين في سبأ في أيامه، له أرضون وأملاك واسعة في أماكن متعددة من سبأ. وقد كانت تدرّ عيه أرباحاً كبيرة وغلة وافرة، يضاف إلى ذلك ما كان يأتيه من غلات المعبد الذي يديره، والنذور التي تنذر للإله "سحر"، ثم الأرباح التي تأتيه من وظيفته في الدولة.
ويظهر إنه كتب نصه المذكور بعد اعتزاله الخدمة لتقدمه في السن، في أوائل أيام حكم "كرب ايل وتر". ولذلك تكون جميع الحوادث والأعمال التي أشار إليها قد وقعت في أيام حكم المذكورين إلى ابتداء حكم "كرب أيل وتر"، الذي ذكر من أجل ذلك في آخر أسماء هؤلاء الحكام وفي القسم الأخير من النص.
ويظهر من النص أيضاً إن الأعمال الحربية التي قام بها "تبعكرب"، كانت في أواخر أيام ""كرب ملك"، وامتدت إلى أوائل أيام حكم "يثع أمر بين". أرسله الأول إلى الحرب، ومنحه الثاني شهادة إتمام تلك الحرب وانتهائها. فهذا النصر يبحث عن السنين الخمس التي شغلها "تبعكرب" بالأعمال الحربية.
وأما صاحب النص: Jamme 552، فهو "ابكرب" "أب كرب" "أبو كرب" وكان من كبار الموظفين من حملة درجة "كبر"، أي "كبير" إذ كان كبيراً على "كمدم بن عم كرب" "كمدم بن عمكرب"، وهم من "شوذم" "شوذ". وكان "قيناً"، أي موظفاً كبيراً عند "يدع ايل بين" وعند "سمه على ينف" "سمه على ين وف". وقد سجل نصه هذا عند بنائه "خخنهن" و "مذقنتن" قربة إلى الإلَه "المقه" ليبارك في أولاده و أطفاله وبيته "بيت يهر"، وفي كل عبيده ومقتنياته، وذلك في أيام المكربين المذكورين.
واما النص: Jamme 555، فصاحبه "ذمر كوب بن ابكرب" "ذمر كرب بن أبكرب"، وهو من "شوذيم"، أي "بني شوذب". وكان قيناً ل "يثع امر" و ل "يكرب ملك" و ل "سمه على" و ل "يدع ايل" و "يكرب ملك". وقد دونه عند إتمامه بناء جدار معبد "المقه"، من حد الحافة الجنوبية لقاعدة حجر الكتابة إلى اعلى البناء، وذلك ليكون عمله قربة إلى الإله، ليبارك في أولاده و آسرته وذوي قرابته وفي أملاكه وعبيده، وقد ذكر أسماء الأرضين التي كان يزرعها ويستغلها، وليبارك في بيته: "بيت يهر" وفي بيته الآخر المسمى "بيت حرر" بمدينة "جهرن" "جهران"، وفي أملاكه وبيوته الأخرى في أرض العشيرتين ": "مهأنف" و "يبران" "يبرن" كما دونه تعبيراً عن حمده و شكره له، لأنه من عليه فأعطاه كل ما أراد منه، ومن جملة ذلك تعيين قيناً على "مأرب"، واشتراكه مع "سمه على ينف" "سمهعلى ينوف" في الحرب التي وقعت بينه وبين قتبان في أرض قتبان، فأعد ذلك الحرب العدد التي ينبغي لها.
وقد نعت "أبكرب بن نبطكرب" "ابكرب بن نبط كرب" وهو من "زلتن" "زلتان" نفسه ب "عبد" "يدع ايل بين" و "سمه على ينف" و "يثع أمر وتر"، و "يكرب ملك ذرح" و "سمه على ينف"، وذلك في النص: Jamme 557. وقد دوّنه عند قيامه ببعض أعال الترميم والبناء في معبد "المقه"، تقرباً إلى رب المعبد "بعل أوّام" الإله "المقه"، ولتكون شفيعة لديه، لكي يبارك فيه وفي ذريته وأملاكه. وقد اختتم النص بجملة ناقصة أصيب آخرها بتلف، ولم يبق منها إلا قوله: "وملك مأرب".
وللجملة الأخيرة من النص أهمية سنة كبيرة، لأنها تتحدث عن ملك كان على مأرب في ذلك الزمن، سقطت حروف اسمه، ولم يبق منه غير الحرف الأول.
ويتبين من النصوص الأربعة المذكورة إننا أمام عدد من حكام سبأ، لم تشر تلك النصوص إلى أزمنتهم ولا إلى صلاتهم بالحكام الآخرين، حتى نستطيع بذلك تعيين المواضع التي بحب إن يأخذوها في القوائم التي وضعها الباحثون لحكام سبأ. وقد رأى "جامه" استناداً إلى دراسته لهذه النصوص، وإلى معاينته لنوع الحجر ولأسلوب الكتابة، إن "يدع ايل بين" المذكور في النص: Jamme 552 هو أقدم من "يدع ايل بين" المذكور في النص Jamme 555، ولذلك دعاه ب "الأول"، ودعا "يدع أيل بين" المذكور في النص: Jamme 555 ب "الثاني" و "يدع ايل بين" المذكور في النص: Jamme 550 ب "يدع ايل" الثالث.
ومنح "جامه" "سمه على ينف" "سمعلى ينوف"، المذكور في النص: Jamme 552 لقب "الأول"، ليميزه عن سميه المذكور في النص Jamme 555، وقد لقبه ب "الثاني". كما منح "يثع أمر بين" المذكور في النص: Jamme 555، لقب الأول، ليميزه عن سميه المذكور في النص: Jamme 550 والذي أعطاه لقب "الثاني". وأما "يثع امر وتر" و "يكرب ملك ذرح"، المذكوران في النص: Jamme 552، فلم يمنحهما أي لقب كان لعدم وجود سمي لهما في النصوص الأخرى.
وتفضل "جامه" على "يكرب ملك وتر"، المذكور في النص: Jamme 555 فمنحه لقب "الأول"، ليميزه عن سميه الذكور في النص: Jamme 550 الذي أعطاه لقب "الثاني". وقد وسم "جامه" "يثع أمر بين" المذكور في النص Jamme 555 ب "الأول"، فميزه بذلك عن سميه المذكور في النص: Jamme 550. وأما "كرب ايل وتر"، المذكور في آخر أسماء حكام النص: Jamme 550، فقد ظل بدون لقب، لعدم وجود سمي له.
مدن سبأ
كانت مدينة "صرواح"، هي عاصمة السبئيين في أيام المكربين ومقر المكرب وفيها باعتبارها العاصمة معبد "المقه" إلهَ سبأ الخاص. أما "مأرب"، فلم تكن عاصمة في هذا العهد، بل كانت مدينة من مدن السبئيين، و "صرواح" في هذا اليوم موضع خرب يعرف به "خربة" و ب "صرواح الخريبة" على مسيرة يوم في الغرب من "مأرب"، و يقع ما بين صنعاء ومارب. وقد ذكر "الهمداني" مدينة "صرواح" في مواضع عدة من كتابه "الاكليل"، وأشار إلى "ملوك صرواح ومأرب". وذكر شعراً في "صرواح" للجاهليين ولجماعة من الإسلاميين، كما أشار إليها في كتابه "صفة جزيرة العرب".
وتحدث "نشوان بن سعيد الحميري" عنها، فقال: صرواح موضع باليمن قريبٌ من مأرب فيه بناء عجيب من مآثر حمير، بناه عمرو ذو صرواح الملك بن الحارث بن مالك بن زيد بن سدد بن حمير الأصغر، وهو أحد الملوك المثامنة". وزعم إن "قُسّ بن ساعدة الإيادي" ذكر "عمرو بن الحارث القيل ذو صرواح" في شعر له. وذكر غيره من علماء اليمن الإسلاميين هذه المدينة السبئية القديمة أيضاً. وفي إشارتهم إليها ونحدثهم عنها، دلالة على أهمية تلك المدينة القديمة، وعلى تأثيرها في نفوس الناس تأثيراً لم يتمكن الزمان من محوه بالرغم من أفول نجمها قبل الإسلام بأمد.
وذكر بعض أهل الأخبار إن "صرواح حصن باليمن أمر سلمان عليه السلام الجن فبنوه لبلقيس". وقولهم هذا هو بالطبع أسطورة من اْلأساطير المتأثرة بالإسرائيليات التي ترجع أصل أكثر المباني العادية في جزيرة العرب إلى سليمان وإلى جن سليمان.
وقد عثر في أنقاض هذه المدينة القديمة المهمة على كتابات سبئية بعضها من عهد المكربين. و من هذه النصوص ، النص المهم الذي تحدثت عنه المعروق بكتابة "صرواح"، و الموسوم عند العلماء ب Glaser 1000 A,B. و صاحبه الآمر يتدوينه هو المكرب الملك "كرب ايل وتر". و هو من أهم ما عثر عليه من نصوص هذا العهد. و قد دوّن فيه اخبار فتوحاته و انتصاراته و ما قام به من أعمال، كما دونته قبل قليل. و لأسماء المواضع و القابائل فيه أهمية كبيرة للمؤرخ و لا شك، إذ تعينه على أن يتعرف مواضع عديدة ترد في نصوص أخرى، و لم نكن نعرف عنها شيئاً، كما اعانتنا في الرجوع بتأريخ بعض هذه الأسماء التي لا تزال معروفة إلى ما قبل الميلاد، إلى القرن الخامس قبل الميلاد، و ذلك إذا ذهبنا مذهب من يرجع عهد "كرب ايل وتر" إلى ذلك الزمن.
و في مقابل خربة معبد صراوح، خربة أخرى تقع على تل، هي بقايا برج المدينة الذي كان يدافع عنها. و هناك أطلال أخرى، يظهر انها من بقايا معابد تلك المدينة و قصورها.
و كان على المدينة "كبر" أي كبير، يدير شؤونها، و يصرف أمورها و أمور الارضين التابعة لها، و تحت يديه موظفون يصرفون الأمور نيابة عنه، و هو المسؤول أمام المكربين عن إدارة أمور المدينة و ما يتبعها من قرى و أرضين و قبائل.
و في "صراوح" كان معبد "المقه" إله سبأ، و من هذه المدينة انتشرت عبادته بانتشار السبئيين. و من معابد هذا الإله التي بنيت في هذه المدينة معبد "يفعن" "يفعان" الذي حظي بعناية المكربين.
و قد زارها "نزيه مؤيد العظم", و ذكر أنها خربة في الوقت الحاضر، بنيت على أنقاضها قرية تتألف من عدد من البيوت، و تشاهد فيها بقايا القصور القديمة، و الأعمدة الحجرية المنقوشة بالمسند، و أشار إلى أن القسم الأعظم من المباني القديمة، مدفون تحت الأنقاض خلا أربعة قصور أو خمسة لا تزال ظاهرة على وجه الأرض، منها قصر يزعم الأهلون إنه كان لبلقيس، وكان به عرشها ولذلك يعرف عندهم بقصر بلقيس. كما زار خرائب "صرواح" أحمد فخري من المتحف المصري في القاهرة، وصور أنقاض معبد "المقه" وعدداً من الكتابات التي ترجم بعضها الأستاذ "ركمنس" M. Ryckmans.
ولم تكن "مرب"، أي "مأرب" عاصمة سبأ في هذا الوقت، بل كانت مدينة من مدن سبأ الكبرى، ولعلها كانت العاصمة السياسية ومقر الطبقة المتنفذة في سبأ. أما "صرواح"، فكانت العاصمة الروحية، فيها معبد الإله الأكبر، وبها مقر الحكاّم الكهنة "المكربون". وقد وجه "المكربون" عنايتهم كما رأينا نحو مأرب، فاقاموا بها معبد "المقه" الكبير والقصور الضخمة وسكنوا في فترات، وأقاموا عندها سدّ مأرب الشهير، فكأنهم كانوا على علم بأن عاصمة سبأ، ستكون مأرب، لا مدينتهم صرواح. وقد يكون لمكان مأرب دخل في هذا التوجه.
قوائم بأسماء المكربين
اشتغل علماء العربية الجنوبية بترتيب في حكام سبأ المكربين بحسب التسلسل التأريخي أو وضعهم في جمهرات على أساس القدم، مراعين في ذلك دراسة نماذج الخطوط والكتابات التي وردت فيها أسماء المكربين، وآراء علماء الآثار في تقدير عمر ما يعثر عليه مما يعود إلى أيام أولئك المكربين، و دراسة تقديراتهم لعمر الطبقات التي يعثر على تلك الآثار فيها. ومن أوائل من عني بهذا الموضوع من أولئك العلماء "كلاسر"، العالم الرحالة الشهير الذي كان له فضل نشر الدراسات العربية الجنوبية والعالم "فرتس هومل"، و "رودوكناكس"، و "فلبي"، وغير هم.
قائمة "هومل"
وقد رتب "هومل" "مكربي" سبأ على هذا النحو: 1 - سمه على، ولم يقف على نعته في الكتابات، واليه تعود الكتابة الموسومة ب Glaser 1147.
2 - يدع آل ذرح "يدع ايل ذرح"، و إلى عهده تعود الكتابات: Arn.9, Glaser 901,1147,484, Halevy 50 3- يثع امر وتر "برخ أمر وتر" وإلى أيامه ترجع الكتابات: Halevy 626,627 4 - يدع آل بين "يدع ايل بين"، وإلى عهده يرجع النص: Halevy 280.
5 -يثع أمر، ولم يذكر نعته، وقد ورد اسمه في النصوص الموسومة ب: Halevy 352,672, Arn. 29..
6 - كرب ايل بين "كرب آل بين".
7 - سمه على ينف "سمهعلى ينوف" "سمه على ينوف".
ويكوّن هؤلاء على رأيه جمهرة مستقلة، هي الجمهرة الأولى لمكربي سبأ. وتتكون الجمهرة الثانية على رأيه من المكربين: 1 - ذمر عد.
2 - سمه على ينف "سمه على ينف"، "سمهعلى ينوف"، و هو باني سد "رحب"، "رحاب"، وإلى أيامه تعود الكتابات: Glaser 413,414, Halevy 673, Arn.14.
3 - يثع امر بين "يثع أمر بين"، وهو باني سد "حببض"، "الحبابض" وموسع سد "رحب" "رحاب"، والمنتصر على "معن" معين والى عهده تعود الكتابات: Glaser 523, 525, Halevy 678, Arn. 12,13, Glaser 418,419 .
4 - ذمر على، لعله ابن يثع أمر بين.
5 - كرب آل وتر "كرب ايل وتر"، صاحب نص صرواح.
وقد عثر في بعض الكتابات على صورة النعامة محفورة مع كتابة ورد فيها اسم الإله "المقه"، كما عثر على كتابات ذكر فيها اسم هذا الإله وحفرت فيها صورة "نسر". وقد ذهب بعض الباحثين إلى احتمال كون هذه الصور هي رمز إلى الإلَه المقه.
قائمة "رودوكناكس"
ناقش "رودوكناكس" القوائم الني وضعها "كلاسر" و "وهومل" و "هارتمن"، وحاول وضع جمهرات جديدة مبنية على أساس الرابطة الدموية والتسلسل التأريخي، وما ورد في الكتابات من أسماء، فذكر في كتابه: "نصوص قتبانية في غلات الأرض" Katabanische ****e Zur Bodenwiristchaft هذه الجمهرات: جمهرة ذكرت أسماؤها في الكتابة: Glaser 1693، وتتألف من: 1 - يدع آل بين ""دع ايل بين".
2 -سمه على ينف "سمه على ينوف".
3 - يثع مر وتر "يثع أمر وتر".
وجمهرة أخرى وردت أسماؤها في الكتابة Glaser 926 و تتكون من: 1 - يثع أمر.
2- يدع آل "يدع ايل".
3-سمه على.
وتكون لمجموعة رمز إليها ب A.
وذكر مجوعة ثالثة تتألف من: 1- يدع آل "يدع ايل".
2- يثع امر "يثع أمر".
3- يدع اب "يدع أب".
وجمهرة رابعة تتكون من: ا- كرب آل "كرب ايل".
2- يدع اب "يدع أب".
3- اخ كرب "أخ كرب".
وقارن بين "هومل" و "هارتمن"، فذكر الجمهرتين.
1- يدع آل "يدع ايل"0 1- يدع أب "ي لى ع أب".
2- يثع امر "يثع أمر" 2- اخ كرب "أخ كرب".
3- كرب آل "كرب اي ل".
وجمهرة: 1- "يدع آل ""يدع ايل".
2- يثع امر "يثع أمر.
3- كرب آل "كرب ايل".
وهي جمهرة B.
ولخص "رودوكناكس" هذه الجمهرات في جمهرات ثلاث هي:جمهرة A وجمهرة B وجمهرة C.
جمهرة "A" Glaser 926 وتتألف من ? ا- يثع امر "يثع أمر".
2- يدع آل ""يدع ايل".
3- سمه على.
جمهر ة "B" Glaser 1752, 1761 Halevy 626، وتتكون من: ا- يدع آل "يدع ايل"، 2- يثع امر "يثع أمر".
3- كرب آل "كرب ايل".
4- سمه على.
جمهرة "C" Glaser 1693 وقوامها: 1- يدع آل بين "يدع ايل بين".
2-سمه على ينف "سمه على ينوف".
3- يثع امر وثر "يثع أمر وتر".
وفي مناقشه للمجموعات الثلاث المتقدمة عاد فذكر الجمهرات التالية: جمهرة "1": سمه على.
يدع آل ذرح "يدع ايل ذرح"،CIH 366, FR 9, Halevy 50 يثع امر وتر ""يثع أمر وتر"، 626 Halevy CIH 490, "يدع آل بين" "يدع ايل بين"، Halevy 45 جمهرة "2".
يثع امر "يثع أمر" لم يرد نعته ".
كرب آل بين "كرب ايل بين" 352, 672 Halevy سمه على ينف "سمه على ينوف" Halevy 45 وذكر الجمهرة التالية في آخر مناقشته لقوائم أسماء المكربين، وتتألف من: يثع امر بين "يثع أمر بين" Gkaser 926 يدع آ ل بين "يدع ايل بين" فاتح مدينة "نشق" Halevy 630, Glaser 926, 1752.
يثع امر "يثع أمر" Halevy 630, Gkaser 1752 كرب آ ل "كرب ايل" Halevy 633, Gaser 1762 .
سمه على Gaser 926, 1762 وليس في تعداد هذه الجمهرات هنا علاقة بعدد المكربين أو بتسلسلهم التأريخي وإنما هي جمهرات وأسماء متكررة، ذكرها "رودوكناكس" للمناقشة ليس غير، وقد أحببت تدوينها هنا ليطلع عليها من يريد التعمق في هذا الموضوع.
قائمة "فلبي"
وقفت على قائمتين صنعها "فلبي" لمكربي سبأ، نشر القائمة الأولى في كتابه: "سناد الإسلام" ونشر القائمة الثانية في مجلة Le Museon. وقد قدر "فلبي" تاريخاً لكل مكرب حكم فيه على رأيه شعب "سبأ". فقدر في قائمته التي نشرها في كتابه المذكور لكل ملك مدة عشرين سنة، وجعل مبدأ تأريخ كحم أول مكرب حوالي سنة "800" قبل الميلاد. وسار على هذا الأساس بإضافة مدة عشرين عاماً لكل ملك، فتألفت قائمته على هذا النحو: ا- سمه على، أول المكربين، حكم حوالي سنة "800" قبل الميلاد.
2- يدع آل ذرح "يدع ايل ذرح"، وهو ابن "سمهعلى"، حكم حوالي سنة "780" قبل الميلاد.
3- يثع امر وتر بن يدع آل ذرح، حكم حوالي سنة "760" قبل الميلاد.
4- يدع آل بين بن يثع امر وتر، حكم حوالي سنة "740" قبل الميلاد.
5- يدع امر وتر بن سمه على ينف، وهو معاصر الملك الآشوري سرجون، وقد حكم حوالي سنة "720" قيل الميلاد.
6- كرب آل بين بن يثع امر، حكم حوالي سنة "700" قبل الميلاد.
7- ذمر على وتر ولا يعرف اسم والده على وجه التأكيد، وربما كان والده "كرب آل وتر"، أو "سمه على ينف" وربما كان شقيقاً ل "كرب آل بين"، وقد حكم في حوالي سنة "680" قبل الميلاد.
8- سمه على ي نف بن ذمر على، وهو باني سدّ "رحب" "رحاب" وقد حكم حوالي سنة "660" قبل الميلاد.
9- يثع امر بين بن سمه على ينف، وهو باني سدّ "حببضن" احبابض، وقد حكم حوالي سنة "640" قبل الميلاد.
10- كرب آل وتر بن ذمر على وتر، آخر المكربين وأول ملوك سبأ، وقد حكم على رأيه من سنة "620" حتى سنة "610" قبل الميلاد.
أما قائمته التي نشرها في مجلة Le Museon. ، فهي على النحو الآتي: 1- سمه على، وهو أقدم مكرب عرفناه. بدأ حكمه حوالي سنة "820" قبل الميلاد. وقد وضع "فلبي" الكتاإت: CIH 367, 418,488,955 إلى جانب اسم هذا المكرب دلالة على أن اسمه ذكر في فيها، غير أني لم أجد لهذا المكرب أية علاقة.الكتابات: CIH 418, 488, 955، فالكتابة CIH 418 أي Glaser 926 لا تعود إلى هذا المكرب، وإنما تعود إلى مكرب آخر زمانه متأخر عنه. وقد وجدت خطأ مشابهاً في مواضع أخرى من هذه المواضع التي أشار فيها إلى الكتابات التي تخص كل مكرب من المكربين.
2- يدع آل ذرح "يدع ايل ذرح"، حكم حوالي سنة "800" قبل الميلاد. أما الكتابات التي ورد فيهما اسمه، فهي: CIH 366, 418, 488, 490, 636, 906, 955, 975, REP. EPIG. 3386, 3623, 3949, 3950, AF 17, 23, 24, 38.
3- سمه على ينف، وقد حكم حوالي سنة "780" قبل الميلاد. أما الكتابات التي تعود إلى أيامه فهي: CIH 368, 371, REP. EPIG. 3623, AF 86, 91, 92 4- يثع امر وتر، لم يذكر المدة التي حكم فيها، وإنما جعل مدة حكمه مع مدة حكم سلفه ثلاثين عاماً، تنتهي بسنة "750" قبل الميلاد. أما الكتابات التي ورد اسمه فيها، فهي: CIH 138, 368, 371, 418, 490, 492, 493, 495, 634, 955, REP. EPI. 3623, 4405 وذكر "فلبي" بعد اسم "سمه على ينف" اسم ابنه "يدع آل وتر"، ولكنه لم يشر إلى أنه كان مكرباً. وقد أشار إلى ورود اسمه في الكتابات:AF 86, 91, 92.
5- يدع آل بين، وهو ابن يثع أمر وتر. وقد حكم في حوالي سنة "750" قبل الميلاد. وورد اسمه في الكتابات: CIH 138, 414, 492, 493, 495, 634, 961, 967, 979, REP, EPIG. 3387, 3389, 4405, AF 34, 89.
وذكر "فلبي" اسم "سمه على ينف" مع اسم شقيقه "يدع آل بين"، ولم يكن هذا مكرباً، وقد ذكر في الكتابات CIH 563, 631.
6- ذمر على ذرح وهو ابن "يدع آل بن"، وقد حكم حوالي سبة "730" قبل الميلاد. جاء اسمه في الكتابات: CIH 633, 979, REP. EPIG. 3387, 3389, AF. 29 وكان له ولد اسمه "يدع آل" "يدع ايل" لا نعرف نعته، ولم يكن مكربا، وقد ورد اسمه في الكتابات: CIH 633, AF,29.
7- يثع امر وتر. ووالده هو "سمه على ينف" شقيق "يدع آل بين"، وقد ذكرت انه لم يكن مكربا. لم يذكر "فلبي" مدة حكمه، وإنما جعل مدة حكمه مع مدة حكم سلفه "ذمر على ذرح" ثلاثين عاماً، انتهت حوالي سنهْ "700" قبل الميلاد.
8- كرب آل بين، وهو ابن يثع امر وتر، حكم حوالي سنة "700" قبل الميلاد، وورد اسمه في الكتابات: CIH 610, 627, 732, 627, 691, REP. EPIG. 3388, 4125, 4401, AF. 43,86.
9- ذمر على وتر بن كرب آل بين، حكم حوالي سنة "680" قبل الميلاد، وورد اسمه في الكتابات: CIH 610, 623, REP, EPIG. 3388, 4401.
10- سمه على ينف، وهو ابن ذمر على وتر. حكم حوالي سنة "660" قبل الميلاد، وذكر اسمه في الكتابات: CIH 622, 623, 629, 733, 774, Philby 77, REP. PEIG. 3650, 4177, 4370.
11- يدع امر بين، وهو ابن سمه على ينف، حكم حوالي سنة "640" قبل الميلاد، وذكر اسمه في الكتابات:CIH 622, 629, 732, 864, Philby 77, AF 62, III, REP. EPIG. 3653, 4177.
وذكر "فلبي" مع اسم "يثع امر.بين" اسم "يكرب ملك وتر" وقد ورد اسمه في الكتابة: AF 70، ولم يكن مكرباً.
2 ا- ذمر على ينف، وقد حكم حوالي سنة "620" قبل الميلاد، وجاء اسمه في الكتابات: AF 70 ,CIH 491 REP. EPIG. 3498, 3636, 3045, 3946.
3 ا- كرب آل وتر، وهو آخر المكربين، وقد حكم حوالي سنة "615" قبل الميلاد، وورد اسممه في الكتابات: CIH 126, 363, 491, 562, 582, 601, 881, 965, REP. EPIG. 3234, 34498, 3636, 3916, 3945, 3946, Philpy 16, 24, 25, 70? 101, 133?
قائمة "ريكمنس" J. Ryckmans
وقد دوّن "ريكمنس" أسماء المكربين على هذا النحو: ا- سمه على.
2- ي دع آل ذرح ""دع ايل ذرح" وهو ابن "سمه على".
3- سمه على ينف، وهو ابن "يدع ايل ذرح".
4- يثع أمر وتر، وهو ابن "يدع ايل فرح" كذلك.
5- يدع آل بين "دع ايل بين"، وهو ابن "يثع أمر وتر".
6- ذمر عد فرح، وهو ابن ""يدع ايل بين".
7- "يثع أمر وتر، وهو ابن "سمه على ينف"، ابن "يثع أمر وتر" وهو شقيق "يدع ايل بين".
8- كرب ايل بين.
يتبع


![]() ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .