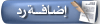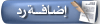بحث مهم حول أسماء الله تعالى وصفاته
منذ : سنتين | الزيارات : 1550
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أسماء الله تعالى، هل هي توقيفيّة، أم لا؟ :
قال النوويّ رحمه الله تعالى: قد اختَلَفَ أهل السنة في تسمية الله تعالى، ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يَرِد به الشرِع، ولا مَنَعَه، فأجازه طائفةٌ، ومنعه آخرون، إلا أن يَرِدَ به شرع مقطوع به، من نصِّ كتاب الله، أو سنة متواترة، أو إجماع على إطلاقه، فإن ورد خبر واحد، فقد اختلفوا فيه، فأجازه طائفة، وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل، وذلك جائز بخبر الواحد، ومنعه آخرون؛ لكونه راجعًا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى، وطريق هذا القطع، قال القاضي: والصواب جوازه؛ لاشتماله على العمل، ولقوله الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 180]. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ (1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ جواز تسمية الله تعالى ووصفه بما ورد في خبر الآحاد، مثل هذا الحديث، وأن خبر الآحاد الصحيح الثابت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مما يوجب العلم والعمل معًا، والقول بأنه لا يوجب العلم، والإشتراط في باب العقائد التواتر قول ضعيف، بل باطلٌ، وإن كان كثُر القائلون به من المتكلّمين ومن سار على منهجهم، وقد ذكرتُ تحقيقه في “التحفة السنيّة”، وشرحها، وقد تقدّم أيضًا في “شرح المقدّمة”، فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.
وقال في “الفتح”: اختُلِفَ في الأسماء الحسنى، هل هي توقيفية؟ بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يَشْتَقَّ من الأفعال الثابتة لله تعالى أسماء، إلا إذا وَرَدَ نَصّ، إما في الكتاب، أو السنة، فقال الفخر: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية، وقالت المعتزلة، والكرامية: إذا دَلَّ العقل على أن معنى اللفظ ثابتٌ في حقّ الله جاز إطلاقه على الله، وقال القاضي أبو بكر، والغزاليّ: الأسماء توقيفية دون الصفات، قال: وهذا هو المختار، واحتج الغزاليّ بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نُسَمِّي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – باسم لم يسمه به أبوه، ولا سَمَّى به نفسه، وكذا كل كبير من الخلق، قال: فإذا امتَنَع ذلك في حقّ المخلوقين، فامتناعه في حق الله تعالى أولى، واتفقوا على أنه لا يجوز أن يُطْلَق عليه اسم، ولا صفةٌ تُوهِم نقصًا، ولو وَرَدَ ذلك نصًّا، فلا يقال: ماهدٌ، ولا زارعٌ، ولا فالقٌ، ولا نحوُ ذلك، وإن ثَبَت في قوله عز وجل: {فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ} [الذاريات: 48]، {أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} [الواقعة: 64]، {فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى} [الأنعام: 95]، ونحوها، ولا يقال له: ماكرٌ، ولا بَنَّاءٌ، وإن وَرَدَ {وَمَكَرَ اللَّهُ} [آل عمران: 54]، {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا} [الذاريات: 47].
وقال أبو القاسم القشيريّ: الأسماء تُؤخذ توقيفًا من الكتاب والسنة والإجماع، فكلُّ اسم وَرَدَ فيها وجب إطلاقه في وصفه، وما لم يَرِد لا يجوز، ولو صَحَّ معناه.
وقال أبو إسحاق الزجاج: لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يَصِفْ به نفسه.
والضابط أن كلَّ ما أذن الشرع أن يُدْعَى به، سواءٌ كان مُشْتَقًّا، أو غير مُشْتَقّ، فهو من أسمائه، وكل ما جاز أن يُنْسَبَ إليه، سواءٌ كان مما يدخله التأويل أو لا، فهو من صفاته، ويُطلَق عليه أيضًا.
قال الحليميّ: الأسماء الحسنى تنقسم إلى العقائد الخمس:
[الأولى]: إثبات الباري؛ رَدًّا على المعطلين، وهي الحيّ، والباقي، والوارث، وما في معناها.
[والثانية]: توحيده ردًّا على المشركين، وهي الكافي، والعليّ، والقادر، ونحوها.
[والثالثة]: تنزيهه ردًّا على المشبّهة، وهي القدوس، والمجيد، والمحيط، وغيرها.
[والرابعة]: اعتقاد أن كلَّ موجود من اختراعه؛ ردًّا على القول بالعلّة والمعلول، وهي الخالق، والبارئ، والمصوِّر، والقويّ، وما يلحق بها.
[والخامسة]: أنه مُدَبّرٌ لما اخترَعَ، ومُصَرِّفه على ما شاء، وهو القيُّوم، والعليم، والحكيم، وشبهها.
وقال أبو العباس بن مَعَدّ: من الأسماء ما يدل على الذات عينًا، وهو الله، وعلى الذات مع سلب، كالقدوس، والسلام، ومع إضافة، كالعليّ العظيم، ومع سلب وإضافة، كالملك، والعزيز، ومنها: ما يَرجع إلى صفة، كالعليم، والقدير، ومع إضافة، كالحليم، والخبير، أو إلى القدرة مع إضافة، كالقهّار، وإلى الإرادة، مع فعل وإضافة، كالرحمن الرحيم، وما يرجع إلى صفة فعل، كالخالق، والبارئ، ومع دلالة على الفعل، كالكريم واللطيف، قال: فالاسماء كلُّها لا تخرج عن هذه العشرة، وليس فيها شيء مترادف؛ إذ لكل اسم خصوصيةٌ مَا، وإن اتفق بعضها مع بعض في أصل المعنى. انتهى كلامه.
وقال الفخر الرازيّ: الألفاظ الدالة ثلاثةٌ ثابتةٌ في حقّ الله قطعًا، وممتنعة قطعًا، وثابتةٌ لكن مقرونة بكيفية، فالقسم الأول: منه ما يجوز ذكره مفردًا ومضافًا، وهو كثيرٌ جدًّا، كالقادر والقاهر، ومنه ما يجوز مفردًا، ولا يجوز مضافًا إلا بشرط، كالخالق، فيجوز خالقٌ، ويجوز خالق كل شيء مثلًا، ولا يجوز خالق القِرَدَة، ومنه عكسه يجوز مضافًا، ولا يجوز مفردًا، كالمنشئ، يجوز منشئ الخلق، ولا يجوز منشئ فقط، والقسم الثاني: إن ورد السمع بشيء منه أُطلق، وحُمِل على ما يليق به، والقسم الثالث: إن ورد بشيء منه أطلق ما ورد منه، ولا يقاس عليه، ولا يتصرف فيه بالإشتقاق، كقوله تعالى: {وَمَكَرَ اللَّهُ}، و {يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ}، فلا يجوز ماكر، ومستهزئ. انتهى ما ذكره في “الفتح” (2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن أسماء الله تعالى توقيفيّة من حيث الدعاء بها، وأما الإخبار بها، فبابه واسع، فيجوز أن يُخْبَر عن الله سبحانه وتعالى بكلّ ما لا ذمّ فيه أصلًا، بل فيه كماله تعالى، وإن لم يَرِد بذلك نصّ، وسيأتي تحقيق ذلك في كلام الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في المسألة التالية – إن شاء الله تعالى -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): قد حقّق هذا الموضوع الإمام الناقد البصير ابن قيّم الجوزيّة رحمه الله تعالى في كتابه “بدائع الفوائد”، أحببت إيراده هنا، وإن كان فيه طولٌ؛ لكونه مشتملًا على تحقيقات بديعة، لا توجد عند غيره مجموعة، قال رحمه الله تعالى:
(فائدةٌ جليلةٌ): ما يَجري صفةً، أو خبرًا على الربّ تبارك وتعالى أقسام:
[أحدها]: ما يَرجِع إلى نفس الذات، كقولك: ذات، وموجود، وشيء.
[الثاني]: ما يَرجِع إلى صفات معنوية: كالعليم، والقدير، والسميع.
[الثالث]: ما يَرجع إلى أفعاله، نحو: الخالق، والرزاق.
[الرابع]: ما يرجع إلى التَّنْزِيه المحض، ولا بُدّ من تضمنه ثبوتًا؛ إذ لا كمال في العدم المحض، كالقُدُّوس، والسلام.
[الخامس]: ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدالّ على جملة أوصاف عديدة، لا تختص بصفة معينة، بل هو دال على معناه، لا على معنى مفرد، نحو: المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد مَن اتصف بصفات متعددة، من صفات الكمال، ولفظه يدلّ على هذا، فإنه موضوع للسعة، والكثرة، والزيادة، فمنه: استمجد الْمَرْخُ، والْعَفَار (3)، وأمجدَ الناقةَ علفًا (4)، ومنه: {ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15)} [البروج: 15]، صفة للعرش؛ لسعته وعظمه وشرفه، وتأمَّل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب الصلاة من الله تعالى على رسوله – صلى الله عليه وسلم -، كما عَلَّمَنَاه – صلى الله عليه وسلم -، لأنه في مقام طلب المزيد، والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأَتَى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول: اغفر لي، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يَحْسُن: إنك أنت السميع البصير (5)، فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل، وأحبها إليه.
ومنه الحديث الذي في “المسند”، والترمذيّ: “أَلِظُّوا بيا ذا الجلال والإكرام” (6).
ومنه: “اللهم إني أسألك بأن لك الحمدَ، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام“، فهذا سؤال له، وتوسل إليه بحمده، وأنه الذي لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة، وأعظمه موقعًا عند المسؤول، وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد، أشرنا إليه إشارةً، وقد فُتِحَ لِمَن بَصّره الله تعالى.
ولنرجع إلى المقصود، وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة، فالعظيم من اتَّصَف بصفات كثيرة من صفات الكمال، وكذلك الصمد، قال ابن عباس – رضي الله عنهما -: هو السيد الذي كَمُلَ في سؤدده (7)، وقال أبو وائل (8): هو السيد الذي انتهى سؤدده، وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد، وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهي إليه السؤدد، فقد صَمَدَ له كلُّ شيء، وقال ابن الأنباريّ: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يَصمُد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم، واشتقاقه يدل على هذا، فإنه من الجمع، والقصد: الذي اجتمع القصد نحوه، واجتمعت فيه صفات السؤدد، وهذا أصله في اللغة، كما قال [من الطويل]:
أَلَا بَكَّرَ النَّاعِي بِخَيْرِ بَنِي أَسَدْ … بِعَمْرِو بْنِ يَرْبُوعِ وَبِالسَّيِّدِ الصَّمَدْ
والعربُ تُسمي أشرافها بالصمد؛ لاجتماع قصد القاصدين إليه، واجتماع صفات السيادة فيه.
[السادس]: صفة تَحصُل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو: الغنيّ الحميد العفو القدير الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة، والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغِنَى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما، وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله، فإنه من أشرف المعارف.
وأما صفات السلب المحض، فلا تدخل في أوصافه تعالى، إلا أن تكون متضمنة لثبوت، كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية، والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يُضَادُّ كماله، وكذلك الإخبار عنه بالسُّلُوب، هو لتضمنها ثبوتًا كقوله تعالى: {لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ} [البقرة: 255]، فإنه مُتَضَمِّنٌ لكمال حياته وقيوميته، وكذلك قوله تعالى: {وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} [ق: 38] متضمن لكمال قدرته، وكذلك قوله: {وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ} [يونس: 61] متضمن لكمال علمه، وكذلك قوله: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3)} [الإخلاص: 3] متضمن لكمال صمديته وغناه، وكذلك قوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)} [الإخلاص: 4] متضمن لتفرده بكماله، وأنه لا نظير له، وكذلك قوله تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103] متضمن لعظمته، وأنه جَلّ عن أن يُدْرَك بحيث يحاط به، وهذا مُطَّرِدٌ في كلّ ما وَصَف به نفسه من السُّلُوب، ويجب أن تُعْلَم هنا أمور:
[أحدها]: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يَدخُل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء، والموجود، والقائم بنفسه، فإنه يُخْبَر به عنه، ولا يَدخُل في أسمائه الحسنى، وصفاته العليا.
[الثاني]: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص، لم تَدخُل بمطلقها في أسمائه، بل يُطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد، والفاعل، والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غَلِطَ مَن سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلًا وخبرًا.
[الثالث]: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يُشْتَقَّ له منه اسم مطلق، كما غَلِطَ فيه بعض المتأخرين، فجعل من أسمائه الحسنى المضلّ الفاتن الماكر، تعالى الله عن قوله، فإن هذه الأسماء لم يُطلَق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخضوصة معينةٌ، فلا يجوز أن يُسَمَّى بأسمائها.
[الرابع]: أن أسماءه عز وجل الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العَلمية، بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي علميتهم؛ لأن أوصافهم مُشترَكَةٌ، فنافتها العلمية المختصة، بخلاف أوصافه تعالى.
[الخامس]: أن الاسم من أسمائه له دلالاتٌ: دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم.
[السادس]: أن أسماءه الحسنى لها اعتباران: اعتبارٌ من حيث الذات، واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول: مترادفة، وبالاعتبار الثاني: متباينة.
[السابع]: أن ما يُطلَق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفيّ، وما يُطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيًّا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه.
فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية، أو يجوز أن يُطْلَق عليه منها بعض ما لم يَرِد به السمع؟ .
[الثامن]: أن الاسم إذا أُطلق عليه جاز أن يُشتَقَّ منه المصدرُ والفعلُ، فَيُخْبَر به عنه فعلًا ومصدرًا، نحو السميع البصير القدير، يُطلَق عليه منه السمع والبصر والقدرة، ويُخْبَر عنه بالأفعال من ذلك، نحو {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ} [المجادلة: 1]، و {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (23)} [المرسلات: 23]، هذا إن كان الفعل متعديًا، فإن كان لازمًا لم يُخبَر عنه به، نحو الحيّ، بل يُطلَق عليه الاسم والمصدر دون الفعل، فلا يقال: حَيِيَ.
[التاسع]: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتُقَّت له الأسماء بعد أن كَمُلَ بالفعل، فالربّ لم يزل كاملًا فحَصَلَت أفعاله عن كماله؛ لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله، كَمُلَ فَفَعَلَ، والمخلوق فَعَلَ فَكَمُلَ الكمال اللائق به.
[العاشر]: إحصاء الأسماء الحسنى، والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلوماتِ سواه إما أن تكون خلقًا له تعالى، أو أمرًا، إما عِلْمٌ بما كَوَّنَهُ، أو عِلْمٌ بما شَرَّعَهُ، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباطَ المقتضَى بمقتضيه، فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى، وهذا كله حَسَنٌ، لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم، والإحسان إليهم، بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه، فأمره كُلُّه مصلحة وحكمة ولطف وإحسان؛ إذ مصدره أسماؤه الحسنى، وفعله كلُّه لا يَخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة؛ إذ مصدره أسماؤه الحسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عَبَثَ، ولم يَخلُق خلقه باطلًا ولا سُدًى ولا عبثًا، وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده، فوجود مَن سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه، فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه، فالعلم بأسمائه، وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم؛ إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم؛ لأن المعلومات هي من مقتضاها، ومرتبطة بها، وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تَجِد فيها خللًا ولا تفاوتًا؛ لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله، إما أن يكون لجهله به، أو لعدم حكمته، وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يَلْحَق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض.
[الحادي عشر]: أن أسماءه كلها حسنى، ليس فيها اسم غير ذلك أصلًا، وقد تقدم أن من أسمائه ما يُطلَق عليه باعتبار الفعل، نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض، لا شَرَّ فيها؛ لأنه لو فعل الشر لاشتُقَّ له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، وهذا باطلٌ، فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته، ولا يَلحَق ذاته، لا يدخل في أفعاله، فالشرّ ليس إليه، لا يضاف إليه فعلًا ولا وصفًا، وإنما يدخل في مفعولاته.
وفَرْقٌ بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله المباين له، لا بفعله الذي هو فعله.
فتأمل هذا، فإنه خَفِيَ على كثير من المتكلمين، وزَلَّت فيه أقدامٌ، وضَلَّت فيه أفهام، وهَدَى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
[الثاني عشر]: في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة، ومدار النجاة والفلاح:
المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها.
المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها.
المرتبة الثالثة: دعاؤه بها، كما قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 180]، وهو مرتبتان:
إحداهما: دعاءُ ثناءٍ وعبادةٍ.
والثاني: دعاءُ طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، وكذلك لا يُسأل إلا بها، فلا يقال: يا موجود، أو يا شيء، أو يا ذات اغفر لي، وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيًا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلًا إليه بذلك الاسم.
ومن تأمل أدعية الرسل عليهم السلام، ولا سيما خاتمهم – صلى الله عليه وسلم – وإمامهم، وَجَدَها مطابقة لهذا، وهذه العبارة أولى من عبارة مَن قال: تَخَلَّقُوا بأسماء الله، فإنها ليست بعبارة سديدة، وهي مُنتزَعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة.
وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان، وهي التعبد، وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن، وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال.
فمراتبها أربعٌ، أشدها إنكارًا عبارة الفلاسفة، وهي التشبه، وأحسن منها عبارة مَن قال: التخلق، وأحسن منها عبارة مَن قال: التعبد، وأحسن من الجميع الدعاء، وهي لفظ القرآن.
[الثالث عشر]: اختَلَف النُّظَّار في الأسماء التي تُطلَق على الله، وعلى العباد، كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها:
فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقةٌ في العبد، مجاز في الربّ، وهذا قول غلاة الجهمية، وهو أخبث الأقوال، وأشدُّها فسادًا.
الثاني: مقابلها وهو أنها حقيقة في الربّ، مجازٌ في العبد، وهذا قول أبي العباس الناشئ.
الثالث: أنها حقيقة فيهما، وهذا قول أهل السنة، وهو الصواب، واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقةً فيهما، وللرب تعالى منها ما يَليق بجلاله، وللعبد منها ما يَليق به.
وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها، وتصحيح صحيحها، فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب، ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سِفْرين أو أكثر.
[الرابع عشر]: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاثة اعتبارات:
اعتبارٌ من حيث هو، مع قطع النظر عن تقييده بالربّ تبارك وتعالى، أو العبد، اعتباره مضافًا إلى الرب مختصًّا به، اعتباره مضافًا إلى العبد مقيدًا به، فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتًا للربّ والعبد، وللرب منه ما يَليق بكماله، وللعبد منه ما يَليق به.
وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات، والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات، والعليم والقدير وسائر الأسماء، فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها، فما لَزِمَ هذه الأسماء لذاتها، فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، بل ثبتت له على وجه لا يماثله فيه خلقه، ولا يشابههم، فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه، وجَحَد صفات كماله، ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه، فقد شبّهه بخلقه، ومن شبّه الله بخلقه فقد كَفَر، ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه، بل كما يليق بجلاله وعظمته، فقد برئ من فَرْث التشبيه، ودم التعطيل، وهذا طريق أهل السنة.
وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله، كما يلزم حياة العبد من النوم والسِّنَةِ والحاجة إلى الغذاء، ونحو ذلك، وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به، ودفع ما يتضرر به، وكذلك ما يلزم علوَّه من احتياجه إلى ما هو عال عليه، وكونه محمولًا به مفتقرًا إليه محاطًا به، كلُّ هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى.
وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها، فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه، كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم، وقدرته وإرادته وسائر صفاته، فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق.
فإذا أحطت بهذه القاعدة خبرًا، وعقلتها كما ينبغي، خَلَصتَ من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين: آفة التعطيل، وآفة التشبيه، فإنك إذا وَفَّيت هذا المقام حقَّه من التصور، أثبَتَّ لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة، فخَلَصت من التعطيل، ونَفَيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم، فخلصت من التشبيه، فتدبر هذا الموضع، واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب، والله الموفق للصواب.
[الخامس عشر]: أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة: أمران لفظيان، وأمران معنويان.
فاللفظيان: ثبوتيّ، وسلبيّ، فالثبوتيّ أن يُشْتَقَّ للموصوف منها اسم، والسلبيّ أن يمتنع الإشتقاق لغيره.
والمعنويان: ثبوتيّ، وسلبيّ، فالثبوتيّ أن يعود حكمها إلى الموصوف، ويُخبَر بها عنه، والسلبيّ أن لا يعود حكمها إلى غيره، ولا يكون خبرًا عنه، وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات.
فلنذكر من ذلك مثالًا واحدًا: وهو صفة الكلام، فإنه إذا قامت بمحلّ، كانت هو التكلم، دون من لم تقم به، وأخبر عنه بها، وعاد حكمها إليه دون غيره، فيقال: قال، وأمر، ونهى، ونادى، وناجى، وأخبر، وخاطب، وتكلم، وكلَّم، ونحو ذلك، وامتنعت هذه الأحكام لغيره، فيُستَدَلُّ بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به، وسلبها عن غيره على عدم قيامها به، وهذا هو أصل السنة الذي رَدُّوا به على المعتزلة والجهمية، وهو من أصحّ الأصول طردًا وعكسًا.
[السادس عشر]: أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر، ولا تُحَدَّ بعدد، فإن لله تعالى أسماءً وصفاتٍ استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب، ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: “أسألك بكل اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك” (9)، فجعل أسماءه ثلاثة أقسام:
قسمٌ سَمَّى به نفسه، فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، ولم يُنْزِل به كتابَهُ، وقسم أَنْزَل به كتابه، فتعَرَّفَ به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه، فلم يَطَّلع عليه أحد من خلقه، ولهذا قال: “استأثرت به”: أي انفَرَدت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به؛ لأن هذا الإنفراد ثابت في الأسماء التي أنزل الله بها كتابه.
ومن هذا قول النبيّ – صلى الله عليه وسلم – في حديث الشفاعة: “فيَفْتَح عليّ من محامده بما لا أُحسنه الآن” (10)، وتلك المحامد تفي بأسمائه وصفاته. ومنه قوله – صلى الله عليه وسلم -: “لا أُحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك” (11).
وأما قوله – صلى الله عليه وسلم -: “إن لله تسعةً وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة” (12)،
فالكلام جملة واحدةٌ، وقوله: “من أحصاها دخل الجنة” صفة، لا خبر مستقبل، والمعنى: له أسماء متعددة، مِن شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها، وهذا كما تقول: لفلان مائة مملوك، وقد أعَدَّهم للجهاد، فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم مُعَدُّون لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه.
[السابع عشر]: أن أسماءه تعالى منها: ما يُطلَق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره، وهو غالب الأسماء، فالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، وهذا يسوغ أن يُدْعَى به مفردًا ومقترنًا بغيره، فتقول: يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يُفْرَد كلُّ اسم، وكذلك في الثناء عليه، والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع.
ومنها: ما لا يُطلَق عليه بمفرده، بل مقرونًا بمقابله، كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يُفرَد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفوّ، فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفوّ المعز المذل؛ لأن الكمال في اقتران كلّ اسم من هذه بما يقابله؛ لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية، وتدبير الخلق، والتصرف فيهم عطاءً ومنعًا ونفعًا وضرًّا وعفوًا وانتقامًا، وأما أن يُثنَى عليه بمجرد المنع والإنتقام والإضرار فلا يسوغ، فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مَجرَى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة، ولم تُطلَق عليه إلا مقترنة، فاعلمه.
فلو قلت: يا مُذِلّ يا ضار يا مانع، وأخبرت بذلك لم تكن مثنيًا عليه، ولا حامدًا له حتى تذكر مقابلها.
[الثامن عشر]: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال، وصفات نقص، وصفات لا تقتضي كمالًا ولا نقصًا، وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسمًا رابعًا، وهو ما يكون كمالًا ونقصًا باعتبارين، والرب تعالى مُنَزَّه عن الأقسام الثلاثة، وموصوف بالقسم الأول، وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله، وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته، هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها، وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم.
وإذا عرفت هذا، فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى، وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص، فله من صفة الإدراكات: العليمُ الخبيرُ، دون العاقل الفقيه، والسميع البصير، دون السامع والباصر والناظر، ومن صفات الإحسان: البرُّ الرحيم الودود، دون الرفيق والشفوق ونحوهما، وكذلك العليُّ العظيمُ، دون الرفيع الشريف، وكذلك الكريمُ، دون السخيّ، والخالق البارئ المصور، دون الفاعل الصانع المشكّل، والغفور العفوّ، دون الصَّفُوح الساتر، وكذلك سائر أسمائه تعالى يَجرِي على نفسه منها أكملُهما وأحسنُها، وما لا يقوم غيره مقامه، فتأمّل ذلك، فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تَعْدِل عما سَمَّى به نفسه إلى غيره، كما لا تَتَجَاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله – صلى الله عليه وسلم – إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون.
[التاسع عشر]: أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالًّا على عِدّة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولًا لجميعها تناولَ الاسم الدالّ على الصفة الواحدة لها، كما تقدم بيانه، كاسمه العظيم والمجيد والصمد، كما قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره: الصمد السيد الذي قد كَمُل في سؤدده، والشريف الذي قد كَمُل في شرفه، والعظيم الذي قد كَمُل في عظمته، والحليم الذي قد كَمُل في حلمه، والعليم الذي قد كَمُل في علمه، والحكيم الذي قد كَمُل في حكمته، وهو الذي قد كَمُل في أنواع شرفه وسؤدده، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفوًا أحد، وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار، هذا لفظه (13).
وهذا مما خَفِي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى، ففَسَّر الاسم بدون معناه، ونقصه من حيث لا يَعلَم، فمن لم يُحط بهذا علمًا بَخَس الاسم الأعظم حقه، وهَضمه معناه، فتدبره.
[العشرون]: وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه، وهي معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه، قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (180)} [الأعراف: 180].
والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت
لها، وهو مأخوذ من الميل، كما يدلّ عليه مادته (ل ح د) فمنه اللَّحْدُ، وهو الشَّقُّ في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الْمُلْحِد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل، قال ابن السِّكِّيت: الْمُلْحِدُ: المائل عن الحق، المدخل فيه ما ليس منه، ومنه الْمُلْتَحَدُ، وهو مُفْتَعَلٌ من ذلك، وقوله تعالى: {وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا} [الكهف: 27]، أي مَن تَعْدِل إليه، وتهرُب إليه، وتلتجئ إليه، وتبتهل فتميل إليه عن غيره، تقول العرب: التحد فلان إلى فلان: إذا عَدَل إليه.
إذا عُرِف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع:
[أحدها]: أن يُسَمِّي الأصنام بها، كتسميتهم اللات من الإلهية، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلهًا، وهذا إلحاد حقيقةً، فإنهم عَدَلُوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة.
[الثاني]: تسميته بما لا يَليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبًا، وتسمية الفلاسفة له موجِبًا بذاته، أو عِلَّةً فاعلةً بالطبع، ونحو ذلك.
[وثالثها]: وصفه بما يتعالى عنه، ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود: إنه فقير، وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم: {يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} [المائدة: 64]، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته.
[ورابعها]: تعطيل الأسماء عن معانيها، وجَحْدُ حقائقها، كقول مَن يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجرَّدَةٌ لا تتضمن صفات، ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون: لا حياة له، ولا سمع، ولا بصر، ولا كلام، ولا إرادة تقوم به، وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلًا وشرعًا ولغةً وفطرةً، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أَعْطَوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله، وجحدوها وعطّلوها، فكلاهما مُلْحِد في أسمائه.
ثم الجهمية وفُروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي، والمتوسط، والمنكوب.
وكُلُّ مَن جَحَد شيئًا مما وَصَف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله – صلى الله عليه وسلم -، فقد ألحد في ذلك، فليستقلّ، أو ليستكثر.
[وخامسها]: تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول المشبِّهون علوًّا كبيرًا، فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، فإن أولئك نَفَوا صفة كماله وجحدوها، وهؤلاء شبَّهوها بصفات خلقه، فجَمَعَهُم الإلحاد، وتفَرَّقت بهم طرقه.
وبَرَّأ الله أتباع رسوله – صلى الله عليه وسلم -، وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يَصِفُوه إلا بما وَصَف به نفسه، ولم يَجحدوا صفاته، ولم يشبّهوها بصفات خلقه، ولم يَعْدِلوا بها عما أُنزِلت عليه لفظًا ولا معنًى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات، ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئًا من التشبيه، وتنزيههم خليًّا من التعطيل، لا كَمَن شَبَّهَ حتى كأنه يعبد صنمًا، أو عَطَّل حتى كأنه لا يعبد إلا عدمًا.
وأهلُ السنة وَسَطٌ في النِّحَل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، تَتَوَقَّدُ مصابيح معارفهم من {شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ} [النور: 35]، فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره، ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته، ومتابعة رسوله – صلى الله عليه وسلم -، إنه قريب مجيب.
فهذه عشرون فائدةً مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى، فعليك بمعرفتها، ومراعاتها، ثم اشْرَحْ الأسماء الحسنى، إن وجدت قلبًا عاقلًا، ولسانًا قائلًا، ومحلًّا قابلًا، وإلا فالسكوت أولى بك، فجناب الربوبية أجلّ وأعزّ مما يخطر بالبال، أو يُعَبِّر عنه المقال، {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف: 76] حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علمًا.
وعسى الله أن يُعِين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى، مراعيًا فيه أحكام هذه القواعد، بريئًا من الإلحاد في أسمائه، وتعطيل صفاته، فهو المانُّ بفضله، والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلام الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى، ولقد شفى، وكفى لمن تأمّله بالإنصاف، ولم يُعم بصيرته التقليد والاعتساف.
{رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8)} [آل عمران: 8]، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، اللهم آمين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
__________
(1) “شرح صحيح مسلم” 2/ 90 – 91.
(2) “الفتح” 11/ 226 – 227 “كتاب الدعوات” رقم الحديث (6410).
(3) قال في “القاموس”: “الْمَرْخُ”: شجر سريع الْوَرْي، و”الْعَفَارُ” كسحاب: شجرٌ يُتّخذ منه الزناد، وقال أيضًا: استمجد الْمَرْخُ والْعَفَارُ: استكثرا من النار. انتهى. ص 236 و 288 و 398.
(4) أي أشبعها، أو علفها ملء بطنها، أو نصف بطنها. انتهى. “ق” ص 288.
(5) هكذا قال ابن القيّم، والمقام مقام نظر، وتأمّل، والله تعالى أعلم.
(6) حديث صحيح، أجاد في تخريجه الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى، راجع: “الصحيحة” 4/ 49 – 51 رقم (1535).
(7) ذكر الحافظ ابن كثير في “تفسيره” كلام ابن عباس – رضي الله عنهما – هذا مطوّلًا، فقال: قال علي بن طلحة، عن ابن عباس: هو السيّد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته، لا تنبغي إلا له، ليس له كفء، وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهّار. انتهى. “تفسير ابن كثير” 14/ 513.
(8) وقع في النسخة: “ابن وائل”، والظاهر أنه تصحيف، راجع: “تفسير ابن كثير” في “سورة الإخلاص”، والله تعالى أعلم.
(9) هو ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في “مسنده”، فقال:
(3528) حدثنا يزيد، أنبأنا فضيل بن مرزوق، حدثنا أبو سلمة الجهنيّ، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله، قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “ما أصاب أحدًا قط همّ، ولا حزنٌ، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سَمَّيت به نفسك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجَلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله هيه وحزنه، وأبدله مكانه فرجًا”، قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: “بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها”.
وقوله: “فرجًا” بالجيم، وفي رواية “فرحًا” بالحاء المهملة.
وهو حديث صحيح، على الراجح، وقد أشبع الكلام فيه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على “المسند” (5/ 267)، والشيخ الألبانيّ في “الصحيحة” (1/ 336 – 341) رقم (199)، فراجعه تستفد.
(10) متّفق عليه.
(11) رواه مسلم وأبو داود.
(12) متّفقٌ عليه.
(13) أخرجه ابن جرير في “تفسيره” 24/ 692، وأبو الشيخ في “العظمة” (98)، والبيهقيّ في “الأسماء والصفات”، وفي إسناده: أبو صالح كاتب الليث، وهو متكلّم في حفظه.
المصدر : البحر المحيط الثجاج 3 / 102-118
منذ : سنتين | الزيارات : 1550
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في أسماء الله تعالى، هل هي توقيفيّة، أم لا؟ :
قال النوويّ رحمه الله تعالى: قد اختَلَفَ أهل السنة في تسمية الله تعالى، ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يَرِد به الشرِع، ولا مَنَعَه، فأجازه طائفةٌ، ومنعه آخرون، إلا أن يَرِدَ به شرع مقطوع به، من نصِّ كتاب الله، أو سنة متواترة، أو إجماع على إطلاقه، فإن ورد خبر واحد، فقد اختلفوا فيه، فأجازه طائفة، وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العمل، وذلك جائز بخبر الواحد، ومنعه آخرون؛ لكونه راجعًا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى، وطريق هذا القطع، قال القاضي: والصواب جوازه؛ لاشتماله على العمل، ولقوله الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 180]. والله أعلم. انتهى كلام النوويّ (1).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ جواز تسمية الله تعالى ووصفه بما ورد في خبر الآحاد، مثل هذا الحديث، وأن خبر الآحاد الصحيح الثابت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مما يوجب العلم والعمل معًا، والقول بأنه لا يوجب العلم، والإشتراط في باب العقائد التواتر قول ضعيف، بل باطلٌ، وإن كان كثُر القائلون به من المتكلّمين ومن سار على منهجهم، وقد ذكرتُ تحقيقه في “التحفة السنيّة”، وشرحها، وقد تقدّم أيضًا في “شرح المقدّمة”، فراجعه تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق.
وقال في “الفتح”: اختُلِفَ في الأسماء الحسنى، هل هي توقيفية؟ بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يَشْتَقَّ من الأفعال الثابتة لله تعالى أسماء، إلا إذا وَرَدَ نَصّ، إما في الكتاب، أو السنة، فقال الفخر: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية، وقالت المعتزلة، والكرامية: إذا دَلَّ العقل على أن معنى اللفظ ثابتٌ في حقّ الله جاز إطلاقه على الله، وقال القاضي أبو بكر، والغزاليّ: الأسماء توقيفية دون الصفات، قال: وهذا هو المختار، واحتج الغزاليّ بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا أن نُسَمِّي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – باسم لم يسمه به أبوه، ولا سَمَّى به نفسه، وكذا كل كبير من الخلق، قال: فإذا امتَنَع ذلك في حقّ المخلوقين، فامتناعه في حق الله تعالى أولى، واتفقوا على أنه لا يجوز أن يُطْلَق عليه اسم، ولا صفةٌ تُوهِم نقصًا، ولو وَرَدَ ذلك نصًّا، فلا يقال: ماهدٌ، ولا زارعٌ، ولا فالقٌ، ولا نحوُ ذلك، وإن ثَبَت في قوله عز وجل: {فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ} [الذاريات: 48]، {أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} [الواقعة: 64]، {فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى} [الأنعام: 95]، ونحوها، ولا يقال له: ماكرٌ، ولا بَنَّاءٌ، وإن وَرَدَ {وَمَكَرَ اللَّهُ} [آل عمران: 54]، {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا} [الذاريات: 47].
وقال أبو القاسم القشيريّ: الأسماء تُؤخذ توقيفًا من الكتاب والسنة والإجماع، فكلُّ اسم وَرَدَ فيها وجب إطلاقه في وصفه، وما لم يَرِد لا يجوز، ولو صَحَّ معناه.
وقال أبو إسحاق الزجاج: لا يجوز لأحد أن يدعو الله بما لم يَصِفْ به نفسه.
والضابط أن كلَّ ما أذن الشرع أن يُدْعَى به، سواءٌ كان مُشْتَقًّا، أو غير مُشْتَقّ، فهو من أسمائه، وكل ما جاز أن يُنْسَبَ إليه، سواءٌ كان مما يدخله التأويل أو لا، فهو من صفاته، ويُطلَق عليه أيضًا.
قال الحليميّ: الأسماء الحسنى تنقسم إلى العقائد الخمس:
[الأولى]: إثبات الباري؛ رَدًّا على المعطلين، وهي الحيّ، والباقي، والوارث، وما في معناها.
[والثانية]: توحيده ردًّا على المشركين، وهي الكافي، والعليّ، والقادر، ونحوها.
[والثالثة]: تنزيهه ردًّا على المشبّهة، وهي القدوس، والمجيد، والمحيط، وغيرها.
[والرابعة]: اعتقاد أن كلَّ موجود من اختراعه؛ ردًّا على القول بالعلّة والمعلول، وهي الخالق، والبارئ، والمصوِّر، والقويّ، وما يلحق بها.
[والخامسة]: أنه مُدَبّرٌ لما اخترَعَ، ومُصَرِّفه على ما شاء، وهو القيُّوم، والعليم، والحكيم، وشبهها.
وقال أبو العباس بن مَعَدّ: من الأسماء ما يدل على الذات عينًا، وهو الله، وعلى الذات مع سلب، كالقدوس، والسلام، ومع إضافة، كالعليّ العظيم، ومع سلب وإضافة، كالملك، والعزيز، ومنها: ما يَرجع إلى صفة، كالعليم، والقدير، ومع إضافة، كالحليم، والخبير، أو إلى القدرة مع إضافة، كالقهّار، وإلى الإرادة، مع فعل وإضافة، كالرحمن الرحيم، وما يرجع إلى صفة فعل، كالخالق، والبارئ، ومع دلالة على الفعل، كالكريم واللطيف، قال: فالاسماء كلُّها لا تخرج عن هذه العشرة، وليس فيها شيء مترادف؛ إذ لكل اسم خصوصيةٌ مَا، وإن اتفق بعضها مع بعض في أصل المعنى. انتهى كلامه.
وقال الفخر الرازيّ: الألفاظ الدالة ثلاثةٌ ثابتةٌ في حقّ الله قطعًا، وممتنعة قطعًا، وثابتةٌ لكن مقرونة بكيفية، فالقسم الأول: منه ما يجوز ذكره مفردًا ومضافًا، وهو كثيرٌ جدًّا، كالقادر والقاهر، ومنه ما يجوز مفردًا، ولا يجوز مضافًا إلا بشرط، كالخالق، فيجوز خالقٌ، ويجوز خالق كل شيء مثلًا، ولا يجوز خالق القِرَدَة، ومنه عكسه يجوز مضافًا، ولا يجوز مفردًا، كالمنشئ، يجوز منشئ الخلق، ولا يجوز منشئ فقط، والقسم الثاني: إن ورد السمع بشيء منه أُطلق، وحُمِل على ما يليق به، والقسم الثالث: إن ورد بشيء منه أطلق ما ورد منه، ولا يقاس عليه، ولا يتصرف فيه بالإشتقاق، كقوله تعالى: {وَمَكَرَ اللَّهُ}، و {يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ}، فلا يجوز ماكر، ومستهزئ. انتهى ما ذكره في “الفتح” (2).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن أسماء الله تعالى توقيفيّة من حيث الدعاء بها، وأما الإخبار بها، فبابه واسع، فيجوز أن يُخْبَر عن الله سبحانه وتعالى بكلّ ما لا ذمّ فيه أصلًا، بل فيه كماله تعالى، وإن لم يَرِد بذلك نصّ، وسيأتي تحقيق ذلك في كلام الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في المسألة التالية – إن شاء الله تعالى -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): قد حقّق هذا الموضوع الإمام الناقد البصير ابن قيّم الجوزيّة رحمه الله تعالى في كتابه “بدائع الفوائد”، أحببت إيراده هنا، وإن كان فيه طولٌ؛ لكونه مشتملًا على تحقيقات بديعة، لا توجد عند غيره مجموعة، قال رحمه الله تعالى:
(فائدةٌ جليلةٌ): ما يَجري صفةً، أو خبرًا على الربّ تبارك وتعالى أقسام:
[أحدها]: ما يَرجِع إلى نفس الذات، كقولك: ذات، وموجود، وشيء.
[الثاني]: ما يَرجِع إلى صفات معنوية: كالعليم، والقدير، والسميع.
[الثالث]: ما يَرجع إلى أفعاله، نحو: الخالق، والرزاق.
[الرابع]: ما يرجع إلى التَّنْزِيه المحض، ولا بُدّ من تضمنه ثبوتًا؛ إذ لا كمال في العدم المحض، كالقُدُّوس، والسلام.
[الخامس]: ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدالّ على جملة أوصاف عديدة، لا تختص بصفة معينة، بل هو دال على معناه، لا على معنى مفرد، نحو: المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد مَن اتصف بصفات متعددة، من صفات الكمال، ولفظه يدلّ على هذا، فإنه موضوع للسعة، والكثرة، والزيادة، فمنه: استمجد الْمَرْخُ، والْعَفَار (3)، وأمجدَ الناقةَ علفًا (4)، ومنه: {ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15)} [البروج: 15]، صفة للعرش؛ لسعته وعظمه وشرفه، وتأمَّل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب الصلاة من الله تعالى على رسوله – صلى الله عليه وسلم -، كما عَلَّمَنَاه – صلى الله عليه وسلم -، لأنه في مقام طلب المزيد، والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأَتَى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول: اغفر لي، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم، ولا يَحْسُن: إنك أنت السميع البصير (5)، فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل، وأحبها إليه.
ومنه الحديث الذي في “المسند”، والترمذيّ: “أَلِظُّوا بيا ذا الجلال والإكرام” (6).
ومنه: “اللهم إني أسألك بأن لك الحمدَ، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام“، فهذا سؤال له، وتوسل إليه بحمده، وأنه الذي لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة، وأعظمه موقعًا عند المسؤول، وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد، أشرنا إليه إشارةً، وقد فُتِحَ لِمَن بَصّره الله تعالى.
ولنرجع إلى المقصود، وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة، فالعظيم من اتَّصَف بصفات كثيرة من صفات الكمال، وكذلك الصمد، قال ابن عباس – رضي الله عنهما -: هو السيد الذي كَمُلَ في سؤدده (7)، وقال أبو وائل (8): هو السيد الذي انتهى سؤدده، وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد، وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهي إليه السؤدد، فقد صَمَدَ له كلُّ شيء، وقال ابن الأنباريّ: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يَصمُد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم، واشتقاقه يدل على هذا، فإنه من الجمع، والقصد: الذي اجتمع القصد نحوه، واجتمعت فيه صفات السؤدد، وهذا أصله في اللغة، كما قال [من الطويل]:
أَلَا بَكَّرَ النَّاعِي بِخَيْرِ بَنِي أَسَدْ … بِعَمْرِو بْنِ يَرْبُوعِ وَبِالسَّيِّدِ الصَّمَدْ
والعربُ تُسمي أشرافها بالصمد؛ لاجتماع قصد القاصدين إليه، واجتماع صفات السيادة فيه.
[السادس]: صفة تَحصُل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو: الغنيّ الحميد العفو القدير الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة، والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغِنَى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما، وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله، فإنه من أشرف المعارف.
وأما صفات السلب المحض، فلا تدخل في أوصافه تعالى، إلا أن تكون متضمنة لثبوت، كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية، والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يُضَادُّ كماله، وكذلك الإخبار عنه بالسُّلُوب، هو لتضمنها ثبوتًا كقوله تعالى: {لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ} [البقرة: 255]، فإنه مُتَضَمِّنٌ لكمال حياته وقيوميته، وكذلك قوله تعالى: {وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} [ق: 38] متضمن لكمال قدرته، وكذلك قوله: {وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ} [يونس: 61] متضمن لكمال علمه، وكذلك قوله: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3)} [الإخلاص: 3] متضمن لكمال صمديته وغناه، وكذلك قوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)} [الإخلاص: 4] متضمن لتفرده بكماله، وأنه لا نظير له، وكذلك قوله تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} [الأنعام: 103] متضمن لعظمته، وأنه جَلّ عن أن يُدْرَك بحيث يحاط به، وهذا مُطَّرِدٌ في كلّ ما وَصَف به نفسه من السُّلُوب، ويجب أن تُعْلَم هنا أمور:
[أحدها]: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يَدخُل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء، والموجود، والقائم بنفسه، فإنه يُخْبَر به عنه، ولا يَدخُل في أسمائه الحسنى، وصفاته العليا.
[الثاني]: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص، لم تَدخُل بمطلقها في أسمائه، بل يُطلق عليه منها كمالها، وهذا كالمريد، والفاعل، والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غَلِطَ مَن سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلًا وخبرًا.
[الثالث]: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يُشْتَقَّ له منه اسم مطلق، كما غَلِطَ فيه بعض المتأخرين، فجعل من أسمائه الحسنى المضلّ الفاتن الماكر، تعالى الله عن قوله، فإن هذه الأسماء لم يُطلَق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخضوصة معينةٌ، فلا يجوز أن يُسَمَّى بأسمائها.
[الرابع]: أن أسماءه عز وجل الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العَلمية، بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي علميتهم؛ لأن أوصافهم مُشترَكَةٌ، فنافتها العلمية المختصة، بخلاف أوصافه تعالى.
[الخامس]: أن الاسم من أسمائه له دلالاتٌ: دلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم.
[السادس]: أن أسماءه الحسنى لها اعتباران: اعتبارٌ من حيث الذات، واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول: مترادفة، وبالاعتبار الثاني: متباينة.
[السابع]: أن ما يُطلَق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفيّ، وما يُطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيًّا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه.
فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية، أو يجوز أن يُطْلَق عليه منها بعض ما لم يَرِد به السمع؟ .
[الثامن]: أن الاسم إذا أُطلق عليه جاز أن يُشتَقَّ منه المصدرُ والفعلُ، فَيُخْبَر به عنه فعلًا ومصدرًا، نحو السميع البصير القدير، يُطلَق عليه منه السمع والبصر والقدرة، ويُخْبَر عنه بالأفعال من ذلك، نحو {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ} [المجادلة: 1]، و {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (23)} [المرسلات: 23]، هذا إن كان الفعل متعديًا، فإن كان لازمًا لم يُخبَر عنه به، نحو الحيّ، بل يُطلَق عليه الاسم والمصدر دون الفعل، فلا يقال: حَيِيَ.
[التاسع]: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتُقَّت له الأسماء بعد أن كَمُلَ بالفعل، فالربّ لم يزل كاملًا فحَصَلَت أفعاله عن كماله؛ لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله، كَمُلَ فَفَعَلَ، والمخلوق فَعَلَ فَكَمُلَ الكمال اللائق به.
[العاشر]: إحصاء الأسماء الحسنى، والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلوماتِ سواه إما أن تكون خلقًا له تعالى، أو أمرًا، إما عِلْمٌ بما كَوَّنَهُ، أو عِلْمٌ بما شَرَّعَهُ، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباطَ المقتضَى بمقتضيه، فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى، وهذا كله حَسَنٌ، لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم، والإحسان إليهم، بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه، فأمره كُلُّه مصلحة وحكمة ولطف وإحسان؛ إذ مصدره أسماؤه الحسنى، وفعله كلُّه لا يَخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة؛ إذ مصدره أسماؤه الحسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عَبَثَ، ولم يَخلُق خلقه باطلًا ولا سُدًى ولا عبثًا، وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده، فوجود مَن سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه، فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه، فالعلم بأسمائه، وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم؛ إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم؛ لأن المعلومات هي من مقتضاها، ومرتبطة بها، وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تَجِد فيها خللًا ولا تفاوتًا؛ لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله، إما أن يكون لجهله به، أو لعدم حكمته، وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يَلْحَق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض.
[الحادي عشر]: أن أسماءه كلها حسنى، ليس فيها اسم غير ذلك أصلًا، وقد تقدم أن من أسمائه ما يُطلَق عليه باعتبار الفعل، نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض، لا شَرَّ فيها؛ لأنه لو فعل الشر لاشتُقَّ له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، وهذا باطلٌ، فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته، ولا يَلحَق ذاته، لا يدخل في أفعاله، فالشرّ ليس إليه، لا يضاف إليه فعلًا ولا وصفًا، وإنما يدخل في مفعولاته.
وفَرْقٌ بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله المباين له، لا بفعله الذي هو فعله.
فتأمل هذا، فإنه خَفِيَ على كثير من المتكلمين، وزَلَّت فيه أقدامٌ، وضَلَّت فيه أفهام، وهَدَى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
[الثاني عشر]: في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة، ومدار النجاة والفلاح:
المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها.
المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها.
المرتبة الثالثة: دعاؤه بها، كما قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: 180]، وهو مرتبتان:
إحداهما: دعاءُ ثناءٍ وعبادةٍ.
والثاني: دعاءُ طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، وكذلك لا يُسأل إلا بها، فلا يقال: يا موجود، أو يا شيء، أو يا ذات اغفر لي، وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيًا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلًا إليه بذلك الاسم.
ومن تأمل أدعية الرسل عليهم السلام، ولا سيما خاتمهم – صلى الله عليه وسلم – وإمامهم، وَجَدَها مطابقة لهذا، وهذه العبارة أولى من عبارة مَن قال: تَخَلَّقُوا بأسماء الله، فإنها ليست بعبارة سديدة، وهي مُنتزَعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة.
وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان، وهي التعبد، وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن، وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال.
فمراتبها أربعٌ، أشدها إنكارًا عبارة الفلاسفة، وهي التشبه، وأحسن منها عبارة مَن قال: التخلق، وأحسن منها عبارة مَن قال: التعبد، وأحسن من الجميع الدعاء، وهي لفظ القرآن.
[الثالث عشر]: اختَلَف النُّظَّار في الأسماء التي تُطلَق على الله، وعلى العباد، كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها:
فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقةٌ في العبد، مجاز في الربّ، وهذا قول غلاة الجهمية، وهو أخبث الأقوال، وأشدُّها فسادًا.
الثاني: مقابلها وهو أنها حقيقة في الربّ، مجازٌ في العبد، وهذا قول أبي العباس الناشئ.
الثالث: أنها حقيقة فيهما، وهذا قول أهل السنة، وهو الصواب، واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقةً فيهما، وللرب تعالى منها ما يَليق بجلاله، وللعبد منها ما يَليق به.
وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها، وتصحيح صحيحها، فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب، ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سِفْرين أو أكثر.
[الرابع عشر]: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاثة اعتبارات:
اعتبارٌ من حيث هو، مع قطع النظر عن تقييده بالربّ تبارك وتعالى، أو العبد، اعتباره مضافًا إلى الرب مختصًّا به، اعتباره مضافًا إلى العبد مقيدًا به، فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتًا للربّ والعبد، وللرب منه ما يَليق بكماله، وللعبد منه ما يَليق به.
وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات، والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات، والعليم والقدير وسائر الأسماء، فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها، فما لَزِمَ هذه الأسماء لذاتها، فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، بل ثبتت له على وجه لا يماثله فيه خلقه، ولا يشابههم، فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه، وجَحَد صفات كماله، ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه، فقد شبّهه بخلقه، ومن شبّه الله بخلقه فقد كَفَر، ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه، بل كما يليق بجلاله وعظمته، فقد برئ من فَرْث التشبيه، ودم التعطيل، وهذا طريق أهل السنة.
وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله، كما يلزم حياة العبد من النوم والسِّنَةِ والحاجة إلى الغذاء، ونحو ذلك، وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به، ودفع ما يتضرر به، وكذلك ما يلزم علوَّه من احتياجه إلى ما هو عال عليه، وكونه محمولًا به مفتقرًا إليه محاطًا به، كلُّ هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى.
وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها، فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه، كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم، وقدرته وإرادته وسائر صفاته، فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق.
فإذا أحطت بهذه القاعدة خبرًا، وعقلتها كما ينبغي، خَلَصتَ من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين: آفة التعطيل، وآفة التشبيه، فإنك إذا وَفَّيت هذا المقام حقَّه من التصور، أثبَتَّ لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة، فخَلَصت من التعطيل، ونَفَيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم، فخلصت من التشبيه، فتدبر هذا الموضع، واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب، والله الموفق للصواب.
[الخامس عشر]: أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة: أمران لفظيان، وأمران معنويان.
فاللفظيان: ثبوتيّ، وسلبيّ، فالثبوتيّ أن يُشْتَقَّ للموصوف منها اسم، والسلبيّ أن يمتنع الإشتقاق لغيره.
والمعنويان: ثبوتيّ، وسلبيّ، فالثبوتيّ أن يعود حكمها إلى الموصوف، ويُخبَر بها عنه، والسلبيّ أن لا يعود حكمها إلى غيره، ولا يكون خبرًا عنه، وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات.
فلنذكر من ذلك مثالًا واحدًا: وهو صفة الكلام، فإنه إذا قامت بمحلّ، كانت هو التكلم، دون من لم تقم به، وأخبر عنه بها، وعاد حكمها إليه دون غيره، فيقال: قال، وأمر، ونهى، ونادى، وناجى، وأخبر، وخاطب، وتكلم، وكلَّم، ونحو ذلك، وامتنعت هذه الأحكام لغيره، فيُستَدَلُّ بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به، وسلبها عن غيره على عدم قيامها به، وهذا هو أصل السنة الذي رَدُّوا به على المعتزلة والجهمية، وهو من أصحّ الأصول طردًا وعكسًا.
[السادس عشر]: أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر، ولا تُحَدَّ بعدد، فإن لله تعالى أسماءً وصفاتٍ استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب، ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: “أسألك بكل اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك” (9)، فجعل أسماءه ثلاثة أقسام:
قسمٌ سَمَّى به نفسه، فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، ولم يُنْزِل به كتابَهُ، وقسم أَنْزَل به كتابه، فتعَرَّفَ به إلى عباده، وقسم استأثر به في علم غيبه، فلم يَطَّلع عليه أحد من خلقه، ولهذا قال: “استأثرت به”: أي انفَرَدت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به؛ لأن هذا الإنفراد ثابت في الأسماء التي أنزل الله بها كتابه.
ومن هذا قول النبيّ – صلى الله عليه وسلم – في حديث الشفاعة: “فيَفْتَح عليّ من محامده بما لا أُحسنه الآن” (10)، وتلك المحامد تفي بأسمائه وصفاته. ومنه قوله – صلى الله عليه وسلم -: “لا أُحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك” (11).
وأما قوله – صلى الله عليه وسلم -: “إن لله تسعةً وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة” (12)،
فالكلام جملة واحدةٌ، وقوله: “من أحصاها دخل الجنة” صفة، لا خبر مستقبل، والمعنى: له أسماء متعددة، مِن شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها، وهذا كما تقول: لفلان مائة مملوك، وقد أعَدَّهم للجهاد، فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم مُعَدُّون لغير الجهاد، وهذا لا خلاف بين العلماء فيه.
[السابع عشر]: أن أسماءه تعالى منها: ما يُطلَق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره، وهو غالب الأسماء، فالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم، وهذا يسوغ أن يُدْعَى به مفردًا ومقترنًا بغيره، فتقول: يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم، وأن يُفْرَد كلُّ اسم، وكذلك في الثناء عليه، والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع.
ومنها: ما لا يُطلَق عليه بمفرده، بل مقرونًا بمقابله، كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يُفرَد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفوّ، فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفوّ المعز المذل؛ لأن الكمال في اقتران كلّ اسم من هذه بما يقابله؛ لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية، وتدبير الخلق، والتصرف فيهم عطاءً ومنعًا ونفعًا وضرًّا وعفوًا وانتقامًا، وأما أن يُثنَى عليه بمجرد المنع والإنتقام والإضرار فلا يسوغ، فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مَجرَى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة، ولم تُطلَق عليه إلا مقترنة، فاعلمه.
فلو قلت: يا مُذِلّ يا ضار يا مانع، وأخبرت بذلك لم تكن مثنيًا عليه، ولا حامدًا له حتى تذكر مقابلها.
[الثامن عشر]: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال، وصفات نقص، وصفات لا تقتضي كمالًا ولا نقصًا، وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسمًا رابعًا، وهو ما يكون كمالًا ونقصًا باعتبارين، والرب تعالى مُنَزَّه عن الأقسام الثلاثة، وموصوف بالقسم الأول، وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله، وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته، هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها، وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم.
وإذا عرفت هذا، فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى، وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص، فله من صفة الإدراكات: العليمُ الخبيرُ، دون العاقل الفقيه، والسميع البصير، دون السامع والباصر والناظر، ومن صفات الإحسان: البرُّ الرحيم الودود، دون الرفيق والشفوق ونحوهما، وكذلك العليُّ العظيمُ، دون الرفيع الشريف، وكذلك الكريمُ، دون السخيّ، والخالق البارئ المصور، دون الفاعل الصانع المشكّل، والغفور العفوّ، دون الصَّفُوح الساتر، وكذلك سائر أسمائه تعالى يَجرِي على نفسه منها أكملُهما وأحسنُها، وما لا يقوم غيره مقامه، فتأمّل ذلك، فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا تَعْدِل عما سَمَّى به نفسه إلى غيره، كما لا تَتَجَاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله – صلى الله عليه وسلم – إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون.
[التاسع عشر]: أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالًّا على عِدّة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولًا لجميعها تناولَ الاسم الدالّ على الصفة الواحدة لها، كما تقدم بيانه، كاسمه العظيم والمجيد والصمد، كما قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره: الصمد السيد الذي قد كَمُل في سؤدده، والشريف الذي قد كَمُل في شرفه، والعظيم الذي قد كَمُل في عظمته، والحليم الذي قد كَمُل في حلمه، والعليم الذي قد كَمُل في علمه، والحكيم الذي قد كَمُل في حكمته، وهو الذي قد كَمُل في أنواع شرفه وسؤدده، وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفوًا أحد، وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار، هذا لفظه (13).
وهذا مما خَفِي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى، ففَسَّر الاسم بدون معناه، ونقصه من حيث لا يَعلَم، فمن لم يُحط بهذا علمًا بَخَس الاسم الأعظم حقه، وهَضمه معناه، فتدبره.
[العشرون]: وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه، وهي معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه، قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (180)} [الأعراف: 180].
والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت
لها، وهو مأخوذ من الميل، كما يدلّ عليه مادته (ل ح د) فمنه اللَّحْدُ، وهو الشَّقُّ في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الْمُلْحِد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل، قال ابن السِّكِّيت: الْمُلْحِدُ: المائل عن الحق، المدخل فيه ما ليس منه، ومنه الْمُلْتَحَدُ، وهو مُفْتَعَلٌ من ذلك، وقوله تعالى: {وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا} [الكهف: 27]، أي مَن تَعْدِل إليه، وتهرُب إليه، وتلتجئ إليه، وتبتهل فتميل إليه عن غيره، تقول العرب: التحد فلان إلى فلان: إذا عَدَل إليه.
إذا عُرِف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع:
[أحدها]: أن يُسَمِّي الأصنام بها، كتسميتهم اللات من الإلهية، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلهًا، وهذا إلحاد حقيقةً، فإنهم عَدَلُوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة.
[الثاني]: تسميته بما لا يَليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبًا، وتسمية الفلاسفة له موجِبًا بذاته، أو عِلَّةً فاعلةً بالطبع، ونحو ذلك.
[وثالثها]: وصفه بما يتعالى عنه، ويتقدس من النقائص، كقول أخبث اليهود: إنه فقير، وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم: {يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} [المائدة: 64]، وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته.
[ورابعها]: تعطيل الأسماء عن معانيها، وجَحْدُ حقائقها، كقول مَن يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجرَّدَةٌ لا تتضمن صفات، ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون: لا حياة له، ولا سمع، ولا بصر، ولا كلام، ولا إرادة تقوم به، وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلًا وشرعًا ولغةً وفطرةً، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أَعْطَوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله، وجحدوها وعطّلوها، فكلاهما مُلْحِد في أسمائه.
ثم الجهمية وفُروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي، والمتوسط، والمنكوب.
وكُلُّ مَن جَحَد شيئًا مما وَصَف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله – صلى الله عليه وسلم -، فقد ألحد في ذلك، فليستقلّ، أو ليستكثر.
[وخامسها]: تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى الله عما يقول المشبِّهون علوًّا كبيرًا، فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، فإن أولئك نَفَوا صفة كماله وجحدوها، وهؤلاء شبَّهوها بصفات خلقه، فجَمَعَهُم الإلحاد، وتفَرَّقت بهم طرقه.
وبَرَّأ الله أتباع رسوله – صلى الله عليه وسلم -، وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يَصِفُوه إلا بما وَصَف به نفسه، ولم يَجحدوا صفاته، ولم يشبّهوها بصفات خلقه، ولم يَعْدِلوا بها عما أُنزِلت عليه لفظًا ولا معنًى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات، ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئًا من التشبيه، وتنزيههم خليًّا من التعطيل، لا كَمَن شَبَّهَ حتى كأنه يعبد صنمًا، أو عَطَّل حتى كأنه لا يعبد إلا عدمًا.
وأهلُ السنة وَسَطٌ في النِّحَل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، تَتَوَقَّدُ مصابيح معارفهم من {شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ} [النور: 35]، فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره، ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته، ومتابعة رسوله – صلى الله عليه وسلم -، إنه قريب مجيب.
فهذه عشرون فائدةً مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى، فعليك بمعرفتها، ومراعاتها، ثم اشْرَحْ الأسماء الحسنى، إن وجدت قلبًا عاقلًا، ولسانًا قائلًا، ومحلًّا قابلًا، وإلا فالسكوت أولى بك، فجناب الربوبية أجلّ وأعزّ مما يخطر بالبال، أو يُعَبِّر عنه المقال، {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف: 76] حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكل شيء علمًا.
وعسى الله أن يُعِين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى، مراعيًا فيه أحكام هذه القواعد، بريئًا من الإلحاد في أسمائه، وتعطيل صفاته، فهو المانُّ بفضله، والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلام الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى، ولقد شفى، وكفى لمن تأمّله بالإنصاف، ولم يُعم بصيرته التقليد والاعتساف.
{رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8)} [آل عمران: 8]، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، اللهم آمين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
__________
(1) “شرح صحيح مسلم” 2/ 90 – 91.
(2) “الفتح” 11/ 226 – 227 “كتاب الدعوات” رقم الحديث (6410).
(3) قال في “القاموس”: “الْمَرْخُ”: شجر سريع الْوَرْي، و”الْعَفَارُ” كسحاب: شجرٌ يُتّخذ منه الزناد، وقال أيضًا: استمجد الْمَرْخُ والْعَفَارُ: استكثرا من النار. انتهى. ص 236 و 288 و 398.
(4) أي أشبعها، أو علفها ملء بطنها، أو نصف بطنها. انتهى. “ق” ص 288.
(5) هكذا قال ابن القيّم، والمقام مقام نظر، وتأمّل، والله تعالى أعلم.
(6) حديث صحيح، أجاد في تخريجه الشيخ الألبانيّ رحمه الله تعالى، راجع: “الصحيحة” 4/ 49 – 51 رقم (1535).
(7) ذكر الحافظ ابن كثير في “تفسيره” كلام ابن عباس – رضي الله عنهما – هذا مطوّلًا، فقال: قال علي بن طلحة، عن ابن عباس: هو السيّد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه، هذه صفته، لا تنبغي إلا له، ليس له كفء، وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهّار. انتهى. “تفسير ابن كثير” 14/ 513.
(8) وقع في النسخة: “ابن وائل”، والظاهر أنه تصحيف، راجع: “تفسير ابن كثير” في “سورة الإخلاص”، والله تعالى أعلم.
(9) هو ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في “مسنده”، فقال:
(3528) حدثنا يزيد، أنبأنا فضيل بن مرزوق، حدثنا أبو سلمة الجهنيّ، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله، قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: “ما أصاب أحدًا قط همّ، ولا حزنٌ، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سَمَّيت به نفسك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجَلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله هيه وحزنه، وأبدله مكانه فرجًا”، قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: “بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها”.
وقوله: “فرجًا” بالجيم، وفي رواية “فرحًا” بالحاء المهملة.
وهو حديث صحيح، على الراجح، وقد أشبع الكلام فيه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على “المسند” (5/ 267)، والشيخ الألبانيّ في “الصحيحة” (1/ 336 – 341) رقم (199)، فراجعه تستفد.
(10) متّفق عليه.
(11) رواه مسلم وأبو داود.
(12) متّفقٌ عليه.
(13) أخرجه ابن جرير في “تفسيره” 24/ 692، وأبو الشيخ في “العظمة” (98)، والبيهقيّ في “الأسماء والصفات”، وفي إسناده: أبو صالح كاتب الليث، وهو متكلّم في حفظه.
المصدر : البحر المحيط الثجاج 3 / 102-118


![]() ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .